
تأتي رواية «كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضّك» للكاتب الجزائريّ «عمارة لخوص» لترصد حدثا بوليسيّا مشتبكا، يبدو من خلاله جميعُ الشخوص منشغلين بواقعة مقتل الشاب الإيطاليّ «لورانزو مانفريدي» واختفاء قاتله الافتراضيّ «أماديو» الذي يسيطر على تفكيرهم جميعا، ويستثير فضولهم بغموضه وبراعته، وتعامله الحسن مع الجميع.
بهاء بن نوار
يتضخّم حضورُ «أماديو» ويمتدّ، ليغطي على جميع التفاصيل، ويصبح سؤال الرواية وهاجسها، فهو العنصر المهيمن على الأحداث، وواقعة اختفائه هو أهمّ بكثيرٍ من واقعة موت إنسانٍ آخر، اُفتُكّت حياتُه، وسُلبت في مصعد البناية، التي يقطنها جميع الشخوص، من إيطاليّين، ومهاجرين.
لا أحد فيهم يفهم الآخر، ووحده هذا «الإيطاليّ» البارع يستوعب الجميعَ ويحتويهم، وقد أصبح ببساطةٍ مفصلَ الرواية وعصبَها، حيث أمعن الكاتبُ في إثارة فضولنا حوله، فكان يقدّم لنا بعد كلِّ فصلٍ على لسان أحد الشخوص فصلا مونولوجيّا مستقلا على لسانه، يكشف فيه بعضَ حالاته، ويزيح الغشاوة عن معاناته، دون أن تتكشّف هويّته الحقيقيّة أو تبين، فتأتي هذه الفصول البوحيّة غير بائحةٍ بشيءٍ، بل على العكس من ذلك، تأتي على غايةٍ من الغموض، والالتباس، وتتأكّد في كلِّ واحدٍ منها عبثيّة النبش وراء الحقائق، ومحاولة تعريتها، فما من حقيقةٍ واضحةٍ سوى حقيقة الوحشة، والعزلة، والانطواء على آلام النفس، وصرخاتها.
ولنتأمّل بعضَ اعترافاته العوائيّة: «الغراب هو أول خبيرٍ في دفن الأموات في التاريخ. أنا غرابٌ من نوعٍ خاصٍّ: مهمّتي هي دفنُ الذكريات الملوثة بالدم.» (ص46)
«البقاء في الكهف أفضل من الخروج منه. لا فائدة من معرفة الحقيقة. العزاء الوحيد هو هذا العواء الليليّ. أووووووووووووو...»(ص48)
«أنا أعشق إجهاضَ الحقيقة. العواء هو إجهاضُ الحقيقة. أوووووووووو»(ص82)
ويبدو من خلال هذه المقاطع – وغيرها كثيرٌ- مدى ولع «أماديو» بمراوغة الحقيقة ومخاتلتها، فهو لا يعتدّ بها، ولا يأبه بها: إنّه في هذه المقاطع يفضي ولا يفضي، يظهر ويخفي، ويصيح، ويتكتّم؛ يبوح بألمه، وتشظّيه، ولا يبوح بشيءٍ من أسبابهما وملابساتهما.
وفي أثناء هذا الاعتراف الكتوم، تتصاعد صراعات بقيّة الشخوص من إيطاليّين أو مهاجرين، وتتكاثف مسافاتُ اللبس والغموض في علاقاتهم، فلا أحد فيهم يفهم الآخر، أو يطيقه، جميعهم منطوون على ذواتهم، ومنغلقون على افتراضاتهم؛ فالعجوز «إليزابيتا» التي خاب أملها في ابنها الوحيد «ألبرتو» الذي هجرها، تفرغ طاقات الحب والاهتمام كلّها في كلبها الصغير «فالنتينو» وحين تفجع باختفائه، يغدو جميع سكان العمارة – وبخاصة المهاجرين منهم – متّهمين باختطافه، واِلتهامه، فهي تتوجّس من «برويز» الإيرانيّ الذي تعتقد أنّه غجريّ(ص65) وتشكّ في الصينيّين وأهل سردينيا(ص67) ولا تني توزّع اتّهاماتها على الجميع، عدا أماديو المنزَّه عن الشكوك، لأنه وحده مَنْ كان يحبّ الكلبَ، ويحتمل نباحه الليليّ الطويل(ص61) فيما تصبّ بوّابة العمارة «بنديتا» نقمتها كلّها على «إقبال» البنغاليّ – الذي تعتقد أنّه باكستانيّ، وتتّهمه بالمتاجرة في المخدرات، وإدارة شبكة دعارة(ص47- 48) ولا تحاول أبدا التعرّف إلى «ماريا» القادمة من «بيرو» بل تصرّ على أنّها من الفلبين(ص76) وتبدو هذه المهاجِرة على غايةٍ من التمزّق والضياع، فلم تأتِ إلى إيطاليا إلا بحثا عن الزوج والبيت والأطفال، ولم تجد لنفسها من ملاذٍ حين لم تنل أيّا من أمنياتها، سوى: الجنس والأكل، والتلفزيون(ص79)
ولا يقلّ احترابُ الإيطاليّين، وعدوانيّتهم فيما بينهم عن عدوانيّتهم مع المهاجرين، فهذا «أنطونيو» القادم من «ميلانو» لا يتوقف عن ذمّ «روما» والقدح فيها(ص84) ومثله يفعل «ساندرو» ابن «روما» الذي لا يطيق الجنوبيّين من «نابولي» ولا الشماليّين» من «ميلانو».
جميعهم مختصمون، ومتشنّجون، ولا يثق الواحدُ منهم إلا في «أماديو» الكاريزميّ الذي استطاع أن يحتوي خلافاتهم كلّها، ويوحّد أهواءهم؛ فهو صديق المهاجرين، يفهمهم جيّدا، ولا يتعالى عليهم، وبالقدر نفسه هو صديق الإيطاليّين، يعرف عاداتهم وطقوسَهم جيّدا، ولا يسيء أبدا نطقَ لغتهم، أو محاكاة يوميّاتهم.
إنّه منصهِرٌ فيهم، ومنشقٌّ عنهم: يتآلف معهم نهارا، فتلتقي في ذاته المفردة هواجسهم الجمعيّة، وانشغالاتهم اليوميّة، ويتمرّد عليهم ليلا، فينأى بأوجاعه الغامضة عنهم، ويتفرّد بصوته الحميم، الذي لا يشبه أيّا من أصواتهم، ممّا بدا بجلاءٍ من خلال موضوعة: «المصعد» الذي ظلَّ دائما مصدرَ اهتمامهم وهوسهم جميعا؛ يتجادلون حوله، ويختصمون، ويعقدون اجتماعاتٍ كثيرة للبتّ في طرق العناية به وتزيينه، فبدا بهذا سفينة تائهة يحاول كلُّ واحدٍ منهم أن يكون قبطانها(ص99) ولم يزد على أن يكون في نظره هو قبرا وجحيما: «هذا المصعد هو ديكورٌ لكابوسٍ أراه في نومي من حينٍ لآخر، بل هو قبرٌ ضيِّقٌ وبلا نوافذ.» (ص103)
إنّه الذات الجذّابة، الليليّة الإيقاع، المتجاوزة كينونتها البشريّة النسبيّة، والمتماهية مع ذاتٍ أكبر وأوسع؛ هي ذات المدينة كلّها: «روما» بتاريخها الغابر، وحاضرها الراهن، وبشرها، وحجرها، وكلِّ ما ينبض بالحركة والحياة فيها، لقد غدا ذئبا حقيقيّا، يمتزج عواؤه الليليّ الجهوريّ بعواء المدينة المبطن، يتناغمان معا، ويتضافران، ويزداد فضولنا مع كلِّ فصلٍ يعبر عن هويّته الأصليّة، وعن سرِّ حزنه، وتفرّده، وانشقاقه الروحيّ عن العامة والمجموع: فمن هو «أماديو»؟ وما هو سرّه الغائر، وجوهره الدفين؟
لا يطول بنا الانتظارُ كثيرا، فسرعان ما يكشف لنا الكاتبُ ما أمعن في إخفائه، والتعمية عليه طوال فصول الرواية، فيفرد جزءا منها على لسان «عبد الله بن قدور» جار «أماديو» ورفيق طفولته، الذي يسقط جميعَ الأستار، ونعلم من خلاله أنّ هذا الشخص الإشكاليّ لم يكن سوى مهاجرٍ جزائريٍّ، وواحدٍ من ضحايا الإرهاب الذي عصف بالبلاد خلال التسعينيّات، ففقد حينها خطيبته «بهجة» – ولنتأمّل التعالق الكبير بين هذا الاسم، وبين الاسم الذي يُطلَق على العاصمة – ولم يبق أمامه سوى الرحيل، والغياب، مثيرا في مستقرِّه الجديد كثيرا من الغموض والأسئلة لازماه أيضا في مهده ووطنه، فلم تفارقه الشائعاتُ والتخميناتُ في كليْهما، ولولا تطوّع «ابن قدور» بكشف سرِّ هويّته وتفاصيل ماضيه لظلاّ معتميْن أمامنا، ومثله فعل المفتِّش «ماورو بتاريني» الذي كشف سرَّ اختفائه الغامض، وفكّك لغز الجريمة التي اتَهِم بها، فلم يكنْ قد لاذ بالفرار كما تشير جميعُ القرائن، بل كان قد تعرّض لحادث مرورٍ، أدخله في غيبوبةٍ طويلةٍ، قد يفيق منها معطوبَ الذاكرة، كما أماط اللثامَ أيضا عن القاتل الحقيقيّ، الذي لم يكن سوى العجوز «إليزابيتا» التي تظاهرت بالجنون حزنا على كلبها، وانتهزت أول فرصة لتطعن مختطِفَ كلبها في المصعد؛ بؤرة التصارع والاشتباك في الرواية.
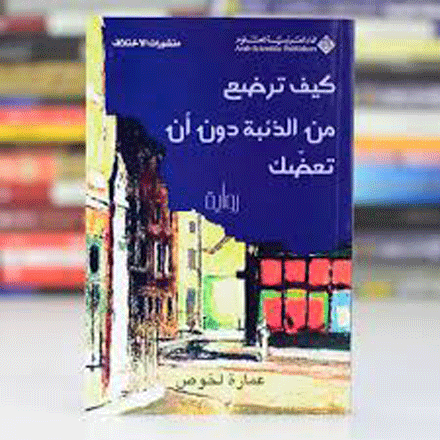
هكذا يضع الكاتبُ ختامَ الأحداث، بالإجابة على الأسئلة كلِّها، وتبديد الغموض والضباب المتلبِّسيْن بعلاقات الشخوص وحالاتهم، ولا يفوته أن يكون آخر الفصول عواءً أخيرا لأحمد/ أماديو ينعى فيه حبَّه الضائعَ، وذاكرته المفقودة، وقد تماهى بذات شهرزاد التي تماطل الموتَ بالحكي، ويماطله هو بالعواء؛ كلاهما يرفض الصمتَ، ويأبى الخضوعَ.
ورغم براعة الكاتب العالية في صياغة هذا الختام، وحذقه العالي في مراوغة قارئه، وإثارة فضوله، وتكثيف تلك الهالة الهائلة من الإلغاز والغموض حول الشخصيّة المفصليّة «أحمد» وقد قدّم لنا حقيقته على جرعاتٍ شحيحةٍ كما الدواء(ص149) فإنّ سؤالا ملحّا جدّا يُطرَح حول جدوى كشف جميع الأوراق، والإجابة بوضوحٍ على جميع الأسئلة: أكان لزاما أن نعرف حقّا مَن هو «أحمد»؟ وأن يُهتك أمامنا لغزُ اختفائه؟ هل يعنينا حقّا أن نعرف مَنْ هو مرتكِب جريمة القتل؟ وأن نفهم ملابساتها، وسياقاتها؟ وبدايات خيطها الأول: اختطاف الكلب، ومقتله في إحدى مصارعات الكلاب السريّة؟
أعتقد أنّ كشف هذه التفاصيل كلِّها لم يكن منسجما مع ذلك السحر الفاتن الذي أجاد الكاتبُ بثّه ونفثه فينا؛ لقد كان أحمد/ أماديو غامضا جدّا طوال أغلب فصول الرواية، وشقٌّ كبيرٌ من جاذبيّته مستمَدٌّ من ذلك الغموض، فلم يكن مناسبا – حسب رأيي – تبديده فجأةً، وإنزاله من ليليّة وجعه/ عوائه الحميم، إلى نهاريّة أقنعته، واحتكاكاته اليوميّة مع بقيّة الشخوص.
أمّا تفاصيل الجريمة، فلم تكن بذات أهمّيةٍ منذ البداية، ولم يكن مقتل ذاك الشاب الإيطاليّ ليشغل سوى جزءٍ ضئيلٍ جدّا من سيرورة الأحداث وتطوّراتها، لذا لا أرى من المفيد كشفُ لغز قاتله، كما يحدث في أيّة روايةٍ بوليسيّةٍ عاديّةٍ.
لقد كان عصَب هذه الرواية وجوهرها عن صراع الهويّات وتناحرها، وعن سوء الفهم القدَريّ، الذي لم ينج من التورّط فيه أغلبُ الشخوص، وكان العواء صوتا متفرِّدا كونيّا تخلّل تلك الأصوات الجمعيّة المختلطة، وكم كان خيط السرد سيستمرّ متينا لو استمرّ الكاتبُ في مخاتلة وعينا، واستثارة فضولنا، بمزيدٍ من الغموض، والأسئلة، والأكاذيب المقصودة أو العفويّة، دون إجاباتٍ واضحةٍ، ودون حقائق ثابتة.












 في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...
في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...