
تبرز السيارات الكهربائية كأحد الحلول الناجعة في طريق التحوّل العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، يعد بعالم نظيف وخال من الانبعاثات الكربونية، ويراهن البعض على أنها البديل الأكثر صداقة للبيئة، خصوصا في ظل تسارع عجلة الابتكار لاعتمادها بشكل أكثر، مع ذلك تطرح تحديات بيئية، وتقنية، واقتصادية أمام هذا المسعى، ويعتبر خبراء أن الانتقال سيكون معقدا، خصوصا وأن هناك أسئلة مهمة لا تزال تطرح بخصوص مدى الاستدامة الفعلية لهذه المركبات.
إعداد :إيمان زياري
يشهد العالم تحوّلا جذريا نحو ما يصطلح عليه بالتنقل الكهربائي، الذي يشكل خطوة كبيرة ومهمة نحو تحقيق هدف استدامة البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية التي يفرزها خط النقل التقليدي.
وتأتي السيارات الكهربائية، والحافلات، والدراجات الكهربائية كحل مثالي وأكثر انتشارا، مدعوما بتطورات تكنولوجية مستمرة، تعمل على توفير حلول مبتكرة لكل تلك العراقيل والصعوبات التي تواجه هذا الحلم الأخضر، كما يبرز ذلك التغيير الشامل في النظرة العالمية نحو الحفاظ على البيئة وبناء مستقبل أكثر استدامة.
وتزيد الحاجة إلى هذا البديل في ظل ثورة السيارات الكهربائية التي تعرف زخماً متزايداً على مستوى العالم، وتزايد المخاوف بشأن تلوث الهواء، وانبعاث الكربون، والتكاليف العالية للوقود التقليدي، حيث تعتبر السيارات الكهربائية حلا للعديد من تحديات النقل في العالم، مشكلة لاعبا رئيسيا في معادلة مكافحة تغير المناخ.
مع ذلك، يواجه هذا التحول العديد من التحديات البيئية واللوجيستية بداية بمصادر الطاقة، والمواد الخام المستخدمة في البطاريات، ووصولا إلى إعادة التدوير بعد انقضاء العمر الافتراضي للبطارية.
استمرار في نمو المبيعات العالمية
يكشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية صادر منتصف ماي الجاري، أنه وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة حول مستقبل السيارات الكهربائية في العالم، إلا أنه تم تسجيل عام آخر من النمو القوي، وصارت حصة سوق السيارات الكهربائية على مشارف تجاوز 40 بالمائة بحلول عام 2030، مع تزايد أسعارها في السوق العالمية.
ويظهر التقرير، أنه من المقرر أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية العالمية 20 مليون سيارة في هذا العام 2025، وهو ما يمثل أكثر من ربع السيارات المباعة في جميع أنحاء العالم وفقا للنسخة الجديدة من تقرير التوقعات العالمي للسيارات الكهربائية السنوي، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.
ويظهر ذات المصدر، أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الأخيرة التي ضغطت على قطاع السيارات، فقد واصلت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية تحطيم الأرقام القياسية مع تزايد أسعار الطرازات الكهربائية، بحيث تجاوزت المبيعات 17 مليون سيارة عالميا في عام 2024، مما يرفع حصة هذه المركبات في سوق السيارات إلى أكثر من 20 بالمائة لأول مرة، وفقا لتوقعات الوكالة التي قالت إن مبيعات السيارات الكهربائية قد ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025 بنسبة 35 بالمائة على أساس سنوي.
وقد شهدت جميع الأسواق الرئيسية والعديد من الأسواق الأخرى، أرقاما قياسية جديدة لمبيعات الربع الأول من العام.
ورغم الشكوك الكبيرة التي ما تزال تحيط بملف السيارات الكهربائية، إلا أن الطلب على هذه المركبات يشهد نموا قويا عالميا، ما يعكسه حجم المبيعات التي تسجل أرقاما قياسية جديدة، بما يؤثر بشكل كبير على صناعة السيارات العالمية.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول :» نتوقع هذا العام أن تباع سيارة كهربائية واحدة من بين كل أربع سيارات مباعة عالميا مع تسارع النمو في العديد من الاقتصاديات الناشئة، وبحلول نهاية العقد من المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة سيارتين من أصل كل 5 سيارات».
أما بالنسبة للأسعار، فيشير تقرير الوكالة إلى انخفاض متوسط سعر السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية في عام 2024، وذلك في ظل تزايد المنافسة وانخفاض التكاليف.
* الباحثة في مركز تنمية الطاقات المتجدّدة سعيدة مخلوفي
الجزائر سوق واعدة
تؤكد الباحثة في مركز تنمية الطاقات المتجددة، الدكتورة سعيدة مخلوفي، بأن سوق السيارات الكهربائية تشهد زخما كبيرا في خضم حاجة ملحة للانتقال نحو بديل آمن بيئيا، لكن الطريق سيكون طويلا نحو اعتماد واسع النطاق لهذه السيارات في الجزائر، لأنه لا يزال مليئا بالتحديات، بدءا من الفجوات في البنية التحتية إلى تردد المواطن والمستثمرين.
مشيرة، إلى العديد من العقبات التي ترى بأنه من الواجب التغلب عليها قبل أن تنتشر السيارات الكهربائية على الطرق الجزائرية.
ضعف البنية التحتية للشحن أول عائق
ويُعد ضعف البنية التحتية للشحن في نظر الباحثة، أحد أبرز التحديات أمام اعتماد السيارات الكهربائية في الجزائر، وتكشف أنه وإلى غاية الآن تم تركيب 1000 نقطة شحن موزعة على كامل التراب الوطنى، وإدراكاً لهذا التحدي، تقول إنه يتعين على الشركات المصنعة والموردين التعاون مع الجهة المعنية لضمان توفير الشواحن على نطاق واسع، مع التركيز على المواقع الاستراتيجية مثل الطرق السريعة، والمراكز الحضرية، والمجمعات السكنية، للقضاء على هاجس انحصار المدى وتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية.
التكلفة الأولية مرتفعة
وتعتبر الدكتورة مخلوفي، التكلفة الأولية المرتفعة لاستيراد السيارات الكهربائية وإنشاء شبكة نقاط الشحن مصدر قلق رئيسي في الجزائر موضحة، أن تجاوزه ممكن من خلال تبني سياسة تخفيض التكاليف عبر إلغاء الرسوم الجمركية على المكونات الأساسية للسيارات الكهربائية وهي خطوة حيوية بالنسبة لها، بحيث تُسهم هذه السياسة في خفض تكاليف الصيانة، مما يجعل الأسعار أكثر تنافسية.
وللتحكم أكثر في الأسعار، ينبغي بحسب الخبيرة إعطاء الأولوية لتوطين إنتاج البطاريات، وتحقيق وفرة الحجم في التصنيع على المدى الطويل والتركيز على دور التقدم في تكنولوجيا البطاريات، بحيث من المتوقع أن تصبح أسعار السيارات الكهربائية أكثر تنافسية، مما يتيح للجزائر فرصة لعب دور بارز في تصنيع البطاريات وإعادة تدويرها، أو استعمالها في تطبيقات أخرى.
وضع تسعيرة تنافسية لشحن السيارات الكهربائية
وتقول الباحثة، إنه بالنظر إلى دعم الحكومة الجزائرية لأسعار الوقود والكهرباء، فإن نجاح المرحلة الأولى لنشر السيارات الكهربائية ممكن، مع ضمان رضا الزبائن من خلال تقديم أسعار تنافسية، وهذا التوجه يشكل كما أوضحت، أحد التحديات الرئيسية لتعزيز سياسة التنقل المستدام في الجزائر. وأضافت، بأن بلادنا تتمتع بظروف ممتازة لتطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي يمكن أن تكون مصدرًا نظيفًا لطاقة شحن بطاريات السيارات الكهربائية.
ولأجل دعم هذا التوجه أجرت مخلوفي، دراسة حديثة على مدينة الجزائر العاصمة، استعرضت فيها الفوائد التقنية والاقتصادية للسيارات الكهربائية ومحطات الشحن المرتبطة بها، أين ركزت الدراسة على زيادة تدريجية في مسافات التنقل الأسبوعية، مع تركيب نظام طاقة شمسية في موقف السيارات القريب من محطة المترو.
وأظهرت الدراسة، أن السيارات الكهربائية يمكنها تغطية أكثر من نصف استهلاكها للطاقة من نظام الطاقة الشمسية، مما يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 40% في المتوسط. ويمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 50% عند التنقل لمسافات أقل من 1000 كيلومتر أسبوعيًا.
وتؤكد النتائج المتحصل عليها قدرة الأنظمة الشمسية على تقليص تكاليف التنقل، خاصة عند استخدام محطات الشحن المنزلية، مما يعزز من جدوى السيارات الكهربائية، ويمهد الطريق لانتشارها الواسع في الجزائر.
حذرت الدراسة مع ذلك، من الاعتماد المفرط على محطات الشحن عالية القدرة، التي قد تعاني من انخفاض في نسبة تشغيلها في المرحلة الأولى من الاستخدام.
نقص الوعي لدى المواطن
وتقول الباحثة، إن المواطن الجزائري لا يزال غير مدرك لفوائد السيارة الكهربائية، وأن العديد من الأفراد ينظرون إلى السيارات الكهربائية كمنتج غير مألوف، ويفتقرون إلى المعرفة حول التوفير طويل الأجل والفوائد البيئية التي تقدمها هذه السيارة. ولمعالجة هذا الأمر، يجب على الشركات والهيئات الحكومية استيراد السيارات، واعتماد حملات توعية واسعة النطاق، ويمكن حسبها أن تلعب التجارب العامة للقيادة، والبرامج التعليمية، والحوافز للمستهلكين دورًا حاسمًا في تعريف المواطن بالتنقل الكهربائي، وإبراز إمكانية التوفير في حجم تكاليف الوقود، والصيانة الدنيا، والفوائد البيئية، وهذا ما ترى بأنه سيساعد في تغيير تصورات المواطن والتحول إلى اقتناء سيارة كهربائية.
تكنولوجيا البطاريات وقيود المدى
تصنف الدكتورة مخلوفي، أداء البطاريات ضمن أحد الهموم الأساسية للأشخاص الذين يفكرون في اقتناء سيارة كهربائية، فعلى الرغم من تحسن بطاريات السيارات الكهربائية، إلا أنها لا تزال حسبها لا تتطابق مع المدى أو الراحة التي توفرها السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.
ويشكل المدى المحدود مصدر قلق كبير خاصة للجزائريين الذين اعتادوا حسبها، التنقل لمسافات طويلة أو التجول بالسيارة، كما تؤثر التكلفة العالية للبطاريات بشكل كبير على السعر الإجمالي للسيارات الكهربائية. ولمعالجة هذه المشكلات، تدعو الخبيرة المستوردين لاختيار أنواع السيارات بعناية، من حيث كفاءة البطاريات وأدائها وعمرها الافتراضي، علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم الابتكارات في تقنيات الشحن السريع وأنظمة تبديل البطاريات في معالجة قلق المدى ومشكلات الراحة بشكل أكبر.
وتهدف هذه السياسة كما قالت، إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للبطاريات مع تقليل الاعتماد على الواردات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى بطاريات أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة، ومع استمرار تطور تكنولوجيا البطاريات، ترى بأن المستهلك سيستفيد من بطاريات أطول أمدًا، وبتكلفة مقبولة، وذات أداء أعلى، مما يجعل السيارات الكهربائية خيارًا أكثر جاذبية.
من جانب آخر، تسلط الباحثة الضوء على دور النصوص والقوانين التنظيمية، وتقول إنه و بدون سياسات مدروسة ومستقرة، قد يتردد المستهلكون، والمصنعون، والموردون في الاستثمار طويل الأجل في التنقل الكهربائي، ولذلك تشدد الباحثة، على ضرورة وجود إطار تنظيمي متكامل يشمل حوافز مستدامة طويلة الأمد.
علاوة على ذلك، فإن تحديد أهداف واضحة لتبني السيارات الكهربائية إلى جانب تشريعات تنظيمية مرنة، سيوفر بيئة سياسية شفافة ومستقرة تعزز الثقة اللازمة لتطوير وتحديث قطاع النقل.
نظام الصيانة والخدمة
وقالت الدكتورة مخلوفي، إن السيارات الكهربائية تتطلب صيانة أقل مقارنة بالسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، إلا أن الجزائر يجب أن تستعد للمرحلة بالتفكير في إنشاء مراكز خدمة متخصصة، و تحضير فنيين مؤهلين في هذا المجال. وبحسب ما نبهت إليه الباحثة، فإن غياب نظام خدمة متين قد يمنع المشترين المحتملين من التحول إلى السيارات الكهربائية.
ولمواجهة هذا التحدي، يتعين علينا كما أوضحت، إنشاء شبكة خدمات قوية مزودة بكوادر مدربة وموارد كافية، تشمل الحلول المقترحة لتوسيع شبكة الخدمات، من خلال إدخال وحدات خدمة متنقلة للصيانة و تطوير منصات عبر الإنترنت للبحث عن مركز خدمات وصيانة قريب.
ومع توسع سوق السيارات الكهربائية، تتوقع الخبيرة أن ينمو نظام الخدمة بشكل طبيعي، مما يجعل من السهل على المستهلكين صيانة سياراتهم.
تبنّي الحافلات الكهربائية بين الطموح البيئي والواقع الاقتصادي
توضح الباحثة من جهة ثانية، أن الجزائر تتمتع بشبكة واسعة من الحافلات تشكل العمود الفقري لوسائل النقل الجماعي، ومع ذلك تقول خبيرة الطاقات المتجددة سعيدة مخلوفي، إن الاعتماد المستمر على وقود" الديزل" يضر بالبيئة والمواطنين على حد سواء، ما يفرض تحولا نحو استخدام الحافلات الكهربائية يشمل الطرق بين المدن، وهو ما من شأنه أن يساهم في خفض الانبعاثات، وتقليل تكاليف النقل، وتطوير وسائل النقل الجماعي.
وعلى الرغم من أن الحافلات الكهربائية تتطلب استثمارًا أوليًا مرتفعًا، إلا أنها توفر حسب محدثتنا مزايا مالية على المدى الطويل، فهي تحتاج إلى صيانة أقل بكثير، مما يلغي العديد من التكاليف المرتبطة بمحركات "الديزل".
وحسبها، فإنه مع مرور الوقت ستؤدي وفرة الوقود وتقليل الصيانة إلى جعل هذه المركبات خيارًا أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية، علاوة على ذلك، فإن دمج محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية، يمكن من تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة.
كيف نتجاوز التحديات؟
رغم الفوائد العديدة للتحول نحو استخدام الحافلات الكهربائية، إلا أن هناك تحديات كبيرة تقول الباحثة، إنه يجب علينا أخذها بعين الاعتبار عند بدء رسم خريطة نشر الحافلات الكهربائية في الجزائر.
ويُعد نقص محطات الشحن من أبرز هذه التحديات، لا سيما في المناطق الحضرية وعلى الطرق السريعة التي تربط المدن، ففي ظل غياب عدد كافٍ من نقاط الشحن، قد يصعب تشغيل الحافلات الكهربائية بكفاءة على المسافات الطويلة. ولضمان نجاح هذا التحول يتعين على كل من الحكومة والقطاع الخاص التعاون لإنشاء محطات الشحن، وخاصة في المناطق التي تشهد كثافة عالية في حركة الحافلات.
ومع وجود شبكة شحن كافية، يمكن للحافلات حسب الباحثة، أن تعمل بسلاسة، ما يشجع السائقين على الانتقال من الديزل إلى الكهرباء بثقة أكبر.
تحديات تقنية تعرقل انتشار الحافلات الكهربائية
تُعد التكلفة من أبرز العقبات التي تواجه التوسع في استخدام الحافلات الكهربائية، وتشير الباحثة إلى أنه حتى مع تقديم الحكومة لإعانات مالية لتخفض أسعار هذه الحافلات، فإن التكلفة تبقى مرتفعة بالنسبة لكثير من الناقلين، مما يجعل عملية التحول صعبة.
وتقترح خيارات التأجير التي ترى بأنها قد تساعد في تخفيف العبء المالي، مع ذلك توضح أنها قد لا تكون مناسبة للجميع، وسيظل الاستثمار الأولي مصدر قلق رئيسي.
وأشارت الخبيرة، إلى أنه رغم تطور تقنيات البطاريات، والجهود المستمرة لزيادة عمرها وتسريع عملية الشحن، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، فزمن الشحن المرتفع وتكاليفه يمثلان عائقًا أمام التشغيل الفعال لمسافات طويلة.
ومن الضروري كما قالت، تحسين هذه الجوانب لضمان تشغيل الحافلات بكفاءة، خصوصا مع استمرار التقدم التقني وتوفير دعم مالي أفضل، حيث يمكن أن يصبح التحول إلى الحافلات الكهربائية أكثر سهولة بمرور الوقت.
* الخبيرة في المناجمنت الطاقوي والبيئي فتحية ياسمين روابح
تأثير بيئي مشجع تقابله مشاكل البطاريات
من جهتها، تؤكد الخبيرة في المناجمنت الطاقوي و البيئي، والتنمية المستدامة، الدكتورة بجامعة البليدة، فتحية ياسمين روابح، أن السيارات الكهربائية تحظى بشعبية متزايدة في ظل تميزها بنقاط قوة تجعل منها محط أنظار الحريصين على حماية الكوكب من التغيرات المناخية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل، إلا أنها تعترف بوجود جملة من العراقيل التي تقول بأنها لا تزال ترهن الانطلاقة القوية لهذه المركبة الخضراء.
وتشير الخبيرة، إلى أن إحدى أكبر نقاط القوة لهذه السيارة تكمن في التأثير البيئي الأقل، بحيث لا تنتج عنها أي انبعاثات لغازات ثاني أكسيد الكربون، أو أكسيد النيتروجين، أو الجسيمات الدقيقة أثناء القيادة، مما يساعد على تحسين جودة الهواء في المدن على مدار دورة حياتها بأكملها.
وتؤكد، أنه رغم إنتاج البطارية والكهرباء، فإن هذه السيارة تملك بصمة كربونية أقل من بصمة السيارة التي تعمل بالوقود، خاصة إذا كانت الكهرباء من مصدر متجدد.
ولأن السيارات الكهربائية تعتمد على الطاقة النظيفة، فإن تكاليف تشغيلها بحسب المتحدثة، تكون أقل من ملء خزان الوقود بالبنزين أو الديزل، خاصة إذا تم شحنها في المنزل خلال ساعات الذروة المنخفضة.
وتضيف الخبيرة في المناجمنت الطاقوي والبيئي، أن السيارة الكهربائية تحتوي على عدد أقل من الأجزاء المحركة لها، مع انعدام محرك احتراق أو علبة ميكانيكية معقدة، أو فلتر زيت وما إلى ذلك، مما يقلل احتياجات الصيانة وبالتالي التكاليف المرتبطة بها.
من جانب آخر، تشير الخبيرة إلى أن العديد من البلدان تقوم بتشجيع شراء هذا النوع من السيارات، وذلك من خلال مساعدات متنوعة مثل المكافئة البيئية ومنحة التحويل أو الرسكلة، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا الضريبية.
وأشارت المتحدثة كذلك، إلى أن المحرك الكهربائي يوفر تسارعا فوريا وخطيا بدون اهتزازات، وقيادة هادئة للغاية، وهذا ما يساهم حسبها في قيادة فائقة ويقلل من التلوث، وغالبا ما تعفى السيارات الكهربائية من قيود المرور مما يوفر حركية أكبر.
هذه نقاط ضعف السيارات الكهربائية
على الرغم من جملة الفوائد التي تضمنها السيارة الكهربائية، إلا أن لديها نقاط ضعف تفرض بعض المخاوف، وقد أوضحت الخبيرة أنه رغم التقدم المستمر في التكنولوجيا إلا أن مدى السيارات الكهربائية لا يزال يمثل عائقا في بعض الأحيان، خاصة في الرحلات الطويلة بسبب الخوف من نفاد الشحنة الكهربائية، وهو ما يجعل منه مصدر قلق على الرغم من تطور محطات الشحن بسرعة.
وتتحدث الخبيرة أيضا، عن وقت الشحن الطويل الذي يكون أكثر من وقت ملء خزان الوقود العادي، فحتى مع الشواحن السريعة يستغرق الأمر 20 دقيقة إلى عدة ساعات حسب قوة الشاحن وحجم البطارية ،كما يطرح كذلك مشكل سعر الشراء الذي ترى أنه يبقى أعلى من سعر الطراز الحراري، وأن تضمن مساعدات حكومية لتقليل الفارق.
وتشير الخبيرة، إلى البنية التحتية للشحن والتي تعترف بتوسعها السريع، إلا أن شبكة محطات الشحن ليست كثيفة ومتاحة مثل شبكة محطات الوقود، وعدم توفر الشواحن خاصة في المناطق الريفية وحتى في المجمعات السكنية.
وتطرقت أيضا، إلى إشكالية عمر البطاريات وإعادة التدوير، لأن للبطارية عمرا افتراضيا كما أن استبدالها قد يكون مكلفا، بينما تعتبر إعادة تدويرها قضية بيئية مهمة خصوصا وأن سلاسل التوريد قيد الإنشاء تتحسن باستمرار.
وتشير الخبيرة البيئية فتحية ياسمين روابح، إلى ثقل البطاريات التي تزيد من ثقل السيارات، ما من شأنه أن يؤثر على استهلاك الطاقة وعلى تآكل بعض المكونات كالإطارات والفرامل، مع ذلك تعتبر بأن السيارة الكهربائية تعكس تقدما كبيرا في مجال التنقل المستدام، لأن لها مزايا بيئية واقتصادية مهمة.
وترى، أنه من الضروري مراعاة القيود المتعلقة بالمدى والشحن، بالإضافة إلى التكلفة الأولية لتحديد ما إذا كانت تتناسب مع احتياجات وأسلوب حياة المواطن الجزائري.
ولكي تنجح تجربة السيارات والحافلات الكهربائية على نطاق واسع في بلادنا، لا بد من وضع خطة واضحة وشاملة، فلا يزال غياب محطات الشحن على الطرق السريعة يمثل أحد أبرز التحديات كما قالت، وبدون شبكة شحن كافية لن تتمكن الحافلات ولا السيارات من إكمال رحلاتها الطويلة بكفاءة، ومن هنا كما عبرت، تبرز ضرورة التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء نقاط الشحن في المناطق الحيوية.
ورغم أن التكلفة ما تزال مرتفعة، إلا أن هناك وسائل لجعلها أكثر جدوى اقتصاديا، فالدعم يخفف من العبء المالي، كما أن إدخال خيارات دفع مرنة قد يُسهّل اتخاذ قرار التحول، ومن شأن تقسيط المدفوعات أن يقلل الضغط، ويُساهم في تسريع التحول من الوقود إلى الكهرباء.
وأوضحت المتحدثة، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكنه أن يُساهم في تقاسم التكاليف وتوفير دعم إضافي. وإلى جانب ذلك فإن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل محطات الشحن، يساعد في خفض تكاليف الكهرباء على المدى الطويل.
وأوضحت، أن الانتقال إلى مركبات الكهرباء في الجزائر يسير ببطء ورغم كل التحديات فإن الاستثمارات الاستراتيجية، والدعم الفعّال ومشاركة المجتمعات المحلية يمكن أن تمهّد الطريق لتحول ناجح، بأنه في حال تبنّي التنقل الكهربائي، فإننا سنكون أمام فرصة كبيرة لتصدر مشهد النقل المستدام.
وأضافت، أن التغلب على تحديات البنية التحتية، التكلفة، الوعي، التكنولوجيا، السياسات، وشبكات الخدمة، أمر حاسم لتحقيق اعتماد واسع النطاق، وذلك من خلال الاستفادة من المبادرات الحكومية، التصنيع المبتكر، والشركات الاستراتيجية، حيث يمكن للمستثمرين المعنيين بقطاع النقل تسريع تحول الجزائر نحو شبكة نقل متطورة وأكثر استدامة.
مؤكدة، على أهمية التخطيط المتكامل، الدعم الحكومي ، والاستثمار المدروس، ودورهم في ضمان نجاح التحوّل نحو تنقل مستدام ناجح.

تتجدد مشاهد تمزيق الكتب والكراريس ورميها عشوائيا في الشوارع ومحيط المؤسسات التربوية مع اقتراب نهاية السنة الدراسية، ما يتسبب في تلوث المحيط وهدر مورد ثمين يمكن تدويره، وتجنبا لتكرار سيناريو السنوات الماضية تجند ناشطون بيئيون ومتعاملون اقتصاديون وجمعيات للتحسيس بأهمية استرجاع الورق خلال هذه الفترة قصد إعادة تدويره، خدمة للبيئة و للاقتصاد معا، وقصد التكريس لثقافة جديدة ينخرط فيها كل أفراد المجتمع بما في ذلك التلاميذ الصغار.
غرس ثقافة بيئية لدى الأطفال
وأكد متدخلون للنصر، أن المعالجة الناجعة لهذه السلوكيات لا تكون فقط بالتحذير من مخاطرها البيئية، بل أيضا عبر غرس ثقافة بيئية لدى الأطفال منذ الصغر، وتشجيع تداول الكتب المستعملة، واستحداث تطبيقات ذكية لتوزيعها على المحتاجين، وتفعيل مشاريع استثمارية لتدوير الورق المدرسي بما يخدم الاقتصاد الأخضر ويحفظ جمالية المحيط.
وتجدر الإشارة، إلى أن السوق المحلية عرفت ظهور العديد من المؤسسات الناشئة والجمعيات التي تنشط في مجال إعادة تدوير الورق والكرتون، بعضها تعمل مقابل مبالغ رمزية، بهدف تشجيع الأفراد على التقليل من التلوث البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من فاتورة الاستيراد وتعزيز الاقتصاد التدويري.
* ياسين طالبي صاحب مؤسسة متخصصة في جمع وتدوير الورق
تدوير الكراريس والكتب المدرسية خطوة بيئية واعدة
كشف ياسين طالبي، صاحب مؤسسة متخصصة في جمع وتدوير الورق والكرتون، عن مشروع اتفاقية مرتقبة سيتم توقيعها خلال السنة الجارية بين مديرية التربية ومديرية البيئة، تهدف إلى تنظيم عملية إعادة رسكلة الكراريس والكتب المدرسية التي يتخلص منها التلاميذ نهاية كل سنة دراسية، بدل رميها أو تمزيقها بشكل عشوائي. وأوضح طالبي، أن مؤسسته تعمل منذ سنوات على جمع كميات معتبرة من النفايات الورقية من المؤسسات التربوية، خاصة تلك التي تظهر انخراطا حقيقيا في تبني ثقافة بيئية. وقد تم في هذا الإطار تزويد عدد من المدارس بحاويات كبيرة مخصصة لجمع الأوراق المستعملة، ليتم نقلها لاحقا إلى مراكز التدوير، ومعالجتها بطريقة تساهم في حماية البيئة وتقليص حجم النفايات. وأكد المتحدث، أن هذه الخطوة ساهمت في ترسيخ وعي بيئي لدى التلاميذ، الذين باتوا أكثر إدراكا لأهمية الورق كعنصر قابل لإعادة الاستخدام وليس مجرد نفاية، كما لاقت المبادرة تجاوبا كبيرا من الأولياء، حيث بادر العديد منهم إلى تسليم كتب وأوراق قديمة متوفرة في منازلهم للمشاركة في العملية.
وأشار طالبي، إلى أن الجمعيات البيئية المحلية تلعب دورا محوريا في تنظيم حملات دورية لجمع الورق، بالتنسيق مع المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، ما يعزز فعالية الجهود الرامية إلى تعميم ثقافة التدوير على نطاق واسع.
وفي سياق متصل، كشف أن مؤسسته تخطط لإطلاق مبادرة جديدة مع نهاية الموسم الدراسي الحالي، هدفها تحفيز التلاميذ على عدم تمزيق أو رمي كراريسهم وكتبهم، بل توجيهها نحو مسار إعادة الرسكلة من خلال جمع منظم ومدروس، يشرك الأطفال في عملية بيئية تربوية عملية.
وعن نوع النفايات الورقية التي تستهدفها المؤسسة، أوضح أنها تشمل الكراريس، والكتب، والكارتون، وحتى الأرشيف الإداري غير المستخدم، مؤكدا أن نهاية السنة الدراسية تعد ذروة النشاط، حيث يتم تسجيل ارتفاع كبير في كمية الأوراق المهملة.
عملية تدوير الورق رافد اقتصادي حيوي
وشدد المتحدث، على أن عملية تدوير الورق لا تسهم فقط في تقليص التلوث البيئي، بل تشكل كذلك رافدا اقتصاديا حيويا، من خلال الحد من استهلاك الموارد الطبيعية وتقليص الاعتماد على الورق المستورد. كما وجه طالبي رسالة للتلاميذ وأوليائهم، داعيا إياهم إلى تبني ثقافة بيئية حقيقية تنطلق من البيت، وتعتمد على الوعي بقيمة الورق وضرورة تدويره بدل التخلص منه عشوائيا، مشيرا إلى أن هذا الوعي يمكن أن يغرس في النفوس منذ سن مبكرة، ليصبح سلوكا يوميا يعكس احترام الفرد لبيئته ومحيطه.
* محمد عقون صاحب مؤسسة لجمع الأوراق المستعملة
سلات ذكية قيد التجربة في المدارس
أكد محمد عقون، صاحب مؤسسة متخصصة في جمع الأوراق المستعملة، أن مؤسسته تنشط منذ سنوات في مجال تدوير النفايات الورقية، بالشراكة مع زملائه إبراهيم حزمون وعبد الستار لخياري وجميعهم مستثمرون حاصلون على رخص رسمية لجمع الورق من المؤسسات التربوية، وذلك في إطار مشروع بيئي طموح يهدف إلى المساهمة في حماية البيئة وخلق مناصب شغل. وأوضح عقون، أنهم قاموا بإنجاز دراسة شاملة حول سبل التخلص من الأوراق المدرسية بطريقة بيئية وصحية، بالتنسيق مع مديرية البيئة، التي أعدت بدورها سجلا خاصا يوثق فيه نوع الورق، ومصدره، ومسار جمعه من نقطة الانطلاق إلى غاية مركز المعالجة أو الرسكلة. وأشار المتحدث، إلى أن هذا المشروع لا يحمل فقط أبعادا بيئية، بل هو فرصة اقتصادية حقيقية تساهم في توفير ما وصفه «ثورة بيئية وتنموية»، خاصة في ظل الانتشار الكبير للنفايات الورقية طوال السنة، وقال إنه مورد يتضاعف بشكل ملحوظ خلال فترة نهاية الامتحانات، حيث تشهد المدارس كميات هائلة من الكراريس والكتب المهملة. وبين عقون، أن التحدي الأكبر يتمثل في ضعف وعي الأطفال بأهمية إعادة التدوير، ما يدفعهم إلى التخلص العشوائي من الكراريس والكتب، دون التفكير في إمكانية استغلالها بطريقة مفيدة.
وفي هذا الإطار، كشف عن شروع مؤسسته المتمثل في تجربة نموذجية لتوزيع «سلات ذكية» داخل المدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية ومديرية البيئة، وهي سلات مخصصة لجمع الكراريس والكتب وحتى الأقلام المستعملة، بهدف فرزها لاحقا وتوجيهها نحو التدوير، مع إبراز بعد توعوي يرافق العملية داخل الوسط التربوي.وأضاف المتحدث، أن عملية التدوير تتطلب توفر شروط معينة في الورق، أبرزها أن يكون نظيفا وغير ملوث بأي مواد «كالأغذية أو المواد الكيميائية»، لأن ذلك يتسبب في تلفه ويمنع إعادة تدويره، مما يجعل عملية الفرز ضرورية قبل كل مرحلة من مراحل الرسكلة.أما فيما يخص مراحل إعادة التدوير، فأوضح أنها تبدأ بعملية الجمع المنظم عبر مؤسسات خاصة تمتلك تجهيزات وعتادا خاصا، يتنقل وفق برنامج عمل مضبوط، كما يجب ضمان تجميع كميات معتبرة من الورق، لأن العتاد المستعمل لا يعمل بكفاءة إذا كانت الكميات صغيرة أو متفرقة. مشددا، على ضرورة ترسيخ ثقافة إعادة التدوير داخل المدارس والأسر، ومشيرا إلى أن الورق ليس مجرد نفايات، بل هو مورد قابل للاستغلال بطرق مستدامة، شرط توفر الوعي والالتزام من جميع الفاعلين، بدءا من التلميذ إلى الإدارة والمجتمع المدني.
* رئيس جمعية البيئة والطبيعة عبد المجيد سبيح
التوعية مهمة لينخرط التلاميذ في خدمة البيئة
وصف رئيس جمعية البيئة والطبيعة عبد المجيد سبيح، تمزيق الكتب والكراريس الذي يتكرر في نهاية كل سنة دراسية، بالسلوك غير المقبول وقال إنه استفحل في السنوات الأخيرة داخل المجتمع، معتبرا أننا أمام أزمة متعددة الأبعاد سلوكية، وتربوية، وبيئية. وأكد سبيح، أن تدخل الجمعية في مواجهة هذه الظاهرة جاء من خلال التنسيق مع مديرية التربية وقطاعات أخرى، حيث تم تركيز الجهود على العمل التوعوي والتحسيسي، باعتباره الأداة الأنجع لتغيير هذا السلوك السلبي.
وأوضح أن الجمعية، اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية، لإيصال رسائلها التربوية والبيئية إلى التلاميذ والأولياء على حد سواء. وفي هذا الإطار، نظمت الجمعية أياما إعلامية و تحسيسية داخل المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، حيث تم إدراج برامج توعوية موجهة خصيصا للتلاميذ، لحثهم على عدم تمزيق الكراريس والكتب المدرسية، وتبني سلوك بيئي راق، يحترم الكتاب والمعرفة.
كما شمل العمل التحسيسي حسب المتحدث المؤسسات الشبانية، ولجان الأحياء، التي تم إشراكها في نشر الوعي داخل الأحياء السكنية، لما لها من تأثير مباشر على الأطفال والمراهقين، معتبرا أن الحي هو الخلية الأساسية في نشر الوعي السلوكي والبيئي. ومن الجانب التربوي، يرى سبيح أن تمزيق الكتب يعكس غيابا في ثقافة احترام العلم والمعرفة، أما من الناحية الاقتصادية، فاعتبر أن هذا السلوك يؤدي إلى هدر مالي كبير تتحمله الأسر سنويا، داعيا إلى تشجيع تداول الكتب والكراريس بين التلاميذ من جيل إلى جيل بدل التخلص منها. وأشار، إلى أن الظاهرة تترك أيضا أثرا بيئيا سلبيا كبيرا، حيث تشوه المحيط العام، خصوصا عند انتشار الأوراق الممزقة في الفضاءات المفتوحة والأحياء. كما حذر، من الخطر الكامن في قابلية هذه الأوراق للاشتعال، خاصة مع حلول فصل الصيف وانتشار الأعشاب الجافة القريبة من المناطق السكنية، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرائق خطيرة. وأكد، أن النظرة المستقبلية لمواجهة هذه الظاهرة يجب أن تقوم على أساس التحسيس المستمر والمتعدد القنوات، سواء عبر المساجد والمدارس، أو وسائل الإعلام وحتى من خلال جمعيات الأحياء. متابعا بالقول، بأنه من المستحسن استرجاع الكتب والكراريس والاعتماد على رقمنتها وإعادة توزيعها على التلاميذ المحتاجين، عبر تطبيق رقمي خاص يسمح بحصر المحتاجين وإعادة توجيه الموارد، بما يضمن النظافة العامة ويعزز التكافل الاجتماعي.
لينة دلول
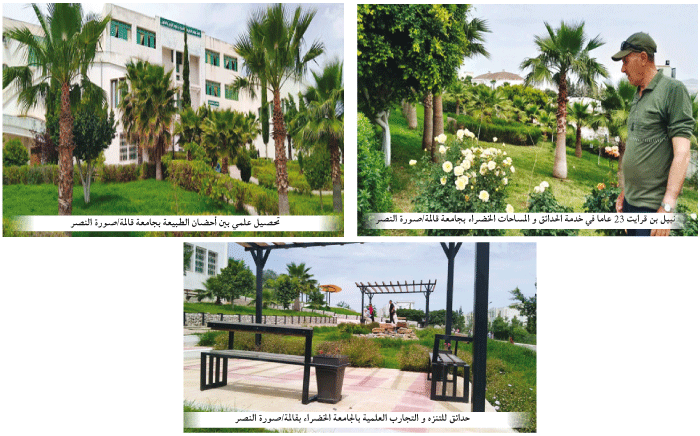
الجامعة الخضراء بقالمة
قطب للعلوم و الآداب وسط بيئة طبيعية مثالية
يعد القطب الجامعي الجديد 5 آلاف مقعد بيداغوجي بقالمة، بمثابة نموذج حقيقي للبيئة المثالية بالوسط التعليمي، بيئة محفزة على التحصيل العلمي، و باعثة على الراحة و الهدوء بين الطلبة و هيئة التدريس، و الموظفين الآخرين الذين يسهرون على أمن القطب الجديد الذي اتخذ من سفح جبل ماونة، موقعا له قبل عدة سنوات، في إطار جهود التوسيع الجارية لمواكبة التحولات الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
قطب علمي واعد، يسميه الطلبة الجامعة الخضراء، مستمدين ذلك من اللون الأخضر الذي يكسو كل المباني، بما فيها رئاسة جامعة 8 ماي 1945، و المدرجات و المخابر و أقسام التدريس و أجنحة الإقامة و القاعة الكبرى للمحاضرات الساسي بن حملة، التي تحتضن الملتقيات الوطنية و الدولية على مدار العام، كل شيء أخضر هنا، حتى الحدائق الجميلة و مواقع الراحة، تحافظ على اخضرارها على مدار العام، متحدية مواسم الجفاف و حرارة الصيف القوية، التي تحول أحراش ماونة إلى هشيم لا حياة فيه.
و تبلغ مساحة القطب الأخضر نحو 21 هكتارا تضم مبنى رئاسة الجامعة و قاعة المحاضرات و كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون، و كلية الآداب و اللغات، و إقامات جامعية و مطعم و حظائر واسعة للسيارات.
و خصص المهندسون، الذين صمموا القطب الجامعي الجديد نحو 30 بالمائة تقريبا من المساحة الكلية، لغرس الأشجار و المساحات الخضراء التي تحيط اليوم بالمباني و حظائر السيارات و على جوانب الأرصفة و الطرقات.
و عندما تدخل الجامعة عبر البوابة الرئيسية، كأنك في منتجع غابي سياحي، عشب دائم الاخضرار و أزهار و أشجار من مختلف الأصناف الدائمة الخضرة، بينها الفيكس ريتيزا التي تلائم مناخ منطقة قالمة، و أشجار أخرى أضفت على المكان المزيد من الجمال و الخضرة على مدار العام.
يقول نبيل بن قرايت، المشرف على المساحات الخضراء و حدائق جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، متحدثا للنصر، بأن عالم النباتات يعد جزءا رئيسيا من مكونات الجامعة الفتية، و في كل كلية مساحات خضراء و حدائق، بها مختلف انواع النباتات و الأزهار و العشب الطبيعي، و حتى أشجار الفواكه كالتين و التوت.
و أضاف نبيل بن قرايت، الذي قضى 23 عاما في خدمة حدائق جامعة قالمة، بأن فرق العمل المنتشرة عبر الكليات و الرئاسة و الحظائر، تعمل دون انقطاع، لغرس المزيد من النباتات و صيانة المساحات الخضراء، بالسقي و التقليم و التصفيف، مؤكدا بأن التواجد المستمر بهذه الفضاءات الخضراء، يعد أمرا بالغ الأهمية، فعندما تغيب عن هذه الفضاءات فإنها تتعرض للتدهور، و لذا تولي رئاسة الجامعة، و عمداء الكليات، أهمية كبيرة لهذه الفضاءات التي تعد مكونا مهما بالوسط الجامعي.
و قد رافقنا نبيل بن قرايت إلى حدائق المجمع القديم، حيث بساتين التين النخيل، و جداول المياه الجارية، و إلى حدائق الجامعة الخضراء، حيث الرئاسة و كلية علوم الطبيعة و الأرض و الكون، و كلية الآداب و اللغات و الإقامات الجامعية، هنا الاخضرار الدائم و العشب الأخضر و الأزهار و النخيل و التوت و الفيكيس ريتيزا، الشجرة المتوسطية المقاومة للجفاف.
و قادنا الرجل بشغف كبير إلى مشتلة التجارب التي تحولت إلى ميدان للبحث و التطوير في مجال الكائنات النباتية المختلفة.
و في كل مساحة خضراء، نظام للسقي يعمل دون انقطاع و عمال البستنة المدربون في حركة دؤوبة للتقليم و التصفيف و التنظيف و السقي، و مراقبة صحة النباتات المختلفة.
و تقع كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الكون و الأرض، في قلب منتجع غابي جميل، في رمزية معبرة عن هذا التخصص العلمي الحيوي، الذي يدرس مكونات الطبيعة و الحياة البرية، و بإمكان الطلبة الاعتماد على مخبر طبيعي، يحيط بهم من كل الجهات لاكتساب المزيد من الخبرة، و إجراء الملاحظات و التجارب على أرض الواقع، لدعم مكتسبات المخابر و الأقسام و الدروس النظرية.
و تحرس رئاسة الجامعة بشدة على المساحات الخضراء، و تعتبرها مكونا رئيسيا من مكونات الجامعة الفتية، الآخذة في التمدد و التوسع تحت سفح جبل ماونة، موطن الزان و الفلين و شجرة الأرز، و المنتجعات الغابية التي صارت قبلة للسياح و الباحثين. و تتكون ممرات المساحات الخضراء من مواد صديقة للبيئة، كالخشب و الحجارة و البلاط، و يجد زوار الجامعة متعة كبيرة بحدائق الجامعة، و يحرس هؤلاء الزوار و الطلبة على أخذ الصور التذكارية الجميلة بهذه الفضاءات الخضراء التي تزداد جمالا كل ربيع.
و تعيش بحدائق الجامعة الخضراء، مختلف أنواع الطيور التي وجدت ملاذات آمنة بهذا الوسط الهادئ، المحمي من مختلف أنواع المخاطر كالجفاف و الحرائق و القطع.
يقول طلبة كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون، الذين وجدناهم بحديقة الكلية، بأن الوسط الطبيعي الأخضر مهم للغاية في الحياة اليومية للطالب، سواء تعلق الأمر بالدراسة و إجراء التجارب، أو بالتنزه و الراحة و الصحة، مؤكدين بأن الجلوس في حدائق الكلية و التجوال فيها، يبعث على الراحة و النشاط، و يخفف من ضغوط الدراسة و الحياة بالإقامات الجامعية. و بدون مياه لن تكون حدائق الجامعة الخضراء، قادرة على الصمود أمام حرارة الصيف و التغيرات المناخية، التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة، و لذا تحرس رئاسة الجامعة على توسيع شبكات السقي، انطلاقا من البئر المكتشف بكلية سوداني بوجمعة و البئر المتواجد بالمجمع القديم.
و عندما يكتمل مشروع التوسيع ستكون كل الحدائق و المساحات الخضراء، مرتبطة بنظام سقي دائم، و سيكون عمال الحدائق المتمرسين في مأمن من مخاطر الجفاف خلال فصل الصيف.
و نظرا لموقعها بجبل ماونة، فقد أبقى المهندسون المصممون للجامعة الخضراء، على مساحات من النباتات البرية السائدة بالمنطقة، كالضرو و الديس و القندول، لتحقيق الاندماج بين البيئة الأصلية للمنطقة، و البيئة المستجدة، المعتمدة على نباتات جديدة لم تكن موجودة من قبل بهذا الموقع الجبلي، المتميز بالتنوع الطبيعي.
فريد.غ
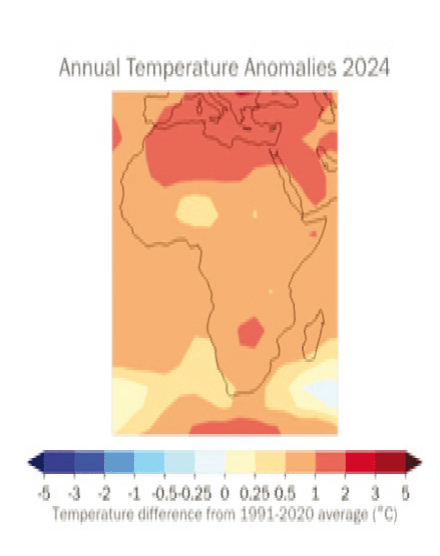
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
درجة الحرارة في إفريقيا كانت الأعلى سنة 2024
صنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية العام 2024 من أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في القارة الإفريقية، بينما بلغت درجة حرارة سطح البحر مستوى قياسيا، مع طقس متطرف كانت له آثار وخيمة على الحياة وسبل العيش.
وشددت المنظمة، أن هذه الظروف تبرز الحاجة الملحة لرفع الوعي باستراتيجيات التكيف وتبني الابتكار الرقمي لتعزيز قدرة إفريقيا على الصمود في مواجهة آثار الظواهر الجوية المتطرفة.
دعوة للوعي باستراتيجيات التكيف الفعالة وتعزيز التكنولوجيا
وأوضحت في تقريرها المفصل الأخير الصادر منتصف ماي الجاري، أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم قد أثرت بشكل كبير على القارة الإفريقية من حيث الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، إذ اعتبر متوسط درجة حرارة الهواء بالقرب من السطح في جميع أنحاء القارة الأعلى أو الثاني على الإطلاق منذ سنة 1900 وإلى غاية الآن. وتحدث التقرير أيضا، عن التذبذب الكبير الذي تم تسجيله في تساقط الأمطار، أين شهدت العديد من المناطق كميات أقل من المعدل الطبيعي، في حين شهدت مناطق أخرى إجمالي هطول أمطار طبيعي أو أعلى من المعدل الطبيعي.
ولوحظت ظروف أكثر جفافا من المعتاد على وجه الخصوص وذلك في الأجزاء الشمالية من جنوب إفريقيا، حيث استمرت الظروف الأكثر جفافا من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. ورصدت زيادة في هطول الأمطار في أجزاء من منطقة الساحل وأجزاء عديدة من وسط وشرق إفريقيا، وشمال شرق مدغشقر، وسيشل وأجزاء من جزر القمر وأجزاء من أنغولا.
سطح البحر صفيح ساخن
كما سلط التقرير الضوء على ارتفاع مستوى سطح البحر، وبين أنه يحدث نتيجة الاستجابة لارتفاع درجة حرارة المحيطات، وذوبان الأنهار الجليدية والغطاء الجليدي والصفائح الجليدية، مما يؤثر على حياة وسبل عيش المجتمعات الساحلية والدول الجزرية المنخفضة، أين كان ارتفاع مستوى سطح البحر في الفترة الممتدة بين 1993 إلى غاية 2024 قريبا من المتوسط العالمي، أو أعلى منه في كل منطقة من إفريقيا، باستثناء جنوب البحر الأبيض المتوسط.وقالت المنظمة الدولية في تقريرها، إن درجة حرارة سطح البحر خلال سنة 2024 كانت هي الأعلى على الإطلاق بناء على جملة البيانات المتحصل عليها، موضحة أن درجة حرارة سطح المحيط تلعب دورا في تحديد مناخ إفريقيا، وذلك من حيث الأمطار والجفاف و العواصف القوية، إذ يقدم تتبع درجات حرارة سطح البحر أدلة حيوية حول أنماط المناخ المتغيرة، و تأثيرها على السكان والنظم البيئية في جميع أنحاء القارة.
ظواهر متطرفة بالجملة
وعن الأحداث المتطرفة، فقد شهدت إفريقيا بحسب ذات التقرير، العديد من الظواهر المتطرفة خلال العام 2024، أين تأثرت بأمطار غزيرة وفيضانات وأعاصير مدارية وجفاف وموجات حر، مما أثر على مختلف نواحي الحياة، بداية بالزراعة والأمن الغذائي.وأدت هذه الأحداث إلى مجموعة متنوعة من التأثيرات على الزراعة والأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة السمراء،وشهدت منطقة شمال إفريقيا انخفاضا في حصاد الحبوب للعام الثالث على التوالي عن المتوسط العام الماضي، وذلك نتيجة لشح الأمطار على نطاق واسع وارتفاع درجات الحرارة بشكل حاد.وقدر إنتاج الحبوب على مستوى المنطقة الفرعية لنفس السنة بنحو 7 بالمائة أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية 2019/2023، بينما أدى الجفاف الحاد الناتج عن ظاهرة النينو إلى انخفاض حاد في حصاد الحبوب لسنة 2024، وانخفض إجمالي الإنتاج بـ16 بالمائة مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها. بينما أثرت الفيضانات على أكثر من 4 ملايين شخص في غرب إفريقيا.
التكنولوجيا و التمويل الدولي لمسايرة التكيف
ومع تكثيف تأثيرات تغير المناخ، ترى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ضرورة في رفع الوعي باستراتيجيات التكيف الفعالة وتعزيز أطر السياسات، وتعزيز الحلول التكنولوجية المبتكرة، معتبرة إياها أمرا حاسما في بناء المرونة المجتمعية والاقتصادية والبيئية في إفريقيا. مشيرة أيضا، إلى أهمية قضية التمويل الدولي لملف التكيف مع تغير المناخ للدول النامية، والذي تقول بأنه وعلى الرغم من تسجيل زيادة فيه من 22 مليار دولار أمريكي سنة 2021 إلى 28 مليار دولار أمريكي سنة 2022، إلا أن التمويل يظل أٌقل بكثير من الاحتياجات السنوية المقدرة والتي تتراوح بين 187 مليار دولار أمريكي و359 مليار دولار.واعتبر التقرير أن التحول الرقمي يعد أمرا بالغ الأهمية لتعزيز نطاق ودقة بيانات الطقس، وتحسين أوقات التنفيذ في تقديم الخدمات في ضوء التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والطقس والظواهر المتطرفة. ويؤكد التقرير، على أن التطبيقات المحمولة، والبث الخلوي، وتنبيهات الرسائل النصية القصيرة، وأنظمة الراديو المجتمعية وغيرها من منصات الاتصال، يمكن لها أن تساعد الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية في الوصول إلى المجتمعات المحلية في الميل الأخير بتوقعات محسنة في الوقت المناسب. واعترفت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، بوجود وعي متزايد بفوائد استخدام المنصات الرقمية في العديد من البلدان في إفريقيا، لتحسين التنبؤات الجوية والتحذيرات المبكرة.
وأوضح التقرير أن 18 مؤسسة وطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في جميع أنحاء القارة الإفريقية، قامت العام 2024 بتحديث مواقعها الإلكترونية وأنظمة الاتصالات الرقمية لديها، وذلك بهدف تعزيز نطاق وتأثير خدماتها ومنتجاتها وتحذيراتها.
مضيفا، أن أطر خدمات الطقس والمياه والمناخ الوطنية والإقليمية تبقى بحاجة لتعزيز التنسيق بين الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية لمعالجة تبادل البيانات المناخية عبر الحدود.
إيمان زياري

أحصت اللجنة الولائية المكلّفة بجرد وتصنيف المساحات الخضراء بقسنطينة وجود ما يقارب 9 مليون متر مربع منها، سنة 2024، فيما ارتفع نصيب الفرد الواحد من هذه الفضاءات إلى 6.66 مترا مربعا بعدما كان في سنوات سابقة 5.1، كما تعمل هذه اللجنة على تشكيل قاعدة بيانات لحماية وتثمين المساحات الخضراء واستحداث هوية لها إذ تشهد العملية تقدما لافتا بلغ نسبة 85 بالمائة.
وأفادت المهندسة البيئية بمديرية البيئة بقسنطينة، نسيمة عليوط، في حديث مع النّصر أنّ هذه العملية جاءت بناء على أحكام القانون رقم 07/06 المتعلّق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، زيادة على القرار رقم 26 المؤرخ في 6 جانفي 2025 المعدّل الناتج عن المرسوم التنفيذي رقم 24_396 المؤرخ في 18 ديسمبر 2024 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء، التي تضم الوالي أو ممثل عنه، رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله كذلك ورؤساء البلديات، بالإضافة إلى ممثلين عن مديريات الثقافة، المصالح الفلاحية، محافظة الغابات، مديرية العمران والأشغال العمومية، زيادة على الموارد المائية والسياحة والصحة، أيضا البيئة والتنظيم والشؤون العامة مع وجود خبير أيضا في مجالي علم النباتات وهندسة المناظر الطبيعية وممثلين عن الجمعيات.
ويراد من خلال هذه العملية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمختلف المساحات الخضراء المصنّفة عبر إقليم ولاية قسنطينة إذ باشرت اللجنة عملها منذ أزيد من سنة وبلغت العملية وتيرة متقدّمة تناهز 85 بالمائة إذ لا تزال هناك بعض المناطق والهياكل التي سيشملها عمل اللجنة حتى تكتمل المهمة ممثلة في الغابات، المناطق الصناعية، الفنادق وكذا المستشفيات، كما أوضحت المتحدّثة أنّ عمل اللجنة يمر عبر مرحلتين تمثل الأولى في دراسة التصنيف والجرد للمساحات الخضراء لتشمل الخاصية الطبيعية وكذا الإيكولوجية لهذه الفضاءات والمخطط العام لتهيئتها، بحيث ينبغي أن تبرز هذه الدراسة أهمية هذه المساحات بالنسبة للإطار المعيشي وفائدتها للساكنة، أيضا يتم استغلالها وكذا تردّد الزوار، بالإضافة للقيمة الخاصة لمكوّناتها بحيث يتم تقييم مدى وجود أصناف نباتية نادرة ما يتطلب حمايتها، بحيث يتم القيام بجرد شامل لمختلف الأصناف الموجودة، فضلا عن تقييم أخطار التدهور ما إذا كان طبيعيا أو ناتجا عن سلوكيات أخرى ما يسمح بتحديد الشكل المناسب للتّكفّل، فيما تشمل المرحلة الثانية من العمل التصنيف الذي يتم مكتبيا حسب المتحدّثة بإدراج مختلف البيانات المستقاة.
ويتم إعداد بناء على ذلك وضع قرارات التصنيف لكل المساحات الخضراء تشمل تطبيق مواد من القانون 07/06 لضمان حماية وتنمية المساحة الخضراء مهما كانت طبيعتها القانونية أو نظام ملكيتها بحيث تشمل هذه الأخيرة منع أي تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة أو كل نمط شغل جزء منها، كذلك منع كل بناء أو إقامة منشأة على مسافة لا تقل عن 100 متر عن حدود هذه المساحات، فضلا عن منع وضع الفضلات والنفايات في المساحة خارج التراتيب والأماكن المعينة لهذا الغرض مع منع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة.
تصنيف 99 مساحة خضراء
وتمت وفق المتحدّثة معاينة 126 مساحة خضراء عبر مختلف بلديات قسنطينة لحد الآن بحيث أسفرت نتائج عمل اللجنة عن تصنيف 99 منها على اعتبار أنّ هناك مساحات لا تستوفي المعايير الخاصة بالتصنيف المدرجة ضمن القوانين لتشمل حظيرتين حضريتين، 53 حديقة عمومية و19 حديقة جماعية، بالإضافة إلى 23 صفوفا مشجرة وحديقتي إقامة، إلى جانب ذلك أحصت اللجنة خلال سنة 2024 مساحة إجمالية تقدّر بـ 8 مليون و882 ألفا و800 متر مربع من المسحات الخضراء وحدّدت المنظمة العالمية للصحة والبيئة معدّل 10 متر مربع نصيبا للفرد الواحد من المساحات الخضراء بناء على معايير صحية وبيئية وغيرها، حيث تم تسجيل في هذا الإطار معدّل يقدّر بـ 6.66 مترا مربّعا نصيب الفرد الواحد بقسنطينة من هذه المساحات الخضراء.
وترى، عليوط، أنّ هناك زيادة معتبرة في هذا الجانب قدّرت بحوالي 1.5 متر مربّع لكل مواطن مقارنة بسنة 2021، حيث كان يبلغ نصيب الفرد حينها 5.1 متر مربّع، وتعود هذه الزيادة وفق محدّثتنا إلى السياسة الرشيدة المسطرة من قبل السلطات المحلية بغية ترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال مجهودات أدّت لخلق فضاءات خضراء جديدة وإعادة تهيئة أخرى موجودة أساسا.
اقتراحات لإنشاء مساحات خضراء
ومكّنت هذه العملية في المقابل من الوقوف على احتياجات ونقائص كل بلدية من المساحات الخضراء إذ تمّ على إثرها مراسلة رؤساء الدوائر للاتصال برؤساء البلديات بخصوص تقديم اقتراحات حول إنشاء مساحات خضراء وفضاءات جديدة للترفيه والراحة للعائلات أكثر اتساعا، فضلا عن ذلك تم بناء على نتائج عمل اللجنة استحداث خلية ولائية مكلّفة بمراقبة عمل المؤسسات العمومية لتسيير وصيانة الحدائق العمومية المستحدثة، حيث تشرف على مراقبة مدى احترام المؤسسات العمومية لتجسيد البرامج المسطرة ميدانيا فيما يخص النظافة، الإنارة العمومية وصيانة المساحات الخضراء، برمجة خرجات ميدانية لمعاينة المساحات الخضراء مع حصر جميع النقائص المسجلة وتبليغ المؤسسة العمومية المسؤولة عنها سواء بلدية أو ولائية، بالإضافة إلى إعداد تقرير أسبوعي مدعّم بالصور عن العمل وتقديمه للوالي وبناء على هذا فقد استعادت العديد من المساحات الخضراء المتدهورة رونقها عند معاينة اللجنة لها.
وقالت المتحدّثة إنّ مختلف الأصناف النباتية الموجودة بقسنطينة مناسبة على العموم إذ يمكنها التأقلم مع طبيعة المناخ، ينبغي فقط الوقوف عليها والمتابعة، إذ تم إحصاء خلال هذه العملية ما يفوق 25 نوعا من الأشجار المغروسة في المساحات الخضراء على غرار Platane, Mélia, Eucalyptus , ficus، كما أشارت المتحدّثة إلى أن حملات التشجير ينبغي لها أن تكون مؤطرة حتى يتم تفادي الغرس الفوضوي وإهدار الجهد والأموال، كما لفتت إلى أنّه ينبغي الاعتماد على الجودة في عملية الغرس عوض الكم وغرس الأنواع المناسبة في الأمكنة المناسبة بناء على خصائص الأشجار التي تسمح لها بالنمو في مناطق عوض أخرى، كما أكّدت، عليوط، وجود نوع من الوعي البيئي بأهمية وجود المساحات الخضراء بدليل مطالبة المواطنين خلال الخرجات الميدانية باستحداث هذه الفضاءات.
إسلام قيدوم
تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال
إطلاق المرحلة الثانية من خطة التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
تم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجودة الحياة والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
وجرت مراسم الاطلاق الرسمي لهذه المرحلة بحضور وزيرة القطاع، نجيبة جيلالي، وممثلة منظمة اليونيدو، حسيبة سايح، ومنسق مكتب الأوزون في الجزائر، أحمد أكلي، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، محمد هشام قارة، وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030، عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد، إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود بـ 5 وحدات تجريبية، وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون)، إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين.
بالإضافة إلى هذا، سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية، إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة، تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية، فضلا عن تأهيل 40 مدربا معتمدا وفق المعايير الدولية.
وستواكب هذه الأنشطة حملات تحسيسية وإعلامية، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم الاطلاق.
وإجمالا، يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الأولى في 2012 إلى الالغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون، في آفاق 2030، وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الإلغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010.
ويأتي ذلك، تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت السيدة جيلالي أن المرحلة الأولى من هذا المشروع حققت نتائج عملية «معتبرة»، إذ سمحت بتقليص استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 5ر67 بالمائة مع مطلع 2025.
ولنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، أكدت الوزيرة أهمية «تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال تبني مقاربة تشاركية وإدماجية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام».
كما سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية، تقودها وزارة البيئة وجودة الحياة، لضمان المتابعة الفعلية لمختلف المؤسسات التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون، تضيف السيدة جيلالي.
من جهتها، أبرزت ممثلة منظمة اليونيدو، أهمية هذا المشروع، مشيرة إلى استعداد المنظمة الأممية لمرافقة الجزائر في مشاريع أخرى في إطار الجهود الدولية لحماية البيئة.
ووفقا للمعطيات التي قدمتها السيدة سايح، فقد تم تخصيص ما يزيد عن 75ر3 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة الثانية، مقسمة على ثلاث دفعات.
من جانبه، اعتبر اللواء بخوش أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يشكل مرحلة «حاسمة» لتعزيز القدرات الوطنية في المجال البيئي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور مصالح الجمارك التي تعد «شريكا فعالا» في تنفيذ هذا المشروع، من خلال مهامها الرقابية على الحدود وسهرها على منع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة.

حسب آخر تقرير للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية
أفريل 2025 ثاني أدفأ شهر أفريل على مستوى العالم
صنف شهر أفريل 2025 ثاني أدفأ شهر أفريل على مستوى العالم، بما يبقي درجة الحرارة العالمية أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وبحسب آخر تقرير للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى كجزء من برنامج «كوبرنيكوس»، فقد سجل ارتفاع في متوسط درجة حرارة الهواء السطحي خلال شهر أفريل 2025 أعلى بمقدار 0.60 درجة مئوية عن متوسط أفريل 1991/2020، بحيث كان شهر أفريل 2025 أعلى بمقدار 1.51 درجة مئوية عن المتوسط المقدر للفترة 1850/1900 المستوى المستخدم لتحديد مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وأوضح التقرير أن الفترة الممتدة ما بين ماي 2024 وأفريل 2025 والتي استمرت 12 شهرا، كانت أعلى بمقدار 0.70 درجة مئوية عن متوسط الفترة 1991/2020، وأعلى بمقدار 1.58 درجة مئوية عن مستوى ما قبل الثورة الصناعية، مضيفا أنه قد تمت ملاحظته شذوذ في درجة حرارة الهواء السطحي العالمية الشهرية مقارنة بالفترة الممتدة من جانفي 1940 إلى غاية أفريل 2025، لتتواصل بذلك سلسلة الأشهر التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 1.5درجة مئوية أكثر ما قبل العصر الصناعي.
التقرير أشار أيضا إلى تسجيل ارتفاع في درجة حرارة سطح البحر، أين بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر لشهر أفريل 2025 فوق خط عرض60 درجة جنوبا و60 درجة شمالا 20.89 درجة مئوية، بحيث صنفت كثاني أعلى قيمة مسجلة لهذا الشهر، و0.15 درجة مئوية أقل من الرقم القياسي لشهر أفريل 2024، وظلت درجة حرارة سطح البحر مرتفعة بشكل غير معتاد في العديد من أحواض المحيطات والبحار، ومن بينها مناطق واسعة في شمال شرق المحيط الأطلسي الشمالي والتي واصلت تسجيل درجات حرارة سطح بحر قياسية خلال الشهر، وكان معظم البحر المتوسط أكثر دفئا بكثير من المتوسط، إلا أنها لم تكن بنفس مستوى درجة الحرارة القياسية التي سجلت في مارس.
وبالنسبة للجليد البحري في القطب الشمالي، فقد أظهر التقرير أن مداه كان أقل بنسبة 3 بالمائة عن المتوسط، كما كان مدى الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية أقل بنسبة 10 بالمائة من المتوسط، مما يجعله عاشر أدنى مستوى مسجل لهذا الشهر، بحيث كان شذوذ تركيز الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية مختلطا.
تميز شهر أفريل 2025 أيضا بجفاف على مستوى العديد من مناطق العالم منها أجزاء كبيرة من وسط أوروبا وبريطانيا العظمى، وعلى العكس من ذلك كان الطقس أكثر رطوبة من المتوسط في معظم أنحاء جنوب أوروبا وشمال النرويج وجنوب فنلندا إضافة إلى أجزاء من غرب روسيا، فيما شهدت منطقة جبال الألب هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية، بينما شهدت أجزاء من كندا وألاسكا وجنوب إفريقيا أحوالا جوية تفوق المعدلات الطبيعية، أين أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وأضرار مختلفة في العديد من هذه المناطق.
إيمان زياري

أصناف جديدة رُصدت بالمناطق الرطبة
إحصاء أكثر من 16 نوعا من الطيور المهاجرة بتبسة
تحصي محافظة الغابات في ولاية تبسة، أكثر من 16 نوعا من الطيور المهاجرة، المتواجدة على مستوى المناطق الرطبة السبعة بالولاية، أين يتم في كل مرة ملاحظة صنف جديد من الطيور.
المكلف بالإعلام بمحافظة الغابات بالولاية، أوضح بأن ولاية تبسة تحيي هذه السنة اليوم العالمي للطيور، تحت شعار ‘’إنشاء مدن و مجمعات صديقة للطيور»، باعتبارها أوساطا ذات أهمية إيكولوجية و حيوية، تستقطب الطيور المهاجرة التي تعبر القارات سواء لتمضية فصل الشتاء أو التكاثر، وتعمل المحافظة على تعريف المواطنين بأهمية الطيور ودورها في التنوع البيولوجي، وسبل حمايتها بالإضافة إلى تقديم شروحات حول عملية إحصائها والأصناف المحمية منها.
المتحدث أوضح أن هذه العملية لها دور هام في معرفة حالة التنوع البيولوجي والمراقبة الدورية لعدد الأنواع، وكذلك حالة النظام البيئي للمناطق الرطبة وتأثرها بالتغير المناخي أو بعوامل أخرى، وبخصوص أنواع الطيور المائية الملاحظة هذه السنة، أفاد المتحدث، أنه تم تسجيل تزايد في عدد الطيور الوافدة مقارنة بشهر جانفي 2023، وهذا راجع لزيادة منسوب مياه الحواجز المائية، وأهمها طائر البط ذي العنق الأخضر بنسبة 74في المائة، من عدد الأنواع الملاحظة، وطائر غراب الماء الذي يأتي في المرتبة الثانية، فضلا عن وجود أنواع نادرة أخرى مثل البط ذي الرأس الأبيض، وأما بالنسبة للأنواع الجديدة الوافدة، فقد تمت ملاحظة صنف جديد لأول مرة في ولاية تبسة وهو طائر النكات الأنيق، وهو طائر مائى، يتميز بامتلاك منقار رفيع وطويل، يشبه السيف المغروس في رأسه، والذي يستخدمه في الصيد، و يتمكن الطائر من تحريك هذا المنقار في اليمين واليسار، ويمتلك هذا الطائر سيقان طويلة ورفيعة زرقاء اللون، يستخدمها أيضا في الصيد من المياه الضحلة، يغطي جسمه بريش بني وبعض الريش الأبيض لذا سمي هذا الطائر أيضا بالراهبة البيضاء. وكشف المتحدث، أن هذه العملية المتواصلة، تندرج في إطار الإحصاء التقليدي للطيور المهاجرة الذي يتم في كل سنة من طرف مختصين في علم الطيور، وأضاف أن الجرد السنوي للطيور المائية المهاجرة الذي يشارك فيه ملاحظون تابعون لخلية التعداد بمحافظة الغابات، يسمح بتحديد عدد الطيور المقيمة بالأحواض المائية المتواجدة بالولاية، حيث تتوقف بها لفترة معينة قبل مواصلة رحلتها نحو أوروبا، وتنطلق عملية التعداد على مستوى المناطق الرطبة، والتي يتوافد عليها عدد كبير من الطيور المائية، باعتبارها ملاذا مناسبا لتعشيش العديد من أصناف الطيور، حيث ترسم هذه المواقع، حسب ذات المصدر، بمعية الطيور المهاجرة لوحة طبيعية جميلة ذات ألوان زاهية، تؤهلها كي تصبح محل جذب للزوار والسياح أيضا، وتتواصل عملية الإحصاء لتشمل بقية المسطحات المائية، ويتعلق الأمر بالمسطح المائي الطبيعي لمرتفعات كل من بكارية والحمامات، ووادي ملاق بالونزة، ووادي عين الزرقاء، وبحيرة نقرين، إلى جانب مسطحات مائية من صنع الإنسان على غرار الحاجز المائي لبورمان ببلدية بكارية، الذي تقصده منذ استلامه عام 2011 عديد أنواع الطيور المهاجرة أو المستوطنة.
ع.نصيب
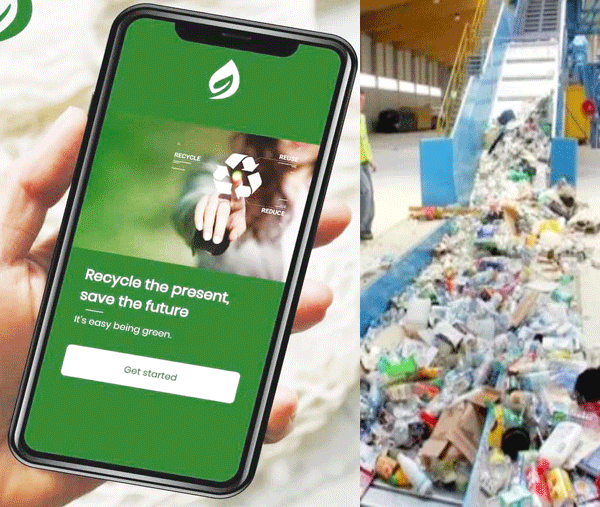
تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بمجال تدوير النفايات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي، ومصدرا لإنتاج سلع جديدة، ما شجع جامعيين على توظيف أفكارهم لدعم القطاع من خلال إدخال التكنولوجيا والابتكار عبر مشاريع ناشئة لتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية مربحة، بتقديم معدات وتطبيقات ذكية، تربط، وفق ما أوضحوا للنصر، بين الأفراد والمؤسسات الناشطة في المجال، وتسهل عملية التدوير وتضمن نجاعتها وتساعد في الحفاظ على البيئة.
إعداد / لينة دلول
وأطلقت ضمن هذا التوجه وزارة البيئة والطاقات المتجددة ، مشروعSNGID، وهو جزء من الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات بحلول عام 2035، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، يهدف هذا المشروع إلى تطوير إدارة حديثة وفعالة للنفايات في الجزائر، بما يساهم في تقليص التلوث البيئي وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وذلك لأن الجزائر تواجه تحديات عديدة في إدارة النفايات، إذ لا تزال كميات كبيرة منها تلقى في المكبات العشوائية، مما يؤثر سلبا على البيئة وصحة المواطنين، كما يفقد الاقتصاد الوطني موارد كان يمكن استغلالها في عمليات التدوير، وفي حال عدم اتخاذ إجراءات جادة، قد يتفاقم هذا الوضع في المستقبل.
بحسب وزارة البيئة، فإن الأهداف الرئيسية لهذه الإستراتيجية تشمل تقليل حجم النفايات المنتجة واسترجاعها قدر الإمكان، وتحسين فعالية جمع النفايات ومعالجتها في المدن الجزائرية، فضلا عن تعميم عملية الفرز الانتقائي، عبر فصل النفايات العضوية عن الورق والكرتون والزجاج والبلاستيك وغيرها من المواد، مما يسهل إعادة التدوير والاستفادة منها كمادة أولية.
إذا تم تنفيذ هذه الإستراتيجية بفعالية، فمن المتوقع خلال سنة 2035، بحسب الوزارة تحقيق أهداف تتمثل في تخفيض حجم النفايات المنزلية وما يماثلها بنحو 6 ملايين طن سنويا، وتحقيق إيرادات بقيمة 88 مليار دينار جزائري من خلال تدوير النفايات القابلة للاسترجاع، وإغلاق 1300 مكب عشوائي وتقليل المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالنفايات النهائية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جمع ومعالجة النفايات، باستثمارات تقدر بـ 54 مليار دينار جزائري، ناهيك عن خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة، منها 30 ألف وظيفة مباشرة و70 ألف وظيفة غير مباشرة، تحقيق توازن مالي بقيمة 122 مليار دينار جزائري بين الإيرادات والاستثمارات في هذا المجال، تطوير نظام معلومات رقمي لإدارة النفايات يسمح بمتابعة مسارها وتحليل البيانات المتعلقة بها.
إضافة إلى ذلك، تولي الحكومة أهمية خاصة لنشر ثقافة التدوير بين المواطنين، من خلال حملات التوعية الموجهة للأطفال والنساء، وتعزيز التواصل المفتوح حول أهمية هذه العملية.
إصلاحات قانونية لتعزيز التدوير والاستثمار في القطاع
ترافق هذا التوجه تعديلات قانونية حديثة من شأنها إحداث نقلة نوعية في التعامل مع النفايات، بما يواكب متطلبات العصر من أبرز هذه التعديلات ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 24/61 الصادر في 29 جانفي 2024، والذي يحدد المواد القابلة للاسترجاع ويقدم إعفاءات وتسهيلات جبائية للأفراد الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
كما أعادت القوانين الجديدة تصنيف النفايات، بحيث لم تعد تعتبر مجرد مخلفات، بل أصبحت تعامل كـ»مادة» أو»منتوج» بعد معالجتها، مما يفتح المجال أمام استخدامها في الصناعات المختلفة، مثل صناعة البلاستيك المعاد تدويره، الورق، المعادن، والأسمدة العضوية.
التكنولوجيا.. آداة الشباب للمساهمة في نجاح عملية التدوير
إلى جانب الجهود الحكومية، لعب شباب جزائري دورا محوريا في إدخال التكنولوجيا والابتكار في قطاع التدوير، فقد ظهرت حاضنات أعمال جامعية تدعم مشاريع ناشئة في هذا المجال، يقودها رواد أعمال شباب يسعون إلى تحويل النفايات إلى موارد اقتصادية مربحة، على سبيل المثال، أطلق العديد من المقاولين الشباب تطبيقات ذكية تربط بين الأفراد والمؤسسات الناشطة في مجال التدوير، مما يسهل عمليات جمع النفايات، فرزها، بيعها ونقلها إلى مراكز المعالجة، من أبرزها بيك أب مانجمنت للشاب ثابت لقمان، وكذا مشروع محمد أكرم بوراس، الذي أسس شركة ناشئة تعتمد على تطبيق ذكي يربط بين الموردين الذين يملكون النفايات والمستهلكين الراغبين في شرائها لغرض التدوير، مما يسمح بتحقيق دورة اقتصادية مغلقة وفعالة. وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الأخيرة حول نسبة النفايات المعاد تدويرها في الجزائر بحسب الوكالة الوطنية للنفايات قد ارتفعت إلى 9.83 بالمئة، وهي نسبة تحسنت مقارنة بالسنوات الماضية، لكنها لا تزال بعيدة عن المعدلات العالمية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل أكبر مع تطبيق القوانين الجديدة وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في هذا المجال.
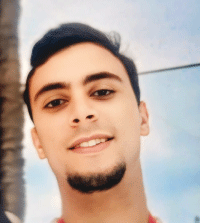
* لقمان ثابت مؤسس مشروع لتدوير النفايات
تسهيل التدوير عبر البرامج الحاسوبية وتطبيقات الهاتف
لقمان ثابت أول، خريج تخصص الميكانيك من ولاية تلمسان، قال في حديثه للنصر إنه أسس مشروعا ناشئا باسم «بيك أب مانجمنت»، يساهم في عملية تدوير النفايات القابلة للتدوير، ويربط الأفراد والمؤسسات مباشرة بمصادر التدوير من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والبرامج الحاسوبية. في حديثه عن فكرة المشروع، أشار لقمان إلى أنه قام بتطوير عدة تطبيقات يسهل على المستخدمين الوصول إليها، بالتسجيل فيها وإدخال النفايات القابلة للتدوير التي يمتلكونها، بعد ذلك، يتم إرسال شخص لجمع هذه النفايات من الموقع المحدد، وعند إتمام عملية جمع النفايات، يحصل المستخدم على نقاط أو هدايا تشجيعية لتعزيز مشاركتهم في عملية التدوير. وأوضح لقمان، أن التدوير بدأ بالبلاستيك، وذلك لأنه من أكثر المواد المتوافرة ويشكل حوالي 17 بالمئة من إجمالي النفايات المنزلية، كما أنه من السهل نقله وإعادة تدويره، ما جعله الخيار الأمثل للبدء في هذه المبادرة، مضيفا بأنه يطمح لتوسيع نطاق العمل ليشمل ولايات أخرى في الجزائر، بهدف نشر هذه الفكرة المهمة بين المواطنين وتعزيز الوعي بأهمية التدوير كجزء مهم في الحفاظ على البيئة .
وأشار محدثنا في ذات السياق، إلى أن عملية التدوير تتم بالتعاون مع شركاء متخصصين في مجال تدوير النفايات، حيث يقومون بتحويل هذه النفايات إلى منتجات جديدة ومفيدة، وبالتالي يساهمون في تقليل الأثر البيئي للنفايات، مؤكدا أن من أبرز التحديات التي يواجهها المشروع هي عملية فرز النفايات، التي تتطلب وقتا طويلا، لذا قرر وفريقه، أن يتم هذا الفرز من قبل الأفراد والشركات قبل تسليمهم النفايات القابلة للتدوير، وهو ما يساهم في تسريع العملية وتحسين الكفاءة.
مشروع حاوية ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي
وكشف لقمان عن خططه المستقبلية للاستثمار في تقنيات جديدة تهدف إلى تحسين فعالية عملية التدوير، على وجه الخصوص، كما ذكر أنه يخطط لربط البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين عمليات جمع النفايات، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بتحليل البيانات لزيادة الكفاءة في عمليات الجمع وتقليل التكاليف، وبالتالي توفير الوقت والمال. وأعلن لقمان عن منتج جديد لم يتم تجسيده بعد على شكل نموذج أولي، وهو عبارة عن حاوية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، موضحا أنها ستساعد في عملية الفرز من خلال تقنيات مثل معالجة الصور أو آليات أخرى تهدف إلى تسهيل عملية الفرز بشكل دقيق وسريع، مما سيمكن الأفراد والشركات من ربح الوقت وتقليص الجهد، وتجنب الطريقة التقليدية للفرز اليدوي .

* رئيسة مصلحة البيئة الحضرية بمديرية البيئة لولاية قسنطينة
قانون النفايات الجديد خطوة نحو الاقتصاد الدائري
أكدت، رئيسة مصلحة البيئة الحضرية بمديرية البيئة لولاية قسنطينة ليلى طريفة، أن التعديلات القانونية الجديدة الخاصة بتسيير النفايات، والتي تم إصدارها بتاريخ 20 فيفري 2025، تمثل نقلة نوعية في التعامل مع النفايات، بما يتماشى مع متطلبات العصرنة والتوجه نحو التنمية المستدامة.
وأوضحت المسؤولة، أن القانون الجديد 25/02 جاء ليحل محل القوانين السابقة المتعلقة بتسيير النفايات، مضيفا مصطلحات جديدة لم تكن مذكورة سابقا، من بينها «المواد العضوية» التي تعد مصدرا لاستخراج الطاقة والأسمدة، فضلا عن منتجات أخرى في مجال إعادة التدوير، كما أحدث القانون الجديد تغييرا جوهريا في طريقة تصنيف النفايات، حيث لم تعد مجرد مخلفات ينبغي التخلص منها، بل أصبحت «مادة» و»منتوجا» بعد المعالجة، مما يعكس أهميتها الاقتصادية والإنتاجية، فإذا تمت معالجتها بطرق سليمة بيئيا، يمكن أن تتحول إلى موارد أساسية لإنتاج مواد جديدة، مما يعزز مفهوم «الثروة المهدورة» التي يمكن استغلالها بشكل أفضل.
كما تطرقت المتحدثة إلى مفهوم «النفايات النهائية»، التي تشمل جميع المراحل التي تمر بها النفايات منذ إنتاجها في المنازل والمتاجر والمصانع، وحتى وصولها إلى محطات المعالجة النهائية، مؤكدة أن التسيير الفعال للنفايات يبدأ من المصدر، أي من خلال الفرز الانتقائي في المنازل للمخلفات مثل البلاستيك، الخبز، والزجاج، مما يسهل عملية التدوير لاحقا.
القانون ينظم بشكل دقيق كيفية إدارة النفايات
وشرحت رئيسة مصلحة البيئة، أن القانون ينظم بشكل دقيق كيفية إدارة النفايات وفق المراحل التالية، الفرز الانتقائي في المصدر، حيث يتم تصنيف النفايات حسب نوعها، مما يسهل معالجتها لاحقا، وتوفير حاويات مخصصة، وهو دور تتكفل به البلديات لضمان تنظيم عملية الجمع، وكذا نقل النفايات إلى مراكز المعالجة والتي يتم خلالها الفصل النهائي للمواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات، لتأتي بعد ذلك عملية المعالجة التي تشمل عمليات التدوير وإعادة الاستخدام، أو تحويل النفايات إلى طاقة، وأخيرا مراكز الطمر حيث يتم التخلص من النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها بعد التأكد من استخلاص أقصى قيمة منها.
ويعزز القانون الجديد، حسب المتحدثة، مفهوم «الاقتصاد الدائري»، الذي يقوم على إعادة استخدام الموارد بدلا من التخلص منها، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة شملت أيضا تعزيز «الاقتصاد الأخضر» والوقاية من النفايات، وقد تم اتخاذ خطوات نحو التخلص التدريجي من «المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد»، لما تسببه من أضرار بيئية جسيمة.وأوضحت المتحدثة أن القانون الجديد تضمن تعديلات هامة في الأحكام الجزائية المتعلقة بإدارة النفايات، إضافة إلى إصدار 15 مرسوما تنفيذيا و12 قرارا وزاريا، من بينها 4 قرارات وزارية مشتركة، بهدف تسهيل تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.كما صدر بتاريخ 29 جانفي 2024 المرسوم التنفيذي رقم 24/61، الذي منح صفة قانونية وتنظيمية للأشخاص الذين يجمعون النفايات بهدف إعادة تدويرها، مع تقديم تسهيلات لمدة 6 سنوات دون فرض ضرائب عليهم، وذلك في إطار تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة القانونية.
تسهيلات للراغبين في الحصول على رخصة جمع النفايات
وبخصوص شروط الحصول على ترخيص لجمع النفايات الموجهة لإعادة التدوير، أكدت طريفة أنه يشترط أن يكون الشخص طبيعيا أي فردا وليس شركة، مع تقديم طلب خطي، و إرفاق نسخة من شهادة الميلاد وبطاقة التعريف الوطنية، وكذا توقيع اتفاقية مع شركات التدوير المعتمدة، مشيرة إلى أنه ومنذ صدور المرسوم التنفيذي، تم منح تسع رخص رسمية للأشخاص الذين يعملون في هذا المجال بشكل نظامي، في انتظار تقديم المزيد من التسهيلات لجذب عدد أكبر من المستثمرين في القطاع.
و كشفت المسؤولة أن ولاية قسنطينة تضم حاليا 13 مؤسسة مرخصة تعمل في مجال تدوير النفايات بطرق نظامية، حيث يتركز نشاطها بشكل رئيسي على إعادة تدوير البلاستيك، كونه الأكثر طلبا في السوق وأسهل في إعادة التصنيع، يلي ذلك إعادة تدوير الورق والكرتون، ثم الزجاج بكميات محدودة، والنسيج، والخشب، والحطب.
وأكدت المتحدثة، أن إعادة التدوير ليست فقط عملية بيئية، بل هي مشروع اقتصادي ناجح من جميع الجوانب، حيث تساهم في حماية الموارد الطبيعية من الهدر، وتقليل التلوث البيئي عبر خفض كمية النفايات المرسلة إلى مراكز الطمر، و خلق فرص عمل جديدة للشباب في قطاع التدوير. مشيرة في سياق متصل، إلى أن تفعيل القوانين الجديدة وتطبيقها بصرامة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، عاملان أساسيان في إنجاح منظومة التدوير، وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

* عبد الرحمن بن يزار، مبتكر جهاز ذكي
GreenAl مشروع لتدوير النفايات في الملاعب
يعمل الشاب عبد الرحمن بن يزار، طالب بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3، على رؤية مبتكرة لحل مشكلة النفايات البلاستيكية من خلال مشروعه الذي يقوده مع زميله أنيس الموسوم بـ»GreenAl»، والذي يهدف إلى ضمان اقتصاد دائري يدمج الرياضة مع حماية البيئة.
وأوضح عبد الرحمن في حديث سابق للنصر، أن المشروع جاء استجابة لمشكلة النفايات البلاستيكية المتفاقمة، خاصة في الجزائر حيث يتم تدوير أقل من 2 بالمئة من البلاستيك، لذلك استغل الرياضة كوسيلة لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير.
وأكد عبد الرحمن، أن الابتكار يكمن في تصميم جهاز لجمع قارورات بلاستيكية في المنشآت والمجمعات الرياضية، مما يسهل لاحقا إعادة تدويرها واستخدامها في الصناعات المختلفة، مردفا بأن المشروع يركز على تعزيز التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بالبعد البيئي، أي من خلال تقليل النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى موارد قابلة لإعادة الاستخدام، وحماية البيئة من تأثيرات البلاستيك الضارة، مع تقليل تكاليف جمع النفايات ومعالجتها وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، أما البعد الاجتماعي للمشروع فيتمثل في نشر الوعي البيئي وتعليم الأجيال الجديدة أهمية الحفاظ على البيئة.
تصميم نظام ذكي لجمع النفايات البلاستيكية
ويتضمن مشروع «GreenAl» تصميم نظام ذكي لجمع النفايات البلاستيكية، حيث يتم تثبيت جهاز مبتكر داخل المنشآت الرياضية لجمع القارورات البلاستيكية وفرزها، موضحا بأن الهدف منه تسهيل عملية الجمع والفرز باستخدام أجهزة ذكية متصلة بتطبيق يمكن التحكم فيه عن بعد، كما يتضمن تصميم تطبيق إلكتروني يسمح بمراقبة الجهاز وإدارته، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر، علاوة على ذلك فإن الجهاز يقدم للشخص الذي يرمي مخلفاته البلاستيكية داخله، قسيمة تمكنه من اقتناء شيء ما من أحد الأكشاك.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن المشروع يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الإنتاج والاستهلاك المسؤول، فضلا عن مكافحة التغير المناخي وحماية النظم الإيكولوجية البرية، موضحا، بأنه وزميله يتطلعان إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل قطاعات أخرى خارج الرياضة، ويصبح الابتكار جزءا من الحياة اليومية في الجزائر، مما يساهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك وتحقيق اقتصاد دائري شامل.

* محمد أكرم بوراس، صاحب مؤسسة ناشئة
ابتكرت تطبيقا ذكيا يربط الفاعلين في المجال
الشاب محمد أكرم بوراس، مقاول في مجال التسيير المستدام للنفايات، حاصل على شهادة ماستر في نفس التخصص، وصاحب مؤسسة ناشئة تعمل في مجال جمع ونقل النفايات، أكد أن الابتكار الذي تقدمه مؤسسته يكمن في استخدام تطبيق هاتف ذكي يربط بين الفاعلين في مجال النفايات، مثل الموردين الذين يقدمون النفايات أو المواد الأولية والمستهلكين الذين يقومون بعملية التدوير.
يهدف التطبيق بحسب المتحدث، إلى تسهيل التواصل بين هؤلاء الفاعلين، حيث يمكن للمؤسسة جمع النفايات من الموردين سواء كانت نفايات منزلية أو صناعية، ثم يتم عرض هذه النفايات على التطبيق الذكي.
من خلاله، يستطيع المستهلكون فحص النفايات المتاحة، واختيار المواد التي يحتاجون إليها، ثم شراء هذه المواد مباشرة عبر التطبيق، متابعا بالقول، بأنه يتم بعد ذلك توصيل هذه المواد إلى المستهلكين في مواقعهم.
وأشار الشاب، إلى أنه يدير أيضا مؤسسة مصغرة وهي جزء من الشركة الناشئة، ودورها الأساسي هو تدوير النفايات، وبالأخص البلاستيك من صنفي PP وPET حيث تقوم المؤسسة بجمع البلاستيك، ثم تجري عليه عملية الرحي «التكسير» والغسيل لتحويله إلى مادة أولية معاد تدويرها، والتي يمكن استخدامها في صناعات أخرى.
وذكر المتحدث أن عملية التدوير التي يتبعها فريق العمل تشمل عدة مراحل، على غرار تخزين النفايات في مقر الشركة بعد جمعها، فرز النفايات حسب نوع المادة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، بعد ذلك، يتم رحي النفايات لتحويلها إلى قطع صغيرة، ليتم وضع النفايات في غسالة لإزالة الشوائب، وأخيرا، يتم تجفيف المواد.
وأكد المتحدث، أن الشركة تعتمد على تقنيات حديثة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية، مما يمكنها من متابعة عمل الآلات وتحليل بياناتها لضمان كفاءة العمليات كما يعتمد المشروع على التطبيق الذكي، الذي يربط بين جميع الأطراف الفاعلة في هذا المجال.
وأشار أكرم إلى أن فكرة تطوير التطبيق الذكي جاءت نتيجة الحاجة الملحة في سوق النفايات، الذي يعتبر سوقا غير مؤطر بشكل كاف فبعض الأفراد بحسبه، يملكون كميات كبيرة من النفايات، لكنهم لا يعرفون كيف يتصرفون بها أو لمن يقدمونها، لذا فمن خلال التطبيق، أصبح من السهل على هؤلاء الأفراد العثور على زبائن لتنشيط عملية التدوير.
ويفكر صاحب التطبيق في الاستثمار في تقنيات جديدة من إن التكوين الأكاديمي الذي حصل عليه في مجال التسيير المستدام للنفايات منحه رؤية أوسع حول هذا المجال، متابعا بالقول «أعتقد أن تدوير النفايات في الجزائر ما زال مجالا غير معروف إلى حد كبير، وهذا ما دفعني للبحث أكثر في مجالات الرسكلة والابتكار في هذا القطاع».

* الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي
التدوير يقوي الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة
أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي، أن الهدف الأساسي من إعادة التدوير هو أن تكون المواد المستخلصة بعد عملية التدوير أقل تكلفة في الإنتاج عند استخدامها مقارنة بالمواد الأصلية.
فعلى سبيل المثال، عندما يرغب شخص في شراء المواد الأولية من البلاستيك، التي تكون عبارة عن حبيبات إما مستوردة أو منتجة محليا، فإنه يجد أمامه خيارين إما شراء المادة الأساسية الأصلية «البلاستيك المصنع» أو شراء مواد مسترجعة من عملية التدوير.
في هذه الحالة، سيكون سعر المادة المدورة أقل من المادة الأصلية، وبالتالي يحقق المشتري ومن قام بإعادة التدوير فائدة اقتصادية، كما سيستفيد الاقتصاد الوطني من هذه العملية لأن التدوير لا يتطلب استيراد العملة الصعبة ولا بناء مصانع كبرى، وبالتالي تكون تكاليفها أقل من تكلفة استيراد المواد الخام.
وأوضح الخبير، أن هذه هي أهمية عملية التدوير بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تقليل الاعتماد على المواد المستوردة وتوفير العملات الأجنبية، كما أن البنك الوطني يستفيد من هذه العملية من خلال تقليل الحاجة لاستيراد المواد الأولية، مما يساهم في رفع قيمة العملة الوطنية، مشيرا في سياق آخر، إلى أن عملية التدوير لا تكون مجدية إذا كانت تكلفة المواد المدورة أكبر من تكلفة شراء المواد الأصلية من المصدر، في هذه الحالة، تصبح عملية التدوير غير مهمة لأن التكاليف سترتفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار المتحدث، إلى أن عملية التدوير في العالم تشمل العديد من المواد الصلبة مثل البلاستيك، الورق، الأقمشة، الصوف، الكارتون، المعادن، بالإضافة إلى تدوير المياه المستعملة، وهي عملية مهمة جدا لأن المواد المسترجعة يمكن استخدامها في الإنتاج الوطني بل وأكثر من ذلك، يمكن تصدير المواد المدورة والحصول على العملات الصعبة، مما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.
وشدد سلامي، على أهمية التدوير لأنه يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى المداخيل المحلية بالدينار من خلال الضرائب والجبايات، كما يساعد على توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، سواء في مجال النقل أو في استهلاك الكهرباء أو في توظيف العمال في مختلف مراحل العملية.
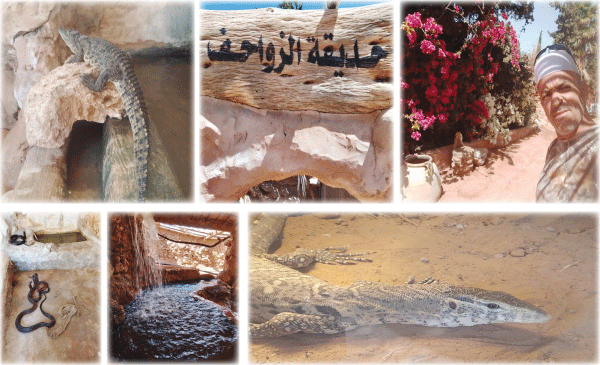
تعد حديقة الزواحف المتواجدة بقصر «تاجنينت» بلدية العطف واحدة من أبرز المحميات في ولاية غرداية، فقد حولها صاحبها عزيز حاج عيسى إلى متحف مفتوح للزوار يلتقون فيها بأندر الحيوانات ويغيرون فكرة الموت المغروسة في أذهانهم عن الثعابين والأفاعي من خلال المعلومات التي يزودهم بها عن هذه الكائنات.
إيناس كبير
استلهم مربي الزواحف من الطابع الهندسي الفريد من نوعه للبيئة الصحراوية لينشئ حديقته، فطريقة بناء الغرف التي تتواجد بها مختلف الأصناف تدل على موطن عيشها الأصلي، ورغم نقص الوسائل والإمكانيات المادية إلا أن الشاب وظف ساعديه لتجسيد حلم طفولته خصوصا وأن عائلته معروفة بتربية الحيوانات منذ عقود فكانت إرادته أقوى من كل العوائق وسعى لتعلم أي حرفة تساعده في إنشاء المحمية سواء في جانب الهندسة، البناء، العناية بالحيوانات وحجرا بحجر نمت الفكرة أمامه التي مازال يعمل على تطويرها.
الحديقة ذات طابع علمي توعوي
أخبرنا محدثنا أن تربية الحيوانات والعناية بها هي إرث عُرفت به عائلة حاج عيسى بداية من الجد بلحاج الذي نجح في المجال منذ عقود، أما بالنسبة لعزيز فقد عشق الزواحف وقرر التخصص فيها، ناهيك عن نقص هكذا مشاريع في الجزائر وقلة الاهتمام بهذه الكائنات، أما عن الهدف الأساسي من إنشاء حديقته قال إنه يقصد من خلالها تغيير نظرة الناس للزواحف بالتعرف عليها عن قرب، وحذف صورة العدوانية والشر المطلق المنتشرة حول الأفاعي والثعابين على وجه الخصوص، مضيفا أن الغاية من الحديقة ليس تجاريا بقدر ما هو تسليط الضوء على الوجه الآخر للزواحف بأسلوب علمي و توعوي.
وقد كان اكتشافه للكوبرا السوداء في الجزائر أول مرة بعد سنوات من البحث ومحاولة إقناع الناس بتواجدها، حافزا جعل عزيز يصر على إنشاء الحديقة حتى يشبع فضول الزوار حول الكائنات التي لا يستطيعون رؤيتها في طبيعتها الأم، وأوضح في حديثه مع النصر أن البيئة الجزائرية هي الموطن الأصلي للكوبرا وقد أكد على ذلك في وسائل إعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أنها ليست عدوانية فليومنا هذا لم يسجلوا أي حادث هجوم لأن مهمتها الدفاع عن نفسها فحسب.
ولإنشاء حدائق للحيوانات توجد شروط يجب التقيد بها، وفقا له، على غرار الحصول على تصريح، والتمتع بالخبرة في التعامل مع الحيوانات، وعلق الشاب أن هذا العمل يتطلب أيضا الشغف به لأنه صعب وصاحبه يجد نفسه يقدم الكثير من التنازلات مردفا أن الهدف أيضا يجب أن يكون نبيلا وفيه فائدة.
حوالي 38 صنفا جمعها بوسائله الخاصة
تحتوي حديقة الزواحف على حوالي 38 صنفا وتتربع على مساحة سبعة هكتارات كما يعمل صاحبها على توسيعها ومن الأصناف التي ذكرها الثعابين، الأفاعي، العقارب، التماسيح، السحليات، وقد جمعهم في زاوية خاصة بالإضافة إلى أصناف نادرة ذكر منها العضاية، والكوبرا السوداء.
وكشف أنه جمعها بوسائله الخاصة، فهو في الأساس موثق للحياة البرية قال إنه يخرج في مغامرات إلى البرية تدوم من 15 يوما إلى شهر وقد علمه تواجده بين مختلف الكائنات الحية الكثير عنها كوظيفتها في الطبيعة والهدف من تواجدها، يضيف أنه وثق كثيرا من المقاطع المصورة عن تفاعل الزواحف في البرية وطريقة عيشها وقدمها بمثابة حقائق لمتابعيه، أما عن الصيد أخبرنا أنه في الوقت الحالي مكتف بالمجموعات التي يملكها في حديقته.
وعرج عزيز للحديث عن المخاطر التي يمكن أن تواجه جامع الحيوانات في الطبيعة، حيث أفاد أنه لم يتعرض لأي مشكلة عندما يكون وحيدا في البرية، كما أنه لا يشعر بالخوف لأنه يعرف الطريقة الصحيحة للتعامل مع كائناتها، وعلق قائلا علينا إدراك أن الإنسان هو الذي يذهب إلى مكان تواجد الحيوان وبالتالي يجب أن يحترمه مع تفادي تواجده في الطبيعة خلال فترات يكون فيها الكائن الحي عدوانيا، وذكر فترة الولادة، أو عندما يكون الحيوان مع صغاره.
ويفد أيضا طلبة وباحثون من كل ولايات الوطن إلى حديقة الزواحف بغرداية لإجراء دراسات علمية حول المخلوقات الموجودة بها، أو بغرض التعرف عليها، هناك يجدون محدثنا الذي يزودهم بكل المعلومات التي يحتاجونها، وفي هذا السياق عبر قائلا «الحديقة للجميع وأبوابها مفتوحة لكل هواة الطبيعة».
للزواحف دور بيئي وطبي
لم تكن بدايات عزيز سهلة في هذا المجال خصوصا في جانب التعامل مع ذهنيات الزوار، فقد أخبرنا أن بعضهم يتعامل بعدوانية مع الحيوان، وحتى الأشجار بكسر أغصانها، ورمي النفايات في الأرجاء، لكن مع مرور الوقت تغيرت بعض السلوكيات التي يرى صاحب الحديقة أنها مهمة الجميع فضلا عن أن ثقافة احترام الكائنات الأخرى سواء نباتات أو حيوانات تبدأ من الصغر.
وقال إنه حقق نتائج من خلال المقاطع المصورة التي يشاركها على حسابه، وذكر أن الناس سابقا كانوا يقتلون الأفاعي جاهلين أهميتها لكن من خلال متابعته أدركوا أنها غير عدوانية، وفي حالة مصادفتها يجب التواصل مع مختص لإعادتها للطبيعة أو تسليمها للمحميات، وأردف أن كل مخلوقات الكون وجدت بأسلوب خاضع للتوازن ولتأدية مهمة معينة، فعلى سبيل المثال لولا الزواحف من أفاعي، ثعابين وعقارب لتعب الإنسان كثيرا مع القوارض الصغيرة مثل الفئران التي تعيش في حقول الفلاحين وتفسد المحاصيل الزراعية فإذا تتبع نظام السلسلة الغذائية، يدرك أنه المستفيد من الحياة البرية.
وللزواحف منفعة طبية أيضا وفقا لعزيز حاج عيسى، فبالرغم من قوة سم الأفاعي والثعابين على سبيل المثال إلا أنها تستخدمه كوسيلة للدفاع عن نفسها أو لاصطياد فريستها، وأفاد محدثنا أنه في الوقت الحالي يوظف الانسان البحوث العلمية والتكنولوجيا للاستفادة من سمومها في استخراج المصل، واستخدامها في علاج بعض الأمراض، إضافة إلى سم العقرب الذي يعد الأغلى عالميا وهو مطلوب في مجال صناعة الأدوية لمنفعته الكبيرة.
وتحتوي الجزائر على سبعة أنواع من الأفاعي السامة، وفقا لما ذكره مربي الزواحف وموثق حياة البرية، وقد صنفها حسب قوة سمها أولها الكوبرا السوداء، أفعى الأهرامات وهي نوع نادر في الجزائر، الأفعى الرملية ذات القرنين، الأفعى الرملية، الأفعى الموريتانية، أفعى وحيدة القرن، أما الثعابين فيوجد حوالي 28 صنفا، و46 صنفا من العقارب بالإضافة إلى عديد الأنواع الأخرى مثل السحالي.
إ.ك

موثق الحياة البرية جمال حاج عيسى للنصر
بيئتنا فريدة ومناسبة جدا لصناعة وثائقيات عن البرية
تثير الصور ومقاطع «الفيديو» التي ينشرها موثق الحياة البرية، جمال حاج عيسى، اهتمام وفضول محبي الطبيعة فميزتها تكمن في قرب المسافة التي تفصله عن الحيوان أثناء التصوير ما يقدم تفاصيل دقيقة جدا وواقعية كبيرة للمشهد، وقد نشرت مؤخرا عدة صحف عالمية صورة جمعته بشبل صغير لاقت عفويتها تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
إيناس كبير
لم يعلم الفتى ذي 15 سنة، حين حمل آلة تصوير أول مرة، بعدما حصل عليها كهدية من صديق بلجيكي، أن عدسته ستبدع في توثيق صور عن الحياة البرية والطبيعة، وأن صوره ستتخطى حدود وطنه وتتحدث عنها كبريات المواقع والصحف الأجنبية.
وقد اختار أن يتميز عمن سبقه إلى المجال بالنظرة الفنية، مبرزا التفاصيل في الصورة ليجعلها أكثر حيوية، فالذي يرى أعماله يُبهر بدقة ملامح الكائنات الحية التي تظهر سواء الحشرات، أو الطيور، أو الأفاعي وغيرها، كما يدفعه عمله المتقن إلى التأمل طويلا في ألوانها وتناسق وجودها في الطبيعة.
وقد أوضح المصور للنصر، أن صوره تؤكد للإنسان أن كائنات البرية غير ضارة وإنما تتخذ وضعية الهجوم في حالة الدفاع عن نفسها فقط، لذلك من الواجب عدم الاعتداء عليها في بيئتها تحت مبرر الخوف.
المخاطرة لالتقاط صور مميزة
تعلم مصور الحياة البرية جمال حاج عيسى، التصوير في سن صغيرة جدا ثم بدأ هذا النشاط بطريقة منظمة من بوابة الصحافة التي عمل بها سنوات التسعينيات إلى غاية الألفينيات، قبل أن يصبح مصورا مستقلا، بعد ذلك شجعه أصدقاء سبقوه إلى البرية للالتحاق بهم، ويقول إنه كان يملك تصورا مسبقا عن المجال، لأن إخوته يملكون حوالي سبع حدائق للحيوانات في ولايات جزائرية مختلفة ذكر منها، سطيف، تلمسان، أم البواقي، غرداية، ووهران. وعن أهم الصور والفيديوهات التي وثقها، أوضح أن عدسته رصدت حيوانات اكتشفت لأول مرة في الجزائر من طرف الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، منها عشرات الطيور التي سجلت في الجزائر، بالإضافة إلى توثيق حيوان الثعلب الشاحب في «تين زاواتين». تنال صور جمال ثناء كثيرا من متابعيه الذين يُبهرون بدقتها والتفاصيل التي تكشفها لهم مثل «فيديو» لكوبرا تستعرض قوامها فوق رمال الصحراء الذهبية، حيث أخبرنا أنه يعتمد على الصورة المقربة جدا التي ينقل من خلالها رسالة للناس، بأن القرب من هذه الحيوانات لا يشكل خطرا كبيرا.
ويضيف أنه لالتقاط هذا النوع من الصور يجب أن يمتلك الموثق آلة تصوير متطورة، وعدسة تصوير عن بعد تقرب الأجزاء المراد تصويرها جيدا، بالإضافة إلى اختيار المخبأ المناسب.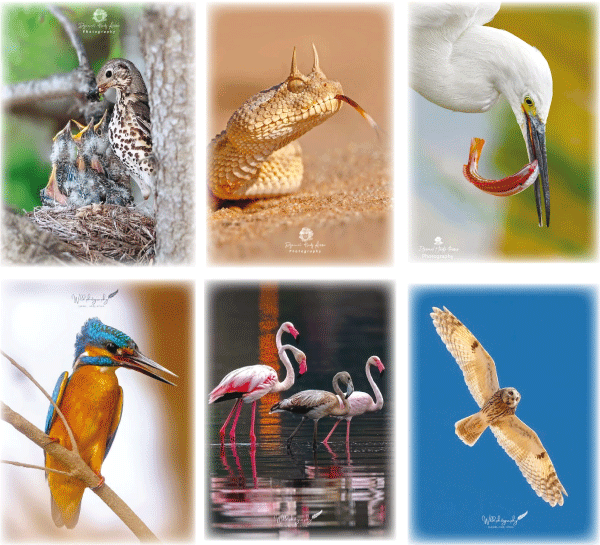
وأوضح، أن المخبأ قد يتمثل أحيانا في لباس خاص، وشبكة، كما قد يضطر المصور أحيانا أخرى لصناعة خيمة صغيرة من أغصان الشجر تكون مموهة حتى يتمكن من التقاط صور لبعض الحيوانات، أو الطيور في بيئتها الطبيعية، ورصد أسلوب عيشها وتفاعلها مع الطبيعة، لأن شعورها بقرب الإنسان منها سيدفعها إلى تغيير عاداتها. وقد سرد علينا جمال، قصة الصورة العفوية التي جمعته بشبل ونشرتها صحيفة «ديلي إيكسبريس» على صفحاتها، قائلا إن الحيوان ولد في حديقة ملك لأخيه حمله معه إلى الصحراء وكان الكائن يلتقي لأول مرة بالبرية فجلس فوق الكرسي وبقي يشاهد أجواءها، مضيفا أن ابن أخيه استغل الفرصة ووثق تلك اللحظة الجميلة التي تأثر بها كثير من المتابعين، كما اتصلت به عدة مواقع أجنبية وعربية للحصول على ترخيص بنشر الصورة، منها مواقع من أمريكا، وشيلي، وبريطانيا، ومصر، ولبنان، ودول أخرى. لا تنحصر مغامرات جمال حاج عيسى في البرية على اللحظات العفوية والصور الجميلة فقط، بل قد تتحول أحيانا إلى مواقف صعبة وخطيرة، وعن أخطر حادث تعرض له، قال إنه حدث يوم أمسك بيديه أفعى قرناء من الأنواع الخطيرة جدا، غرست نابها في ظفره ثم سحبته عندما كان بصدد إطلاقها، وقد نجا بأعجوبة حسبه، فلو وصلت اللدغة إلى اللحم لكانت ستتسبب في موته مباشرة، لأن المصاب وفقا له لا يملك أكثر من 72 ساعة للمقاومة إن لم يتحصل على الإسعافات، وأوضح أن آلام وأعراض اللدغة تستمر إلى أكثر من شهرين أحيانا حتى بعد التدخل الطبي.
لا نفتقر للجودة
نشر المصور مؤخرا، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» تجربته الأولى في صناعة فيلم قصير من 4 دقائق صُور في إحدى بحيرات ولاية غرداية يتحدث عن طائر الكرسوع أبيض الرأس. وفي حديثنا معه حول صناعة الأفلام الوثائقية، أوضح أنها ما تزال فكرة فتية لأن هذا المجال يحتاج إلى دعم مالي كبير، لأنه من الصعب أن يتنقل المصور ويسافر معتمدا على أمواله الخاصة فقط لإنجاز فيلم، بالإضافة إلى الوقت والجهد المطلوبين.ويرى محدثنا، أن الجزائر تملك كل المؤهلات لتقدم أفلاما وثائقية عن البرية بجودة عالية، خصوصا في ظل تجاوز العوائق التي كانت معروفة سابقا، وأفاد أن ظهور «الجمعية الجزائرية لتوثيق حياة البرية» سهل على الموثقين الحصول على التصريحات التي تساعدهم في العمل الميداني.
الحيوانات في البيئة الجزائرية ليست عدوانية
من جهة أخرى، علق جمال حاج عيسى، أن قضاءه ساعات في البرية مع كائناتها علمه أن هذه الحيوانات هي «أمم مثلنا» كل له دور خُلق من أجله في البيئة ولم تخلق عبثا، لذلك لا يجب قتلها دون مبرر.مردفا أن رصد «الكوبرا» على سبيل المثال يُعد إنجازا بالنسبة للمصور لأنها تختبئ فور شعورها بتواجد الإنسان بالقرب منها، وبحسبه فمن النادر جدا أن تلدغ هذه الأفاعي إنسانا ما لم يشكل تهديدا مباشرا لها، أما الوضعيات التي تظهر بها في الصور فهي للدفاع. وعقب عضو الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، أن الحيوانات الموجودة في الجزائر أغلبها غير عدوانية، واعتبر أن المشكل الحقيقي هو الإنسان لأن الكائنات التي يتعامل معها كلها تهرب في حالة وجوده مثل الوشق.وقال، إن هذا الحيوان بالرغم من عيشه في الجزائر، إلا أنه من النادر رؤيته كونه مسالم ويتفادى الأماكن التي يتواجد فيها البشر خوفا من الاصطياد، كذلك الأمر بالنسبة للذئب والثعلب، وكلها حيوانات من الصعب رصدها ما لم يختبئ المصور جيدا في انتظار أن تظهر فجأة.وقال محدثنا، إن أعضاء الجمعية يعملون على توعية الناس، وتغيير بعض الأفكار النمطية بخصوص الحيوانات البرية قصد حمايتها، كما يحاولون التقليل من الخوف المرتبط بها و الذي يؤدي أحيانا إلى قتلها دون الانتباه إلى أهميتها في الطبيعة، وعقب قائلا :»في السنوات الأخيرة قُتل أكثر من 30 ضبعا مخططا وهذا التصرف خاطئ، فهذا الحيوان يتغذى على الحيوانات النافقة فحسب ومهمته تنظيف المحيط منها».مضيفا، أن رؤيته صعبة أيضا، لأنه يخاف من الإنسان وحتى باقي الحيوانات ولا يعترض الحيوانات الأخرى إلا نادرا جدا في حال لم يجد ما يأكله لفترة.
إ.ك

بهدف توسيع استخدام الطاقة النظيفة إلى المنازل بقالمة
إطلاق دورة للتدريب على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
أطلقت غرفة الصناعة التقليدية و الحرف لولاية قالمة، دورة جديدة للتكوين و تحسين المستوى، في مجال تقنيات الطاقة الشمسية النظيفة، التي بدأت تكتسح مختلف القطاعات بالجزائر، في خضم التحول الكبير نحو الطاقات النظيفة المتجددة.
و ستتولى مدرسة التكوين و تحسين المستوى بالغرفة، مهمة تدريب الشباب الراغب في اكتساب المهارات و خوض تجربة ممتعة و مفيدة في تركيب و صيانة الألواح الشمسية، بما في ذلك حرفيي الكهرباء و محترفي قطاع البناء، و تقنيي المؤسسات العاملة في مجال الطاقة و المبتدئين، الذين سيخوضون تجربة الطاقة الشمسية، التي تعرف رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة.
و حسب غرفة الصناعة التقليدية و الحرف بقالمة، فإن الدورة تهدف إلى توسيع إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة بالمنازل و المؤسسات، و كيفية تحديد الاحتياجات، و معرفة أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية، و مراحل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية واختيار المعدات اللازمة لذلك، و هذا من خلال الحصول على المعارف النظرية و التطبيقية الضرورية لتركيب نظام طاقة شمسية بموقع معزول، و اختيار نظام مكيف يلبي احتياجات الزبون، وتحقيق معيار الأمان و السلامة.
وسيتولى مدربون ذوو خبرة الإشراف على دورة التدريب التي ترتكز على الجانب النظري و الجانب التطبيقي الميداني، حيث يتلقى المشاركون في الدورة مفاهيم وافية عن عالم الكهرباء و الطاقة الشمسية الضوئية، الحقل الشمسي، و إمكانيات الطاقة الشمسية في الجزائر، و مكونات المولد، و الأنظمة الضوئية، و كيفية تركيب نظام ضوئي ذاتي، و حماية المواد و الأشخاص، و التصليح و طرق الصيانة الدورية للمعدات، و مفاهيم أساسية حول الحساب في الكهرباء، و مقياس الكهرباء، و مخطط النظام الشمسي الضوئي. و دعت الغرفة كل المهتمين بالطاقة الشمسية إلى المشاركة في الدورة لكسب المعارف العلمية الصحيحة، و التوجه نحو الاستثمار و إنشاء المؤسسات الصغيرة، التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل، في ظل التحول الكبير الذي تخوضه الجزائر نحو الطاقة النظيفة المتجددة، التي ستحدث تغيرات جذرية في مجال الاقتصاد و البيئة و الحياة الاجتماعية للسكان.
فريد.غ

يعرض نادي بيتروليوم العلمي، المؤسس من قبل طلبة بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، عدة مشاريع ابتكارية منها ما صممت نماذجه الأولية، وهي أفكار تخدم توجه الدولة في مجال الطاقات المتجددة، ومتعلقة أساسا بإنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقات المتجددة باستغلال أحدث التكنولوجيات والتقنيات، وتقديم بدائل تستغل الطاقة الشمسية والنفايات في إنتاج الوقود.
أسماء بوقرن
يعد نادي بيتروليوم سكيكدة من النوادي العلمية التي تمكنت من البروز بفضل تقديم أفكار ابتكارية مميزة وتجسيد الكثير منها، بفضل نشاط وكفاءة أعضائه من تخصصات علمية مختلفة، والذين بلغ عددهم 50 عضوا، يستغلون هذا الفضاء العلمي لتبادل المعارف والاستفادة من خبراء في المجال، ويعتبرون النادي حقلا خصبا للابتكار ولتشجيع الطلبة على تقديم أفكار حديثة مسايرة لمتطلبات العصر.
النادي مقسم لفرق حسب التخصص والمهام، والمشاريع المسطرة، بحيث توكل مهمة كل مشروع لفريق، حسب مسؤول النادي، الذي أكد للنصر بأن عدد الفرق غير محدد، ويتغير حسب عدد المشاريع وطبيعتها، مشيرا إلى أنه من الفرق الناشطة حاليا، فريق مكلف بمشروع خاص بالطاقة الشمسية وآخر بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولهما مشروع مشترك لتقديم فكرة مشروع تربط بين المجالين، إلى جانب فرق أخرى بالنادي.
مشاريع لاستغلال النفايات البلاستيكية كمصدر للطاقة
الطالب أشرف بوكلوة سنة ثانية ماستر تخصص تكرير وبيتروكيمياء، من الأعضاء الناشطين بالنادي، الذي تم تأسيسه سنة 2016 من قبل طلبة البيتروكيمياء، تحدث للنصر عن توجه النادي واهتماماته العلمية في قطاع المحروقات، بالقول بأن هناك ثلاثة مشاريع قيد التطوير، من بينها مشروع إعادة استخراج الوقود من النفايات البلاستيكية، والتي يعد البترول مادتها الأولية، حيث يتم إعادة هذه النفايات لحالتها الابتدائية، للتمكن من استخدامها كمصدر للطاقة، وتعد أيضا حلا لمشكلة التخلص من النفايات البلاستيكية، وحماية البيئة من التلوث الذي تسببه، مردفا بأن فكرة المشروع توجت بالجائزة الأولى لأحسن فكرة مشروع في الصالون الوطني للابتكار والمؤسسات الناشئة، المنظم بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 02.
من جهته تحدث مسؤول النادي، الطالب إياد زكريا وضاح، سنة أولى ماستر تخصص هندسة كيميائية، للنصر عن أنشطة ومشاريع النادي، التي منها ما تم الإنهاء من ضبط فكرته وتجسيد نموذجه الأولى وينتظر الحصول على براءة الاختراع للانتقال لمرحلة التسويق، ومنها ما سطرت أفكارها ويتم العمل على تطويرها واختبار جدواها ودراسة السوق.
فيما يتعلق بالأفكار الإبتكارية المجسدة، ذكر مبتكر درون لاستشعار تسربات الغاز ودخان الحرائق، حيث تم تقديم نموذجها الأولي واختبار فعاليتها، وتم تحقيق نتائج مبهرة، والتأكد من قدرة الجهاز على القيام بدوره بفعالية عالية في استشعار دخان الحرائق ما يساعد على التدخل الفوري، فالدرون مزودة بكاميرا حرارية وبخاصية الكشف عن مكان تواجد الأشخاص وتحديد أماكنهم بدقة، وتتيح سرعة التدخل ولها قدرة على التغلغل في الأماكن الوعرة.
كما تم تجريب «الدرون» في استشعار التسربات في حينها وتم اثبات نجاعتها، مردفا بأن للجهاز دور آخر صناعي، وذلك لإمكانية ربطه بقاعة المراقبة على مستوى المصانع، وقيامه بمهام متعددة في المجال الصناعي والبترولي، موضحا بأن الفريق لم يصل بعد لمرحلة تسويق المنتج، حيث يتم العمل حاليا من أجل الحصول على براءة الاختراع، ليتم تسجيله كفكرة مشروع شركة ناشئة، حائزة على جائزة أفضل فكرة مشروع.
سلة نفايات ذكية للحد من خطر النفايات الطبية
إلى جانب المشروع سابق الذكر، قدم النادي مشاريع أخرى في ميدان البحث العلمي كمشروع القمامة الآلية الذكية والتي تفتح آليا بمجرد تمرير اليد أمامها، وهي فكرة جديدة لم يسبق تطرق فرق بحثية لها، فالسلة الذكية مزودة بنظام استشعار ذكي وبرنامج آلي، موجهة للمستشفيات بدرجة أولى كما يمكن استعمالها في الفضاءات العمومية، وهذا لتجنب الاحتكاك المباشر مع النفايات، خاصة الطبية التي تشكل خطورة كبيرة على صحة الأفراد، مردفا بأنه تم تجسيد النموذج الأولي واختبار الفعالية في انتظار الحصول على براءة الاختراع كشركة ناشئة.
تحويل مياه البحر إلى مصدر للطاقة النظيفة
كما طرح مسؤول النادي، أفكار مشاريع جديدة يتم دراستها حاليا ووضع لبناتها الأساسية، تصب في مجملها في ميدان الطاقات المتجددة، وتركز على الهيدروجين الأخضر، كتوجه طاقوي عالمي، وإستراتيجية جديدة للدولة، حيث تتمحور المشاريع المسطرة حول آليات إنتاجه وتخزينه كطاقة نظيفة وصحية له استعمالات عديدة، واعتماده كبديل صحي وبيئي لكل ما يضر ويلوث البيئة، ومن المشاريع التي يتم العمل عليها أعمدة الطاقة الشمسية المزودة ببطاقة أردوينو لتقليل استعمال الطاقة.
منصف قرقور، أحد أعضاء النادي، سنة ثانية ليسانس تخصص آلية وتحكم صناعي، ومن عناصر الفريق المكلف بمشروع خاص بالطاقات المتجددة في مجال البيتروكيمياء للحد من ملوثات البيئة، قال بأن المشروع يتمحور حول إدماج محطات للطاقة الشمسية في مختلف أقسام مصفاة سوناطراك سكيكدة، الواقعة على الساحل، من أجل تحويل مياه البحر إلى مصدر للطاقة النظيفة عبر عملية التحليل الكهربائي. وتعتمد هذه المحطات، حسب المتحدث على استغلال الطاقة الشمسية لتحقيق هدفين رئيسيين، هما تزويد القسم الذي تتواجد فيه المحطة بالطاقة الكهربائية اللازمة لتسيير نشاطاته الصناعية، وتشغيل وحدة خاصة للتحليل الكهربائي لمياه البحر، بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر والأوكسجين.
يتم تخزين الهيدروجين الناتج، كما أوضح، عن هذه العملية في خزانات مخصصة ونقله إلى وحدة تفاعل كيميائي، حيث يلعب دورا حاسما في التخلص من المواد الفائضة والشوائب الناتجة عن عملية تكرير البترول، وبدلا من حرق هذه المخلفات وانبعاث غازات سامة خاصة مع وجودها في منطقة مأهولة بالسكان، يتم إدخالها في تفاعلات نظيفة مع الهيدروجين الأخضر الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء الذي يمتاز بقدرته العالية على التفاعل مع مختلف المركبات وتفكيكها إلى عناصر غير ضارة، مما يساهم بشكل مباشر في تقليص انبعاث الغازات السامة وتخفيف التأثير البيئي للمصفاة، أما الأوكسجين المُنتج، فيُعاد توجيهه إلى مجالات حيوية، خاصة القطاع الطبي، ما يعزز من قيمة المشروع كمصدر متعدد الفوائد.
أنظمة مراقبة ذكية ودرون لصيانة الألواح الشمسية
ولضمان استمرارية وكفاءة عمل محطات الطاقة الشمسية، حسب المتحدث، يتضمن المشروع أنظمة مراقبة ذكية وطائرات درون مخصصة لمتابعة وصيانة الألواح الشمسية، نظرا لحساسيتها وتأثرها السريع بالعوامل الخارجية، مردفا بأن النادي شارك في المسابقة الوطنية بين النوادي العلمية، وحصد المرتبة الثالثة وطنيا عن مشروع مبتكر يجمع بين الطاقات المتجددة والحلول البيئية الذكية في قطاع البيتروكيماويات.
هذه أنشطة النادي
وبخصوص أنشطة النادي، يتم تنظيم دورات تكوينية لأعضاء النادي وكذا للطلبة الجامعيين غير المنخرطين، في تخصصات مختلفة تشمل المقاولاتية وتعليم مهارات الإلقاء أمام الجمهور والتواصل عموما وكذا البرمجة، بالاعتماد على مكونين مختصين أو الاعتماد على الأعضاء الذين لهم خبرة في المجال، ودعم الأعضاء للتمكن من تقديم أفكارهم ووضع مشاريع جديدة، وغرس ثقافة المقاولاتية وتكوين الطلبة الراغبين في خوض هذا المجال، وتنظيم مسابقات وطنية ودولية، بالتنسيق مع هيئات علمية، وتعزيز التوجه نحو تطوير البحث العلمي، إلى جانب تنظيم منافسات علمية.
أ ب

مختصة تقترح إنشاء مؤسسات مصغرة خاصة للتكفل بها
تعدّد الفاعلين أثر على تسيير النفايات المنزلية
تقترح الدكتورة بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3، عائشة بن عزوز، إدراج القطاع الخاص في مجال تسيير النفايات المنزلية بخلق مؤسسات تتكفّل بهذه العملية، مؤكّدة أنّ الاستراتيجية الجزائرية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2035 تحمل رهانات طموحة ومستدامة، لم تطبّق ميدانيا.
إسلام. ق
وذكرت الدكتورة بمعهد التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، في حديث مع النّصر على هامش الملتقى الوطني حول الأمن البيئي في الجزائر، الذي انعقد أول أمس، بقسنطينة، وشاركت خلاله بمداخلة بعنوان «مدينة قسنطينة بين واقع تسيير النفايات المنزلية وآفاق الاستراتيجية الجزائرية 2035 للتسيير المدمج للنفايات المنزلية لتحقيق الأمن البيئي» إنّ توجّهات هذه الاستراتيجية جاءت برهانات طموحة على أساس الحصول على نسب مرتفعة من الرسكلة والتسميد وما إلى ذلك، حيث تضمّنت منذ سنة 2018 برامج وخططا توجيهية على المستوى القريب، المتوسّط وحتى البعيد تمثّلت أهمها في ترقية الاستثمار في سوق النفايات، تصميم استراتيجية اتصال بيئي وطني، كذلك تدعيم تقنيات التسيير والتدبير عن طريق إكمال وتحيين البرامج والمخططات الحالية وخاصة تحديث الخطط البلدية لتسيير النفايات المنزلية.
ودعت إلى جانب ذلك لتفعيل مخطط «الإيكو- جمع»، كما أبدت رغبة قوية في التحوّل إلى نموذج اقتصاد تدويري من خلال وضع سيناريوهات طموحة لرفع نسبة الرسكلة والتسميد، حيث تعتقد المتحدّثة أنّ هذه الاستراتيجية كانت لتكون فعالة في حالة تطبيقها على أرض الواقع كما أنها تسير وفق مبادئ التنمية المستدامة والتوجّهات الدولية كما وصفت قانون 2025 الذي صدر مؤخرا بالطموح، حيث دعّم وأكمل قانون سنة 2001، غير أنّ هذه المعطيات تظل توجيهات نظرية.
وأضافت ذات المتحدثة أنّه على الصعيد الميداني لم يتم تطبيق أي برنامج في مدينة قسنطينة، رغم مرور 7 سنوات على انطلاق الاستراتيجية الجزائرية سنة 2018، بحيث لا يزال ملف تسيير النفايات المنزلية بمدينة قسنطينة يؤثر سلبا على البيئة والصحة العمومية للأفراد، فسيرورة إدارة النفايات المنزلية بمدينة قسنطينة تمثّلت في أنّه بعد قانون سنة 2001 تم إعداد بموجبه مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية سنة 2005 وجاء كذلك بقرار لخلق مركز الردم التقني «بوغرب» سنة 2008 ليدخل حيز الخدمة سنة 2010، غير أنه أحرق كما أردفت المتحدّثة بعد أربع سنوات من الرّدم، بحيث تحوّل إلى مفرغة عمومية إلى غاية سنة 2019 ليتم حرقه مرة ثانية مع خروجه عن الخدمة نهائيا مخلفا أضرارا كبيرة عن البيئة على غرار تسرّب عصارة النفايات.
وتمّ وفق المتحدّثة العودة إلى نقطة الصفر سنة 2025 من خلال الرمي العشوائي والمختلط بالمفرغة العمومية ببلدية عين اسمارة وهو الأمر الذي كان يتم قبل سنة2001 فتجدها تحتوي على نفايات المذابح والزجاج على سبيل المثال، رغم عديد البرامج المجرّبة على غرار الفرز الانتقائي والحاويات نصف المطمورة، الأحياء النموذجية وغيرها، مضيفة أنّه تم ضمن برنامج الرسكلة خلق محطة فرز وتحويل ببلدية عين اسمارة غير أنّ تطبيقها فعليا تمّ فقط خلال سنة 2018، إذ تمت رسكلة البلاستيك بأنواعه، الكرتون، الحديد والنحاس ثم تعرّضت للحرق.
وترى المتحدّثة أنّ تعدّد الفاعلين حال دون نجاح أي عملية أو استراتيجية، حيث أوضحت، بن عزوز، بمثال حول تطبيق «نظيف» الذي يلفت الأفراد إلى أنّه في حالة رؤية مفرغة عمومية أو أشياء مرمية يتم تصويرها وإرسالها إلى الوكالة الوطنية للنفايات التي بدورها تراسل البلدية وهي الأخرى تراسل المؤسسات العمومية للرّفع، غير أنّ تعدّد الفاعلين وكل منها يخضع لسلطة جهة معينة فمديرية البيئة والوكالة الوطنية للنفايات تابعتان لوزارة البيئة بينما البلديات تنتمي لوزارة الداخلية وبالتالي مديرية البيئة لا تمتلك سلطة تّجاه البلدية. وتعتقد المتحدّثة أنّه يمكن معالجة المشكلة بخلق فاعل موجّه لتسيير النفايات عبر استحداث مؤسسات مصغّرة خاصة تتحمل مسؤولية إدارة النفايات المنزلية في حدود البلديات، بعيدا عن المؤسسات العمومية التي تفوّضها البلدية للقيام بعملية جمع النفايات في قطاعها الخاص، إذ لفتت إلى أنّ الاستراتيجية الجزائرية لآفاق 2035 دعت إلى تدعيم القطاع البيئي بالخواص، مضيفة أنّ هذا الطرح تعمل وفقه بلدان ناجحة تعتمد على هذه المؤسسات الخاصة التي تتكفّل بعمليات الجمع والنّقل وحتى الرّدم والتسميد واستخراج «الميثان»، إذ ترى المتحدّثة أنّه كلما اتّجه هذا القطاع إلى الخوصصة كلما وجدت حلول، رغم المصاريف المهدورة فالعملية لا تتعلق بالميزانيات إذ أنّ الدولة تستثمر في هذا المجال.

في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الغازات الدفيئة بالجزائر
نحو إنشاء حوض لامتصاص الكربون بنصف مليون شجرة بقالمة
قالت محافظة الغابات بقالمة، بأن المنطقة الواقعة بأقصى شرق البلاد، معنية بالمشروع الوطني الكبير، لإنشاء أحواض معتمدة لامتصاص الكربون، و الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، التي تعد المتسبب الرئيسي في التغيرات المناخية، و تدهور الحياة على كوكب الأرض.
و تقدر حصة ولاية قالمة من المشروع بنحو نصف مليون شجرة، سيتم غرسها على مساحة تتجاوز 500 هكتار من الأراضي التي تعرف تدهورا في الغطاء النباتي، و يمكن تحويلها إلى حوض غابي يساهم في امتصاص الكربون، إلى جانب الغابات الحالية التي تعد رئة المنطقة، بينها غابات بني صالح، و غابات بوعربيد، و غابات ماونة و هوارة و جبال الركنية، و بوعاتي محمود.
و تعمل المحافظة على بناء حوض طبيعي واسع، لامتصاص الكربون المنبعث من الوحدات الصناعية و وسائل النقل، و غيرها من الأنشطة البشرية الأخرى، المنتجة للكربون و غازات دفيئة أخرى.
و تعد الأشجار بمثابة خزان طبيعي، للحد من الانبعاثات الغازية و تحسين جودة الهواء، و كلما زاد الغطاء الغابي داخل المدن و حولها، كلما كان انبعاث الغازات الدفيئة قليلا، لكن هذا السد الطبيعي المضاد لهذه الغازات، يعرف تدهورا مستمرا بولاية قالمة، بسبب الحرائق و التوسع العمراني، و عمليات التجريف و القطع، و الرعي العشوائي، و الجفاف و الأمراض النباتية. و تبدو اغلب مدن ولاية قالمة خالية من الغطاء الغابي، و لذا فإنه من غير الممكن السيطرة على الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري، و من المتوقع أن تبادر محافظة الغابات بإنشاء أحواض صغيرة للكربون، داخل هذه المدن و حولها، بالتنسيق مع هيئات العمران و البلديات، و ذلك في إطار المشروع الوطني الكبير، الذي تساهم فيه شركة سوناطراك .
و منذ أن وقعت الجزائر على اتفاقية باريس للمناخ 2016 ، لم تتوقف الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الالتزامات الدولية حول المناخ، حيث تم في هذا الإطار إطلاق المشروع الغابي الوطني، في شهر ديسمبر 2024 لإنشاء أحواض الكربون عبر العديد من ولايات الوطن، وفق اتفاق بين المديرية العامة للغابات، و شركة سوناطراك الوطنية، التي تعمل منذ عدة سنوات على خفض الانبعاثات الغازية، و المساهمة في الجهد الوطني و الدولي، لحماية كوكب الأرض و الحد من الاحترار و التغيرات المناخية المتسارعة. و تعتزم الجزائر غرس 423 مليون شجرة على مساحة نصف مليون هكتار بحلول 2030، لإنشاء ما يعرف بأحواض الكربون المعتمدة (pfcpcc) للمساهمة في الجهد الدولي لخفض الانبعاثات الغازية، و الحد من ارتفاع حرارة كوكب الأرض التي زادت 1.5 درجة عقب الثورة الصناعية، و يخشى علماء المناخ و حماة البيئة، من وصول الاحترار الى 2 درجة مئوية في غضون السنوات القليلة القادمة، إذا تواصل انبعاث الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري حول العالم.
و تعد البرامج الحكومية المحلية، الحلقة الأقوى في مواجهة الكربون، و غيره من الغازات الدفيئة الأخرى، و يعد البرنامج الجزائري المستمر منذ عدة سنوات الأهم في منطقة حوض المتوسط و شمال إفريقيا، حيث تعمل البلاد بجدية كبيرة، على التحول إلى الطاقة النظيفة، و تكثيف مشاريع التشجير، و سن المزيد من القوانين لحماية الثروة الغابية، و البيئة و تحسين جودة الحياة.
فريد.غ
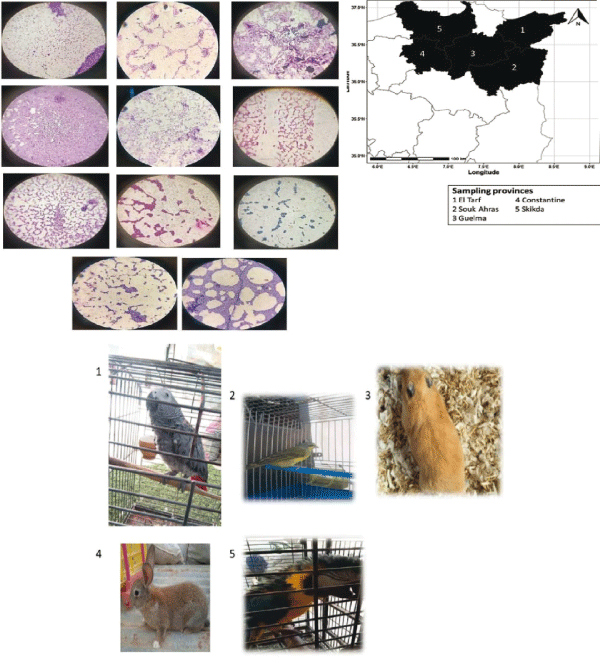
حقق فريق بحث من جامعة 8 ماي 1945 بولاية قالمة اكتشافا علميا جديدا، حيث تمكن من كشف بكتيريا مسببة للأمراض تظهر لأول مرة بالقرب من البحر المتوسط في دراسة بيئية ووبائية رائدة حول خطر انتشار الأمراض حيوانية المنشأ نتيجة تجارة الحيوانات البرية الغريبة في 5 ولايات شرقية. وعزل الباحثون خلال الدراسة التي امتدت على 3 سنوات 17 نوعا من البكتيريا المسببة للأمراض والقابلة للانتقال إلى الإنسان، وذلك من خلال تحليل عينات من عدة أنواع من الحيوانات البرية التي يجلبها المربون من مناطق بعيدة من القارة الإفريقية، كما أبرزوا غيابا تاما للوعي لدى المربين بالمخاطر المذكورة.
إعداد: سامي حباطي
ونشر باحثون من جامعة 8 ماي 1945 بولاية قالمة ورقة علميّة جديدة في العدد الفصلي الأول لسنة 2025 من المجلة العلمية الدولية المسماة Acta Microbiologica Bulgarica بعنوان «معدل انتشار وتأثير تجارة الحياة البرية في «خطر انتشار الأمراض حيوانية المنشأ» وظهور البكتيريا في شمال شرق الجزائر: منظور بيئي ووبائي». وينتمي الباحثون الذين أعدوا الدراسة إلى قسم علم البيئة وهندسة المحيط ومخبر البيولوجيا والمياه والبيئة التابعين لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون بالجامعة المذكورة، حيث أنجزت ما بين سنوات 2022 و2023 و2024، وشملت فحص عينات من حيوانات برية غريبة Exotic Pets تُسوّق في ولايات الطارف وسوق أهراس وقالمة وقسنطينة وسكيكدة.
الحياة البرية مصدر 75 بالمئة من الأمراض حيوانية المنشأ
وأفاد الباحثون في الدراسة التي اطلعنا على المقال المنشور حولها بأن الحيوانات الغريبة، التي أصبح يستألفها المربون، تمثل مستودعا طبيعيا لمخاطر انتشار الأمراض حيوانية المنشأ Zoonoses، حيث اعتبروا أن تجارة الحياة البرية تمثل عاملا رئيسيا لهذا الأمر، كما أشاروا من خلال مراجع الدراسات السابقة إلى أن 75 بالمئة من الأمراض حيوانية المنشأ تعود إلى تجارة الحياة البرية، بينما تمثل البكتيريا 55 بالمئة من أسباب ظهور هذه الأمراض. وفحص فريق البحث 54 حيوانا خلال الدراسة، حيث تشمل 44 حيوانا من فصيلة الطيور وحيوانا زاحفا واحدا و9 حيوانات من الثديات، إذ جمعوا عينيتين من كل حيوان. واعتمد فريق البحث على منهج عام في التعريف البكتيري لتحليل مختلف خصائصها، حيث يتبنى معهد باستور الجزائر هذه الطريقة وتخضع لمعيار المنظمة العالمية للمقاييس ISO 15189:2012، مثلما بينوا.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 63 بالمئة من دوافع امتلاك الحيوانات البرية الغريبة يكمن في التجارة، بينما ذكر 37 بالمئة من مربيها أنهم يمتلكونها من باب الهواية أو انجذابا لخصائصها الجمالية، كما بينت الدراسة أن تجارة هذه الحيوانات يمكن أن توفر عائدات مادية معتبرة، فضلا عن أن البيع والشراء يتم على المستوى المحلي بشكل أساسي، إذ يعتمد 70 بالمئة من ملاك هذه الحيوانات على شبكة معارفهم في عمليات البيع والشراء، بينما يعتمد 30 بالمئة الآخرون على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر 90 بالمئة من ملاك الحيوانات المعروضة للبيع أن مصدرها من الجزء الجنوبي من إفريقيا، على غرار موزمبيق ووسط إفريقيا مثل الغابون والكونغو ومنطقة الساحل. وبينت الدراسة أن هذه الحيوانات تجلب من مناطق مختلفة، على غرار الكناري أصفر الجبهة «سورا» الذي يؤتى به من موزمبيق وينتشر في أسواق الولايات الشرقية المذكورة، في حين نبه الباحثون في النتائج أن أصحاب الحيوانات المذكورة ذكروا بأن تجارتهم عرفت نموا كبيرا بنسبة 80 بالمئة خلال العقود الأخيرة، إلا أن الدراسة لفتت إلى أن جميع ملاك هذه الحيوانات الذين شملهم البحث يعتقدون، بنسبة 100 بالمئة، أنها لا يمكن أن تنقل أمراضا حيوانية المنشأ، أي بما يمثل غيابا تاما للوعي بإمكانية تسببها في أمراض.
أسعار مرتفعة مقابل حيوانات برية مهددة بخطر الانقراض
وأبرز فريق الباحثين وضعية 6 حيوانات برية تسوق على مستوى الولايات المذكورة بحسب ملحقات التصنيف للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، حيث وجدوا فيها طائر الحسون الذهبي Carduelis carduelis المصنف في خانة الأنواع «المهددة بخطر انقراض أدنى»، والببغاء الرمادي Psittacus erithacus المصنف في خانة الأنواع «المهددة بالانقراض» والأرنب البري الأوروبي Oryctolagus cuniculus المصنف في خانة الأنواع «المهددة بالانقراض» أيضا. وتصنف السلحفاة الإغريقية Testudo graeca في خانة الحيوانات «المهددة بخطر انقراض أدنى»، فيما يصنف الهامستر الأوراسي Cricetus cricetus في خانة الحيوانات «المهددة بخطر انقراض أقصى»، إلى جانب الهامستر السوري Mesocricetus auratus المصنف في خانة الحيوانات «المهددة بخطر انقراض أدنى».
وكشفت الدراسة عن الأسعار المتداولة في سوق الحيوانات البرية، حيث وجد فريق الباحثين أنها تبلغ متوسط 800 دولار للحيوان الواحد، بما يقترب من 11 مليون سنتيم، بحسب سعر الصرف الرسمي، في حين نبهوا أن سعر الببغاء الرمادي وصل إلى 1500 دولار، أي بما يتجاوز 20 مليون سنتيم، بينما يصل سعر القط الفارسي إلى 120 دولارا بما يعادل حوالي مليوني سنتيم. وقد قصدنا بعض بائعي الحيوانات عبر مدينة قسنطينة، حيث سألنا أحد البائعين عن الببغاء الرمادي فأوضح لنا أنه غير متوفر لديه، فيما لم نلاحظ في المحل حيوانات غريبة، باستثناء بعض القطط السيامية التي أخبرنا أن سعرها يصل إلى 6 آلاف دينار والعصافير المعهودة، مثل الكناري، وبعض الكلاب والأسماك. وقال صاحب المحل إن سعر الببغاء الرمادي يمكن أن يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه «يتكلم».
ولاحظنا عبر المحلات المذكورة أن الحيوانات الغريبة غير معروضة، باستثناء بعض السلاحف الإغريقية التي وجدناها لدى صاحب محل بالمدينة، حيث سعينا إلى البحث عن أنواع الحيوانات نفسها التي شملتها دراسة الباحثين، من أجل معاينة أسعارها. من جهة أخرى، لاحظنا الكثير من عروض بيع الحيوانات المذكورة في الدراسة عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
الكشف عن أنواع بكتيرية تهدد صحة الحيوان والإنسان
وقاد الفحص الباحثين إلى إيجاد تنوع كبير في البكتيريا المعزولة من الحيوانات المدروسة، حيث كشفوا عن 17 نوعا من البكتيريا، سجلت أربعة أنواع منها على امتداد سنتين وسجل النوع المسمى Photobactertum damsella لثلاث سنوات، واعتبر الباحثون أنها من أكبر مسببات الأمراض البكتيرية حيوانية المنشأ وتصيب الحيوان والإنسان معا، في حين سجل 12 نوعا آخر في سنة واحدة. وتمكنت الدراسة من عزل البكتيريا المسماة Plesiomonas shigelloide لأول مرة في منطقة قريبة من البحر الأبيض المتوسط خلال فحصهم لعينات الحيوانات البرية في الولايات الشمالية الشرقية المذكورة، ما يعتبر اكتشافا جديدا، حيث ذكروا أنها يمكن أن تنتقل عبر الطيور وتعتبر من أكبر مسببات الأمراض، فضلا عن عزلهم للبكتيريا المسماة Pasteurella pneumotropica في 2024 في الولايات الشرقية المذكورة، ويعتبر تسجيلها في هذه المنطقة من البلاد أمرا جديدا، كما أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، بالإضافة إلى حمل الحيوانات البرية الغريبة للبكتيريا المسماة Raoultella ormithinolytica.
وقدم فريق البحث تحليلات لمصادر بعض الأنواع البكتيرية المسجلة في دراسة العينات، حيث أوضحوا في مناقشة النتائج أن الطيور والثديات القادمة من الغابات الإستوائية تحمل بكتيريا Aeromonas hudrophila، ويمكن أن تنتقل عن طريق قرد الطمارين قطني الرأس، بينما أكدوا عزل البكتيريا المسماة Enterobacter sakazakii في سنتي 2022 و2024، مفترضين أنها بكتيريا انتهازية ولا تظهر إلا في ظروف محددة. وسجل الباحثون أيضا البكتيريا المسماة Chryseobacterium indolegenes، حيث أكدوا أنها عزلت لأول مرة من ثعبان الكرة Python regius في إيران، رغم أن الموطن الأصلي لهذا الحيوان يتمثل في الجهة الغربية لجنوب الصحراء، في حين ذهب الباحثون إلى أن تسجيل هذه البكتيريا يعود إلى سلوك مربي الحيوانات الغريبة الذي يتجه إلى امتلاك أنواع جديدة من الحيوانات، مثل الثعابين.
المسؤول عن البحث: كوفيد- 19 دليل على خطر الأمراض حيوانية المنشأ
وتحدثنا إلى البروفيسور مسلم بارة، المختص في دراسة البيئة والبيولوجيا المجهرية من جامعة 8 ماي 1945 بقالمة حول الدراسة التي قادها رفقة طلبة الجامعة، حيث أوضح أن الدافع الأول لاقتراح هذا البحث يعود إلى التغيرات المناخية وظهور أمراض جديدة، خصوصا الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات البرية إلى الإنسان بما يهدد صحته. وأضاف المصدر نفسه أن جائحة كوفيد- 19 تعتبر دليلا نموذجيا على هذه الأمراض، حيث نبه أن الهدف الأساسي للدراسة يتمثل في وضع خريطة توزع البكتيريا في شمال شرق الجزائر، لاسيما البكتيريا المتنقلة عن طريق الحيوانات البرية التي يربيها الإنسان في المنزل، مشيرا إلى أن الفرد في شمال شرق الجزائر أصبح يربي أنواعا جديدة من الحيوانات البرية، على غرار الطيور. وقدم البروفيسور بارة، الذي نشرت له من قبل عدة مقالات ومساهمات علمية في مجال البيئة، مثالا عن الطيور التي أصبح يربيها الأفراد في الولايات التي شملتها الدراسة، مثل العصفور المسمى “سورا موزمبيق”، المعروفة بين المربين بتسمية “السورا”، وهو الكناري أصفر الجبهة، كما ذكر أنواعا أخرى من الحيوانات، مثل الزواحف التي تشمل بعض الحشرات والعناكب. وأضاف المصدر نفسه أن هذه الحيوانات تُجلب من مناطق أخرى من العالم ذات بيئة مختلفة، مثل المناطق الإستوائية في إفريقيا وجنوب إفريقيا. ونبه محدثنا بأن الدراسة المذكورة تندرج في إطار مشروع بحث في مجال الأمن الصحي، أين شرح لنا أنها شملت حيوانات غير أليفة في الأصل، على عكس الحيوانات الأليفة المعتادة مثل الكلاب والقطط، وإنما تتمثل في حيوانات برية تعيش في الطبيعة ويصطادها الإنسان محاولا تربيتها.
وعزا المتحدث دوافع الأفراد لتربية هذه الحيوانات البرية الغريبة إلى عدة أسباب، مثل أشكالها وألوانها الجذابة أو تغريدها، مثلما يسجل مع الطيور، لكنه نبه أن هذه الحيوانات قادمة من بيئة ذات مناخ مختلف تماما عن البيئة في الجزائر، ما يجعلها قادرة على حمل بكتيريا خطيرة تهدد صحة الإنسان لأنها “تكون في احتكاك معه”، مثلما أضاف. وفي رد البروفيسور بارة على سؤالنا حول إمكانية حمل الحيوانات الأليفة المعتادة مثل القطط والكلاب للبكتيريا، أكد الباحث أنها يمكن أن تحملها، لكنه نبه أنها تكون محل مراقبة من قبل الطبيب البيطري من خلال المتابعة والتلقيح اللازم، في حين لا تخضع الحيوانات البرية للمراقبة بشكل عام، ما يشكل خطرا على الصحة.
ولفت المتحدث إلى أن الحيوانات الأليفة المعتادة يمكن أن تنقل أمراضا، مثل داء الكلب، فضلا عن إمكانية انتقال أمراض أيضا من الحيوانات التي تحتك بالإنسان في العادة، على غرار الخرفان أو الأبقار، مثل مرض الحمى المالطية، رغم تأكيده بأن السلطات العمومية تنتهج إستراتيجيات وبروتوكولات لحماية الأفراد من هذه الأمراض، لذلك لا تسجل إصابات ناجمة عنها، على عكس الحيوانات البرية التي تشكل خطرا. أما بخصوص الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوانات البرية، فقد أوضح محدثنا أن بعض الأمراض تصيب الجهاز الهضمي والدورة الدموية مسببة أمراض الدم، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية التي قد تنجم عن الاحتكاك بها بسبب البكتيريا، مثل بكتيريا “ستافيلوكوك” الذهبية The Golden Staphylococcus التي يمكن أن تنتقل عن طريق الهواء من الحيوان البري الذي قد يحملها في ريشه أو شعره إلى الإنسان مباشرة، «وتعتبر خطيرة جدا»، مثلما أوضح. وقد أخذت العينات التي شملتها الدراسة من داخل أجسام الحيوانات، خصوصا فضلاتها، أو من الأجزاء الخارجية مثل ريش العصافير وشعرها، حيث بحث الفريق من خلالها عن البكتيريا، مثلما أكده لنا البروفيسور بارة، في حين شرح لنا بأن ظهور بكتيريا جديدة في مناطق غير معهودة، على غرار البكتيريا المسجلة لأول مرة في الولايات الشمالية الشرقية، يرتبط أيضا بالعوامل المناخية. وأوضح المتحدث أن فريق البحث يتألف من طلبة في طور الماستر، حيث يتكون من الباحثات زينب بريش وآسيا لوصيف وحنان مسعودي ووصال حدادي وشبيلة حزام وفاتن طراد خوجة وأسماء محمودي ودنيا رحامنية. وقد نبه محدثنا أنهن تخرجن جميعهن من الجامعة. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة منشورة باللغة الإنجليزية تحت عنوان Incidence and Effect of Wildlife Trae in «Zoonotic Spillover Risk» and Bacteria Emergence in Northeastern Algeria: Ecological and Epidemiological Perspective». س.ح
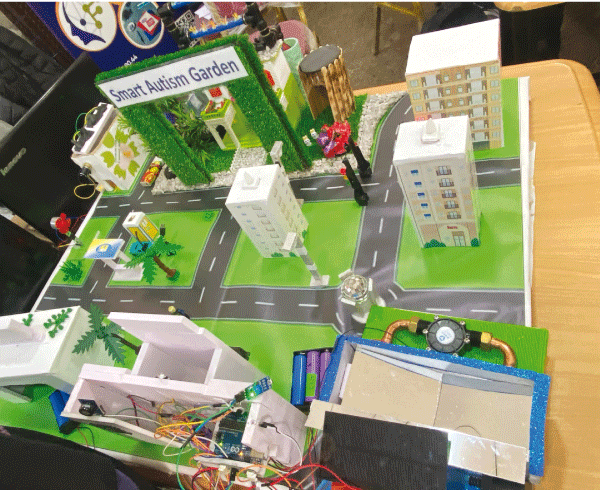
تدمج بين التكنولوجيا والتعليم والوعي المجتمعي
جيل مبتكر يطور مشاريع تخدم البيئة والتنمية المستدامة
يشتغل تلاميذ وشباب جزائريون لا تتعدى أعمارهم 18 سنة، على مشاريع ابتكارية تخدم البيئة وتدعم التنمية المستدامة، وذلك في إطار التحضير للمشاركة قريبا في فعاليات المسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي والبرمجة و الروبوتات المزمع إجراؤها بدولة قطر، والهادفة إلى تشجيع الإبداع الشبابي في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
لينــــــة دلول
وقد عرض مبتكرون مشاريعهم مؤخرا خلال التصفيات الوطنية للمسابقة بقسنطينة، أين أكدوا بأنهم يسعون إلى تحقيق نقلة نوعية في التعامل مع القضايا البيئية عبر حلول مبتكرة تدمج بين التكنولوجيا، والتعليم، والوعي المجتمعي.
غرفة ذكية لإنبات الشعير.. فكرة من قلب الحظيرة
طور أسيم بعيبن، رفقة صديقه براء بن رحال، غرفة ذكية لإنبات الشعير، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحلول البيئية المستدامة، بهدف إنتاج علف عالي الجودة وبأقل التكاليف.
قال أسيم البالغ من العمر 24 سنة، وهو طالب بمؤسسة الجزري للروبوتيك، إنه رغم حبه لعالم البرمجيات، إلا أن جذوره مرتبطة بالفلاحة وتربية المواشي، بحكم أن والدته تعمل بيطرية، وقد كان هذا الارتباط بمثابة جسر قاده نحو فكرة مشروعه.
معلقا:» كنت أرافق أمي إلى أماكن عملها وأراقب عن قرب الحيوانات وطبيعة تغذيتها، وذات مرة رأيت الشعير المستنبت وسألت عنه، فقيل لي إنه مفيد جدا لكن ثمنه باهظ، ومن هنا بدأت أفكر لماذا لا ننتجه بطريقة ذكية وبأقل تكلفة خاصة وأنني كنت أتعلم الروبوتيك وقتها.
وأكد أسيم، أنه شرع في تصميم الغرفة الذكية، التي تتيح التحكم التام في كل تفاصيل إنبات الشعير، بدءا من الإضاءة إلى التهوية والري، وحتى النظام الأمني.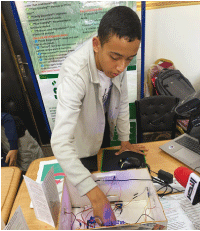
وشرح، بأن الغرفة مزودة بأضواء LED بالأزرق والأحمر، تعمل 19 ساعة يوميا لتحفيز التركيب الضوئي، ما يسرع النمو ويعزز جودة الشعير، كما تحتوي على نظام تهوية مبرمج للعمل 3 إلى 4 ساعات يوميا لتجديد الهواء ومنع تكون العفن.
وأوضح المتحدث، أن الغرفة تحتوي على نظام الري بالتنقيط، بمعدل خمس مرات يوميا، ولمدة 30 ثانية في كل مرة، لتوفير الماء دون تبذير مؤكدا، أنه زود الغرفة بنظام التعرف على الوجه، فلا تفتح إلا لصاحب المشروع، مع دعم إضافي بكلمة مرور لتعزيز الحماية.
أقل تكلفة و أعلى جودة
وأكد أسيم، أن هذا النموذج الذكي يوفر الطاقة والماء بشكل ملحوظ، ويتيح إنتاج شعير عالي الجودة دون الحاجة للمتابعة اليومية أو الجهد المتواصل، وهو ما يجعله مناسبا للفلاحين أو المستثمرين في القطاع الزراعي، وأضاف المتحدث، بأنه ينصح الفلاح باعتماد هذه الغرفة لأنها ليست اقتصادية فقط، بل تنتج شعيرا مغذيا في وقت قصير دون مشقة أو تعقيد.
الشعير المستنبت… الغذاء الأخضر للمواشي
وأشار ، إلى أن زراعة الشعير بنظام»الهيدروبونيك» من الحلول الزراعية الحديثة التي تستجيب لحاجيات المربين، سواء من حيث القيمة الغذائية أو التكلفة.
لأن الشعير المستنبت يزرع دون تربة، ويستهلك كمية قليلة من الماء وهو سريع النمو ويحصد خلال 7 إلى 10 أيام فقط.
وأكد المتحدث، أن له العديد من الفوائد أيضا، أهمها أنه غني بالبروتينات، والألياف، والفيتامينات والمعادن، كما أنه سهل الهضم ويعزز مناعة الحيوانات، لا يحتاج إلى مبيدات أو أسمدة، علاوة على ذلك فهو يقلل الاعتماد على المراعي ويحد من تدهور الأراضي.
وشرح طريقة زراعة الشعير، حيث تحضر البذور عبر غسلها ونقعها، ثم يتم استعمال صواني لتجميعها مع ضبط الحرارة والرطوبة، و ضمان التهوية والري المنتظمين.
وأكد المتحدث، أن عملية النمو والحصاد تتم خلال 7 إلى 10 أيام، بطول 15 إلى 20 سم، مشددا في سياق متصل على ضرورة تقديمه طازجا خلال 24 ساعة.
وأوضح المطور، بأن الشعير مفيد جدا للإنسان حيث يمكن أن يكون مكملا غذائيا صحيا، يحتوي على فيتامينات مثل A، B، C، E، K، إلى جانب الحديد والكالسيوم، ويساهم في تقوية المناعة، تنظيم مستوى السكر في الدم، ودعم صحة القلب، والمساعدة على فقدان الوزن.
وأكد، أنه يتم تقديم الشعير المستنبت حسب نوع الحيوان، فعلى سبيل المثال، تقدم للأبقار الحلوب كمية تتراوح بين 10و15 كغ، وتخصص لعجول للتسمين 7إلى 10 كغ، أما الأغنام والماعز، فتستهلك 2إلى 4 كغ في حين تقدم الجمال كمية بين 8إلى 12 كغ، و الأرانب من 200إلى 300 غ، مقابل 50إلى 100 غ للدواجن. ويشدد أسيم، على ضرورة دمج الشعير المستنبت مع أعلاف أخرى لضمان توازن غذائي، مع تقديمه طازجا للحفاظ على قيمته.
مدينة ذكية تعمل بالطاقات المتجددة
وبرز في مجال الابتكار كذلك، كل من الشابين محمد أمين بدالي ومعتصم بالله، من ولاية الجزائر، وقد انطلقا في مجال الروبوتيك كما علمنا منهما، خلال مشاركتهما في مخيم شتوي نظمته أكاديمية «آم بي أكاديميك» خلال عطلة الشتاء، و توجت جهودهما بابتكار مشروع لمدينة ذكية تعتمد بالكامل على الطاقات المتجددة، مما يعكس رؤيتهما لمستقبل مستدام ومتكامل.
تقوم فكرة المدينة الذكية التي صممها محمد أمين ومعتصم بالله، على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح لتشغيل مختلف المرافق.
ومن أبرز معالم هذه المدينة كما شرحا لنا، مستشفى يعمل بالطاقة المتجددة حيث يتميز بنظام لكشف تسرب الغاز، بحيث تفتح الأبواب أوتوماتيكيا لإنقاذ الأفراد المتواجدين بالداخل، بالإضافة إلى حاضنة بيض ذكية قادرة على التحكم في درجة الحرارة تلقائيا، مما يضمن بيئة مثالية لتفقيس البيض، فضلا عن محطة شحن للسيارات الكهربائية تعمل بطاقة الرياح، مما يوفر حلا صديقا للبيئة لشحن المركبات الكهربائية، مع توفر مساحة مخصصة للأطفال ذوي التوحد، لتنمية الجانب الإبداعي لديهم و يعزز اندماجهم في المجتمع.
الاستفادة من التجارب العالمية والمواد المعاد تدويرها

وأكد معتصم ومحمد، بأنهما استلهما العديد من الأفكار من بلدان متطورة لبناء مدينة ذكية ومريحة، مثل تقنيات الزراعة المائية والعمودية على الأسطح، كما اعتمدا على استخدام المواد المعاد تدويرها في البناء، بهدف تشجيع إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.
و قاما على سبيل المثال، باستخدام الخشب القديم لصناعة مقاعد للزوار وتظليلها بألواح شمسية لتوفير الإنارة الليلية، كما تم تدوير الأنابيب والإطارات كحاويات للزراعة، مما يساهم في حماية النباتات من العوامل الطبيعية الضارة وتوفير الرطوبة اللازمة للتربة.و تضمنت المدينة أيضا، نظام إنارة أوتوماتيكيا حيث تضاء المصابيح عند وجود الأشخاص فقط، مما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة.وأكد المتحدثان، بأنهما من خلال هذا المشروع، أظهرا كيف يمكن للتكنولوجيا والابتكار أن يساهما في بناء مدن مستدامة وصديقة للبيئة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمجتمع.
لعبة مسلية لترسيخ الوعي البيئي لدى الأطفال
من جهتهما، اختارت التلميذتان منار بوعرعور وآية قعاص، أن تسهما بطريقتهما الخاصة في حماية البيئة، عبر تصميم لعبة تعليمية تفاعلية موجهة للأطفال بعنوان «OCEAN PURIFICATION»، هدفها الأساسي ترسيخ سلوكيات بيئية إيجابية بطريقة ممتعة وتحفيزية.
تقوم فكرة اللعبة حسب منار بوعرعار صاحبة 10 سنوات، على تعليم الأطفال كيف يحافظون على المحيطات نظيفة و التخلص من النفايات في الأماكن الصحيحة، من خلال محاكاة واقعية داخل اللعبة ترصد تصرفات اللاعب وتكافئه على كل سلوك بيئي سليم.
وأكدت منار، بأن هذه المبادرة تندرج في إطار مشاركتهما في مسابقة موجهة للمشاريع البيئية المبتكرة «كودافور»، التي تسعى إلى دعم الحلول المستدامة وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل المناخي.
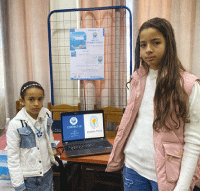
وأكدت منار، بأنها لاحظت هي و زميلتها أية، أن الأطفال يتأثرون كثيرا باللعب، لذا قررتا توجيه هذا التأثير نحو غرس قيم بيئية لديهم منذ الصغر، خصوصا وأن تلوث المحيطات في الآونة الأخيرة صار يؤذي الكائنات البحرية ويجعل الماء غير نظيف.
أما آية، فتؤكد أن اللعبة ليست ترفيها فقط، بل وسيلة لبناء جيل أكثر وعيا بمشاكل البيئة، من خلال مكافأة السلوك الإيجابي وتعزيز مبدأ المسؤولية.
وأكدت منار، أن مشروع «OCEAN PURIFICATION» لا يكتفي فقط بتقديم محتوى ترفيهي، بل يتقاطع مع عدد من أهداف التنمية المستدامة، على غرار العمل المناخي، الاستهلاك المسؤول، الحياة تحت الماء والمدن المستدامة.
و أوضحت الفتاتان أنهما تسعيان، إلى تطوير اللعبة مستقبلا لتشمل مستويات تعليمية متعددة، وتوسيع نطاق التوعية إلى فئات عمرية أكبر، كما تهدفان إلى عرضها على منصات تعليمية وتطبيقات موجهة للأطفال.
وأكدت منار، أن التأثير المتوقع من اللعبة يتمثل في تعزيز الوعي البيئي تحفيز العادات الصحيحة لدى الأطفال عبر التعلم، وذلك من خلال اللعب مع اكتساب مهارات حل المشكلات، وتنمية روح التحدي والمثابرة وإلهام الأطفال للمشاركة في مبادرات بيئية حقيقية.