
توفي، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة الصحفي والروائي والناقد السينمائي جمال الدين مرداسي، عن عمر ناهز 78 سنة، حسب ما علم لدى أقاربه.
ويعتبر الفقيد، وهو من مواليد 1947 بمدينة الحروش بولاية سكيكدة، من الأٌقلام الصحفية المحترفة، إذ اشتغل على مر سنوات طويلة في عدة جرائد وطنية ناطقة باللغة الفرنسية، من بينها مجلة «الشاشتان» وجرائد «المجاهد»، «لوسوار دالجيري» و»الوطن». وهو من عائلة معروفة في قطاع الثقافة والإعلام والتعليم العالي، فهو شقيق للمؤرخ والكاتب الراحل عبد المجيد مرداسي، وكذا الصحافي الراحل نور الدين مرداسي الذي اشتغل إلى جانبه في يومية المجاهد،فضلا عن بقية الإخوة الذين يشتغلون في جامعات قسنطينة ويسكنهم الهم الثقافي و الإعلامي.
كما عرف الراحل بنقده السينمائي في مجلات متخصصة وعبر الجرائد التي كان يعمل بها، وخصوصا ما تعلق بالسينما في الوطن العربي، وكذا بكتابته لسيناريو الفيلم السينمائي «الدخلاء» للمخرج محمد حازورلي.
وبالإضافة إلى نشاطه الصحفي ونقده السينمائي، فقد أصدر الفقيد كذلك عدة أعمال أدبية، منها روايات: الطاغية، زقاق السيدات…
توفي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الصحفي والروائي والناقد السينمائي جمال الدين مرداسي، عن عمر ناهز 78 سنة، حسب ما علم لدى أقاربه.
ويعتبر الفقيد، وهو من مواليد 1947 بمدينة الحروش بولاية سكيكدة، من الأٌقلام الصحفية المحترفة، إذ اشتغل على مر سنوات طويلة في عدة جرائد وطنية ناطقة باللغة الفرنسية، من بينها "المجاهد"، "لوسوار دالجيري" (مساء الجزائر) و"الوطن".
كما عرف الراحل بنقده السينمائي في مجلات متخصصة وعبر الجرائد التي كان يعمل بها، وخصوصا ما تعلق بالسينما في الوطن العربي، وكذا بكتابته لسيناريو الفيلم السينمائي "الدخلاء" للمخرج محمد حازورلي.
وبالإضافة إلى نشاطه الصحفي ونقده السينمائي، فقد أصدر الفقيد كذلك عدة أعمال أدبية.
وأج

استقطبت أمس الأول، سهرة «لمة وأمان» المنظمة ضمن فعاليات صيف سيرتا، بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، جمهورا عريضا ضم أجانب حضروا لأول مرة حفلا قسنطينيا، أعربوا للنصر عن انبهارهم بموسيقى المالوف، كما أبدوا استمتاعهم بأجواء الحفل.
وطبعت السهرة، التي أحيتها جمعية مقام القسنطينية، أجواء رائعة صنعها تفاعل الجمهور مع آداء عناصر الفرقة، حيث أبدعت في تقديم وصلات غنائية متنوعة، منها «دمعي جرى على صحن خدي كما المطر»، والتي ردد أبياتها حضور، مبدين سحرهم بأنغامها وعمق كلماتها. وقد كان جمهور حفل «لمة وأمان» متنوعا، حيث لم يقتصر كما هو معتاد على الفئة المحبة للمالوف والطابع الأندلسي، وإنما شمل جمهورا متنوعا وحتى أجانب لم يسبق وأن حضروا حفلا قسنطينيا أو سمعوا موسيقى محلية، من بينهم سيدة فرنسية، تدعى ألين، أظهرت إعجابها بموسيقى المالوف التي لا تعرفها كثيرا، مضيفة بأنها اطلعت على الآلات الموسيقية التي يقدم بها هذا اللون الغنائي، واستمتعت بطريقة تقديم الجوق الغنائي لوصلة موسيقية طويلة جدا، مشيرا إلى أنها لم تفهم الكلمات جيدا غير أنها استوعبت محتواها العام الذي يبرز مبادئ الدين الإسلامي، معربة في الختام عن سعادتها بقضاء لحظات استثنائية وممتعة مع جمهور ذواق للفن. وفي تصريح خص به النصر، عبّر رئيس جمعية مقام، السيد حمزة بجاجة عن سعادته بنجاح السهرة قائلا: «كان حفلا جميلا، وتفاعلا رائعا من الجمهور الذي أثبت مرة أخرى تعطشه لهذا اللون الفني الأصيل، هدفنا الأول في جمعية مقام هو الترويج للطابع القسنطيني الأصيل والتعريف بالموروث الثقافي الغني للمدينة».
من جهتها، أكدت نجوى بورور، عضوة بالجمعية، على البعد الإنساني الذي يجمع أفراد الفرقة قائلة: «نحن في جمعية مقام عائلة واحدة، تجمعنا المحبة لهذا الفن العريق، نحن هنا لخدمة هذا التراث الفني وصونه ونقله للأجيال».
ولم يخف الجمهور الحاضر إعجابه بالحفل من حيث الأداء والتنظيم، مشيدين بالأجواء العائلية الراقية التي خيمت على القاعة، وبحسن استقبال المنظمين، معتبرين أن مثل هذه التظاهرات تشرف قسنطينة كحاضرة ثقافية بامتياز.
وتتواصل فعاليات «صيف سيرتا 2025 لمة وأمان» بتقديم عروض وأنشطة فنية وثقافية في عدة فضاءات بالمدينة، بهدف تنشيط الساحة الثقافية خلال العطلة الصيفية وإبراز الموروث المحلي في أبهى صوره، وذلك في إطار إستراتيجية تهدف إلى جعل قسنطينة وجهة سياحية وثقافية مستدامة.
عبدالغاني بوالودنين

يبعث روح الفن في كل فضاء تلامسه ريشته، ويعيد الحياة لمساحات مهملة تغرق في الأوساخ، برسومات من وحي الطبيعة والتراث تحمل بين طياتها رسائل ثقافية توعوية تحث على نظافة المحيطة وتعكس خصوصية المنطقة، يحث على إشراك فئة الأطفال لتنمية الحس الجمالي لديهم ومحاربة السلوكات المعادية للفن، هو ابن ولاية الجلفة الفنان نصر الدين حانطي، الذي تحدث للنصر عن تخصصه في فن الشارع، وبعثه لعديد المبادرات الفنية لتهذيب الذوق الفني.
استطاع الشاب نصر الدين حانطي، أن يحتل مكانة في قلوب آلاف متابعيه عبر الفضاء الافتراضي، ويضمن التفاف الكثير حول مبادراته الفنية التي ساهمت في تغيير وجه مدينته، حيث حول صفحاته إلى مساحة لمشاركة ما يقوم به مع المتابعين، الذين يشكلون داعما رئيسا لما يقوم به، على حد تعبيره.علاقة الفنان نصر الدين، صاحب 28 ربيعا، بالريشة والألوان، بدأت تتوطد في سن الثالثة عشر، حيث كان يجيد الرسم، وكانت والدته رحمها الله أول من اكتشفت موهبته وميولاته الفنية، فرافقته بالتشجيع والدعم، كما قوبل بالتحفيز من قبل أستاذه في مادة الرسم في الطور المتوسط، الذي مد له يد المساعدة من خلال توفير ما يحتاجه من أدوات خاصة بالرسم فضلا عن إدماجه في نادي فني، أين فجر موهبته، حيث كان يبدع في رسم البورتريهات.
حبه للرسم جعله وبمجرد قطع تأشيرة الانتقال للجامعة سنة 2017، يختار ميدان الفنون بكلية الفنون والثقافة بجامعة زيان عاشور بالجلفة، وتخصص خلال مساره الجامعي في النقد التشكيلي، غير أن تعطشه لنهل المزيد في هذا المجال وتوسيع رقعة نشاطه الفني دفعه للتسجيل بمعهد الفنون الجميلة بولايته، أين تخصص في الألوان الزيتية، قائلا بأن دراساته الأكاديمية مكنته من تطوير موهبته وساهمت في تدليل الصعوبات التي واجهته عند رسم جداريات في مساحات كبرى، وعلى واجهات البنايات، التي تستدعي تقنيات وقواعد للتمكن من التحكم في الأحجام وتقديم عمل فني خال من الأخطاء.
نشر الوعي بنظافة البيئة جزء من مبادرات فن الشارع
تخصص الشاب نصر الدين بعد إنهاء من تكوينه الأكاديمي، في فن الشارع، وهو تخصص يجده مناسبا لميولاته ويشبع رغبته الفنية كما يحمل رسائل مجتمعية توعوية تحارب بعض السلوكات والظواهر السلبية، فانطلق من محيطه الضيق من خلال رسم جداريات على جدران البنايات وقواعد محولات الكوابل، التي يغرق محيطها في الأوساخ وتشوه جدرانها عبارات حائطية تخل أحيانا بالآداب العامة، ليكسوها برسومات لمناظر طبيعية مستلهمة من الخصوصية الجغرافية للمنطقة، كما يضفي عليها أحيانا لمسة مختلفة تخول لكل من يراها أنه بمدينة ساحلية، هذا بعد تنظيفها.
إشراك الأطفال في رسم الجداريات يشعرهم بالمسؤولية
نشاط نصر الدين الفني سرعان ما ازدهر، بعد تمكنه من بعث مبادرات فنية تطوعية، وانضمام عدد من الشباب مع إشراك الأطفال، الذين يعتبرهم حلقة مهمة في تحقيق مبتغاه من ممارسة فن الشارع، القائم على محاربة كل أشكال العداء للفن، والذي تجلى سابقا في الاعتداء على جداريات وغيرها، ويجد في مشاركتهم فرصة لتحسيسهم بروح المسؤولية اتجاه ما يقومون به والوعي بالقيمة الفنية للجدارية، كما ينمي لديهم ثقافة الاهتمام بالمحيط والحرص على نظافته، من خلال حملة تنظيف المكان التي تسبق كل مبادرة.
قبل إطلاق أي مبادرة، يحرص الفنان نصر الدين على اختيار موضوع الجدارية والرسالة التي يود نقلها للمجتمع، حيث يأخذ نظرة عن طبيعة المكان وسكانه ليختار بعناية فحوى الرسالة والرموز التي تحملها وكيفية التعبير عنها أو تقديمها للجمهور، وغالبا ما يأخذ وقتا في ذلك يصل إلى 20 يوما، ليعلن بعدها على مبادرته، عبر حسابه أو بالحديث لجيرانه وأصدقائه، لتوفير الإمكانيات المادية ثم مباشرة العملية.
مقترحات الجمهور الافتراضي جزء من مواضيع جدارياتي
وعن المواضيع التي يختارها عادة، قال بأنه يروج أحيانا لتراث المنطقة وطبيعة العيش فيها، لتكون رسالة للزائر تعكس خصوصية المدينة وعاداتها وتقاليدها، فيما يختار في أحيان أخرى مناظر طبيعية وأخرى مستوحاة من مناطق ساحلية، كما يضمن رسوماته أيضا بعبارات توعوية للحد من السلوكات التي تشوه المنظر العام للمدن، كالرمي العشوائي للأوساخ وغيرها، كذلك عبارات تحارب اليأس والكسل وتبعث الأمل، وأخرى تعبر عن معاناة فئة معينة من المجتمع، كجدارية تنقل معاناة مرضى السرطان التي قام برسمها في وسط مدينة الجلفة والتي تعبر عن معاناة المصابين بهذا المرض، مشيرا في هذا السياق إلى أنه لا يعتمد فقط على نفسه في ضبط واختيار المواضيع، وإنما يأخذ في أحيان كثيرة بمقترحات متابعيه والمقربين منه، الذين يتفاعلون مع ما يقوم به.
نقل فن الشارع الفنان نصر الدين لعديد الولايات، وجعله يجوب عديد المناطق، بطلب من شباب ساهم بفضل منشوراته الفنية لعديد المبادرات أن يوقظ الحس الفني الجمالي لديهم، حيث يتحملون على عاتقهم تكاليف تغيير الفضاء الذي ينتمون إليه، سواء محيط العمارات وحتى الملاعب الجوارية، حيث يمنحون اشراقة للمكان كما يقترحون رسومات تتعلق بشعار فرقهم الرياضية وعبارات تشجع على التحلي بالروح الرياضية والآداب العامة في هكذا فضاءات.
محدثنا قال ومنذ بداية نشاطه في فن الشارع، منذ نحو سبع سنوات وضع بصمته على جدران 70 مؤسسة تربوية داخل وخارج ولايته، ومن الولايات التي زارها ذكر البليدة والعاصمة والبويرة، مردفا بأن أغلب المؤسسات التي ساهم في تزيينها بولايته بمبادرات شخصية، مشيرا إلى أنه يتلقى طلبات كثيرة من أصحاب المحلات التجارية الذين يفضلون إضفاء لمسة جمالية عليها.
بخصوص تسديد أعباء المبادرات، قال بأنه يتم بفضل مساهمة مشاركين في العملية وتجار المنطقة، وكذا سكانها حيث يوفرون له المواد الأولية، كما تشكل هذه المبادرات مصدر رزق له حيث يستجيب لعدد من الطلبات بمقابل مادي، كما يقوم بإشهار للمحلات عبر صفحته، وعن تكاليف رسم جدارية أوضح بأنها تختلف حسب الحجم والموضوع وتتراوح بين 4 آلاف و40 ألف، يستغرق رسمها يومين كأقصى تقدير.
أسماء ب

سجل المتحف العمومي الوطني سيرتا بقسنطينة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد زواره خلال السداسي الأول من سنة 2025، حيث بلغ 13 ألف زائر، من بينهم أكثر من 3 آلاف زائر أجنبي، في زيادة معتبرة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ولفت عبد المجيد بن زراري، رئيس مصلحة الاتصال بالمتحف العمومي الوطني سيرتا، إلى أن أغلب الزوار الأجانب قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مع تسجيل زوار أقل من دول آسيا، ويشكل الباحثون والمهتمون بمجال الآثار نسبة كبيرة من الزوار، حيث يقصدون الولاية تحديدا للإطلاع على كنوزها الأثرية، وأحيانا يأتون خصيصا لمشاهدة تحفة معينة ويقضون مدة طويلة في مشاهدة وتأمل تفاصيلها والاستفسار عن تاريخها ومكان العثور عليها، للحصول على أكبر قدر من المعلومات وإشباع رغبتهم المعرفية، مرجعا سر زيادة توافد السياح الأجانب على المؤسسات المتحفية بالولاية إلى الإستراتيجية التي تتبعها، كفتح قاعات جديدة وإعادة إبراز تحف ولقى أثرية لم تكن معروضة بالشكل الذي يليق بقيمتها، والترويج لذلك عبر الفضاء الافتراضي.
وأشار بن زراري إلى أن المتحف الوطني سيرتا يفتح أبوابه يوميًا ووسع أوقات الزيارة لتلبية الطلب المتزايد، سواء من قبل تلاميذ المدارس أو السياح والزوار، كما كثف النشاطات الميدانية والتربوية، خاصة نشاط الحقيبة المتحفية الموجهة للمناطق النائية، الذي يسمح لإطارات المتحف بنقل كامل التجهيزات الضرورية، لاطلاع التلاميذ على المجموعات المتحفية، مع تركيز خاص على فترة ما قبل التاريخ، مثل التعريف بموقع كهف الدببة وغيره، وهو نشاط ساهم في تشجيع العديد من الأولياء على زيارة المتحف رفقة أبنائهم.وكشف مسؤول المصلحة عن مبادرة مشتركة مع متحف سطيف، لتنفيذ برنامج مشترك خلال موسم الصيف، يتضمن إحياء الطبعة الثانية من «الحقيبة المتحفية»، في إطار تعميم الثقافة المتحفية وجعلها في متناول جميع الفئات، منوها بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة العدل، المتعلقة بإدراج برنامج «الحقيبة المتحفية» ضمن المؤسسات العقابية، والتي ستمكن من تقديم عروض متحفية داخل السجون والتعريف بالموروث الثقافي لمدينة قسنطينة.
كما تنظم إدارة المتحف، حسب ذات المتحدث، ورشات بيداغوجية وأنشطة تحفيزية خاصة لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المسابقات والخرجات الميدانية، خصوصًا في العطل والمناسبات والأعياد الوطنية.
عبد الغاني بوالودنين
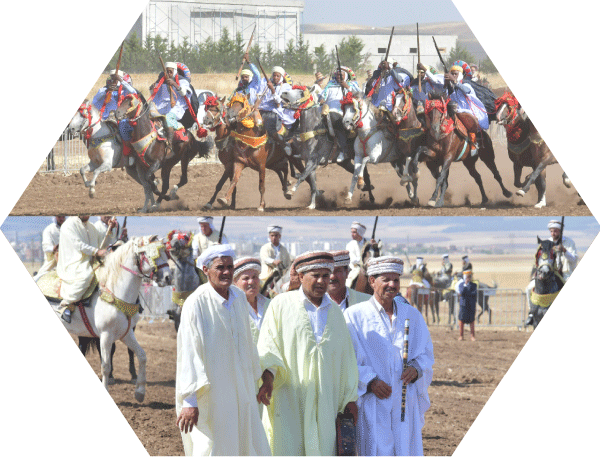
تشكل الفنتازيا والشعر الملحون، ثنائيا شاهدا على الذاكرة الجماعية التي سطرها الأجداد بالحرف والبارود، فهما مشهدان متكاملان ينبعثان من صلب الهوية، ويرسمان ملامح الإنسان الجزائري في صموده وشجاعته وارتباطه الوثيق بأرضه. ويؤكد باحثون وشعراء للنصر، أن هذين الفنين يتعديان حدود المشهد البصري ليصبحا احتفالا للهوية وتجسيدا فنيا لعلاقة الإنسان بالحصان، وهو أيضا أرشيف شعبي وجب الحفاظ عليه ونقله للأجيال اللاحقة.
لينة دلول
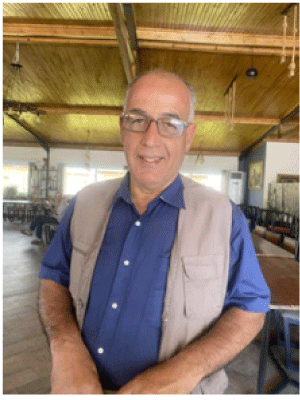
* الباحث في التراث محمد العلمي
الفنتازيا امتداد حي لذاكرتنا الجماعية
يرى الباحث في التراث محمد العلمي، أنه و قبل الحديث عن الفنتازيا أو حتى عن الفرس البربري، وجبت العودة إلى عمق التاريخ، واستحضار الصلة العضوية التي ربطت الجزائري بالحصان، والتي لم تكن مجرد علاقة وظيفية أو قتالية، بل صلة وجودية نسجت ملامح الهوية وألهمت الأدب والوجدان.
وأكد العلمي، أن الحصان البربري ليس مجرد فصيلة من الخيول، بل سلالة نادرة ونقية أصلها من منطقة المغرب الكبير، لطالما تميزت بقوتها وسرعتها، وقدرتها على التحمل.
وهي «وحدة إثنية» نادرة في عالم الخيول، قلما امتلكتها شعوب أخرى، لا من حيث صفاتها البدنية، بل أيضا من حيث رمزيتها في الثقافة الشعبية والتاريخ السياسي.وأضاف المتحدث، أن الحصان البربري قد شكل عبر القرون، قاعدة لتحسين سلالات أخرى، إذ دخل دمه في تهجين عدة فصائل عالمية مثل الحصان الإنجليزي والفرنسي، واعتمد عليه للحصول على نسل أكثر قوة وصلابة. متابعا بالقول، إن دمه يجري اليوم في عروق أشهر الخيول الأوروبية، وهو ما يعكس قيمته الوراثية والتاريخية الكبرى.أما عن البعد التاريخي، فيستحضر العلمي رواية مشهورة تقول إن الإسكندر المقدوني نفسه، في إطار فتوحات توحيد الإمبراطوريتين الإغريقية والفارسية، ركب حصانا بربريا ساعده في خوض معاركه، وظهر ذلك حتى في بعض الكتابات والأعمال الفنية. وذكر، بأن الحصان البربري حظي باهتمام الأدب، والسينما، والشعر الشعبي، لما له من رمزية عالية في المخيال الجمعي، حيث اقترن بالشجاعة والصبر والكرامة.
كما أشار، إلى أن هناك وثائق تاريخية تعود إلى سنة 153 قبل الميلاد، تفيد بأن ابن ماسينيسا وأب يوغرطة، شاركا في الألعاب الأثينية التي تعد أصل الألعاب الأولمبية الحالية على ظهور خيول بربرية، وتمكنا من الفوز بأربع ميداليات ذهبية، ما يعد إنجازا حضاريا موثقا يرفع من شأن هذه السلالة.
وأكد العلمي، بأن العلاقة بين الجزائري والحصان البربري علاقة متكتلة عضوية، ومستمرة، تداخل فيها التاريخ بالوجدان، والبطولة بالتراث، وكل ما أنجزه الأجداد من بطولات على ظهور هذه الخيول، صاغ ما نعرفه اليوم باسم «الذاكرة الجماعية الجزائرية»، التي تحتاج بحسبه إلى التلخيص والنقل من جيل إلى جيل.
أما الفنتازيا، فيراها الباحث تجسيدا حيا لهذا الارتباط العميق، مؤكدا بأن الفنتازيا ليست استعراضا فقط، بل هي شاهد حي على ما كنا عليه، وما نتميز به ثقافيا وتاريخيا، لكونها صورة لذاكرتنا في محيطنا وهويتنا”
كما أشار الباحث، إلى كلمة «جوكي» المستعملة عالميا في سباقات الخيل، وقال إن أصلها ليس إنجليزيا كما يُعتقد، بل مشتقة من «خناتي» أو «زناتي»، نسبة إلى قبائل زناتة الأمازيغية المعروفة بعراقتها في تربية الخيول ومهارتها في الفروسية. مؤكدا في ذات السياق، بأن الفنتازيا موجودة بجميع أقطار المغرب العربي، وتبقى من أبرز تجليات هذا التراث الحي.

* رئيس جمعية الموروث الثقافي غير المادي والفنتازيا خليفة عدادي
الفنتازيا سجل حي للمقاومة الشعبية
من جهته، يؤكد رئيس جمعية الموروث الثقافي غير المادي و الفنتازيا بولاية سعيدة خليفة عدادي ، أن فن الفنتازيا ليس استعراض فروسية جماعيا، بل هو أحد أعمدة التراث الشعبي الجزائري، الذي توارثته الأجيال عبر قرون، خصوصا في مناطق الجنوب والغرب، وأيضا الشرق الجزائري، حيث يحظى باهتمام خاص ويمارس بشكل احترافي في عدد من الولايات.
وقال عدادي، إن الفارس والجواد في المخيال الشعبي الجزائري ليسا مجرد رمزين جماليين، بل هما رمز للمقاومة والكفاح الوطني، متابعا بأن الفنتازيا تحيلنا على ملاحم خالدة من المقاومة الشعبية التي خاضها كل من الشيخ بوعمامة، الأمير عبد القادر، الحاج المقراني، ولالة فاطمة نسومر، ضد الاستعمار الفرنسي، حيث كان الحصان جزءا لا يتجزأ من سلاح المقاومة.
وأوضح المتحدث، أن التاريخ الجزائري في مختلف مراحله وثق فن الفنتازيا، باعتباره مرآة لتحولات المجتمع، وتجسيدا لمظاهر الشجاعة والكرامة والتلاحم بين الفرد ومحيطه الثقافي والديني.
وفي السياق نفسه، استحضر عدادي الدور البارز الذي تلعبه الجزائر في حماية هذا التراث عالميا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد شغل منصب رئيس المنظمة العالمية للحصان العربي والبربري، التي تأسست سنة 1987، والتي انبثقت عنها فروع دولية في أوروبا الشرقية والغربية، مما ساعد على ترسيخ مكانة الحصان البربري كرمز تراثي عالمي.
ويرى المتحدث، أن الحديث عن الفروسية لا ينفصل عن البعد الفكري والروحي، مؤكدا بالقول :« عندما نتأمل في خصوصيات الفروسية، نكتشف أنها سجل حي لجوانب فكرية واجتماعية وثقافية، بل إنها ترمز إلى قيم الإسلام الأصيلة مثل الشهامة، الكرم، والغيرة على الأرض، وهي مبادئ تناقلتها الأجيال عبر الزمن.»
وشدد عدادي، على أن الفنتازيا تمثل أحد المحاور المركزية في الهوية الجزائرية والموروث غير المادي، فهي مزيج من الاستعراض والقوة والرمزية، وتحمل بعدا روحيا يعكس شموخ الإنسان الجزائري وصلابته في وجه المحن.
كما ذكر، أن فن الفنتازيا قد سجلت رسميا سنة 2021 كتراث عالمي غير مادي من طرف اليونسكو، لكنه شدد على أن هذا لا يكفي، قائلا «نحن أولى من غيرنا بهذا الفن، ويجب أن يسجل باسم الجزائر، لأنه امتداد لتاريخ المقاومة ولروح الأمة».
مضيفا، بأن الحفاظ على الفنتازيا واجب وطني، ليس فقط باعتبارها موروثا ثقافيا، بل كذاكرة حية يجب نقلها وتثبيتها في وجدان الأجيال الجديدة.

* الشاعر عامر مراحي الحاج
الملحون ..أداة تثقيفية للأجيال الصاعدة
يرى الشاعر الشعبي، مراحي الحاج، الملقب بعامر، أن الشعر الملحون لم يكن يوما فنا للتسلية أو مجرد تعبير فني بسيط، بل هو وسيلة توثيق حية للتحولات الاجتماعية والوجدانية التي شهدها المجتمع الجزائري، على امتداد مراحله التاريخية، وخصوصا المرحلة الثورية المجيدة.
وأكد المتحدث، بأن الملحون يؤدي دورا قريبا من الصحافة، فهو يرصد الظواهر، وينقل الواقع، ويعلق عليه بلغة الناس، مشيرا في ذات السياق، بأن شاعر الملحون كان بمثابة مراسل شعبي، يكتب بالكلمة ما يعجز عن تدوينه المؤرخ، ويوصل بصدق وحس وطني أصيل.
وقد كان الشعر في زمن الجاهلية أداة التعبير الأولى، وصوت الفطرةحيث كانت المرأة تغزل وتقول الشعر، والرجل يحطب ويقول الشعر.
وأضاف المتحدث، أن شعر الملحون ما يزال صامدا رغم تقلبات الزمن وتسارع العولمة، بفضل شعرائه الأوفياء الذين حافظوا عليه كرمز من رموز الأصالة والانتماء. مشيرا في سياق متصل، إلى أن الملحون ليس مجرد كلام موزون بل هو هوية وطنية وثقافية لابد من نقلها للأجيال القادمة حتى لا تندثر، مؤكدا بأن هذا الفن الشعبي يقدم قيمة جمالية وتربوية عالية من خلال تناوله لموضوعات مثل الكرم، الشجاعة، الجود، حب الوطن مما يجعله أداة تثقيفية للأجيال الصاعدة.
وأضاف المتحدث، أن الملحون مدرسة قائمة بذاتها في النقد والتاريخ إذ يعالج القضايا بأسلوب مبسط وسلس.
كما أوضح، بأن الفنتازيا تكمل الملحون فهي تجسد القوة والشجاعة التي يغنى بها الشاعر، وتحيل إلى المشهد الشعري إلى صورة حية نابضة بالحركة.
ودعا الشاعر، الشباب إلى حمل مشعل الأجداد، والدخول إلى عالم الشعر الملحون، مؤكدا بأن هذا الفن ليس فقط تراثا، بل أمانة في أعناق الأجيال.
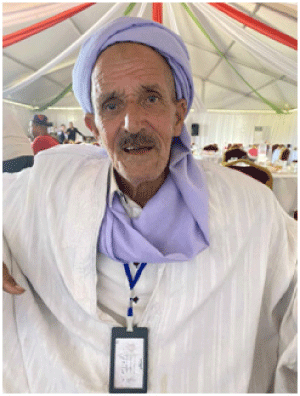
* الشاعر أحمد بروال من ولاية باتنة
الملحون ولد في البادية وظل وفيا للناس والواقع
يعتبر الشاعر أحمد بروال ، وهو من بين أقدم الأصوات الشعرية في ولاية باتنة، أن الملحون ابن البيئة البدوية بامتياز، وقد نشأ وتطور في أحضان الطبيعة، وسط قطعان الأغنام وهدير الخيول، وتحت ظلال الحياة القروية بكل ما تحمله من بساطة وصدق وتجذر في الأرض.
وقال بروال، إن تعلمه لهذا الفن لم يكن في مدرسة أو على يد أستاذ، بل في المرعى وفي المزارع وبين الماشية، حيث تتهجى الروح الكلمات عبر الملاحظة والتأمل والاختلاط بالناس والواقع.
وأكد المتحدث، أن كتابة القصيدة الملحونة موهبة إلهية، وهي منحة من الله يهبها لمن يشاء، لكنها تحتاج إلى صقل ومرافقة بالملاحظة والانغماس في الواقع. وهو ما يجعله يستلهم موضوعاته من الحياة اليومية، ومن التحولات الاجتماعية التي تمس الثقافة، والرياضة، وسلوك الأفراد.
الملحون لم يتوقف عن التجدد
ورغم أصوله التقليدية، يرى بروال أن الملحون لم يتوقف عن التجدد، مثله مثل كل شيء في الحياة فهو قابل أيضا للتصور، والقصيدة الملحونة بدورها تطورت و تجددت، موضحا أنها في الماضي كانت تبنى على أربع حروف «قواف»، أما اليوم يمكن أن يكتفي الشاعر بحرف واحد، دون أن تفقد قوتها أو جماليتها.
وأشار الشاعر، أنه في ظل الثورة الرقمية لم يتوار الملحون كما توقع البعض، بل وجد جمهورا واسعا في عصر التكنولوجيا، وتضاعف عدد المهتمين به، حيث ساهمت المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذا الفن وإيصاله إلى فئات لم تكن على دراية به.
وأكد بروال، أن شعر الملحون يخاطب جميع فئات المجتمع، لأنه يعكس هموم الناس، ويفضح التناقضات، ويعبر عن الفرح والحزن، عن الحب والخذلان، عن الأرض والوطن.
كما أنه لعب وما يزال يلعب دورا كبيرا في توثيق التحولات الوجدانية والاجتماعية للمجتمع الجزائري، من خلال لغته البسيطة الصادقة، وإيقاعه الذي ينساب في الذاكرة بسهولة.
وأوضح المتحدث، أن الملحون ساهم في الحفاظ على اللغة الدارجة وتطويرها، بل ورفعها من مجرد لهجة محكية إلى وسيلة فنية راقية تحمل معاني عميقة، وتخاطب الوجدان الجماعي، دون أن تفقد دفئها الشعبي أو بعدها الثقافي.
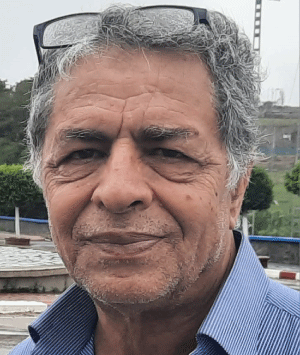
يرى الكاتب والباحث والمهندس الجزائري محمّد حسين طلبي، أنّ المدينة العربيّة تحتاج أوّلاً إلى ثورة خدمية جادة من أجل اِقتحام عالم المُستقبل بكلّ مُتطلباته. كما يرى من جهةٍ أخرى أنّ المُدن الذكية بالنسبة لنا كعرب هي حالة مضطربة وهذا لعدة أسباب من بينها أنّ مُدننا بوضعها الحالي لا يمكن أن تتعايش مع ترسانة التكنولوجيا. ومع هذا فهي بدون شك تُحاول كثيرًا ولكنّها تسير ببطءٍ شديد.
حوار: نـوّارة لحـرش
وقد نَوَّهَ -المُتحدّث- بمُدن المُستقبل، مُشيرًا في هذا السّياق إلى أنها مُدنٌ تقومُ على الاِبتكار والإبداع وتستخدم أحدث الوسائل والتطبيقات من أجل تطوير جودة الحياة فيها ودعم قدرتها وفاعليتها. مُثمِنًا بالموازاة دور الذكاء الاِصطناعي، الّذي هو -كما يقول- تقنية إدارية بالدرجة الأولى تُساعدُ المُدن والمُؤسسات على تفادي أي خلل بشري يُمكن أن يُشكلُ عائقًا تنمويًا. مُؤكدًا أنّ هذا النوع من المُدن يدعم مكانة الدولة (أي دولة) ويُلمعُ صورتها الخارجية.
للإشارة، محمّد حسين طلبي، (مواليد1948) كاتب ومهندس وباحث جزائري، يشغل مُهندسًا ضمن اِختصاصه في الأعمال الميكانيكية والكهربائية. نَشر العديد من المقالات والدراسات والأبحاث في مجلات وجرائد جزائرية وعربية مختلفة. وأصدر أكثر من 12 كتابًا، من بينها: “باب توما باب الفرج”، “جبانة اليهود”، “دنيا بنت عرب”، “بنات فاطمة”، “عزف على نزف”، “هذيان الأحاجي”، “غربة الكلام”، “يدور حول نفسه”، “قريبًا من طقوسهم”، “لاعبون بالرّيح”. إلى جانب كُتبه الفكرية والأدبية، أصدر عدداً من الكُتب العلمية التي تندرج في إطار اِختصاصه العلمي، من بينها: «معجم مصطلحات التكوين المهني بالعربية والإنجليزية والفرنسية»، «كِتاب التصنيع الميكانيكي (الحرفي)»، «كتاب الرسم الهندسي (الحرفي)». «خواطر حول الثقافة العلمية».
في الكثير من أبحاثك ودراساتك وكتاباتك تشتغل على مُدن المُستقبل من خلال مقاربات وتصورات، ما يعني أنّ اِهتمامك بهذا المجال نابع أيضًا من خلال مهنتك. فكيف برأيك سيكون شكل المُدن. خاصةً في العالم العربي؟
- محمّد حسين طلبي: نعم لدي اِهتماماتٌ واسعة بمُدن المُستقبل، ليس فقط من خلال الدراسات والأبحاث والمُتابعات، ولكن لأنّ الأمر يرتبطُ مُباشرةً بمهنتي كمهندس يعملُ منذ أكثر من أربعين سنة في منطقة الخليج التي تُحاول الاِرتقاء بمُدنها إلى مستويات مُتطورة سواء في جانبها المعماري أو في جوانبها الخدمية، كذلك الأمر الّذي جعلني أُتابع منذ زمنٍ بعيد الخط البياني الصاعد لهذه الحالة الجديدة على المنطقة العربية ككلّ والتي عودتنا على إهمالها المُبرمج مع الأسف لكلّ ما يمكن أن يُريح أو يُسعد الإنسان في مُدنه العريقة والتّاريخيّة بمعالمها الأصلية أو حتّى تلك الموروثة عن المُستعمر.
نعم إنّ هذا الجانب يَهمني ويأخذ من وقتي وبالأخص كما قلتُ لكِ أنّه قريب من مهنتي التي هي أقرب إلى الهواية بالنسبة إليّ، أُمارسها بكلّ شغف وحب، وبطبيعة الحال أضافت إليّ الدراسات والأبحاث والإحصائيات التي أقتربُ منها في هذا الجانب الكثير مِمَا هو مُمكن تحقيقه في الأجيال القادمة في الكثير من مناطق العالم التي هي اليوم قدوة تستحقُ التنبيه إليها وبالأخص بعض المُدن الآسيوية التي تُفاجئنا كلّ يوم بجديد يُسهِل على مواطنيها حياتهم ويقترب بهم من عالم السعادة والرفاهية.
أمّا كيفَ سيكون شكل مُدن المُستقبل فذلك يتوقف كما تعلمين على برامج المُسيرين لها ومدى اِقترابهم من تقنيات تطوير الجوانب الخدمية فيها ومدى ربط تلك الخدمات بعوالم البيئة وعوالم المواصلات وعوالم الإدارة الحديثة، هذا من جانب. أمّا من جانب الشكل فإنّنا نعتقد بأنّ للتنمية الاِقتصادية والصناعية والمالية دورٌ فاعل في إيجاد عمارة متطورة ذات جودة خدمية تمنحُ المُدن بريقاً سياحيًّا يُساعد دائمًا على تكثيف الاِبتكارات وفتح أبواب الاِستثمار الفاعل فيها. مُدنُ المُستقبل هي الحياة الأفضل.
لا أرى في المُستقبل القريب أنّنا بصدد التأسيس للمُدن الذكية بالمعنى الصحيح
وماذا عن واقع المُدن العربية، ما مكانتها من دراسات ومشاريع الذكاء المُستقبلي للمُدن؟
- محمّد حسين طلبي: إنّ مُدن المُستقبل الذكية هي واقع يُمثله بالدرجة الأولى الاِرتباط الصحيح بعوالم إنترنت الأشياء والاِستثمار في الطاقات البديلة والأمران يُمثلان تطويرًا مُستمرًا لربط إدارات تلك المُدن ببعضها وربطها في جانب آخر بتشكيلة الخدمات اللانهاية مع عنصر تكوينها بمَا في ذلك سُكانها والفاعلين فيها بطبيعة الحال.
هذه الحياة غدت واقعًا جميلاً ولافتًا اليوم بعد سلسلة لا متناهية من الأبحاث التي نقلت تلك المُدن من الحالة الإلكترونية السابقة إلى الحالة الذكية التي هي في النهاية اِستثمارٌ مُوفق لِمَا يُسمى بالذكاء الاِصطناعي الّذي هو تقنية إدارية بالدرجة الأولى تُساعدُ المُدن والمُؤسسات على تفادي أي خلل بشري يُمكن أن يُشكل عائقًا تنمويًا.
وبطبيعةِ الحال فإنّ حكومات الدول الغربية والآسيوية قد قفزت أشواطًا في الميدان وبالأخص الدول الآسيوية التي ذهبت بعيدًا في هذا وبعضها تجاوز بكثير المُدن الأوروبية ومَنَحَ العالم ما يُسمى بالمُدن الكوكبية التي اِعتمدت بالدرجة الأولى على الحالة الذكية واستثمرت في التعليم وفي اِستقطاب ما يُسمى بالعقول (العالمية) من أي مكان وهو الإنسان المُجتهد والحيوي الّذي يستثمرُ دائمًا في الاِبتكار والإبداع وراحت تمنحهُ التسهيلات والمُساعدات والأمان والاِستقرار. أمّا عن مُدننا العربية فهي بدون شك تُحاول كثيرًا ولكنّها تَسِيرُ ببطءٍ شديد لأنّ بيروقراطية أخرى في الغالب بشرية تتربصُ بها كما هي العادة.
إنّ فكرة ذكاء المُدن هي عملٌ مُتكامل يأتي على رأسه الإحساس بالمسئولية تجاه النّاس والوطن وكذلك مدى توّفر العقول التي يمكنُ الاِعتماد عليها والعمل على ترغيبها وتوفير حاجاتها حتّى تُؤسس وتُتابع البنية الصلبة والواثقة سواء في إدارة شئون المُدن أو ما يتعلقُ بها.
بالنسبة إلينا كعرب هذه حالة مُضطربة كثيرًا لأنّ هناك جانب سياسي مُختل يُسيطر على المُدن والأوطان ما يجعل الإنسان فيها دائم الحيرة وقليل الثقة في ما يفعله وفي مستقبله. لذلك فأنا لا أرى في المُستقبل القريب أنّنا بصدد التأسيس للمُدن الذكية بالمعنى الصحيح.
تحتاج المدينة العربية إلى ثورة خدمية جادة من أجل اِقتحام عالم المُستقبل بكلّ متطلباته
كيف يمكن إعداد أو إعادة تخطيط المُدن الحالية لتكون مستقبلية أو بمعنى آخر لتُناسب المُستقبل المُختلف بترسانات التكنولوجيا الكثيرة والمُتسارعة التطوّر والتجدّد والاِبتكار؟
- محمّد حسين طلبي: نعتقد أنّ المُدن العربية هذه الأيّام بحاجة إلى تطوير أهم، هو جانب الخدمات فيها مثل توفير ضرورات الحياة الأساسية كالماء والطاقة ونظافة أماكن العيش وسلامتها كتطوير شبكات الصرف الصحي والاِستفادة من تنقيتها، وكذلك تقليل ما أمكن من التلوث وغير ذلك من الأعمال التي غدت اليوم مُسلمات معروفة، وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من تطوير الإدارة وما يتعلق بها في الجانب اللوجيستي بشكلٍ موازٍ.
إنّ مُدننا بوضعها الحالي لا يمكن أن تتعايش مع ترسانة التكنولوجيا التي تفضلتِ بذكرها والتي تقتحمنا كلّ يوم قبل أن تُرمم ذاتها وتزيل هذا الاِهتراء المُتراكم بين شوارعها وأزقتها. إنّ التقنيات التي ستدير المُدن بحاجة إلى عمارة سليمة وشارع منظم يستوعبان الترقيمات والتعريفات الحديثة والمُبتكرة ويستوعبان كذلك عملية الربط السليمة مع كلّ ما يتم اِعماره كالتوسيعات الضرورية لمُدن أصبحت مع الأسف مجموعات عشوائية مُتناثرة هنا وهناك.
تحتاج المدينة العربية إلى ثورة خدمية جادة من أجل اِقتحام عالم المُستقبل بكلّ متطلباته وإلاّ سيتضاعف البؤس بين أحيائها وتفقد أي اِرتباط مع العالم المُتحضر وتبقى مُدنًا لا تُصَدِر إلاّ بعض الفولكلور المُسلِّي.
مُدن المستقبل تقوم على الاِبتكار والإبداع وتستخدم أحدث الوسائل والتطبيقات من أجل تطوير جودة الحياة فيها
مفهوم المدينة الذكية/المستقبلية ظهر منذ سنوات. هل يمكن القول إنّ الحياة في الغرب بزخمها الاِقتصادي والاِجتماعي والتكنولوجي ساعدت على بروز هذا المفهوم الّذي يُحاول اِستشراف المُستقبل والتخطيط لتجسيده؟
- محمّد حسين طلبي: نعم إنّها مُدنٌ تقوم على الاِبتكار والإبداع وتستخدم أحدث الوسائل والتطبيقات من أجل تطوير جودة الحياة فيها ودعم قدرتها وفاعليتها وتسهيل الحصول على الخدمات العامة ودعم التنافسية وعملية تحديث هذا النوع من المُدن يدعم مكانة الدولة (أي دولة) ويُلمعُ صورتها الخارجية.
وهذا النوع من المُدن هو موضوع تنافس مستقبلي بين الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا المُتقدمة. وطبعًا كما تفضلتِ أنتِ فقد ظهرت فكرة هذا النوع من المُدن (SMART CITIES) منذ حوالي 17 سنة، والمفهوم في حد ذاته مَرَ بعديد التطوّرات التي تتوافق مع درجة التحديث من المعلوماتية أو الإلكترونية إلى الاِفتراضية ومن ثمّ إلى الذكية وكلها مفاهيم استخدمت بطبيعة الحال التكنولوجيا وتطبيقاتها بهدف الحد من مخاطر التحديات المُستقبلية.
ويسعى المخططون في المُدن الطموحة اليوم إلى ما يُسمى بالاِقتصاد الذكي والحوكمة الذكية والبيئة الذكية والحراك الذكي ومن ثمّ الحياة الذكية. نعم إنّ الحراك والزخم وروح الإبداع كذلك هي من جعل الإنسان بشكلٍ عام يعمل على تطوير حياته ليسَ في الغرب فقط.. إنّها ضرورة حياتية أملتها الكثير من العوامل مثل التكاثر السكاني وما يفرزه من تحديات لإدارة شئونه.
إنّ اِستشراف المُستقبل هي عملية لا حدود لها وإن كان الإنسان في منطقة ما قد اِجتهد أكثر تحت جُملة من الدوافع ونَجَحَ نجاحه الباهر فإنّ العدوى ستنتقل بأقصى سرعة مع الأيّام إلى أماكن شتّى من هذا العالم لأنّ الهموم الإنسانية في النهاية تظلُ مشتركة.
الجميل في المُدن المُستقبلية هو اِستغناء الإنسان شيئًا فشيئًا عن الطاقات الكلاسيكية وهل سيتغير شكل العالم في المستقبل، هل سيصبح أجمل من العالم الّذي كان في المُتناول العادي أو الّذي كان في خيال الإنسان؟
- محمّد حسين طلبي: بشكلٍ تدريجي، نعم، سيتغير، وربّما سيكون أكثر تعقيداً وعُزلة لأنّ التكنولوجيا ستوفر لهذا الإنسان حاجياته، وربّما سيستغني شيئًا فشيئًا عن جاره أو صديقه بالرغم من أنّ تلك التكنولوجيا هي حصيلة عمل جد هام ودائم. في الحقيقة هذا سؤال قد تجيبُ عنه الفلسفة، وربّما عِلم النفس، ولكنّي أؤكد على شيءٍ هام، هو أنّ الإنسان الّذي سيعيش مُدن المُستقبل سيكون مُكبلاً بترسانة من القوانين التي تتحكم فيها الأجهزة والروبوتات والكاميرات وغيرها.
وأقول لكِ كذلك إنّه بالرغم من كافة الإيجابيات التي يمكن إيجازها في رفع كفاءة إدارة المُدن في شتّى المجالات ربّما قد تتجاوز اِحتياجات السُكان ومتطلباتهم فإنّ ثمّة تحديات وتخوفات قد تنجم عن مثل هذا النمو والتحديث المُتسارعين لأنّه قد يُربك المواطن غير المُعتاد على التكنولوجيا المُتقدمة، بل إنّ الآلية التكنولوجية حينما تدخل مناحي الحياة كلها فربّما تُقدم تحديًا مُجتمعيًا أكثر خطورة إذا اِنفصلت في سرعتها ومنطقها عن العوامل المجتمعية وعن حدود الإدراك البشري، فقد يُصاب قطاع من النّاس بالعُزلة عن الآخرين أو يتحول إلى كائن مُنفرد بذاته، وقد يُصاب آخرون بالاِغتراب أو الاِرتباط الوثيق بالأشياء لدرجة لا يمكن الفكاك منها مِمَا يعني أنّنا سنكون أمام نموذجية متطرفين اِجتماعيًا أحدهما لا يستطيع اِستيعاب التغيرات السريعة والآخر يلتصق بها لدرجة عدم الاِنفصال.
إنّ الجميل في المُدن المُستقبلية هو اِستغناء الإنسان شيئًا فشيئًا عن الطاقات الكلاسيكية التي ما زالت تؤذيه بشكلٍ لافت، والجميل كذلك أنّ تلك المُدن ستتكفل بإنتاج حاجاتها من الغذاء بشكلٍ مريح، والجميل كذلك أنّ مُدن المُستقبل ستُيَسِّرُ كثيرًا تواصل النّاس بأعمالهم ومؤسساتهم الإنتاجية عن طريق الأنفاق المُسيرة والتاكسي الجوي الّذي سيتخذ له المسارات الثابتة والآمنة كذلك كوسائل رديفة لوسائل هذه الأيّام.
ن.ل