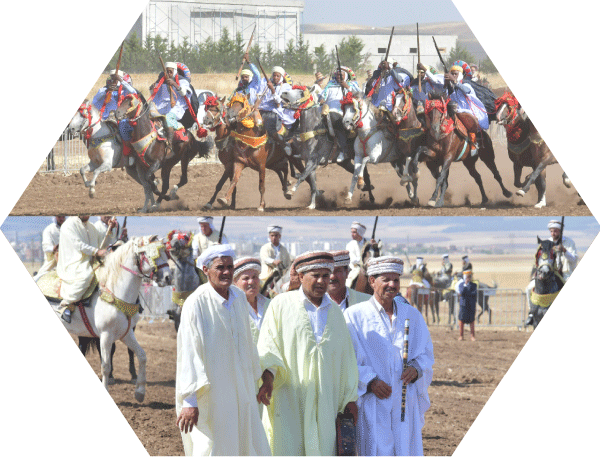
تشكل الفنتازيا والشعر الملحون، ثنائيا شاهدا على الذاكرة الجماعية التي سطرها الأجداد بالحرف والبارود، فهما مشهدان متكاملان ينبعثان من صلب الهوية، ويرسمان ملامح الإنسان الجزائري في صموده وشجاعته وارتباطه الوثيق بأرضه. ويؤكد باحثون وشعراء للنصر، أن هذين الفنين يتعديان حدود المشهد البصري ليصبحا احتفالا للهوية وتجسيدا فنيا لعلاقة الإنسان بالحصان، وهو أيضا أرشيف شعبي وجب الحفاظ عليه ونقله للأجيال اللاحقة.
لينة دلول
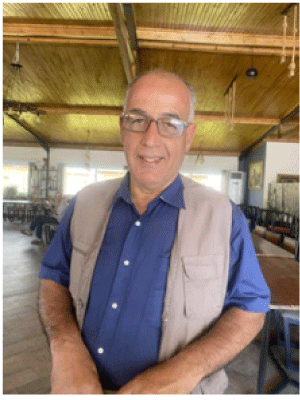
* الباحث في التراث محمد العلمي
الفنتازيا امتداد حي لذاكرتنا الجماعية
يرى الباحث في التراث محمد العلمي، أنه و قبل الحديث عن الفنتازيا أو حتى عن الفرس البربري، وجبت العودة إلى عمق التاريخ، واستحضار الصلة العضوية التي ربطت الجزائري بالحصان، والتي لم تكن مجرد علاقة وظيفية أو قتالية، بل صلة وجودية نسجت ملامح الهوية وألهمت الأدب والوجدان.
وأكد العلمي، أن الحصان البربري ليس مجرد فصيلة من الخيول، بل سلالة نادرة ونقية أصلها من منطقة المغرب الكبير، لطالما تميزت بقوتها وسرعتها، وقدرتها على التحمل.
وهي «وحدة إثنية» نادرة في عالم الخيول، قلما امتلكتها شعوب أخرى، لا من حيث صفاتها البدنية، بل أيضا من حيث رمزيتها في الثقافة الشعبية والتاريخ السياسي.وأضاف المتحدث، أن الحصان البربري قد شكل عبر القرون، قاعدة لتحسين سلالات أخرى، إذ دخل دمه في تهجين عدة فصائل عالمية مثل الحصان الإنجليزي والفرنسي، واعتمد عليه للحصول على نسل أكثر قوة وصلابة. متابعا بالقول، إن دمه يجري اليوم في عروق أشهر الخيول الأوروبية، وهو ما يعكس قيمته الوراثية والتاريخية الكبرى.أما عن البعد التاريخي، فيستحضر العلمي رواية مشهورة تقول إن الإسكندر المقدوني نفسه، في إطار فتوحات توحيد الإمبراطوريتين الإغريقية والفارسية، ركب حصانا بربريا ساعده في خوض معاركه، وظهر ذلك حتى في بعض الكتابات والأعمال الفنية. وذكر، بأن الحصان البربري حظي باهتمام الأدب، والسينما، والشعر الشعبي، لما له من رمزية عالية في المخيال الجمعي، حيث اقترن بالشجاعة والصبر والكرامة.
كما أشار، إلى أن هناك وثائق تاريخية تعود إلى سنة 153 قبل الميلاد، تفيد بأن ابن ماسينيسا وأب يوغرطة، شاركا في الألعاب الأثينية التي تعد أصل الألعاب الأولمبية الحالية على ظهور خيول بربرية، وتمكنا من الفوز بأربع ميداليات ذهبية، ما يعد إنجازا حضاريا موثقا يرفع من شأن هذه السلالة.
وأكد العلمي، بأن العلاقة بين الجزائري والحصان البربري علاقة متكتلة عضوية، ومستمرة، تداخل فيها التاريخ بالوجدان، والبطولة بالتراث، وكل ما أنجزه الأجداد من بطولات على ظهور هذه الخيول، صاغ ما نعرفه اليوم باسم «الذاكرة الجماعية الجزائرية»، التي تحتاج بحسبه إلى التلخيص والنقل من جيل إلى جيل.
أما الفنتازيا، فيراها الباحث تجسيدا حيا لهذا الارتباط العميق، مؤكدا بأن الفنتازيا ليست استعراضا فقط، بل هي شاهد حي على ما كنا عليه، وما نتميز به ثقافيا وتاريخيا، لكونها صورة لذاكرتنا في محيطنا وهويتنا”
كما أشار الباحث، إلى كلمة «جوكي» المستعملة عالميا في سباقات الخيل، وقال إن أصلها ليس إنجليزيا كما يُعتقد، بل مشتقة من «خناتي» أو «زناتي»، نسبة إلى قبائل زناتة الأمازيغية المعروفة بعراقتها في تربية الخيول ومهارتها في الفروسية. مؤكدا في ذات السياق، بأن الفنتازيا موجودة بجميع أقطار المغرب العربي، وتبقى من أبرز تجليات هذا التراث الحي.

* رئيس جمعية الموروث الثقافي غير المادي والفنتازيا خليفة عدادي
الفنتازيا سجل حي للمقاومة الشعبية
من جهته، يؤكد رئيس جمعية الموروث الثقافي غير المادي و الفنتازيا بولاية سعيدة خليفة عدادي ، أن فن الفنتازيا ليس استعراض فروسية جماعيا، بل هو أحد أعمدة التراث الشعبي الجزائري، الذي توارثته الأجيال عبر قرون، خصوصا في مناطق الجنوب والغرب، وأيضا الشرق الجزائري، حيث يحظى باهتمام خاص ويمارس بشكل احترافي في عدد من الولايات.
وقال عدادي، إن الفارس والجواد في المخيال الشعبي الجزائري ليسا مجرد رمزين جماليين، بل هما رمز للمقاومة والكفاح الوطني، متابعا بأن الفنتازيا تحيلنا على ملاحم خالدة من المقاومة الشعبية التي خاضها كل من الشيخ بوعمامة، الأمير عبد القادر، الحاج المقراني، ولالة فاطمة نسومر، ضد الاستعمار الفرنسي، حيث كان الحصان جزءا لا يتجزأ من سلاح المقاومة.
وأوضح المتحدث، أن التاريخ الجزائري في مختلف مراحله وثق فن الفنتازيا، باعتباره مرآة لتحولات المجتمع، وتجسيدا لمظاهر الشجاعة والكرامة والتلاحم بين الفرد ومحيطه الثقافي والديني.
وفي السياق نفسه، استحضر عدادي الدور البارز الذي تلعبه الجزائر في حماية هذا التراث عالميا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد شغل منصب رئيس المنظمة العالمية للحصان العربي والبربري، التي تأسست سنة 1987، والتي انبثقت عنها فروع دولية في أوروبا الشرقية والغربية، مما ساعد على ترسيخ مكانة الحصان البربري كرمز تراثي عالمي.
ويرى المتحدث، أن الحديث عن الفروسية لا ينفصل عن البعد الفكري والروحي، مؤكدا بالقول :« عندما نتأمل في خصوصيات الفروسية، نكتشف أنها سجل حي لجوانب فكرية واجتماعية وثقافية، بل إنها ترمز إلى قيم الإسلام الأصيلة مثل الشهامة، الكرم، والغيرة على الأرض، وهي مبادئ تناقلتها الأجيال عبر الزمن.»
وشدد عدادي، على أن الفنتازيا تمثل أحد المحاور المركزية في الهوية الجزائرية والموروث غير المادي، فهي مزيج من الاستعراض والقوة والرمزية، وتحمل بعدا روحيا يعكس شموخ الإنسان الجزائري وصلابته في وجه المحن.
كما ذكر، أن فن الفنتازيا قد سجلت رسميا سنة 2021 كتراث عالمي غير مادي من طرف اليونسكو، لكنه شدد على أن هذا لا يكفي، قائلا «نحن أولى من غيرنا بهذا الفن، ويجب أن يسجل باسم الجزائر، لأنه امتداد لتاريخ المقاومة ولروح الأمة».
مضيفا، بأن الحفاظ على الفنتازيا واجب وطني، ليس فقط باعتبارها موروثا ثقافيا، بل كذاكرة حية يجب نقلها وتثبيتها في وجدان الأجيال الجديدة.

* الشاعر عامر مراحي الحاج
الملحون ..أداة تثقيفية للأجيال الصاعدة
يرى الشاعر الشعبي، مراحي الحاج، الملقب بعامر، أن الشعر الملحون لم يكن يوما فنا للتسلية أو مجرد تعبير فني بسيط، بل هو وسيلة توثيق حية للتحولات الاجتماعية والوجدانية التي شهدها المجتمع الجزائري، على امتداد مراحله التاريخية، وخصوصا المرحلة الثورية المجيدة.
وأكد المتحدث، بأن الملحون يؤدي دورا قريبا من الصحافة، فهو يرصد الظواهر، وينقل الواقع، ويعلق عليه بلغة الناس، مشيرا في ذات السياق، بأن شاعر الملحون كان بمثابة مراسل شعبي، يكتب بالكلمة ما يعجز عن تدوينه المؤرخ، ويوصل بصدق وحس وطني أصيل.
وقد كان الشعر في زمن الجاهلية أداة التعبير الأولى، وصوت الفطرةحيث كانت المرأة تغزل وتقول الشعر، والرجل يحطب ويقول الشعر.
وأضاف المتحدث، أن شعر الملحون ما يزال صامدا رغم تقلبات الزمن وتسارع العولمة، بفضل شعرائه الأوفياء الذين حافظوا عليه كرمز من رموز الأصالة والانتماء. مشيرا في سياق متصل، إلى أن الملحون ليس مجرد كلام موزون بل هو هوية وطنية وثقافية لابد من نقلها للأجيال القادمة حتى لا تندثر، مؤكدا بأن هذا الفن الشعبي يقدم قيمة جمالية وتربوية عالية من خلال تناوله لموضوعات مثل الكرم، الشجاعة، الجود، حب الوطن مما يجعله أداة تثقيفية للأجيال الصاعدة.
وأضاف المتحدث، أن الملحون مدرسة قائمة بذاتها في النقد والتاريخ إذ يعالج القضايا بأسلوب مبسط وسلس.
كما أوضح، بأن الفنتازيا تكمل الملحون فهي تجسد القوة والشجاعة التي يغنى بها الشاعر، وتحيل إلى المشهد الشعري إلى صورة حية نابضة بالحركة.
ودعا الشاعر، الشباب إلى حمل مشعل الأجداد، والدخول إلى عالم الشعر الملحون، مؤكدا بأن هذا الفن ليس فقط تراثا، بل أمانة في أعناق الأجيال.
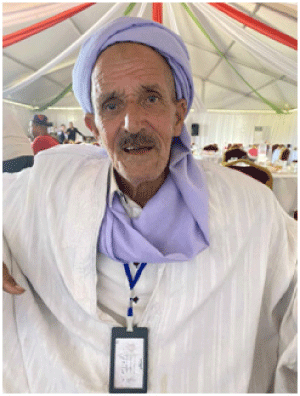
* الشاعر أحمد بروال من ولاية باتنة
الملحون ولد في البادية وظل وفيا للناس والواقع
يعتبر الشاعر أحمد بروال ، وهو من بين أقدم الأصوات الشعرية في ولاية باتنة، أن الملحون ابن البيئة البدوية بامتياز، وقد نشأ وتطور في أحضان الطبيعة، وسط قطعان الأغنام وهدير الخيول، وتحت ظلال الحياة القروية بكل ما تحمله من بساطة وصدق وتجذر في الأرض.
وقال بروال، إن تعلمه لهذا الفن لم يكن في مدرسة أو على يد أستاذ، بل في المرعى وفي المزارع وبين الماشية، حيث تتهجى الروح الكلمات عبر الملاحظة والتأمل والاختلاط بالناس والواقع.
وأكد المتحدث، أن كتابة القصيدة الملحونة موهبة إلهية، وهي منحة من الله يهبها لمن يشاء، لكنها تحتاج إلى صقل ومرافقة بالملاحظة والانغماس في الواقع. وهو ما يجعله يستلهم موضوعاته من الحياة اليومية، ومن التحولات الاجتماعية التي تمس الثقافة، والرياضة، وسلوك الأفراد.
الملحون لم يتوقف عن التجدد
ورغم أصوله التقليدية، يرى بروال أن الملحون لم يتوقف عن التجدد، مثله مثل كل شيء في الحياة فهو قابل أيضا للتصور، والقصيدة الملحونة بدورها تطورت و تجددت، موضحا أنها في الماضي كانت تبنى على أربع حروف «قواف»، أما اليوم يمكن أن يكتفي الشاعر بحرف واحد، دون أن تفقد قوتها أو جماليتها.
وأشار الشاعر، أنه في ظل الثورة الرقمية لم يتوار الملحون كما توقع البعض، بل وجد جمهورا واسعا في عصر التكنولوجيا، وتضاعف عدد المهتمين به، حيث ساهمت المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذا الفن وإيصاله إلى فئات لم تكن على دراية به.
وأكد بروال، أن شعر الملحون يخاطب جميع فئات المجتمع، لأنه يعكس هموم الناس، ويفضح التناقضات، ويعبر عن الفرح والحزن، عن الحب والخذلان، عن الأرض والوطن.
كما أنه لعب وما يزال يلعب دورا كبيرا في توثيق التحولات الوجدانية والاجتماعية للمجتمع الجزائري، من خلال لغته البسيطة الصادقة، وإيقاعه الذي ينساب في الذاكرة بسهولة.
وأوضح المتحدث، أن الملحون ساهم في الحفاظ على اللغة الدارجة وتطويرها، بل ورفعها من مجرد لهجة محكية إلى وسيلة فنية راقية تحمل معاني عميقة، وتخاطب الوجدان الجماعي، دون أن تفقد دفئها الشعبي أو بعدها الثقافي.