
برزتْ في السّنوات الأخيرة، ظاهرة المؤثِّرين واِنتشارهم الكبير واللافت في وسائل الميديا، حيْثُ كثُرت منصّات ومواقع ووسائط التِّكنولوجيا الّتي ساهمت في بروز واِنتشار فئة كبيرة من المؤثرين، وقد صنع هؤلاء قاعدة عريضة من جمهور المشاهدين والمُتابعين، ومن فئات وأعمار ومستويات مختلفة.
يبقى السؤال المحوري هنا: ما مدى تأثيرهم السِّلبي على المجتمع، وكيف؟، ومن جهةٍ أخرى، هل يمكن القول أو الجزم بأنّ لهم بعض التَّأثير الإيجابي على المجتمع أيضا؟ وهل تحتاج الظاهرة إلى آليّاتٍ لتقنين مُمارسة نشاط صناعة المحتوى، أو هل من الضَّروريّ وضع منظومة قانونيّة لتهذيب المحتوى الرّقميّ باِعتباره مُرتبطا بالحقِّ العام؟
أعدت الملف: نوّارة لحرش
وهل حقًّا أنّ فئة كبيرة من المُؤثِّرين تقترن بهم ظواهر الفشل الأسريّ والدِّراسيّ، خاصَّةً وأنّ هناك من يُشيرُ إلى هذا الأمر، مثل الدّكتور عبد الرّزّاق بلعقروز، الّذي يُؤكِّدُ أنّ فئة كبيرة -فعلاً- من المُؤثِّرين تقترنُ بهم ظواهر الفشل الأسريّ والدّراسيّ. لكن في المقابل، فالمجتمع أو بالأحرى العقل الجمعي يتفاعل مع مصالحه أكثر مِمَّا يتفاعل مع ما يُسيء لهذه المصالح أو لهذا العقل. حَوْلَ هذا الشَّأن «ظاهرة المُؤثِّرين ومدى تأثيرهم في/وعلى المجتمع»، كان ملف عدد اليوم من «كراس الثّقافة» مع مجموعة من الدّكاترة والباحثين الأكاديميِّين المُخْتَصِّينَ في العلوم السِّيَاسِيِّة والفلسفة وعلوم الإعلام والاِتِّصال، والَّذين تناولوا المسألة كلٌ من زَاوِيَتِهِ وحسب وجهات نظر مختلفة ومتباينة، لكنّها تلتقي وتتقاطعُ في الكثير من النِّقاط.

* أستاذ التعليم العالي وكاتب في الفلسفة عبد القادر بوعرفة
بيــن قِيّـم الحضــارة وسرديــات التَّفاهــــة
من جهته أستاذ التعليم العالي وكاتب في فلسفة الحضارة والتاريخ، الدكتور عبد القادر بوعرفة من جامعة وهران2، يقول: «اِشتهر كلّ عصر من تاريخ البشرية بسمة مَيَّزَتْهُ عن غيره من العصور، حيثُ كان أوّل شرارة مع اِكتشاف النار، ثَمَ تلاها اِكتشاف البكرة، ثم البُخار، ثم الطاقة، واليوم نشهدُ عصر التكنولوجيا الرقمية، الّذي أَثَرَ تأثيرًا كبيرًا على شبكة العلاقات الاِجتماعية عبر آليات التواصل الجديد، حيثُ أَصبَحَ المؤثرون في الوسائط الاِجتماعية ظاهرة اِجتماعية مُعقدة وخطرة للغاية، وتحمل في طياتها نتائجًا مُتعدّدة الأبعاد».
ثمَ أردفَ: «ظهر مصطلح المُؤثر مع الثورة الرقمية، ويُقصد به كلّ صاحب محتوى لديه إمكانية التأثير في أكبر شريحة مُمكنة، عبر التأثير في الآراء والسلوكات بفعل الأداء الإعلامي، والصناعة المُحتوياتية.وحين ندرس المضمون لأغلب المحتويات الوسائطية، نجد أنّ المُؤثر يُمكن أن نقسمه إلى (مؤثر إيجابي ومؤثر سلبي)».
والمُؤثر الإيجابي، -كما يُوضح-: «هو الّذي يحمل مشروعًا حضاريًا، أو مدنيَا، أو دَعويًا، أو فنيًا،.. ويعمل على صناعة محتوى إعلامي يُفيد الإنسان والمجتمع، ويدفع النّاس نحو الفضيلة، والتضامن، والحب، والعيش المُشترك».
كما يسعى -حسب رأي المُتحدّث- عبر الصورة والصوت إلى ترغيب النّاس في المُثل والقيّم، أو يسعى إلى الدفاع عن مكتسبات الأمة، ولحمة المجتمع، وهؤلاء غالبًا يمتلكون ثقافةً عاليةً، وينتمون إلى جماعات مُحافظة، أو على الأقل يعملون ضمن منظور إنساني.
مُضيفًا في ذات السّياق: «ومن صور الإيجابية نشر الوعي بالقضايا الاِجتماعية، والبيئية، والصحية، كما نراه في حملات التشجير من قِبل مُؤثّرَيْن اِثنين جزائريين، اِستطاعا أن يدفعَا النّاس إلى حب الشجرة، والاِعتناء بها، ثم الإيمان بمشروع (الجزائر الخضراء)».
وأردفَ قائلاً: «يستخدم بعض المؤثرين المنصات للدفاع عن التنمية المُستدامة، ومحاربة الفساد، وبلورة صور العدالة الاِجتماعية. وكذا التعريف بالأخطار التي تُحيطُ بالجزائر على مستوى الأمن الغذائي، والفكري، والعقدي. وهناك من يقدم الوعي الصحي، والوعي الرياضي عبر تقديم نصائح تخص اللياقة البدنية، والتغذية. كما يحرص على تبيان طُرق التمويل الشخصي، والاِستثمار المُفيد، وصور تطوير المسار المهني. ويُقدم طُرق التّعلم، والتثقيف، وكلّ أشكال مُمارسة الثقافة المُفيدة».
أمّا المُؤثر السلبي، -كما يوضح أيضا-: فـ»هو من لا يحمل أي مشروع حضاري، بل ينساق وراء التفاهة، ويُروج لها عبر كُلّ الطُرق والسُبل، ويعتقد أنّ التفاهة هي التي تصنع الشهرة. يكونُ المحتوى عنده لا يرتبط بأي قيم أو مُثُل، بل مبني على أساس شهوة الأنا في الظهور، ولو كان على حساب الغير، والقيم، وحتّى الوطن. والمُراهنة على جدلية الممنوع المرغوب، والمرغوب غير القابل للتحقّق».هنا -يعتقد المُتحدّث- تكمن قدرة المُؤثر على التلاعب بالعواطف، ثم بالأفكار، لاسيما الفئات الشابة المُنساقة نحو بهرج الحياة وزينتها. فالمُتابع المُنبهر يميلُ للتقليد والمُحاكاة دون وعي، ولا حذر، ولا اِستعداد ذهني لتحليل ما يُشاهده، بل تجده ينغمس اِنغماسًا كليًا في المحتوى، وفي الكثير من الحالات يفقد روحه، أو يخسر أعز ما يملك من أجل تجربة محتوى كما حدث في لعبة الحوت الأزرق.
كما أوضح الدكتور بوعرفة، أنّ التأثير السلبي يظهر عندما يسعى المُؤثر وراء الشهرة، والربح دون مُراعاة الأخلاق والعادات، ويُصبح صيد المُتابع (الضحية) هو الغاية بغض النظر عن الوسيلة، هُنا يُمارس الإنسان هوايته الأولى صيد الإنسان للإنسان، لكن عبر صناعة محتوى جذاب، ومغري، تميلُ إليه النفس الأمارة بالسوء، أو النفس الشهوانية بالتعبير الأفلاطوني.
مُضيفًا: «إنّ من صور التأثير السلبي ما نراه في الترويج لمُنتجات ضارة وغير نافعة، ترتبطُ أساسًا بالأمراض المُزمنة، أو التجميل، فيستثمرون في معاناة المرضى وذوي الحاجة، لتحقيق مكاسب مالية. في المُقابل تُنتج جيلًا مُتمردًا على أهله، ومجتمعه، ناقمًا على كلّ شيء، قد تكون نهاية بعضهم أكثر إيلامًا وبؤسًا».
واختتم قائلاً: «لقد أصبح المؤثرون على وسائل التواصل الاِجتماعي قوة مهمة في تشكيل الآراء، والاِتجاهات، إما بشكلٍ مفيد وبناء، وإما بشكل مُدمر وهدام، وعلى الدولة التدخل العاجل لردع التفاهة التي أصبحت هي الأكثر اِنتشارًا».

* الأكاديمي المُختصّ في علوم الإعلام والاِتصال الدكتور نصر الدين مهداوي
نشاط صناعة المحتوى يحتاج لتقنين مُمارسته
يقول الأكاديمي المُختصّ في علوم الإعلام والاِتصال، الدكتور نصر الدين مهداوي، من جهته: «شهدنا في السنوات الأخيرة بروز مؤثرين عبر الوسائط الاِجتماعية يقومون بأدوار مُتعدّدة، بعد أن كان المُؤثر مجرّد مُستخدم مُتلقي للمعلومات إلى مُستخدم نشط يتفاعل ويُشارك وصانع للمحتوى (ماذا يفعل الجمهور بالجمهور!؟) وقد عرفت ظاهرة المؤثرين هذه اِنتشاراً واسعًا بعد ظهور منصات جديدة أتاحت للمُستخدم حرية القيام بمهام عِدة».
مُشيراً في هذا السّياق، إلى تطبيق التيك توك الّذي يُشكل العديد من الخدمات والمُميزات نظير الخوارزميات والتقنيات التي يُتيحها للمُستخدم مِمَّا جعلت منه مُؤثراً يُعالج الكثير من الأفكار ويسهم في صناعة محتويات يسعى من خلالها إلى تأطير الجماهير وتعبئتهم للتأثير فيهم، كإجراء بث مُباشر ولعب الجولات وصناعة محتويات في مجالات عِدة قصد إنعاش اِقتصاديات حسابه عن طريق خاصية: التكبيس والمُشاركة لجمع أكبر عدد مُمكن من المُتابعين التي تُترجم في ما بعد إلى أموال تُضَخُ في حساب المُستخدم.
ثم أردف: «توجه هؤلاء المُؤثرين إلى صناعة ما يُعرف بالمحتوى التافه والرديء الّذي لا يعكس تطلعات ومستوى المُجتمعات من أجل التأثير فيهم وقبول فكرة كلّ ما هو تافه ورديء يسهم في هدم القيم وزعزعة الوازع الديني والأخلاق».
مُضيفاً: «ففي بادئ الأمر كان الجمهور المُلتقي يرفض فكرة كلّ ما هو رديء ليعيش حالة من الصدمة والاِنبهار من ما يستهلكه من أفكار رديئة مقيتة خاصة فكرة لعب الجولات وتنفيذ الأحكام ليصل المُؤثر إلى حالة من الهوس والجنون من أجل اِستقطاب شرائح عديدة من المُتابعين في معادلة رياضية مفادها رفع عدد المشاهدات والمُتابعة والاِشتراك في حسابه»..فوجدَ بعض المُؤثرين -حسب قوله- من هذه المنصات فرصة لكسب المال ومنهم من أصبح ثريًا، ومنهم من جعل منها مهنة وفكرة استثمار ليبقى مُتغير التفاهة والرداءة معياراً قويًا لكسب المال.فمع مرور الوقت -يُضيف المُتحدّث-: «أصبحت التفاهة هي مقصد المُتلقين ومن أولويات اِهتماماتهم لإشباع حاجاتهم النفسية والعاطفية بعد أن كان يرفضها سابقاً، فجعل المؤثرين من المتابعين حمقى وطُعْمًا لإنعاش اِقتصادياتهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا مناص من المُتلقي إلاّ المتابعة والتكبيس لإشباع رغباته. ومن شدة التأثير أصبحت الرداءة من تفضيلاته».وواصل مستدركاً: «تعمّمت الظاهرة في المجتمع وانتقلت إلى الأُسر والمحيط الاِجتماعي وفي كلّ نسق ضمن البيئة الاِجتماعية، فتغيرت تركيبة المجتمعات وذهنياتهم وأصبح الرقص والتحدث مع الكاميرا والقيام بالتصرفات الغريبة أمر عادي وطبيعي أمام عامة النّاس وفي المرافق العمومية».ثم يضيف مُستطردًا: «وما زاد الطين بلة أمام الأولياء الذين يُشجعون أبنائهم على هذه السلوكات بدلاً من السعي على التنشئة الاِجتماعية وتشجيع الأبناء والمراهقين الإقبال على ميمات التربية (المسجد-المدرسة)، للأسف تغيرت سلوكات الشباب والمراهقين سواء في تصرفات الحديث والهندام حتّى أنّه بات لها تأثير سلبي على التربية المجتمعية وخاصةً التحصيل الدراسي، مِمَا قد يُؤثر على مردود التلميذ أو الطالب في دراسته، فمن الناحية النفسية وما توصلت له الإحصائيات أنّ هذه الظاهرة أفقدت التلميذ الرغبة في طلب العِلم مِمّا تراجع في مستواه العلمي وكذا مستوى الذكاء والتركيز بلا اِستثناء». الدكتور مهداوي، يؤكد قائلاً: «المُؤثر الحقيقي يجب أن يتمكن من صناعة محتوى قيم وهادف، وبإمكان أي شخص أن يكون مُؤثراً يهدف إلى نشر الوعي والقيم والتحسيس في مجالات مختلفة، فهناك من المؤثرين من يُنتجون أفكارًا قيمة في مختلف المجالات الاِجتماعية والدينية والصحية والثقافية والعلمية الغرض منها نشر المعرفة وتوعية الفرد بسلوك مُعين ليغرس فيه أُسس مقومات المجتمع النامي والراقي». مُشيراً هنا، إلى أنّ تيك توك -مثلاً- يمكن أن يكون مقصداً للاِستثمار والتسويق والتوعية والتربية والتعليم ونشر القيم الدينية إذا تمَ اِستغلاله اِستغلالاً ناجعًا. وفي ذات المعطى، أردف قائلاً: «فهذه الفجوة بين الصناعة الهادفة والرديئة راجع إلى ثقافة اِستخدام التكنولوجيات وكذا مُؤشر التربية الإعلامية الّذي نعتبره أحد مرتكزات محاربة الظاهرة، نحن أهل الاِختصاص ندعو دومًا إلى إطلاق مادة التربية الإعلامية كمادة أساسية في الأطوار التعليمية من أجل تربية وتوعية التلميذ أو المُتمدرس بثقافة اِستخدام هذه المنصات، لاسيما إرساء معارف وسلوكات قيمة تهدف إلى تدريب وتعليم المتمدرس بأخلاقيات اِستخدام المنصات الاِجتماعية ومعايير صناعة المحتوى الهادف».و-حسب رأيه دائماً-: فإنّ «هذه الظاهرة تفرض إرادة حقة لتطهير الفضاءات الرقمية من هذا التلوث المُثبط في جداراتنا لِمَا تحمله من تحديات ومخاطر قد تُهدّد نسيجنا الاِجتماعي. كما تحتاج أيضا إلى آليات لتقنين مُمارسة نشاط صناعة المحتوى، من قِبل المؤثرين على مستوى الشبكات الاِجتماعية، لاسيما سن نصوص تشريعية تضبط هذه المُمارسة تحت غطاء قانوني وأخلاقي لحماية الفرد والمجتمع من هذه السلوكيات الدخيلة، وكذا تحديد مهام المُؤثر الهادف الّذي يُعد (عصب هام) في المجتمع مثله مثل الإمام والمُعلم والمُربي يقوم بأدوار فاعلة في تنوير وتثقيف وتوعية وتربية المُجتمع». وخلص إلى القول: إنّ مؤثر اليوم إطار الغد.. وسلاحٌ ذو حدين يجب أن يكون نموذجا وقدوة نفسه وقدوة المجتمع يُقدم جهوداً فاعلة ويرسي قيمة مضافة تسهم في رقي مجتمعه ونموه...

* أستاذة العلوم السياسية سمية أوشن
الظَّاهرة أصبحت بمثابة نظام مُعقَّد والبيئة الرَّقميَّة تحتاجُ إلى مُراقبة ومُعاينة
أستاذة العلوم السّياسية بجامعة قسنطينة3، الدكتورة سمية أوشن، تقول بهذا الخصوص: «فرضت ظاهرة المؤثرين في وسائل التواصل الاِجتماعي نفسها على الحياة اليومية في مُختلف المجالات وفي مُختلف أنحاء العالم، وأصبحنا نلمس تداعياتها على الأفراد والمجتمع وعلى الحياة السّياسية والثّقافية والاِقتصادية حتى أضحت بمثابة صناعة عالمية رائجة. ويرجع هذا الاِرتفاع حسب تفسير الكثير من الباحثين إلى فقد الملايين من الأشخاص وظائفهم في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، الأمر الّذي دفعهم إلى اِستخدام منصات التواصل الاِجتماعي للتعبير عن خبرتهم المهنية واهتماماتهم الشخصية على أمل جذب أصحاب العمل». وتضيف في ذات الشأن: «إنّ التفكير في تحديث مفهوم قادة الرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مُتزايدًا في ظل التطورات المُتسارعة، فقد كان يُنظر إليهم على أنّهم حلقة الوصل بين وسائل الإعلام التقليدية وبين الجمهور، وعليه يمكن القول إنّنا نشهد اليوم عمل اِنتقال سلطة الإعلان من وسائل الإعلام التقليدية إلى مواقع التواصل الاِجتماعي، وعليه أضحت الضرورة مُلحة لتوفير حماية جنائية للمُستهلك الاِلكتروني أو كما يُسميه البعض بالضحية الاِفتراضية».لذلك فإنّ ظاهرة المُؤثرين وانتشارهم الكبير في وسائل الميديا -حسب الدكتورة أوشن- أصبحت بمثابة نظام مُعقد، وعليه فإنّ البيئة الرقمية اليوم تحتاج إلى مُراقبة ومُعاينة من طرف هيئات في الدولة، حيثُ أنّ العديد من الشركات أصبحت تعتمد عليهم في تسويق المُنتجات والسلع، نظراً لطبيعة محتواهم الّذي يتميز بقوّة الإقناع والتأثير في المُتلقي.ثم أردفت: «لقد وصلت عملية الوجود أو ما يمكن تسميته بـــ»الحضور الاِقتحامي» للمُؤثرين في وسائل التواصل الاِجتماعي وفي عملية الدخول اليسير إلى التأثير في المجتمع ككلّ، وفي صناع القرار والنُخب السياسية والتفاعل معهم، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى الخضوع نوعاً ما من قِبل النُخب إلى منطقهم والاِستماع إلى رأي الجمهور الّذي يُمثلونه في تلك المنصات عند الشروع في اِتخاذ القرارات بشأن موضوع ما يهم الجميع».المُتحدثة، تعتقد من جهةٍ أخرى أنّ الّذي يُميز وسائل التواصل الاِجتماعي اليوم هو تنامي دور الفرد المُستخدم لوسائل الاِتصال الاِلكترونية وفاعلية الوسائط الاِلكترونية الجديدة في اِنتشار هذا النوع الجديد من الإعلام، كما أنّ عدم إمكانية بعض وسائل الإعلام التقليدية من التفاعل مع المواطن هو ما يترك المجال مفتوحاً للفاعلين في وسائل التواصل الاِجتماعي لسد الفراغ والوصول إلى هذه الجماهير من المجتمع تحت أسماء وشعارات وحملات وبرامج تسهم في تعلق الأفراد بهم وكذا إتباعهم والتأثير عليهم.ولذلك -تُؤكد في الأخير- أنّه لا بدّ من القول إنّ ظاهرة جديدة يتلقاها العالم أجمع عبر الشبكة العنكبوتية أسست لعالم جديد من المُؤثرين في وسائل التواصل الاِجتماعي شكلت مخيلة لعالم غير واقعي ولجمهور حقيقي مُضطر للاِنسياق والتفاعل مع التغيرات الحاصلة برغبة منه أو من دونها.

* الأستاذ والباحث الأكاديمي محمّد لخضر حرزالله
من الضروريّ وضع منظومة قانونيَّة فعّالة لتهذيب المحتوى
يُؤكد الباحث وأستاذ العلوم السياسية الدكتور محمّد لخضر حرزالله، أن: « مصطلح التأثير يُشير إلى القدرة على إحداث تغييرات فكرية أو سلوكية في الآخر، عَبْرَ سلسلة من العلميات العقلية والنفسية المُخطّطة بشكلٍ مُسبق، والتي تؤدي إمّا إلى: تعزيز القيم الإيجابية وتنمية الحس الرفيع وإشاعة المُمارسات الطيبة داخل المُجتمع، أو محاربة ومحاصرة المظاهر السلبية. وإمّا إلى الإغراق في مادة الترف والسفه، عبر تكريس مظاهر وسلوكات دخيلة، من شأنها الإضرار بالسلوك العام، والعدوان على القيم المجتمعية، وتحجير الفكر في قفص التفاهة القاتلة».
مُضيفاً: «ويعتبر جيل اليوم جيلاً رقميًا باِمتياز في لغته ومُمارساته وسلوكاته، فهو شغوفٌ بكافة المُستجدات الطارئة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاِصطناعي، مُتابعٌ لكلّ تفاصيلها وإبداعاتها بشكلٍ يومي، وقد أثر ذلك على نمطه الفكري والاِجتماعي والثقافي، فأصبح مُستهلكًا نَهِمًا لكلّ ما تطفحُ به الانترنت من أفكار وسلوكات، وما ينضحُ به المؤثرون من مشاهد وحكايات، وكثير منهم لا يقف عند حدود المُتابعة، بل يستلهم من هذه المواد الإعلامية أو الشخصيات التأثيرية قيمه ومبادئه وطقوسه التي يرى أنّها نموذجه الأمثل، فيقع في شِراك الاِغتراب والاِستلاب الثقافي».
و-يرى المُتحدّث- أنّ وسائل التواصل الاِجتماعي أو ما يُسمى بالإعلام الجديد تُشكلُ بيئة مُغذية للتحوّلات الثّقافية والفكرية، فبحكم طبيعتها المُتسمة بالاِنكشافية والتعقيد والتشابك والذكاء التقني، يمكنها أن تُشكل ميداناً للتأثير العابر للحدود.
وفي ذات السياق، واصل قائلاً: «كما أنّ تطور التطبيقات وعِلم البرمجيات ساعد على صناعة المواد المُزيفة المُؤثرة في سلوك وعقول الجمهور المُتلقي، وهنا نُشيرُ مثلاً إلى تقنية: (الذباب الإلكتروني) التي تُعبر عن: مجموعة من الحسابات الآلية المُبرمجة على نشر منشورات أو تغريدات مُعيّنة وذلك بهدف التأثير في الرأي العام أو جلب الاِنتباه والنظر إلى فكرةٍ ما مُقابل تهميش أخرى قد تكون ذات أهمية، ويتم ذلك عن طريق روبوت مُبرمج».
وهذا ما يُفسر -حسب الدكتور حرزالله- ظهور موجات هائلة من الأراجيف والإشاعات التي تغذيها مواقع التواصل الاِجتماعي، من خلال ضخّ العديد من المصطلحات والمفاهيم والروايات والشعارات الكثيفة، عبر أسراب من الحسابات الوهمية المُختصة في التشهير والقذف ونشر الدعاية.ثم اِستدرك موضحاً: «وما حصل في مؤسساتنا التربوية كنتيجة لاِستجابة واسعة من التلاميذ لدعوات مجهولة المصدر يُمثلُ أحد صور هيمنة التكنولوجيا على عقول هذا الجيل الرقمي، وقدرتها على إحداث تحولات شاملة في وقت قياسي، مِمَّا يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونُلحُ على ضرورة الاِهتمام بهذا الجانب المُغيب في مناهجنا التربوية وبرامجنا الإعلامية».وببعض الاِستطراد، أضاف: «..فالإعلام الجديد هو الإعلام الّذي أصبح يصوغُ عقول الجمهور والناشئة منهم على وجه الخصوص؛ فالشباب من الجنسين، يتعاملون اليوم مع وسائل اِتصالية رقمية إلكترونية لا تخضع للإشراف أو الرقابة، وهذا ما يجعل الإعلام قوةً مؤثرةً على الجميع دون اِستثناء بحكم أنّ مستخدمي الإنترنت من جميع فئات المجتمع وشرائحه». وفي ذات المعطى، يقول: «يضع المفكر الفرنسي سيرج لاتوش Serge Latouche الإعلام الجديد كجزء من شبكة العولمة التكنو-اِقتصادية وثقافية التي تجتاح العالم اليوم، ليبيّن قدرة العولمة الهائلة على زعزعة نظام القيم، وتوليد أزمات أخلاقية في بنية المجتمع الدولي برمته، في ظل بروز هذا النموذج المجتمعي النّاشئ، والقائم أساسًا على الإعلام والاِتصال على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي، الّذي يعد إطاراً للتّلاعب بالعقول». واختتم بقوله: «إنّ ظهور فئة القادة المُؤثرين على منصات التواصل الاِجتماعي، يجعلنا نُؤكد على ضرورة وضع منظومة قانونية فعّالة لتهذيب المحتوى الرقمي، باِعتباره مُرتبطا بالحق العام، ومن شأنه أن ينتهك خصوصيات وقيم المجتمع والأُسر والأفراد، ولما له من تبعات خطيرة على الوعي وتشكيل الرأي العام وإعادة هندسة الأفكار وتأطيرها في مسارات سلبية من شأنها أن ُتذكِيَ الرذيلة وتقضي على الفضيلة».

* المُحاضر والباحث عبد الرزّاق بلعقروز
فئــة مـن المؤثّريــن تقتــرن بهــم ظواهــر الفشـل الأســـريّ والـدّراســـيّ
يقول المُحاضر والباحث الأكاديمي المُتخصّص في فلسفة القيم، بجامعة سطيف2، الدكتور عبد الرزّاق بلعقروز: «فعلاً، باتت ظاهرة التَّأثير بواسطة وسائط الإعلام الجديدة تفعل فعلها، وتتركُ أثرها في الفضاء العام، ويجبُ بدءاً، التّمييز بين التأثير المُفيد والخيّر، وبين التأثير غير المُفيد والسّيء؛ فالأصل في هذه الوسائل أن تكون كُلها خيراتٌ نافعات وحسنات؛ أي مصالح؛ وأن لا تكون شروراً مُضرّات وسيّئات، أي مفاسد».
وفي ذات المعطى، أضافَ مُستدركاً: «إلاّ أنّ واقع الحال، هو كُثرة المُواقع التي تكتسب أهميتها، ليس من القيمة الإيجابية لمضامينها، ولا من المصالح التي يحتاجها النَّاس، بل من سطحيتها وفراغها العلمي وفسادها الأخلاقي، إنَّها تتخفىَّ خلف جمالية الصُّور والتقنيات؛ كي تنشر المحتويات الهابطة، ولعل من مظاهر هذا الهبوط، هو أنّها تفصل بين اللّغة والقيمة، فالأصل في اللّغة أنّها حاملة للمعاني الرَّفيعة، والعبارات الجزيلة، لكنها مع المحتويات التَّافهة والهابطة، أصبحت مجرّد كلام وثرثرة».ثُمَ أردف: «كما أصبح الكلام في هذه المحتويات كلاماً يخدش الحياء ويرفع من أهمية الكلمات المُتفحشة والسُّباب والقذف؛ باتت هذه المحتويات في جزءٍ منها حرباً نفسية على اللّغة الحاملة للقيمة والمعنى، ونشرٌ للخصوصيات الذَّاتية والدفع بالمُتتبعين إلى كسر الأوامر الأخلاقية مع الذَّات وفي الأسرة وفي شبكة العلاقات الاِجتماعية». مُضيفاً: «وقد أدركت هذه الفئات الصَّانعة للمُحتويات التَّافهة، أنّ حصولها على أكثر المُتابعين ودخول المال إلى حساباتها مُتلازم مع التعدي على الحدود الدينية والأخلاقية والاِجتماعية، والتكشّف للجسد واِستعمال الكلام المُنفصل عن القيمة، وكأنّ لسان حالها هو: بقدر ما تبث المجون والخلاعة بقدر ما تكسب أكثر، وأحد الأسباب في كُثرة المُتابعين لهم؛ أنّ الشبيه يُدرك الشَّبيه كما قال اِبن سينا؛ فلولا تماثل نفوسهم لَمَا كان هذا التَّلاقي في الوسائط الإعلامية».صاحب كتاب «روح الثقافة» واصل مؤكداً: «إنَّ صناعة هذه المحتويات التَّافهة، وإيجاد الفضاءات الإعلامية السَّائدة لنشرها، ما هو إلاّ حربٌ على الهوية الأخلاقية للإنسان، إنّها المحتويات المليئة بالوقاحة، ومعروفٌ في تعريف الوقاحة، أنّها اللُّجاجة في تعاطي القبيح من غير اِحتراز من الذَّم، ويمكن القول إنّ من أسباب هذه الوقاحة، المستوى التعليمي المُنعدم لدى هؤلاء، فأغلب الوقحين في نشر المحتويات التافهة؛ نماذجٌ فاشلة في دراستها، والنفس ما لم تكن ملآنة بالعِلم والخير، اِمتلأت بالجهل والفساد، فهذا الوصف مُلازمٌ لهم؛ أي الجهل والغباء والفراغ العلمي والأخلاقي».
بالإضافة إلى ذلك، أنَّ جزءاً منهم، -كما يُضيف المُتحدث- عاش حياة البؤس والضياع الاِجتماعي والفشل الأسري، وهذه الحالة الفاشلة أخلاقيًا ودينيًا واجتماعيًا، يُريد لها أن تكون مثالاً وتجربة لغيره.
ولهذا نُلاحظ –حسب قوله دائمًا- أنّ فئة من المُؤثرين تقترن بهم ظواهر الفشل الأسري والدراسي والرؤوس الفارغة من العِلم والقراءة والمعرفة، إنّهم يُريدون أن يجعلوا من ذواتهم الشَّاردة، نماذج للشباب في الحياة، بينما تمتلئ قلوبهم بالألم والحسرة وفقدان نقطة الاِرتكاز، وهذه الفئة تؤثر سلبًا على المجتمع.
واختتم بقوله: «إذا كانت هذه بعض سمات صناعة التفاهة، فإنَّ شباب الثقافة والقراءة، لابدّ لهم من أن يشرعوا في صناعة محتويات مفيدة، ويستعملوا أيضا جمالية الصُّورة والتقنية، كي يخلقوا مراكز تأثير أخرى، والأكيد أنَّ المجتمع أو العقل الجمعي يرى ويُلاحظ ويُحلل ويزن ما يسود وينتشر، ويتفاعل مع مصالحه التي هي خيراتٌ نافعات حسنات، ويتنكّب عن هذه المفاسد التي تكتسب أهميتها لا من خيراتها، وإنّما من غرابتها، وقد قال اِبن خلدون من قبل، أنّ النفوس مولعة بالغرائب !!!».

تقدم أطروحة دكتوراه نوقشت خلال الأيام الماضية بجامعة الجزائر 2 قراءة جديدة للاقتباس السينمائي للنصوص الأدبية باعتباره شكلًا من أشكال الترجمة الثقافية والسيميائية، حيث حلّل الباحث محمد ياسين بلقندوز فيلم «القيامة الآن» المقتبس من رواية «قلب الظلمات» بأدوات علم الترجمة ونظرية ما بعد الكولونيالية، ليكشف كيف تتحول الشاشة إلى فضاء يعيد كتابة النص الأدبي ويفكك سلطته ويعيد إنتاجه في سياقات سياسية وجمالية جديدة، مؤسسًا بذلك لمقاربة نقدية نادرة في المتن الأكاديمي الجزائري والعربي، إذ تربط الترجمة بالدراسات السينمائية وتفتح بابًا لدراسة الاقتباس كفعل مقاومة ثقافية يتجاوز حدود النقل السردي إلى إعادة كتابة المعاني والهويات.
قراءة: سامي حبّاطي
وتقف مجموعة من الأسئلة الجوهرية في صميم أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ“تجليات نظرية ما بعد الكولونيالية في الترجمة السينمائية للآداب الروائية: مقاربة نقدية موازنة من خلال فيلم (القيامة الآن) Apocalypse Now المقتبس من رواية «قلب الظلمات” Heart of Darkness» التي أعدها الباحث محمد ياسين بلقندوز في معهد الترجمة بجامعة الجزائر 2 بإشراف البروفيسور محمد الصالح بكوش، حيث تعد واحدة من أهم الدراسات البحثية الحديثة في الجزائر والعالم العربي في مجال علم الترجمة والسينما والاقتباس السينمائي للأدب والدراسات الثقافية من منظور ما بعد الكولونيالية.
وتتمحور التساؤلات التي تثيرها الأطروحة التي نوقشت بتاريخ 3 جويلية الجاري حول أسئلة: هل يمكن اعتبار الاقتباس السينمائي ترجمة؟ وهل يملك الفيلم حين يقتبس رواية كلاسيكية القدرة على إعادة كتابة النص وإعادة تأويله؟ وهل تظل السلطة في يد النص الأصلي أم تصبح الشاشة فضاءً للمقاومة والتفكيك وإنتاج المعنى؟
الاقتباس السينمائي فعل ترجمي متعدد الأبعاد والمستويات
تركز الأطروحة على فيلم «القيامة الآن» Apocalypse Now للمخرج الأمريكي الشهير فرانسيس فورد كوبولا Francis Ford Coppola، المقتبس من رواية «قلب الظلمات» Heart of Darkness لجوزيف كونراد، لتدرسه من زاوية غير مطروقة في المتن الأكاديمي الجزائري والعربي في علم الترجمة، حيث تحلل الاقتباس السينمائي باعتباره ترجمة ثقافية وسيميائية وأيديولوجية تتجاوز النقل السردي، ليصبح فعلًا تأويليًا يعيد كتابة النص في سياقات سياسية وثقافية وجمالية جديدة، كما تستخدم في تحقيق ذلك أدوات علم الترجمة.
وتنطلق الدراسة من افتراض أن الانتقال من الأدب إلى السينما ليس محاكاة شكلية أو امتدادا للنص الأصلي، بل هو فعل تَرجمي مقاوم يشتبك مع قضايا السلطة والهوية والهيمنة الرمزية في سياق ما بعد الكولونيالية. وتدمج هذه الأطروحة أدوات متعددة تشمل دراسات الترجمة الحديثة متمثلة في نظرية الأنساق المتعددة، والترجمة بين السيميائيات، والترجمة التأويلية، إلى جانب الدراسات الثقافية ونقد السلطة والهوية، ونظرية ما بعد الكولونيالية في تحليل التمثيلات الاستعمارية، والدراسات السينمائية بوصف السينما لغة بصرية قادرة على مقاومة النص الأصلي وإعادة إنتاجه.
وتعيد الدراسة من خلال هذا الدمج طرح الاقتباس السينمائي في حقل دراسات الترجمة، كفعل ثقافي حواري يعيد تشكيل الرموز والهويات والتمثيلات في النصوص المقتبسة، وليس كمجرد عملية تقنية. وقد جاءت الأطروحة في أكثر من 700 صفحة، حيث بنيت على الإطار النظري الذي يعيد تعريف الترجمة بما يتجاوز حدودها التقليدية نحو أبعادها السيميائية والثقافية والتأويلية، ويربطها بالدراسات الثقافية ونظرية ما بعد الكولونيالية، كما قدمت الاقتباس السينمائي من منظور دراسات الترجمة من خلال دراسة علاقة الأدب بالسينما خارج ثنائية “الأصل والتابع”، وذلك عبر تحليل تقنيات التحويل من الكلمة إلى الصورة، والبنى السردية والبصرية، مع تطبيق نماذج مثل فيلم “بابل” Babel في الإطار النظري، حيث استعمله الباحث كنموذج عن سيكولوجيا الألوان في السينما، إلى جانب نماذج أخرى حول توظيف الموسيقى وغيرها.
وتوضح الأطروحة أيضا العلاقة بين التراتبية الثقافية والاقتباس السينمائي من منظور ما بعد كولونيالي من خلال تحليل تمثيل «الآخر» والصراعات الهوياتية في النصوص المقتبسة، فضلا عن دور السينما كأداة لمقاومة السرديات الاستعمارية، فيما تنطوي أيضا على تحليل تطبيقي مقارن بين الرواية والفيلم من خلال دراسة المستوى البنيوي القائم على تحليل السرد والشخصيات والبنى الجمالية، والمستوى الدلالي المتمثل في التيمات والخطاب الاستعماري والهوية بين رواية «قلب الظلمات» وفيلم «القيامة الآن»، وذلك لإبراز الكيفية التي أعاد من خلال الفيلم إنتاج النص كترجمة ثقافية بصرية.
وتنبثق الدراسة وأهميتها من مجموعة من الدوافع تتمثل في حاجة الساحة الأكاديمية الجزائرية والعربية لدراسات تجمع بين الترجمة والدراسات السينمائية والنقد ما بعد الكولونيالي، الحاجة إلى فهم علاقة الأدب بالسينما كعلاقة حوارية إنتاجية وليست تبعية، بالإضافة إلى أهمية دراسة كيفية تحول السينما إلى أداة لمقاومة تمثيلات الاستعمار وإعادة بناء الهويات الثقافية، كما أنها تسعى أيضا إلى إعادة تأطير الاقتباس السينمائي داخل حقل دراسات الترجمة كنموذج نقدي وإبداعي يعكس تفاعل الحقول المعرفية ويفتح آفاقا جديدة للبحث في الترجمة السيميائية والثقافية. 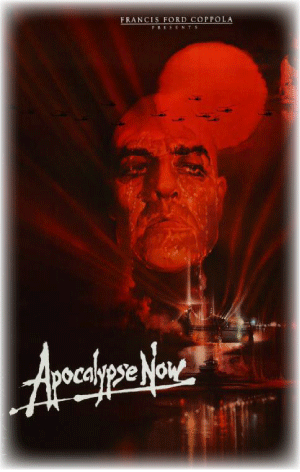
وتعتبر هذه الأطروحة رائدة إذ لا تكتفي بتحليل الفيلم نقديا، وإنما توظف نظريات الترجمة فعليا كأداة تفكيك وتحليل للاقتباس السينمائي، بما يفتح بابا جديدا للبحث، بالإضافة إلى أن اعتبار الاقتباس السينمائي ترجمةً متعددة المستويات وبأدوات دراسات الترجمة يمثل إضافة نوعية في البحث الأكاديمي، حيث يوضع الاقتباس تحت المشرط لفحص مفاهيم السلطة والهوية والمقاومة والهيمنة الرمزية وإعادة كتابة التاريخ ضمن سياق ما بعد الكولونيالية.
النصوص المقتبسة تنتقل إلى الشاشة وفقا لشروط النظام الثقافي المستقبِل
وتتأصل أطروحة الباحث محمد ياسين بلقندوز حول الاقتباس السينمائي بوصفه ترجمة ثقافية في إطار نظري متين يستند على أهم المراجع العالمية التي مهدت لهذا الطرح، حيث استعان بمفهوم «الترجمة ما بين السيميائيات» Intersemiotic Translation الذي وضعه عالم اللسانيات الروسي رومان جاكوبسون، وشق به الطريق لفهم الانتقال من الكلمة إلى الصورة باعتباره ترجمة بين وسائط تعبيرية متعددة، وليس مجرد عملية نقل لغوي، كما وظف الباحث نظرية الأنساق المتعددة Polysystem Theory التي تسمح بفهم الترجمة ضمن ديناميكيات الثقافة والسلطة والتلقي، مؤكدا على أن النصوص المقتبسة لا تنتقل إلى الشاشة بشكل محايد، وإنما وفقا لشروط النظام الثقافي الذي تستقر فيه.
واعتمد الباحث أيضا على دراسات البلجيكي باتريك كاتريس Patrik Cattrysse الذي يعتبر الاقتباس السينمائي أحد أشكال الترجمة ضمن إطار نظرية الأنساق المتعددة، بالإضافة إلى عالم الترجمة الأمريكي البارز، لورانس فينوتي Lawrence Venuti، الذي يناقش الترجمة كإعادة صياغة للسياق الثقافي ويفتح الباب لفهم الاقتباس السينمائي بوصفه «إعادة كتابة» للنص الأصل ضمن شروط ثقافية وسياسية جديدة، كما استلهم الباحث تفكيكية الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا Jacques Derrida لفهم تحطيم صنم الأصل وإعادة إنتاج المعنى من خلال الترجمة، إذ تعد نظرية دريدا «الأرضية الأساسية التي يقوم عليها النقد الثقافي وروافده برمتها»، مثلما يقول الباحث في الأطروحة، فيما يسقط إعادة إنتاج المعنى من خلال الترجمة على الاقتباس السينمائي الذي لا يكتفي بتقديم النص الأصلي في صورة بصرية، وإنما يزعزع سلطته ويفككه ويعيد تأويله. 
ويثبت الباحث من خلال هذا الإطار النظري طرحه بأن الاقتباس السينمائي ليس امتداد للنص الأدبي، وإنما “ترجمة” متعددة الأبعاد، أي ثقافية وسيميائية وتأويلية، بحيث أنها تعيد كتابة النص وتعيد إنتاجه في سياقات جديدة، لتتحول الشاشة إلى فضاء حواري يعيد صياغة الرموز والهويات داخل العمل المقتبس، كما يستدل في هذا الطرح بسحب مفهوم الأقلمة في الترجمة مثلما قدمه عالم الترجمةأندريه ألفونس لوفيفر André Alphons Lefevere على الاقتباس. وتقدم هذه الدراسة نموذجًا ملهمًا لفهم الترجمة كفعل ثقافي يتجاوز اللغة، ويعيد كتابة المعاني والهويات في سياقات جديدة، حيث تأتي في زمن تتزايد فيه أهمية الصورة والشاشة كوسائط للمعرفة والهيمنة والمقاومة، كما أنها دعوة للباحثين لاستكشاف مساحات جديدة في حقل دراسات الترجمة والدراسات الثقافية.
وتجدر الإشارة إلى أن البروفيسور نبيلة بوشريف ترأست لجنة مناقشة الأطروحة، التي ضمت البروفيسور محمد الصالح بكوش مشرفا ومقررا، إلى جانب الأعضاء المناقشين البروفيسور علجة مجاجي والبروفيسور سهيلة أسابع من جامعة الجزائر 2، والبروفيسور سيد أحمد طاسيست من جامعة المدية والبروفيسور فيصل صاحبي من جامعة وهران 1. وتوجت المناقشة بحصول الباحث على تقدير «مشرف جدا» وتهنئة اللجنة إلى جانب توصية بالنشر.
س.ح
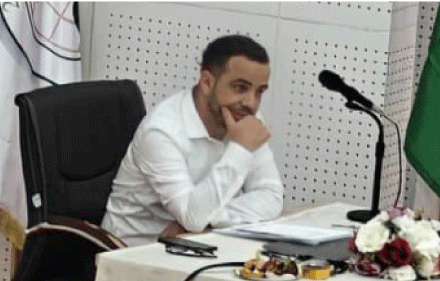
يؤكد الباحث محمد ياسين بلقندوز في هذا الحوار مع النصر حول أطروحة الدكتوراه التي قدمها خلال الأيام الماضية بجامعة الجزائر 2 بأن الخطاب الاستشراقي لم ينقطع، وإنما يعاد إنتاجه بوسائل جديدة، حتى في الأعمال التي تظهر نوايا مناهضة له، حيث يفكك من خلال تحليل اقتباس فيلم “القيامة الآن” لرواية “قلب الظلمات” تمثيل الآخر في عملية الانتقال من الأدب إلى السينما، كما يكيف أدوات علم الترجمة من أجل سبر آليات انتقال الرموز وإعادة تشكيلها وإنتاجها ضمن الترجمة الثقافية وبين السيميائية من النص إلى فضاء الصورة والصوت، موضحا مفاهيم السلطة الخطابية والهوية التي تطغى على العملية.
حاوره: سامي حبّاطي
ويحدثنا الباحث أيضا عن المطبات المعرفية والتحديات التي واجهته أثناء توظيف بعض المفاهيم في عملية التحليل، فضلا عن اقتفائه آثار عبارات عنصرية تبرر للإبادة والعنف الغربي غير المحدود وتطفو على السطح منذ القرون الوسطى إلى سياق العدوان على غزة اليوم من خلال تكررها دلاليا على لسان شخصيات من رواية كونراد والفيلم، ثم شخصيات سياسية وثقافية غربية من عالم اليوم.
النصر: كيف تبلورت لديك فكرة النظر إلى الاقتباس السينمائي كفعل ترجمي؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: انبثقت الفكرة من قناعتي بأن كل اقتباس سينمائي هو في جوهره عملية انتقال من وسيط دلالي إلى آخر، أي من الأدب إلى السينما، بما يتضمنه ذلك من إعادة صياغة وتكييف ثقافي وسيميائي. وجدت أن مقاربة الاقتباس بوصفه ترجمة توسّع أفق الدراسات الترجمية، وتمنحها امتدادًا بصريًا وثقافيًا أكثر شمولاً.
مقاربة الاقتباس بوصفه ترجمة تمنح
الدراسات الترجمية امتدادا أكثر شمولا
النصر: هل الترجمة هنا مفهوم يتجاوز اللغة؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: أتبنّى مفهوم الترجمة السيميائية كما طرحه رومان جاكوبسون، حيث لا تقتصر الترجمة على اللغة، بل تشمل انتقال الرسائل والمعاني بين أنظمة دلالية متعددة، منها الصورة، الحركة، الصوت. فالسينما لا “تتكلم” الرواية، بل تترجمها إلى شيفرة سمعية–بصرية جديدة، مع الحفاظ على خصوصية الوسيط السينمائي.
العلوم الغربية ليست محايدة
وتنطوي على قدر كبير من الأيديولوجيا
النصر: لماذا اخترت “القيامة الآن” Apocalypse Now و”قلب الظلمات”Heart of Darkness كنموذج تطبيقي؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: اخترت هذين العملين لأن العلاقة بينهما تمثّل حالة معقّدة من التفاعل الثقافي والتاريخي. فالفيلم لا يقتبس الرواية حرفيًا، بل يعيد كتابتها ضمن سياق حرب فيتنام، وينقل خطابها الاستعماري إلى منظار نقدي حداثي. هذا التوتر بين الأصل والترجمة هو ما دفعني لاختيارهما كنموذج حيّ لمقاربة الترجمة السينمائية من منظور ما بعد كولونيالي.
الوسائط المتعددة اليوم تستدعي
تحليلا ترجميا يتجاوز اللغة
النصر: ما أبرز التحديات التي واجهتك؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: أحد أبرز التحديات تمثّل في نقل نظرية الأنساق المتعددة، التي تقوم بتحليل موقع الترجمة داخل النسق الأدبي، إلى فضاء السينما، حيث لا نتعامل مع ترجمة لغوية فقط، بل مع ترجمة سيميائية وثقافية معقّدة. اخترت هذه النظرية لأنها تتيح فهم الترجمة كظاهرة ثقافية ديناميكية تتجاوز النقل اللغوي، نحو إعادة التسييق داخل نسق جديد. ومن هذا المنظور، يصبح الاقتباس السينمائي جزءًا من نظام الترجمة، لا باعتباره مجرّد تحويل أدبي إلى بصري، بل كفعل يعيد إنتاج المعنى وفق معايير نسق السينما. وكان التحدي في مواءمة مفاهيم النظرية مع خصوصيات الخطاب السينمائي، لإبراز كيف يتفاعل نسق الترجمة مع نسق الصورة ضمن عملية ثقافية مركّبة.
“القيامة الآن” ينقل الخطاب الاستعماري
لـ”قلب الظلمات” إلى منظار نقدي حداثي
النصر: كيف وظّفت النقد ما بعد الكولونيالي في التحليل؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: اعتمدت النقد ما بعد الكولونيالي لتفكيك تمثيل «الآخر» في الرواية والفيلم، من خلال تتبّع آليات التهميش، والتشييء، والصمت. فالآخر الإفريقي في الرواية، والفيتنامي في الفيلم، يظهر غالبًا كظل أو كتهديد غير منطوق. وقد قاربت هذا التمثيل من زاوية الترجمة النقدية، باعتبار الاقتباس السينمائي يُعيد صياغة موقع «الآخر» داخل نسق ثقافي وسيميائي جديد، دون أن يتحرر بالضرورة من منطق الهيمنة الرمزية.
النصر: ما حدود هذه المقاربة؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: قوّة المقاربة تكمن في تجاوزها للقراءة الموضوعاتية أو الشكلانية، ونفاذها إلى البنى الثقافية والإيديولوجية العميقة في الرواية والفيلم، من خلال عدسة ما بعد كولونيالية. أما حدّها الأبرز، فيتمثل في حاجتها إلى دقّة مفاهيمية كبيرة، لأن إسقاط المفاهيم النقدية على وسيط بصري قد يُنتج تأويلات لا تنسجم دومًا مع منطق التعبير السينمائي، ما يفرض توازنًا منهجيًا حذرًا بين التحليل الثقافي والقراءة الفيلمية.
الترجمة في الاقتباس السينمائي
ليست محايدة، بل محملة بالسلطة
النصر: ما أهم النتائج التي توصّلت إليها؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: توصّلت إلى أن العلاقة بين الأدب والسينما ليست علاقة محاكاة أو تبعية، بل علاقة ترجمة ثقافية بالمعنى الواسع، تُعاد فيها كتابة النص داخل نسق بصري وسيميائي جديد. فالاقتباس لا ينقل الرواية لغويًا، بل يترجمها ثقافيًا وجماليًا، مع ما يرافق ذلك من تحوّلات في المعنى. كما بيّنت الأطروحة أن الترجمة لا تقتصر على اللغة، بل تشمل تحويلات رمزية وثقافية قد تُعيد إنتاج الخطاب الاستعماري بأشكال معاصرة.
الاقتباس السينمائي يعيد إنتاج الآخر دون
أن يتحرر بالضرورة من منطق الهيمنة الرمزية
النصر: هل ترى أن الفيلم قاوم السلطة السردية للرواية؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: الخطاب الاستشراقي لم ينقطع، بل يُعاد إنتاجه بوسائل جديدة، حتى في الأعمال التي تُظهر نوايا مناهِضة له. ففيلم «القيامة الآن»، رغم محاولته تفكيك البنية الكولونيالية لرواية «قلب الظلام»، يترجمها من داخل نسق أمريكي لا يخلو من مركزية ثقافية. وقد برز توتر واضح بين نية الفيلم في مقاومة الخطاب الاستعماري، وبنية إخراجية أعادت تمثيل «الآخر» بصريًا ضمن نفس المنطق التشييئي، وإن في قالب حداثي وجمالي.
المقاربة التي اعتمدتها
تستلزم توازنا منهجيا حذرا
النصر: كيف ساعدك التحليل الترجمي على كشف الأبعاد الثقافية والإيديولوجية؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: التحليل الترجمي أتاح لي تتبّع التحوّلات الدقيقة في السرد والبنية الرمزية والبصرية، ورصد كيف تُعدَّل أو تُضخَّم أو تُهمَّش بعض المعاني بحسب الرؤية الجديدة. الترجمة هنا ليست محايدة، بل محمّلة بالسلطة، وتخضع في آن واحد لمنطق الصورة ولمنطق الإيديولوجيا.
النصر: هل لاقت هذه المقاربة تقبّلًا في الوسط الأكاديمي الجزائري؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: التفاعل كان مشجعًا، خصوصًا من الأساتذة المنفتحين على الدراسات البينية، رغم بعض التحفّظات من التيار التقليدي الذي لا يزال ينظر إلى الترجمة في إطارها اللغوي البحت. لكن الأفق يتّسع، والحوار يتطوّر نحو مزيد من الانفتاح على مقاربات جديدة.
النصر: وهل يمكن تطبيق هذه المقاربة على وسائط أخرى، مثل محتوى التواصل الرقمي؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: بكل تأكيد. نحن اليوم أمام أشكال جديدة من الترجمة المتعددة الوسائط: في الفيديوهات، والميمات MEMEs، والتصميمات البصرية، والتدوينات التفاعلية. وهذه كلها تنتج معاني جديدة وتخضع لمنطق ثقافي بصري يستوجب تحليلا ترجميا يتجاوز اللغة إلى التفاعلية والرمز والصورة.
وجدت أن العلاقة بين الأدب
والسينما علاقة ترجمة ثقافية
النصر: نجد في أطروحتك إشارة إلى تطابق عبارة «أبيدوا كل المتوحشين» «Exterminate all the brutes» على لسان شخصية كورتز Kurtz من رواية «قلب الظلمات»، وعبارة «أسقطوا القنبلة. أبيدوهم جميعا» على لسان العقيد وولتر كورتز في فيلم «القيامة الآن»، مع مضامين عبارات تستدعي خطاب العقاب الجماعي والعنف بلا قيود، وتتكرر اليوم على لسان نيكي هايلي Nikki Haley المرشحة السابقة للرئاسيات الأمريكية التي وقعت على قنابل صهيونية موجهة لإبادة الفلسطينيين عبارة «أجهزوا عليهم» Finish them وعبارة عالم النفس الكندي جوردان بيترسون الذي كتب عبارة «افتحوا عليهم أبواب الجحيم. يكفي يكفي» Give‘em hell, Enough is enough”” على حسابه في 7 أكتوبر 2023. ما تعليقك على هذا الأمر؟
- الدكتور ياسين بلقندوز: يمثل تطابق هذه العبارات تكرارا للخطاب الأمبريالي العنصري نفسه الذي يحقّر بالشرقي والعربي، أو العالم الثالث بشكل عام، فمضمون هذه الخطابات أن “هؤلاء لا يستحقون الحياة ويجب أن نقتلهم جميعا”. وينبع هذا المضمون من خطاب استعماري واستشراقي ممتد على زمن طويل، فهو ليس وليد اللحظة، وإنما تبلور على مدى قرون في الآداب والموسيقى والفنون التشكيلية والسينما، ثم انتقل بطبيعة الحال إلى السياسة والثقافة بشتى أشكالها، وحتى الفضاءات الأكاديمية، فالعلوم الإنسانية والتقنية الغربية ليست موضوعية ومحايدة تماما، وإنما تنطوي على جانب كبير من الأيديولوجيا. لقد بحثت عن أصل عبارة “أبيدوا كل المتوحشين”، فوجدت أنها عبارة لاتينية دينية مسيحية من زمن الحروب الصليبية، ثم ظلت متناقلة دون تغير محتواها ودلالتها مع مرور الزمن.
س.ح

تحتفلُ الجزائر هذا السبت، بالذكرى الـ63 لعيد الاِستقلال، وتأتي اِحتفالات هذا العام في ظل تحديات دولية وإقليمية حساسة. ذكرى الخامس جويلية 1962، تأتي كلّ عام لتستحضر أمجاد وتاريخ وأحداث وبطولات الجزائر، وهي مناسبة أخرى للذاكرة الوطنية، لتفعيل آلياتها، من خلال اِحتفالات ومقاربات سردياتها الثورية والوطنية. هذه الذاكرة التي تحتاج أكثر من أي وقتٍ مضى لتضيء وتُخَلَدَ أكثر.
أعدت الملف: نوّارة لحرش
وبكلّ الطُرق المُمكنة لهذا التخليد أو لهذه الإضاءة، ومن بين هذه الطُرق، التوثيق بكلّ الآليات، ومن بينها آلية وتكنولوجية الرقمنة. فهل يمكنُ -حقًا- أن تُساهم الرقمنة في حفظ الذاكرة الوطنية والتراث التّاريخي الوطني بشكلٍ أفضل من الأرشيف الورقي؟ وهل تُساهم في تعميم وتعزيز المعارف التّاريخيّة ونشرها وتبلغيها وتوفيرها أكثر للأجيال الجديدة والأجيال القادمة، وبالتالي تُثير اِهتمام شريحة أوسع من الشباب الذين يتفاعلون مع المحتوى الرقمي أكثر من التقليدي؟
أيضًا ما مدى أهمية وضرورة هذا التحوّل الرقمي فيما يخص رقمنة المادة والوثائق والملفات والمخطوطات التّاريخيّة؟ وإلى أي حد يمكن اِعتبار الرقمنة أداة فعّالة لحماية وحفظ وصون الوثائق التّاريخيّة وأداة تفعيل للهوية الثّقافيّة وربط المجتمع وعناصره بتاريخ الأجداد؟ ومن جانبٍ آخر: كيف يتصوّر المُؤرخ والباحث الأكاديمي المُختص في التاريخ، مشروع أو عملية رقمنة كلّ ما يتعلق بالمادة التّاريخيّة، وبالموازاة مع هذا، هل تُساهم أيضًا في تسهيل مهمة المؤرخين والمُشتغلين على التاريخ والذاكرة الوطنية؟ وهل تُوفر الرقمنة إمكانية الوصول الواسع واللامحدود واللامشروط إلى المادة التّاريخيّة؟
حول هذا الموضوع "الذاكرة الوطنية والرقمنة"، كان ملف هذا العدد من "كراس الثقافة"، مع مجموعة من أساتذة التاريخ والباحثين الأكاديميين، الذين تناولوا وقاربوا الموضوع كلٌ من زاويته وحسب وجهات نظر مختلفة ومتباينة، لكنها تلتقي وتتقاطع في الكثير من النقاط.

* الباحث والأستاذ مراد سعودي
الأرشيف الرقمي ضرورة عصرية وعلمية
يقول أستاذ التاريخ الدكتور مراد سعودي، من جامعة الجزائر2: "يُعد التاريخ وعاءً لجميع الأعمال الإنسانية وبإيجاز شديد، ينطوي تعريفه على معنيين رئيسيين هُمَا؛ الأحداث التي وقعت فعلاً؛ ورواية تلك الأحداث التي وقعت فعلاً من قِبل المؤرخين".
مُضيفاً في ذات المعطى: "أًعْطِيَت للتاريخ عِدة تعاريف أختار منها تعريف هنري إيريني مارو الّذي عَرَّفَهُ على أنّه (معرفة الماضي البشري المُتوصل إليه بطُرق علمية)، تنطوي عبارة بطُرق علمية معاني التحقّق عن طريق النقد التاريخي الّذي يصفه مارك بلوخ بــ(فن تمييز الصحيح والخاطئ والمُحتمل في الروايات بالنقد التاريخي)، ولمُعالجة أي نقطة تاريخية وجب البحث عن شواهدها وجمعها وهذا من صلب مهمة المؤرخ، هذه الوثائق التي تملأ الأرشيفات مُتباينة بدرجة كبيرة جدًا والسيطرة عليها تتطلب تقنيات عالية ومُمارسة حقول معرفية في غاية الدقة لجمع الوثائق الضرورية للبحث والحصول عليها، فالمُؤرخ المحترف هو الّذي يضبط في ذهنه هذا السؤال: كيف أستطيع أن أعرف ما سأقوله لكم؟".
ثم أردفَ: "هناك مقولة شهيرة مضمونها: (المُؤرخ ينشئ وثائقه)، هذه الوثائق تتعدّد مصادرها وأماكن تواجدها لذا أصبح اليوم مع التغير المُتسارع في شتى المجالات وخصوصًا المجال الرقمي أن تتم إتاحة هذه الوثائق رقميًا؛ هذا الاِتجاه الّذي سارت فيه بعض الدول مُبكرًا وغيرت مفهوم الأرشيف من الورقي إلى الرقمي مثل الولايات المتحدة في السبعينات وكندا ثم تلتها الدول الأنجلوساكسونية، لتلتحق بعض الدول الأوروبية بهذا الركب سنة 1986".
ومع هذا التغير -يُضيف المُتحدّث- أصدرت اليونيسكو سنة 1990 تقريرًا مُفصلاً تحثُ فيه الدول على ضرورة أرشفة الوثائق وإتاحتها رقميًا.
وهنا يتساءل: "هل ما زلنا في الجزائر غير مُواكبين للتغير الحاصل في هذا المجال الّذي أصبح سياديًا؟ أم أنّ التطوّر الرقمي مُتسارع جدًا ويتطلب حشد موارد مادية وتأهيل علمي مُتخصّص؟
وفي ذات الفكرة يُواصل قائلاً: "كان أوّل من طرح هذا الاِهتمام أحد أعمدة الأرشيفيين في الجزائر (عبد الكريم بجاجة) سنة 2001 لكن دون تطوير الفكرة، بعدها أصبح الاِعتراف بحجية الكتابة الإلكترونية من خلال القانون 10 - 05 المُؤرخ في 20 جوان 2005، الّذي يجعل من الشكل الإلكتروني مقبولاً في الإثبات على غرار الشكل الورقي".
إذ أصبحَ -حسبَ رأيه- التدفق الهائل للملفات وضرورة اِسترجاعها والحاجة إليها مُمكنًا بأسرع طريقة وأكثرها أمانًا عبر الطريق الرقمي الّذي أَصبحَ أفضل وعاء للحفاظ عليها، وخصوصًا الوثائق التّاريخيّة التي تجاوز عمرها عقودًا وفي وثائق قرونًا.
مُضيفًا: "اِنتقلنا اليوم إلى عصر المُؤرخ الرقمي الّذي يُواجه كمًا هائلاً من الوثائق في أماكن مُتعدّدة يصعب السفر إليها، اِنعكس على ثراء المعرفة التّاريخيّة وتشعبها وصعوبتها وغدى الأرشيف الرقمي مقومًا لسيادة الدول ومكسبًا لتعزيز المعارف التّاريخيّة والحفاظ على الذاكرة الجماعية حتى لا يحدث أي تلاعب بذاكرة الشعوب لتفتيت ثقافتها مثل ما يحدث هذه الأيّام أين أصبحت صناعة الأرشيف أداة ضغط ودعاية مغرضة".
ويقول ذات المتحدّث، مُؤكداً في هذا الفحوى: "أصبحت الرقمنة ضرورة مُلحة في جميع المجالات والاِنخراط فيها عملٌ أكثر فائدة لحفظ الوثائق من الضياع سواء ما تملكه المؤسسات أو الأفراد، وخير مثال على هذا مشروع NARA الأمريكي سنة 2012 الّذي تمَ تسميته Citizen archivist الأرشيفي المواطن، حيثُ أشرك المواطنين في رقمنة الوثائق ودعاهم للتطوع للقيام ببعض المهام، هُنا ستتغير المعارف التّاريخيّة وتنكشف وثائق جديدة ستؤثر حتى على سياسات الدول".
وخَلص إلى القول: "إنّنا بحاجة كبيرة للتحوّل الرقمي من أجل حفظ معارفنا التّاريخيّة وخلق أمن معرفي للذاكرة الوطنية ومصداقية أكثر في الكتابة التّاريخيّة، وتمكننا من النبش في تاريخنا وتعزيز وجوده في حاضرنا".

* الأستاذ فؤاد عزوز
الرقمنة تحصن الذاكرة الوطنية من التهديدات الجيوسياسية
يرى أستاذ التاريخ في جامعة سطيف، الدكتور فؤاد عزوز، أنّ رقمنة الوثائق والمادة والملفات التّاريخيّة ليست مجرّد عملية تقنية معزولة، بل هي مشروع حضاري مُتكامل تتقاطع فيه الأبعاد الثّقافيّة، السّياسيّة، المعرفيّة والتّقنيّة، ويجب أن يُفهم ضمن رؤية وطنية شاملة لحفظ وصون الذاكرة الجماعية، وتحديث أدوات البحث التّاريخي، وضمان اِستمرارية العلاقة بين الماضي والحاضر والمُستقبل.
مُضيفاً في ذات الشأن: "تُعد الرقمنة أداة فعّالة لحماية الوثائق التّاريخية من التلف، الضياع، أو التلاشي الطبيعي الّذي تُسببه الرطوبة، الزمن، أو الكوارث، كما تُقلل الحاجة للتعامل المُباشر مع النُسخ الأصلية، ما يُحافظ على سلامتها، والأهم أنّ الرقمنة تُحصّن الذاكرة الوطنية من التهديدات الجيوسياسية، إذ يمكنُ إنشاء (نسخ اِحتياطية) مُوزعة في مواقع آمنة، وبالتالي الحفاظ على التُراث الوثائقي حتّى في حال نشوب أزمات أو حروب، في هذا السّياق تُصبحُ الرقمنة وسيلة من وسائل (السيادة الثّقافيّة)، تحمي التّاريخ من الضياع أو التزوير".
ومن أبرز ما تٌحقّقه الرقمنة -حسبَ ذات المتحدّث- هو ديمقراطية الوصول إلى المعرفة التّاريخيّة، وتُصبح مُتاحة للطُلاب والباحثين الأكاديميين بمختلف رتبهم، ويمكن للمنصّات الرقمية أن تُعيد تقديم الوثائق في صيغ جذابة وتفاعلية (خرائط، معارض اِفتراضية، روايات مُتعدّدة الوسائط)، ما يُساهم في إعادة إحياء الاِهتمام بالماضي لدى الأجيال الجديدة، وبالتالي تُصبح الرقمنة أداة تفعيل للهوية الثّقافيّة وربط المجتمع وعناصره بتاريخ أجداده.
ومُستدركاً يقول: "ورغم مزايا الرقمنة، إلاّ أنّ المشروع يُواجه تحديات تقنية ومادية، منها كلفة المعدات والتخزين، الحاجة إلى تدريب الكوادر، وضمان اِستمرارية المنصات الرقمية في ظل تغير التكنولوجيا السريع، كما يجب التنبه إلى التحديات الأخلاقية مثل: حماية الخصوصية أو منع التلاعب بالوثائق، لذلك فإنّ نجاح الرقمنة يتطلب رؤية إستراتيجية شاملة، ووعيًا سياسيًا وثقافيًا بقيمة الأرشيف كركيزة للسيادة والهوية الوطنية".
وأردف مُوضحًا: "قبل الرقمنة، كان الباحث التّاريخي مُضطرًا للتنقل إلى مراكز الأرشيف، والتي قد تكون مُتباعدة أو محدودة الوصول بسبب عوامل إدارية، سياسية أو حتّى بيروقراطية، أمّا بعد الرقمنة فأصبح بالإمكان تصفح الأرشيف من أي مكان في العالم، وفي أي وقت، ما يُوفّر على المؤرخين وقتًا وجهدًا كبيرين، ويفتح المجال أمامهم للإطلاع على كمّ واسع من الوثائق لم يكونوا يستطيعون الوصول إليه سابقًا".
مُضيفًا في ذات المعطى: "تُوفر الرقمنة إمكانية الربط بين مصادر مُتفرقة زمانيًا ومكانيًا، ما يُمكِّنُ المُؤرخ من بناء رؤية شمولية ومُتعدّدة الأبعاد، فيمكنه مثلاً مقارنة مراسلات إدارية من الأرشيف الوطني، مع شهادات شفهية محفوظة رقميًا، أو صور وخرائط تاريخيّة رقمية، مِمَا يُثري التحليل التاريخي ويُوسّع من قاعدة الأدلة التي يستندُ إليها الباحث".
وبالموازاة مع هذا، -يُشيرُ المُتحدّث-، إلى أنّ المادة الرقمية قابلة للبحث النصي، والتعليق، والتكبير، والمُعالجة باِستخدام برامج الذكاء الاِصطناعي أو التحليل النصي، وهذا يُحْدِثُ نقلة كبيرة في طريقة تعامل المُؤرخ مع الوثيقة، ويجعله أكثر قدرة على اِستخراج الأنماط، ورصد التكرارات وربط الأحداث، كما تُتيح الرقمنة الاِستفادة من أدوات التعليم الرقمي، كإنشاء خرائط زمنية تفاعلية أو بناء قواعد بيانات تاريخية قابلة للتحليل الكمي.
كما تُتيح الرقمنة للمؤرخين -يُضيف المُتحدّث- التعاون فيما بينهم عبر الحدود، وتبادل الوثائق والأفكار ضمن شبكات بحث رقمية، وهذا يُسهل بناء مشاريع بحث جماعية عابرة للدول، كما يُقرّب بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والأرشيفية، ويسمح بتقاسم الوثائق النادرة أو الحساسة بطريقة آمنة.
وفي الأخير خلص إلى القول: "من خلال رقمنة الوثائق الهامشية أو غير الرسمية (كالمذكرات الشخصية، الصور، القصاصات، الرسائل الشعبية...)، تُفسح الرقمنة المجال لكتابة تاريخ من الأسفل، يُنصتُ للأصوات المنسية والمُهمشة، وهذا يُحرّر الكتابة التّاريخية من الاِقتصار على الرواية الرسمية، ويفتح بابًا أوسع لتعدّد السرديات التّاريخيّة وفهم الذاكرة الجماعية في كلّ تعقيداتها".

* الأستاذ والباحث مصطفى بن عريب
السبيل الأمثل لحفظ وصون الذاكرة الوطنية
أمّا الباحث وأستاذ التاريخ، الدكتور مصطفى بن عريب، من جامعة محمّد بوضياف/المسيلة، فيقول: "يقتضي الحديث في مسألة رقمنة المادة والوثائق والنصوص والمخطوطات التّاريخيّة بأنواعها المُختلفة التنويه أوّلاً بأنّها قد أصبحت عملية ضرورية وناجعة أكثر من غيرها لضمان حماية وتأمين الوثائق التّاريخيّة وحفظها بطريقة تقنية وإلكترونية لمدى زمني طويل جدًا يضمن وصولها وهي في حالة جيدة للأجيال اللاحقة".
فمسح الوثائق -يُضيف المتحدّث- ورقمنتها يؤدي حتمًا لتفادي المخاطر المُتعدّدة (الإتلاف، الحرائق، تضرّر الوثائق بفعل الرطوبة، الغُبار والبكتيريا) وهي في الحقيقة مخاطر تحيطُ بالعمليات التقليدية لحفظ الوثائق التّاريخيّة في العُلب والحافظات الورقية أو السجلات ورفوف المكاتب والمستودعات وهي في مجملها أدواتٌ ووسائل بالية لا يمكن التعويل عليها في حفظ المادة والوثائق والنصوص التّاريخيّة لأمدٍ طويل.وعليه -يقول ذات المتحدّث- يجب أن تُساير عمليات رقمنة الوثائق التّاريخيّة مُختلف المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائريّة في سبيل رقمنة الإدارة والتجارة والبحث العملي وغيرها، بل أصبح الحفظ الرقمي للمعلومات والكُتُب والوثائق مطمح كلّ مؤسسة أكاديميّة وثقافيّة واِقتصاديّة.ففي هذا السّياق، -يؤكد الدكتور بن عريب-: "يُعدُ مشروع أو عملية رقمنة الوثيقة التّاريخيّة من المشاريع الجادة والخيارات الضرورية والاستراتيجية التي يجب على الجميع المُساهمة في تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع وذلك بالنظر للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية سواء على مستوى الوثائق التّاريخيّة نفسها أو على مستوى تطوّر البحث العلمي التّاريخي وحفظ التُراث المكتوب بشكلٍ عام".
وهنا أردف: "فلا ريب أنّ رقمنة الوثائق التّاريخيّة هي السبيل الأمثل لحفظ وصون الذاكرة الوطنية والطريقة العلمية الأفضل لنشر وعرض كلّ ما هو مدسوس ومُضمر من مادة تاريخية ووثائق ونصوص في مُختلف المكتبات العمومية والخاصة وكذلك مراكز الأرشيف المُتناثرة هنا وهناك فتكون بفضل مسحها ضوئيًا وتحويلها لملفات رقمية مُتاحة على مر العصور وفي مُتناول الأجيال بصفة عامة والطلبة والباحثين والمؤرخين بصفة خاصة".
لاسيما وأنّ عرضها في هذه الحالة -يقول المُتحدّث- سيؤدي حتمًا لتخفيف أعباء البحث التّاريخي واختزال الكثير من الوقت والجهد ويُبدّد الكثير من الصعوبات التي كثيرًا ما واجهها الباحث والمُؤرخ من أجل الحصول على الوثيقة التّاريخيّة كالاِنتقال لأماكن بعيدة. صعوبات ومخاطر الاِستنساخ من الوثائق الأصلية، التكاليف الباهظة للوصول إلى بعض الوثائق الموجودة غالبًا في أماكن مُتفرقة وتضع بعض الشروط القاسية مقابل الاِطلاع على وثائقها.
فضلاً -كما خلص في الأخير- على أهمية وانعكاسات اِستثمارها وتوظيفها على نطاق واسع في تطوّر البحث التاريخي والوصول لأعمال رصينة وجادة تتسم بالمصداقية والحقيقة التّاريخيّة.

* الباحث والأستاذ محمّد بن ساعو
خطوة مهمة في مسار الحفاظ على التاريخ والذاكرة
في حين، يقول الأستاذ والباحث المُختص في التاريخ، الدكتور محمّد بن ساعو من جامعة سطيف2: "لقد أسهم التحوّل الرقمي من خلال التوجه نحو تحويل الأرشيف الورقي من مخطوطات وأرصدة وثائقية وخرائط وتسجيلات إلى صيغ رقمية، في تصدر الموضوع ضمن الخطاب الأكاديمي على مستوى تصوّر مشاريع البحث واهتمامات المخابر العلمية في تخصّصات التاريخ وعِلم الآثار والمخطوطات وعِلم المكتبات، وفي خُطط عمل المُؤسسات المكتبية ودور الأرشيف ومراكز حفظ المخطوطات التي بدأت في التّكيّف مع هذا التوجه الّذي يندرج أيضًا في ما يُسمى بالإنسانيات الرقميّة".
مُضيفًا: "إنّ المُراهنة على اِستمرارية المُحافظة على الوثائق والمخطوطات بصيغتها الأولى أمرٌ في غاية الأهمية، ذلك أنّ الأصول تظل مُهدّدة بتأثير العوامل المُختلفة على الرغم من محاولة توفير ظروف مثالية للحفظ في أحيان كثيرة، على اِعتبار أنّ الرقمنة تلغي الحاجة إلى العودة إلى النسخ الأصلية والاِقتصار على المرقمنة، فينعكس التقليل من التداول الميكانيكي لها على حالتها ووضعيتها ويُطيلُ في أمد مقاومتها".
هذا المسعى -حسب الدكتور بن ساعو- هو خطوة مهمة في مسار الحفاظ على التاريخ والذاكرة من جهة لأنه يُعنى بتنويع حوامل النصوص وهو ما يُضاعف من جودة استمراريتها، كما أنّه يسهم في دمقرطة الوصول إلى المضامين من خلال إتاحة المواد المرقمنة على الشبكة العنكبوتية وفي المواقع المختصة بالبحث التاريخي وفي الأرصدة الإلكترونية للمؤسسات بالمقابل أو بالمجان وفقًا للسّياسة المُتبعة.
الأمر الّذي من شأنه -كما يُضيف- توسيع دائرة الإفادة من جهة والتقليل من حجم المتاعب التي تعترض الباحث في الوصول إلى المظان التي يعتمدها في ضبط الحقائق وإعادة تصوّر الحادثة التّاريخيّة.
ومُستدركًا أردف: "ومن المُهم الإشارة إلى أنّ هذه الدمقرطة لا تخدم البحث العلمي والباحثين الأكاديميين من المُتخصصين فقط، بل يمتد اِنعكاسها وتأثيرها الإيجابي على عموم المهتمين بقضايا التاريخ والذاكرة بصفة عامة، ليشمل أيضًا المشتغلين بالفنون المسرحية والسينمائية ومختلف ضروب الإبداع التي تتخذ من المادة التّاريخيّة ركيزة لبناء متونها وصياغة سردياتها".
وفي ذات السّياق، واصل قائلاً: "في وضعنا الراهن، وعلى الرغم من الوعي بأهمية هذه الخطوة، إلاّ أنّ العملية يبدو أنّها تسير بوتيرة بطيئة سواء على مستوى عملية الرقمنة في حد ذاتها أو على مستوى الإتاحة على الشبكة العنكبوتية، والأمر له خلفيات متعلقة بالإمكانيات المادية والبشرية من جهة وبمدى وجود الإرادة الحقيقية من جهة ثانية، ومع ذلك فإنّ هذا لا ينفي أهمية وفعّالية بعض المُبادرات الجادة سواء في المؤسسات المنضوية تحت قطاعات عمومية بعينها أو من خلال مبادرات خاصة على غرار بعض الزوايا التي اِجتهدت في فهرسة مخطوطاتها ورقمنتها وإتاحتها للمهتمين".
واختتمَ بقوله: "لا يمكن جعل رقمنة الوثائق مجرّد عملية تقنية تقوم على التصوير والإدراج في الوسائط الإلكترونية، بل هي مشروع تتقاطع في تجسيده الكثير من الفواعل لضمان السيادة المعرفية والعدالة التّاريخيّة ويحكمه واجب حفظ الذاكرة وتبليغها للأجيال القادمة، ومن الضروري التنبيه إلى أنّ عملاً من هذا النوع، يتطلب تجنيد إمكانيات مُهمة على المستوى التنظيمي، التقني، والبشري..".

* الباحث والأستاذ عبد القادر عزام عوادي
مشروع حيوي لصون التراث التاريخي
يقول الدكتور عبد القادر عزام عوادي، باحث وأستاذ في قسم التاريخ، بجامعة حمة لخضر/الوادي، من جانبه: "يعدُ مشروع رقمنة الوثائق والمادة التاريخية من أهم المشاريع الحيوية في سبيل الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصون التراث التّاريخي من التلف والضياع. فمع تطوّر التكنولوجيا، أصبح بالإمكان تحويل الأرشيف الورقي الهشّ والمُهدّد بعوامل الزمن إلى نسخ رقمية قابلة للحفظ والاِسترجاع والنشر بسهولة، وهو ما يُمثّل تحوّلاً نوعياً في طُرق التعامل مع التّاريخ ومصادره".
ويضيف المتحدّث: "إنّ رقمنة الوثائق لا تعني فقط تحويلها إلى ملفات إلكترونية، بل هي عملية توثيق منهجية تستوجب التصنيف، والتأريخ، والتحقّق من صحة المعلومات، وربطها بسياقاتها التّاريخيّة الدقيقة. من جهة أولى، تُساهم الرقمنة بشكلٍ مُباشر في حماية الوثائق الأصلية من التلف، سواء بفعل العوامل الطبيعية كالرطوبة والحرارة، أو بفعل الاِستخدام البشري المُتكرّر. كما أنّها تضمن الحفاظ على محتوى الوثائق حتّى في حال ضياع النسخ الأصلية".
وهذا في حد ذاته -حسب رأيه- عمل من أعمال صون الذاكرة الوطنية، لأنّ الوثائق التّاريخيّة ليست مجرّد أوراق، بل هي شواهد على الماضي، وعلى مكوّنات الهويّة الوطنيّة والسّياسيّة والاِجتماعيّة.
من جهةٍ ثانية، -وحسب رأيه دائماً- تُوفر الرقمنة إمكانية الوصول الواسع إلى المادة التّاريخيّة، سواء للباحثين أو للطلبة أو للمهتمين، بغض النظر عن أماكن تواجدهم. فبدل أن تبقى الوثائق حبيسة الأرشيفات والمؤسسات الرسمية، تُصبح مُتاحة عبر منصات رقمية يمكن تصفحها في أي وقت، مِمَا يُساهم في تعميم المعرفة التّاريخية ونشرها بين الأجيال الجديدة، بل وقد يُثير اِهتمام شريحة أوسع من الشباب الذين يتفاعلون مع المحتوى الرقمي أكثر من التقليدي.
أمّا بالنسبة للمُؤرخين والباحثين، فإنّ الرقمنة -يُؤكد الدكتور عوادي- تُسهم في تسهيل مهامهم بشكلٍ كبير، إذ تُوفر الوقت والجهد في التنقل بين الأرشيفات، وتُتيحُ أدوات بحث رقمية تُمكِّن من اِستعراض كميات ضخمة من المعلومات في وقتٍ وجيز. كما تُساعد في الربط بين مصادر مُتعدّدة ومقارنة الروايات وتدقيقها. وهذا ما يُعزّز جودة البحث التّاريخي، ويدفع نحو إنتاج معرفة علمية دقيقة ومُعمّقة.
بالمُوازاة، –يُضيف المُتحدّث- من الضروري الإشارة إلى أنّ مشروع الرقمنة يجب أن يتم ضمن إطار مؤسسي يحترم الضوابط العلمية والأخلاقية، ويضمن حماية البيانات وعدم التلاعب بها. كما أنّ التكوين في هذا المجال ضروري، سواء بالنسبة للأرشيفيين أو المؤرخين، حتى تكون الرقمنة أداة فاعلة لا مجرّد تقنية حديثة.
واختتمَ بقوله: "باِختصار، الرقمنة ليست فقط وسيلة للحفظ، بل هي أفقٌ جديد للتفكير في التاريخ، ولإعادة ربط المجتمع بذاكرته الجماعية، ولتمكين الأجيال القادمة من فهم ماضيها في ضوء معطيات دقيقة ومُتاحة".

* الشِّعر الحديث ليس محل اِستيعاب إنّه بالأحرى محل إثارة وإحساس وتأمل * الشِّعر هو كتابة فوق-تاريخية غير خاضعة لسياقها الزمني
يرى الشاعر عمار مرياش أنّ الشِّعر الحديث كغيره من الفنون الحديثة ليس محل اِستيعاب، إنّه بالأحرى محل إثارة وإحساس وتأمل. مُؤكدًا أنّ أسئلة الشاعر وتساؤلاته هي محض إجابة –رمزيّة طبعًا– وهذا من طبيعة كينونة الشاعر. مُشيرًا في ذات السّياق إلى أنّ من واجب الشاعر -أيضًا- أن يفتح أبوابًا ونوافذ ويُعَبِدَ طُرقًا. كما ذهب مرياش إلى اعتبار أنّ الشاعر هو ذاته معادل موضوعي لقلق الحياة وعبثيتها، لروعتها وفتـنتها العظيمة كما لحمقها وسخافاتها.
حوار: نوّارة لحـرش
كما تطرق صاحب «اِكتشاف العادي» في هذا الحوار، لموضوعات ذات صلة بالحداثة الأدبية والنقد والنُقاد، وباللّغة التي يرى أنّها خارج الإبداع الأدبي، مجرّد أداة، وسيلة لا غير، وأنّ ما هو مهم جدًا هو الرؤيا، وأنّ الحداثة ليست كلّ شيء.
للإشارة، عمار مرياش، (مواليد 8 أكتوبر 1964)، شاعر جزائري، حائز على عدة جوائز أدبية وطنية وعربية، أسَسَ ـفي العام 1990 مع الطاهر وطار مجلة «القصيدة» ورأس هيئة تحرير أعدادها الأولى. اِشتغل بقسم الإنتاج الثقافي بالإذاعة الجزائرية، وفي عام 1996 غادر الجزائر واستقر في غربته الاِختيارية في أوروبا، حيثُ يعيش ويشتغل في مجال التكنولوجيات الجديدة مُطَوِّرًا للبرامج.
صدرت له مجموعة من الدواوين الشِّعرية، من بينها: ديوانه الأوّل «اِكتشاف العادي» العام 1993 وتُرجم إلى الإسبانية، كما تُرجم إلى الفرنسية من طرف الشاعر والمترجم عاشور فني وصدرت الترجمة في العام 2003 ، ديوانه الثاني «لا يا أستاذ» العام 1996 عن الجاحظية في طبعة خاصة وجد معدودة ومحدودة ولم تُوزع في المكتبات، «الحَبَشَة.. يليها النبي» العام 2010 عن دار نقوش عربية في تونس. وآخر ما أصدره مرياش، مجموعة شِعرية بعنوان «حان مستقبلي، (سابقًا: ذهبتُ مع الفكرة حتّى نهايتها ثم واصلتُ وحدي)» 2024، عن دار خيال للنشر والترجمة.
أسئلة الشاعر وتساؤلاته هي محض إجابة رمزيّة
في نصوصك ومجموعاتك الشّعرية زخمٌ من الأسئلة، وفي المقابل زخمٌ من الأجوبة. هل ترى أنّ مهمة الشاعر الأجوبة أيضاً؟
- عمار مرياش: «الحمقى سعداء كثيرًا/ ذلك أنّ إجابتهم جاهزة سلفًا»، هكذا أقول في ديوان «اِكتشاف العادي» ولكن، من قال أنّ الشاعر هو كائن أبله يتجوّل في مستشفى مجانين يفتح فمه باِندهاش ويتساءل باِستمرار؟ ثمّ إنّ أسئلة الشاعر وتساؤلاته هي محض إجابة –رمزيّة طبعًا– ولكن هذا من طبيعة كينونة الشاعر، أنا أكره الإجابات الجاهزة والكلية والكونية والصالحة لكلّ زمان ومكان فقط، أكره أيضًا الصح والحقيقة، وكلّ تجارة في الأخلاق والقيم، بعد هذا من واجب الشاعر أيضًا أن يفتح أبوابًا ونوافذ ويُعَبِدَ طُرقًا. بل واجبهُ الأوّل في المراحل التي يفقد فيها كلّ شيء معناه ووظيفته، وتتحوّل فيها العلامات والإشارات إلى أسئلة.ذاتَ يوم قالت لي مراهقة أنّ مقطعًا شعريًّا لي أنقذها من الاِنتحار، المقطع يقول: «لا نخسر شيئًا إذ نخسر لا شيء». بالنسبةِ لي هذا المقطع هو محض مقدمة منطقية لِمَا يلي في القصيدة، ولكن بالنسبة لها هو إجابة فلسفية على مسألة وجودية، ولِمَ لا؟.
أحيانًا لا يملك القارئ القدرة على اِستيعاب لُغة الشاعر أو مفرداته. إلى أي حد يعنيك هذا القارئ؟
- عمار مرياش: إنّ القارئ هو صورتي في ماء نرجسيتي، إنّه جزء من روحي، وأؤكد أنّ علاقتي باللّغة العربية هي أكثر من علاقة عشق، إنّها الهيام، لديّ إحساس مدهش بهذه اللّغة. صدقيني، لديّ قُراء أكثر من أصدقاء حقيقيين وأكثر من إخوة. إنّ الشاعر هو ذاته معادل موضوعي لقلق الحياة وعبثيتها، لروعتها وفتـنتها العظيمة كما لحمقها وسخافاتها.
الشاعر هو الوحيد من بين كلّ أعضاء الطبقة-الكهنوتية- الّذي يكتب بذاته، وبالتالي فهو الوحيد الّذي لا يمكننا تحكيمه لمنطق الصواب/الخطأ، إنّه هو كما هو، إنّ اِنزياحه بالنسبة لأي معلم كان –مهما كانت شرعيته- هو جزء من وظيفته الأساسية، لذا فهو يخلق لغته، رؤياه وهندسة نصه، إنّه يخلق نفسه باِستمرار، وعلى القارئ أن يعمل على تطوير نفسه قليلاً وإلاّ فإنّه ليس أمامه سوى مواصلة قراءة الخطابات الموزونة والمُقفاة التي تعوَّدَ عليها، ليس هناك حل آخر. بصورة أكثر وضوحًا الشاعر هو نفسه رسالة، إنّه لا يعبر عن، ولا يعكس الـ، إنّه هنا، الآن وهكذا. إنّه هو.لديّ قُراء من مناطق لم أتصوّر مُطلقًا أنّ كتابتي النادرة جدًا يمكن أن تصل إليها ومع ذلك فهم يقرؤونني ويحفظون قصائدي عن ظهر قلب، وهم ليسوا نقادًا ولا أساتذة جامعيين، وأخيرًا يجب الإشارة أيضًا إلى أنّ الشِّعر الحديث كغيره من الفنون الحديثة الأخرى ليس محل اِستيعاب، إنّه بالأحرى محل إثارة وإحساس وتأمل.
خارج الإبداع الأدبي اللّغة مجرّد أداة و وسيلة لا غير ما هو مهم جدًا هو الرؤيا
على ذكرك للشِّعر الحديث. قلتَ سابقًا: «الحداثة لا تتطلب مصطلحات لغوية معينة والخروج على الوزن والقافية بقدر ما تتطلب النظرة الحديثة والمستقبلية للأشياء». ألا ترى أنّ مفهوم الحداثة ملتبس لدى الأغلبية، أو أنّ هذا هو السائد غالبًا؟
- أجدّدُ تأكيدي لِمَا قلتُ منذ سنوات. أيضًا خارج الإبداع الأدبي اللّغة مجرّد أداة، وسيلة لا غير، ما هو مهم جدًا هو الرؤيا طبعًا. ثمَ إنّ الحداثة ليست كلّ شيء ولا أهم شيء بالنسبة للجزائر والعرب، يجب أن يكون هذا واضحًا. والحداثة الأدبية لا يمكن أن تستمر وتتطوّر بدون حداثة اِقتصادية واِجتماعية وسياسيّة. ثم هناك شعراء شعريّتهم ليست عالية جدًا ولكن حداثتهم متطوّرة جدًا، بختي بن عودة نموذجًا هل يمكن أن نُصنفه مع الشعراء؟ على العكس منه هناك شعراء شعريّتهم جد عالية في حين أنّ حداثتهم ليست جد عالية. ثُم لنقل أنّ الحداثة هي التمظهر الفني لروح العصر، أدبيًا أقصد أولوية المدينة، التمدن، العقلانية، الديمقراطية، التسارع، التحكم، المحلي، العالمية، الإيمان المُطلق بحقوق الإنسان، الوعي الفردي باللامتناهيات: اللامتناهي في الكبر -ملايير المجرات-، اللامتناهي في الصِغر -عالم الذرة وما أصغر-، اللامتناهي في التعقيد –الذرات المُتكاملة-، نوع من علاقة وظيفية بين الشكل والوظيفة، بين اللون والمعنى... روح العصر يعني. وبهذا المعنى يمكنُ للحداثة أن تكون نسبية أيضًا.
على النُقاد والدارسين أن يضعوا عُقدهم وأحكامهم المُسبقة جانبًا قبل مُقاربة نص
قلتَ في سيّاقٍ سابق: «كل الذين كتبوا عني أسقطوا ذواتهم على نصوصي لا غير». هل يعني هذا أنّ النُقاد كانوا في حالة بحث واِكتشاف لذواتهم في نصوصك وليس في حالة دراسة ونقد النصوص. ومن جهة أخرى، هل يعني هذا أنّ النقد ظلمك كشاعر ولم ينصف شِعرك الّذي كان يحتاج لعمليات مقاربة وقراءة أكثـر من إسقاطات شخصية؟
- القضية تتعلق بالحديث عن ديوان «اِكتشاف العادي» في لقاء صحفي كهذا، حينَ يجد فيه سهيل الخالدي أنّه أقرب إلى النبوة ويرى فيه احميدة العياشي قطيعة، بينما يرى فيه جمال بلعربي الكتابة بالذات فيما يرى أحمد عبد الكريم أنّها كتابة إمتاع ومُؤانسة وفوزي كريم يرى فيه بصمة خاصة تمامًا تنتسب لعمار مرياش وحده، ويُؤرخ نجيب أنزار للشِّعريّة الجزائرية بِمَا قبل «اِكتشاف العادي» وما بعد، بينما يرى فيه آخرون أنّه خسارة للورق الجيد الّذي طُبِعَ عليه. هذا يغمرني بمنتهى السعادة، لأنّه حين نعرف هؤلاء نجد أنّ كلّ واحد منهم يرى فيه جانبًا قويًا من ذاته هو، هذا رائع ولا يمكنني أن أذهب أبعد من هذا هُنا.
أمّا النقد والنُقاد فموضوعٌ آخر. على النُقاد والدارسين أن يضعوا عُقدهم وأحكامهم المُسبقة جانبًا قبل مُقاربة نص، وأن يختاروا مواضيع أبحاثهم ببعض من الجُرأة والإبداع وأن يتميَّزوا ببعض من النزاهة.
في كثير من الدراسات نجد كلّ دواوين الشِّعر التي صدرت في الجزائر ضمن مراجع الباحث. ثم حين نحاول قراءة العمل نجد أنّ الباحث لا يُوظف سوى شاعرين أو ثلاثة، وفي أعمال هؤلاء لا يُشير إلاّ لأردأ ما في كِتاباتهم، ثُم هناك كثير مِمن يتقيؤون عُقدهم على الورق على أنّها شِعر وفي هذا القيء يجد الكثير من النُقاد ضالتهم، الغموض والإبهام في الشِّعر.. عُقدة أوديب. قتل الأب. التشاؤمية والاِنهزامية في شِعر كذا، وكذا..إلخ، هذا كلّ ما يهم النقد؟
هناك أطباء نفسيون لمعالجة المرضى، الشِّعر فنٌ رفيع ويجب أن يكون كذلك، لماذا لا يبحثون في الإبداعيّة، في الشِّعريّة، في الهندسات المُبتكرة المُدهشة، في الموسيقى، في البنية المُتميزة للجُملة لدى (...)، أو في الوظيفة السحريّة لـ(..)؟ هل عقدة أوديب منتوج اِستهلاكي واسع ودورته سريعة؟ يبحثون عن الشاذ والمُختلف –لو كُنا في بلد به تراكم كمي ونوعي كبير-، لِمَا لا؟ لكن في حالتنا، حالة الجزائر، هو عملٌ عقيم غير ذي جدوى، إنّهم كمن يزعم أنّه يبحث عن النعجة السوداء في قطيعٍ أبيض، لكن لا، في حالتنا القطيع كلهُ أسود. ولا يمكن أن نسكن للطمأنينة والمُهادنة وننشد العمل الجاد والثورة والاِبتكار.
الشِّعر هو كتابة فوق-تاريخية- غير خاضعة لسّياقها الزمني
أمازلتَ تُؤمن بِمَا قلته في سنوات التسعينات: «أنا شاعر مهمتي تكمن في فتح نوافذ وفي إيجاد حلول جديدة لا في تصدير مشاكلي الصغيرة للعالم على أنّها قضايا الجميع والمُستقبل»؟ أما زالت مهمتك نفسها أم تغيرت نظرتك أمام تحديات اليومي والمعيش؟
- هذا أكيد، الشُعراء مهدوا طُرق الأنبياء والفلاسفة والمؤرخين، وإنّ ما يبقى هو ما يكتبه الشُعراء كما يقول هولدرلن، ذلك أنّ الشاعر لا يكتب اِنطلاقًا من حسابات سياسيّة أو موازنات اِجتماعيّة، وليست لديه أيّة سلطة سوى سلطة الكلمة، عليه إذن أن يكون مُهندسًا ذكيًا جريئًا شفافًا وحساسًا إلى اللانهاية، أن تكون شاعرًا هو أن تخلق لنفسك وللآخرين حُلمًا أو وهمًا، تسقط نفسك في المستقبل، ثم تخلق سياقًا لحلمك وتهبه رموزك وعلاماتك وتَسحبه إلى المُستقبل، لا أن تُمجد بؤسك واحتياجاتك الصغيرة. أعتقد أنّ الشِّعر هو كتابة فوق-تاريخية، أي غير خاضعة لسّياقها الزمني.
على الشاعر أن يكون عظيمًا في كتاباته الشِّعريّة قبل أن يكون اِستثنائيًا في تعريفه للشِّعر
هل يمكن أن يكون الشاعر عظيمًا في كتاباته وفي ذات الوقت اِستثنائيًا في تعريفه للشِّعر أو في التعبير عن علاقته بالشّعر؟
- على الشاعر أن يكون عظيمًا في كتاباته الشِّعريّة قبل أن يكون اِستثنائيًا في تعريفه للشِّعر أو في التعبير عن علاقته بالشِّعر، الشِّعر مثل الحب بالنسبة للمحبوب والعبادة بالنسبة للمؤمن والورقة البيضاء بالنسبة للكاتب والحرية بالنسبة لأي مواطن عادي. إنّني أقل شاعريّة وأكثر عقلانيّة ووعيًا، أي لغو هذه المفاهيم البائدة، لا علينا، هو علاقة كعلاقة العشق، يمكن أن نعيش فيها كلّ الحالات بكثافة: الألم، اللذة، الندم، الاِحتقار، البخل، العمي، التهور، الاِندفاع، الكراهية، البكاء،،، كلّ الحالات، لكن من حسن حظي أنني تجاوزت مراهقات كثيرة وصرتُ أتصرف بهدوءٍ قاتل أحيانًا.
علاقتي بالشِّعر جيدة، إنّها علاقة عشق، وعلاقتي بالعشق جيدة أيضًا إنّها علاقة شِعريّة، يتغير المعشوق ولا تزداد العلاقة إلاّ تحسنًا، طبعًا لا أتوانى في قمع نفسي وتأديبها باِستمرار، أذكر، عندما كنتُ صغيرًا كتبتُ شيئًا من الشِّعر في هجائي وعلقته في غرفتي لأراه كلّ يوم، المقطع يقول: «فقاعة الهواء كلما يزداد حجمها يحتمل اِنفجارها»، أنا أتعامل مع الشِّعر كما يتعامل الطالب مع معلمه بمنتهى الثقة ولكن بمنتهى الاِستقلالية وحرية الرأي، أي علاقة عضوية، جدلية، أُعَلِمُهُ كيف يرتكب الحماقات ويُعلمني كيف أتدفق حكمةً وبهاءً، أتعلم باِستمرار من كتاباتي ومن تجاربي بشكلٍ عام، من عثرات القلب أُقوم، ولا أتأجل.
أنا لا أكتب بماء الذهب ولا يتنزل عليّ الوحي، أبحث وأجرب وأجتهد لتقديم عمل نوعي لذا أتردّد كثيرًا قبل النشر. طبعًا ليس مربحًا أن تكون أديبًا، أحيانًا حتى وأنت معروف جدًا تُعاني كثيرًا لإيجاد ناشر لكتابك، ثم لا تكون لديك حقوق تأليف. لذا كان واجبًا خلق معادل فني لهذه الحياة البائسة.

أجمع، أول أمس، مشاركون في ملتقى وطني حول «أسس ثقافة الذوق: الفلسفة وعلوم الإنسان في مواجهة عصر التفاهة» بجامعة وهران 2، على أن التفاهة ليست ظاهرة أصيلة بل هي حالة عرضية تصيب الحضارات التي بلغت ذروتها، وهي انحراف المجتمع الحضاري عن أفق الحضارة، كما أنها نوع من التمرد المجتمعي على منتجات الحضارة . وقد أشرفت على تنظيم الملتقى وحدة البحث في علوم الإنسان للدراسات الفلسفية، الاجتماعية والإنسانية، قسم الدراسات الفلسفية التطبيقية، بكلية العلوم الإجتماعية جامعة وهران 2، بمشاركة أساتذة من عدة جامعات.
بن ودان خيرة

البروفيسور مراد قواسمي، رئيس اللجنة العلمية للملتقى
الفلسفة هي نظام قيم و تطعيم ضد كل ما هو مرهق
أوضح البروفيسور مراد قواسمي رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أنه لم يسبق للبشرية أن مرت بمرحلة كالتي تعيشها اليوم، إذ يلاحظ تصاعد معايير الرداءة والانحطاط واستبعاد أصحاب التحديات الحقيقية، ما قيد الحياة في مختلف المستويات وقتل الإبداع وتخلص من أهل الرسائل النبيلة، فصار العالم مجرد سوق للبيع والشراء الشعبويين باسم الحرية، معتبرا أن ما يحدث في تبجيل للتفيه هو الانشغال عن الجوهر بالعرض وتسهيل لانتشار أسباب المرض والانفصام بها في العالم الفرض وعزل لإعماد العقل في الواقع بتوسيع تأثير السفاهة في المواقع.
وقال البروفيسور قواسمي، إن الفلسفة هي نظام من القيم والمواقف التي تعمل على نشر الذوق والتثقيف وسيادة العقل وجملة القيم التي تؤدي إلى التطعيم ضد كل ما هو مرهق، وهي بمثابة تسامي وترفع عن حالة التردي التي صارت منتشرة، كما أنها منظومة أسس الثقافة السلمية ومنهجية التفكير السليمة، التي تواجه منظومة التفاهة المؤذية لكل ثقافة والمؤدية للاندماج في القطيع. وأضاف المتدخل، أنه من بين القيم الأساسية للفلسفة أنها تنمي الوعي النقدي بالدرجة الأولى، فلا يمكن أن نتصور وجود مجتمع دون تفكير نقدي، لأنه سيكون مجرد قطيع و سيؤول للانحطاط الذي هو من حالات التفاهة و هي واحدة من المشكلات التي قام الكثير من الفلاسفة بنقدها، فالمجتمع دون مثقف ودون فيلسوف، هو مجتمع دون نخبة وسيكون مجرد قطيع من السهل توجيهه والجر به إلى حتفه، و هي وضعية مأساوية لابد من ايجاد حلول لها لتجاوزها والتخلص منها.وأشار الأستاذ قواسمي إلى أن، غياب الفلسفة يعني وجود الغباء في أعلى مستوياته وفق الفيلسوف «جيل دلوز»، متسائلا، هل أصبحت التفاهة معيارا للنجاح الواقعي والبراغماتي؟ ما الذي يجعل السفهاء يقودون العالم نحو عالم الظلمات؟ هل صارت التفاهة ضرورية إلى الحد الذي ينعدم معه كل تفكير بالتريث والعقلنة وكبح الجماح عن إطلاق العنان لفساد الذوق؟، وهل أصبح اللجوء إلى مظاهر التفاهة هو نوع من أنواع التعبير عن التحرر والتخلص من قيم بالية ثابتة أكل الدهر عليها وشرب؟. وتابع بالقول، إن هناك من يقومون بتتفيه الفلسفة وتعريتها من قيمتها الحقيقية، لتصبح مجرد كلام فارغ و نظريات لا علاقة لها بالواقع، وأوضح أن اللجنة العلمية انطلقت في تصورها لملتقى «أسس ثقافة الذوق: الفلسفة وعلوم الإنسان في مواجهة عصر التفاهة»، من قناعة عميقة بالحاجة إلى استعادة الذوق لا بوصفه ترفا أو زينة ثقافية، بل كفعل نقدي وموقف معرفي، والذي بات ضرورة حضارية في زمن صارت فيه الرداءة والتفاهة تتسللان إلى الوعي الفردي والجمعي تحت شعارات الحداثة الزائفة والاستهلاك المعمم، وأن جميع المشاركين سعوا إلى فتح فضاء للحوار بين الفلسفة وعلوم الإنسان، من أجل مساءلة أعمق لمواجهة التفاهة بذوق أسسها، ببنياتها، تمثلاتها وأدوارها في مقاومة الرداءة المكرسة ثقافيا وإعلاميا واجتماعيا.

رئيس الملتقى البروفيسورعبد القادر بوعرفة
فلاسفة انخرطوا في نظام التفاهة وأقصوا الأصالة
أكد البروفيسورعبد القادر بوعرفة مدير وحدة البحث في علوم الإنسان للدراسات الفلسفية، الاجتماعية والإنسانية، قسم الدراسات الفلسفية التطبيقية، ورئيس الملتقى، أن نظام التفاهة هو نظام شامل أصاب جميع مفاصل الأمة والمجتمع ولم يسلم منه فرع من الفروع فهو اليوم ظاهرة عامة، ومن بين مشاهد التفاهة في الفلسفة ظهور مجموعة من الفلاسفة الذين انخرطوا في نظام التفاهة فأصبح ما ينتجونه يعبر عن التفاهة في حد ذاتها، كما ظهر نوع من التوالف والتحالف بينهم وأصبحوا يلقبون بعضهم البعض بالفلاسفة، ويسعون لإقصاء ذوي الأصالة والعمق من باب التفلسف.
وتبرز هذه الظاهرة مثلما قال في منشورات عبر فيسبوك وتويتر، أين يتم تبادل الألقاب دون أصالة وعمق وإنتاج، والأدهى أنهم يتهجمون على الفلاسفة الكبار، مشيرا إلى أن التفاهة في الفلسفة موجودة على عدة مستويات فمنها المرتبطة بالنص الذي أصبح تافها جدا يعبر عن اللامعني واللاجدوى واللامغزى، بمعني أنه يعبر عن «لا»، والمتفلسف في حد ذاته أصبح ينشر أي شيء وغاب عنه النقد و الوعي والتحليل والترشيد، مضيفا أن العالم اليوم أصبح يحتكم للإثارة، والمواطن العادي يحاول أن يثير «الإثارة الصاعقة» التي تعتمد على الاستقطاب للحظات فقط وتزول مثلما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وسط من يلقبون بـ «المؤثرين الذين يعتمدون على «عدد الإجابات» لينافسوا بها دون محتوى جدي، بل هي إثارة مبنية على عدم التعجب وعدم وجود نقد وتشارك وتفاعل.
وأردف المتدخل أن المشكل يكمن في المجموعة الفلسفية التي أصبحت مبنية على مبدأ التأثير والتأثر و ليس على مبدأ الحلقات المنتجة للأفكار مثل ما كان سابقا، كحلقة فيينا و لندن وفرانكفورت والتي تركز على الجدل والحوار والإنتاج الفكري وتبادل معلومات و خبرات، في الوقت الذي نجد المجموعات الفلسفية أو المتفلسفة اليوم تكوًن مجموعات مارقة والأساس عندها هو الخروج عن المألوف لحد الابتذال و ليس من أجل النقد، وهي تنتج قيما دخيلة تجعل الإنسان أكثر انحطاطا وأكثر ابتذالا.من جهة أخرى، هناك إنتاج للنص البسيط و المتفلسف في حد ذاته أصبح ينشر أمور التيه وليس الرشاد، وأصبحت الفلسفة كأنها ذلك النص المنتج الذي يقود الإنسان الحائر إلى المتاهات، عوض أن يرسم له معالم الرشاد، وأصبحت الكتب الآن منخرطة في نظام التفاهة و السفاهة والابتذال والسطحية.
أكبر تجل للتفاهة في الإعلام والثقافة الشعبية
وفي محاضرته التي عنوانها «التفاهة : المفهوم والتجليات في المجتمعات المعاصرة»، أوضح البروفيسور بوعرفة أن أكبر تجل للتفاهة يظهر اليوم في الإعلام والثقافة الشعبية، ففي وسائل الإعلام غالبا ما يتم اللجوء لعرض الشعارات والفضائح وكذلك التصريحات البسيطة، أسرار البيوت وأسرار المشاهير وبالتالي يعتقد الناس أن الخبر يكمن في هذه الأخبار فيتحول إلى إعلام تافه، مثله مثل الثقافة الشعبية التي تحولت إلى ثقافة بهرجية يغلب عليها الانفلات العقلي والموضوعي، مشيرا إلى مقولة الفيلسوف نيتشه «أن التفاهة وحدها التي تجني أرباحا كثيرة هذه الأيام»، داعيا في حال تناول التفاهة كموضوع للتحليل، لتفادي الوقوع في التفاهة ذاتها، مستدلا بمقولة الفيلسوف «آلان دونو» الذي قال أن زمن الحق والقيم تغير لأن التافهون أمسكوا بكل شيء وحسموا المعركة لصالحهم هذه الأيام، وأنه عند غياب القيم والمبادئ الراقية يطفو الفساد المبرمج ذوقا وأخلاقا وقيما. وأشار المتدخل إلى أن «ألبرتو إيكو» ربط بين الثقافة الإعلامية والانحطاط الديمقراطي، بمعنى أن هناك انحدار للديمقراطية الأصيلة وتواجد نظام موازي هو التفاهة، ما أدى لانحطاط السياسة والإدارة، وحدث نوع من الاستبدال الذي سينتج نظاما جديدا يؤدي لأشياء غير مرضية، مضيفا أن التفاهة وصلت للحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية، لتصبح الرداءة معيارا للواقعية، فالتفاهة أصبحت مظهرا من مظاهر الحضارة الجديدة وهذا مما يعد من تجليات الحضارة الآيلة للسقوط، مستدلا بقول ابن خلدون أن الابتذال والسفاهة تصاحب المرحلة الأخيرة للحضارة والأجيال لغاية السقوط.

الدكتور سريرأحمد بن موسى
الثورة التكنلوجية ساهمت في تكريس الظاهرة
من جهته عرف الدكتور سريرأحمد بن موسى من جامعة عين تموشنت، خلال مداخلته الموسومة «الحداثة والتفاهة»، الإنسان التافه بأنه هو من يميل إلى الجمهور العام والى روح القطيع، ويفضل راحة التخفي والابتعاد عن كل ما يتطلب جهدا، ويقع أسيرا للسهولة والرتابة والروتين، وسلوكه المفضل في جميع الحالات هو الإمتثالية، فهو إنسان المحاكاة والتقليد في اللباس وفي مختلف الأشكال التعبيرية مثل الأذواق والهوايات وينتقل إلى الأصالة وغير قادر على الابتعاد عن الوسط.
وأضاف في مداخلته، أن ثورة التكنولوجيا والمعلومات التي يعرفها العالم اليوم ضمن إطار ما يسمى بالعولمة، تكرس الانعكاسات السلبية للحداثة من خلال محاولة توحيد الأذواق والأفكار والسلوكات في نموذج واحد هو النموذج المعولم، وهو نموذج غربي وثقافة غربية، مما يعني أن هناك عالما للتفاهة وهو عالم اجتماعي ذهني وروحي خاص بأكبر عدد من الجماهير أو القطيع.
أما الحداثة فهي ليست مجرد مفهوم سوسيولوجي، أو سياسي أو تاريخي، ولكن نمط حضاري يتعارض مع النمط التقليدي أي مع الثقافات السابقة له، وبالتالي فهي لحظة تعبر، كما قال، عن انتقال من مرحلة قديمة إلى مرحلة جديدة، وهي كظاهرة حضارية لها جملة من الخصائص من بينها الاستقلال الذاتي، التحكم التقني في العالم، العقلنة وغيرها،
لكن الحداثة من جهة أخرى تستدعي، كما أردف، الحركة والتطور وأن يكون المرء ديناميكيا، حيث تشجع الإبداع والاختراع وتحسن شروط الحياة، وما ينبغي الإشارة إليه إلى أنها تحمل طابعا سلبيا أيضا أو ما يسمى بانحراف الحداثة، وتتجلى عندما يصبح الفرد خاضعا لمنطق حداثي مرتبط بالبحث عما هو راهني وجديد ويصبح همه هو الجديد، بمعنى أن الإنسان يتعلق بالحاضر ويحاول أن يفتخر بأنه يواكب هذا الحاضر، وهذا انحراف عن المسار الصحيح وعن تحقيق القيم التي جاءت من أجلها الحداثة .
معرجا على أن المعنى المنحرف والسلبي للحداثة، جعل الإنسان الحداثي تافها، يعيش حالة من الاغتراب تعيق تطوره وتحرره، فالحداثة الأصيلة ليست مجرد موضة ومواكبة سطحية للحاضر، بل هي تحسين كيفي وكمي لشروط الحياة الإنسانية، وتساءل المتدخل متى يزول الوسط؟ مجيبا أن الوسط يزول عندما يغيب الشخص الممتثل، وأنه بدافع غريزة الحفاظ على البقاء، يلجأ الوسط لتذكير أعضائه الذين يميلون للابتعاد عن الخط العام المشترك.
وأشار المتحدث إلى أن مواجهة هذه التحديات، تستدعي وعيا جماعيا وجهدا لإعادة تأهيل التميز والأصالة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية، و هذا الذي سيمكن من الاستفادة الكاملة من وجود الحداثة دون الذوبان في التفاهة.

أسقطت الحروب الجارية الأقنعة وكشفت عن وجه «متوحش» للحضارة الغربيّة المعتدة بنفسها والمتمركزة على «ذاتها» بشكل باتولوجي، جعلها لا تكتفي بالترويج لقيمها، بل تسعى لفرضها على بقية شعوب العالم، باعتبارها وصفةً للعيش السعيد في عصرنا. لكنّها لا تتردّد في الدوس على كل تلك القيّم حين تُنادي المصالح، بل وحين تتحرك النزوات الدينية التي يزعم الغرب العلماني أنه تخلّص منها.وإذا كانت النخب السياسية تختفي وراء أجندات المصالح، في تبرير حروب إبادة، فإن سقوط الفلاسفة والمفكرين في أطروحات عنصريّة، تبرّر العدوان ولا ترفع أصبع الإدانة أمام قتلة الأطفال، يحيل إلى تهافت منظرين يدعون الإنسانيّة والعالمية، وإلى سقوط السردية الغربية التي تُقدّم الغرب كخلاصة للحضارات التي راكمتها الإنسانية في تطورها وكمنتج لقيم الحرية والإنسانية والديمقراطية. ويكفي كمثال على ذلك سقوط هابرماس في مستنقع الصهيونية وهو الذي ظل يُقدّم لعقود كأبرز فلاسفة العصر.
أعدت الملف: نور الهدى طابي
الليبرالية الجديدة ... المال بدل القيم
ويتوقع خبراء و محللون سياسيون وإعلاميون اليوم، بأن تورط أمريكا والغرب عموما في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وقبلها العدوان والإبادة في غزة، سيكون فخا أخلاقيا لن تخرج منه الأنظمة الاستعمارية التقليدية سالمة هذه المرة، خصوصا وأنها فقدت نسبيا السيطرة على الرواية الإعلامية وبالتالي مصداقيتها، ومنه قدرتها على التحكم في الحشد وتوجيه الرأي العالم في الداخل والخارج، مع تزايد تأثير الميديا الجديدة غير الخاضعة للقيود، وانفلات المعلومة من أيدي المؤسسات الإعلامية الكبرى وانهيار السردية الصهيونية واستهلاك تهمة معاداة السامية.
عمقت الحرب بين إيران والكيان الصهيوني المعتدي، تأثير الصدمة الأخلاقية التي تعرضت لها شعوب العالم منذ معركة طوفان الأقصى، أين أزيح الستار عن ازدواجية المعايير وغياب الإنسانية لدرجة مباركة الإبادة العرقية والتصريح بمشروعية التهجير القسري. وجاء الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية تاليا لينهي أسطورة الغرب المتحضر ويورطه أكثر، كاشفا عن مستنقع دموي تتخبط فيه حكومات أسقطت أقنعتها وتبنت خطابا أحاديا عنصريا خاضعا للفكر الليبرالي الجديد الذي يكفر بالقيم و يدين بالمصالح و يقود العالم اليوم.
80 عقدا من الكذب و التضليل الإعلامي
تقدم الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط حسب متابعين، صورة عن نهاية مرحلة أو نظام عالمي، وبداية آخر سيكون أكثر وحشية في ظل انهيار المنظومة الأخلاقية الدولية، و التعدي الصارخ لإسرائيل المدعومة من أمريكا وحكومات الغرب، على كل المواثيق و القرارات الدولية، وتجاوز سلطة كل الهيئات والمنظمات بما في ذلك مجلس الأمن.
ويقول خبراء، إن إسرائيل التي تهلوس بما تسميه «لعنة العقد الثامن»، تخوض حربا وجودية تدعمها أمريكا عسكريا ولوجستيا، وتتجند لصالحها أوروبا كذراع سياسية، من منطلق المصالح، ولكن أيضا لأجل خلفيات عقائدية واضحة، وهو ما لا يتوانى منتخبون في مجلس الشيوخ الأميركي عن التصريح به للإعلام.وقد صنعت مقابلة تلفزيونية للسيناتور تيد كروز، مع المذيع الشهير تاكر كالسون، الحدث في أمريكا والعالم قبل أيام، أين ظهر عضو مجلس الشيوخ جاهلا بكل ما له علاقة بإيران وشعبها ومدافعا شرسا بالمقابل عن إسرائيل، لأنه كما عبر « قرأ في المدرسة أنه واجب عقائدي».
ومعلوم أن هناك شريحة كبيرة من الأمريكيين تدعم إسرائيل لأسباب دينية، وتحديدا من المسيحيين الإنجيليين. يعتقد هؤلاء المسيحيون أن دعم إسرائيل واجب ديني بسبب تفسيراتهم للكتاب المقدس، والتي تربط قيام دولة إسرائيل بحدوث أحداث آخر الزمان. وهناك حركة داخل المسيحية الإنجيلية تعرف باسم «الصهيونية المسيحية». وحسب أتباعها فإن دعم إسرائيل وإعادتها إلى أرضها الموعودة هو تحقيق لنبوءات الكتاب المقدس. يفسر هذا التوجه، مباركة الغرب لعلميات الإبادة، و التجويع، و التهجير القسري ،الممارسة في غزة منذ حوالي سنتين، والتي أودت بحياة 77ألفا و 109 آلاف شهيد، أي ما يعادل 5 بالمائة من سكان القطاع، غالبيتهم نساء وأطفال يقدمون كقرابين، وكيف يحاول الإعلام تقديم الدفاع عن النفس كحجة للإبادة وتبرير للاستخدام التعسفي للفيتو لمنع وقف إطلاق النار وكذلك التعدي عسكريا على دولة ذات سيادة، و التوغل استخباراتيا لتنفيذ عمليات اغتيال علماء و سياسيين داخل منازلهم، ومن ثم قصف المباني وقتل الأبرياء.
ويكشف الاعتداء الأخير على إيران، و التراجع الصارخ في دور الدبلوماسية الدولية لصالح القوة العسكرية، والتصريح الفاضح بالتفوق العرقي، النزعة الاستعمارية المتجذرة لدى الأنظمة التقليدية التي حاولت لعقود وتحديدا منذ بداية التسعينيات، تمرير أجنداتها ومصالحها عن طريق الكذب والدعاية، واستغلال شعارات رنانة من قبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، وقد استطاعت بالفعل أن تخدع شعوب العالم وتقدم ذرائع لغزو العراق وأفغانستان، مستعينة بالذراع الإعلامي لتكريس هذه الرواية وتخذير الضمير الإنساني.
ورطة أخلاقية وتآكل للسردية الصهيونية
عند سؤاله عن « هل تمثل إيران تهديدا لإسرائيل وما مدى خطورته؟ أجاب المؤرخ الإسرائيلي أفي شلايم» بأن التهديد الحقيقي يأتي من إسرائيل نفسها، نظرا لامتلاكها أسلحة نووية وعدم التزامها بالمعاهدات الدولية».جاء التصريح في مقابلة ضمن برنامج لقناة الجزيرة الإنجليزية، وقد قال الباحث :» لم تهاجم إيران جار لها قط، أما إسرائيل فقد شنت هجمات متكررة على جيرانها، إيران وقعت على معادة حظر انتشار الأسلحة النووية، أما إسرائيل فرفضت التوقيع عليها، المنشآت النووية الإيرانية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين ترفض إسرائيل الخضوع لأي تفتيش دولي، إيران لا تملك أسلحة نووية، أما إسرائيل فتملك ما بين 75و 400رأس نووي، وعليه فإن إسرائيل هي التي تشكل تهديدا وجوديا لإيران».
ويواصل قائلا:» على مدى أربعين عاما الماضية، شنت إسرائيل حملة منهجية من التضليل بشأن إيران، لماذا كل هذا الكذب؟ لماذا ازدواجية المعايير ؟ لماذا هذا النفاق؟ويرى متابعون ، بأن ما يحدث اليوم بين إيران والغرب سيعيد ضبط موازين القوى وتشكيل الخارطة السياسية في الشرق الأوسط والعالم عموما، لأن الحرب الدائرة تحمل بين طياتها رسائل مباشرة إلى كل الشعوب و الأمم الأخرى.
ويؤكدون من جهة ثانية، أن الأحداث منذ أكتوبر مثلت حقنة ضد تطبيع الوعي، وأنتجت استفاقة إنسانية تعكسها التحركات ضد الصهيونية وداعميها في المجتمعات الغربية، على غرار حراك الطلبة في الجامعات الأمريكية، والمسيرات الحاشدة في مختلف عواصم العالم، حيث لعبت مواقع التواصل دورا هاما في كشف الحقيقة ومواجهة الدعاية. تتعالى اليوم أصوات من الداخل الأمريكي والأوروبي ضد بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، وفي مقابلة مع قناة الجزيرة صرح أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة كينغز كوليدج أندرياس كريغ: « أن نتنياهو فقد الدعم حتى في الأوساط التقليدية المؤيدة لإسرائيل، ليس فقط اليهودية، بل أيضاً في الدوائر المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية أخرى.
وكتطور طبيعي لهذا التآكل في الدعم، أشار كريغ إلى أن الرأي العام تغير بشكل كبير ضد إسرائيل في أوروبا والولايات المتحدة، حتى في صفوف الشباب اليهود الذين بات ينظرون إلى نتنياهو كشخص «مارق» حتى داخل مجتمعهم».
وعلى المنصات التفاعلية وتحديدا تيك توك، يقود ناشطون حملات كبيرة ضد الممارسات اللا أخلاقية الغربية في منطقة الشرق الأوسط، ويناهض أميركيون دعم بلادهم لخيار الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، حتى إن هناك من عبروا بشكل واضح عن دعمهم لحق طهران في الدفاع عن نفسها.
الدكتور عمار سيغة باحث في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية
المنظومة الغربية استولت على القرارات الدولية

يعتبر الدكتور عمار سيغة، باحث في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية ما تعيشه المنظومة الدولية في الآونة الأخيرة، وخاصة منطقة الشرق الأوسط بعد اندلاع المواجهة بين إيران و النظام الصهيوني، انعكاسا لمخاض عسير تعيشه المنظومة الدولية.
وقد جاء هذا التحول حسبه، على وقع ترتيبات فجرتها العديد من الأزمات والقضايا ذات البعد الدولي لاسيما جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي تخندقت من خلالها المنظومة الغربية إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا، وذلك في ظل إعادة تشكل خارطة نفوذ دولي جديد لاعتبارات تتعلق بالمصالح الجيوستراتيجية لتلك القوى، سواء القوى الدولية التقليدية أو تلك الصاعدة.
ولعل ضمن مستويات أخرى تتعلق بمستويات الصراع انفجرت الحرب بين إيران و الكيان الصهيوني، لضغوط إقليمية يعيشها الكيان بعد حربه على غزة، ومرور سنتين دون تحقيق أي نتائج على أرض الواقع غير التدمير والأزمات الإنسانية.
وحسب سيغة فقد كشفت الحرب في القطاع المحتل الكثير، وأماطت اللثام عن الكثير من الضبابية على المشهد الحقيقي، وتجذر عقيدة ونزعة الهيمنة والسيطرة، وعدم تقبل وجود قوى تعديلية في الفضاء الدولي مثل الصين وروسيا، ليتحول الشرق الأوسط إلى حلبة صراع متجددة خاصة وأن تلك المنطقة قد عاشت العديد من الأزمات نهاية الثمانينيات بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية، وصولا إلى حرب الخليج الأولى والثانية، ثم غزو العراق و حتى أفغانستان.
تقدم المعطيات كما أضاف، صورة واضحة عن أن المنطقة تعتبرا مجالا لإظهار وفرض الهيمنة والسيطرة، وإعطاء دروس لكل الدول التي تسول لها نفسها الوقوف في وجه المنظومة الغربية التي استولت اليوم على القرارات الدولية، والمؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن الذي أصبح أداة لمنح الشرعية للحروب، و التدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما كانت طبيعتها وأهدافها.
ويعبر الوضع الدولي الراهن، عن تغيرات في الخارطة السياسية العالمية بعد أن هيمنت الأحادية القطبية التي تمتعت بها الولايات المتحدة الأميركية بعد نهاية الحرب الباردة، والتي أكدتها أمريكا وحاولت ترسيخها من خلال التدخلات العسكرية في بداية الألفية الثالثة مع غزو الدول، وإبراق رسائل للمجتمع الدولي أنها هي المهيمن وهي شرطي العالم.
إسرائيل هي الراعي الرسمي للمصالح الغربية في المنطقة
والبارز أيضا كما قال الباحث، أن ما يحدث يأتي في ظل إعادة بلورة المعطيات السياسية في منطقة الشرق الأوسط منذ 2001، وما تترتب عنه من ثورات الربيع العربي، بغية إحداث نوع من التوازن في المنتظم المطبع مع الكيان الصهيوني.
علما أن هذا الكيان سيظل القاعدة العسكرية المتقدمة للمنظومة الغربية وفي مقدمتها أمريكا، كما أن إسرائيل هي الراعي الرسمي للمصالح الغربية في المنطقة وهي التي يوازن من خلالها منطق النفوذ والسيطرة على مجال الطاقة في الشرق الأوسط والذي يعتبر رئة العالم الاقتصادية سواء من ناحية الموارد أو الموقع الاستراتيجي.
نشهد في هذه الحرب كذلك حسب الخبير الأمني، تجنيد كل الوسائل والموارد العسكرية اللوجيستية، الاستخبارتية المعلوماتية، والسيبرانية الإلكترونية وأيضا الإعلامية، وذلك لأن الواجهة الإعلامية تحديدا تعتبر أحد أهم مرتكزات تأثير القوى الغربية، و السردية الصهيونية، و المنطق الغربي على المنتظم العالمي عموما، وهو عمل ظلت تشتغل عليه هذه الدول لعقود خدمة لنفوذها وتكريسا لهيمنتها.
مواقع التواصل قلبت الموازين بفضل تجردها من الذاتي و البراغماتية
وعلى الرغم من مناورات الغرب ومحاولة اللعب على الرأي العالم الدولي من خلال تسخير الآلة الإعلامية الغربية، يقول الباحث إن مواقع التواصل قلبت الموازين بفضل تجردها من الذاتي و البراغماتية، وقدرتها على نقل الصورة الحقيقية عن الأحداث التي تعرفها المنظومة الدولية بدءا من الصراع في أوكرانيا، وصولا إلى حرب الغرب ضد غزة، و المواجهة العسكرية مع إيران.
ويرى الباحث، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل تحديا حقيقيا أمام استمرار وفعالية الرواية الغربية، وذلك في ظل طبيعتها الهلامية و المرونة والعجز عن السيطرة عليها وتوجيهها، فقد أضحت المنصات التفاعلية بديلا حقيقيا لنقل الصورة كاملة الأركان، وفضح كل الممارسات اللا أخلاقية التي تورطت فيها المنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استطاع بفضلها اللوبي الصهيوني أن يمرر أجنداته بدعم من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية.
وذكر الخبير معطى آخر، قال إنه مهم جدا ويتعلق برفض المنتظم الغربي رسم خارطة توازن دولية في ظل صعود قوى تقليدية مثل الصين وروسيا، وكذلك قوى أخرى غير تقليدية على غرار إيران التي لم يستوعب الغرب تفوقها، والتحدي الذي رفعته للدفاع عن حقوقها في امتلاك التقنيات النووية رغم الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تحديدا تهديدا مباشرا لها ولوجودها ضمن خارطة الشرق الأوسط.والواقع حسبه، أن مناورات الكيان لن تتوقف عن إقحام أمريكا والمنظومة الغربية عموما في الصراع في الشرق الأوسط ما يهدد بتفجير المنطقة وتوسيع رقعة الحرب لتفسح المجال لدخول قوى أخرى تقليدية، مع مخاوف من التحاق روسيا والصين بالصراع لأجل حماية المصالح الاقتصادية.
والواضح، أن الصين وروسيا لن تقفا مكتوفة الأيدي، خصوصا في ظل امتلاكهما لورقة «الفيتو» التي قد تشهر قريبا، مع إعلان أمريكا التدخل عسكريا ضد إيران. وقالت الباحث، غالبية الفرضيات قابلة للمراجعة خصوصا وأن إدارة ترامب تواجه هاجس أن تكون إيران مستنقعا عسكريا متجددا يشبه فيتنام و العراق وأفغانستان، خصوصا مع تهاوي السردية الأمريكية حول نشر الديمقراطية و العدالة وحقوق الإنسان والمساواة.
الدكتور علي محمد ربيج محلل سياسي و نائب برلماني
الحرب صارت معادلة لتحقيق السلام من منطلق القوة الغربي

يتحدث الباحث في العلوم السياسية والنائب بالبرلمان الجزائري، الدكتور علي ربيج، عن نظام دولي جديد هو في طور التشكل وربما قد بدأت معالمه تظهر من خلال الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية مع أوكرانيا، ثم الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
وتعبر هذه المعطيات كما يقول، عن وجه من أوجه استمرار صراع واستمرار منطق القوه في العلاقات الدولية، فاليوم «صار أفضل استعداد للسلام هو أن تكون مستعدا للحرب»، وهي قاعدة تطبق الآن على أرض الواقع كما قال.
مع ذلك، فإن الحديث عن نظام دولي جديد بملامح جديدة، ورؤى ومقاربات جديدة، وبوسائل الإدارة الجديدة، هو أمر مستبعد لعدة أسباب أولها مواصلة سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على المشهد الدولي، حتى في ظل المنافسة القوية من قبل روسيا والصين.
وقال ربيج، إن التجاذب بين القوى لا يفسح المجال لإبعاد أو إضعاف الموقف الأمريكي والدور الأمريكي بشكل كبير، بالعكس الكل الآن يراهن على دور إدارة ترامب في وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبين إيران وإسرائيل، بالنظر إلى الموقف الكبير الذي لعبه هذا الرئيس في تعليق الصراع بين الهند وباكستان.
ويعلق الباحث بهذا الخصوص:» أنا لست من رواد المدرسة التي تقول بأن أمريكا آيلة إلى الزوال في العقدين أو الثلاثة عقود القادمة، نعم ستكون منافسه قوية من قبل الدول التي ذكرتها، ولكن سيبقى استمرار سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على المشهد السياسي والاقتصادي والعسكري، لأنها تملك محددات وعناصر القوه التي تسمح لها بأن تكون على المسرح الدولي».
ويرى الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي، يمكن القول بحدوث تحول كبير واستراتيجي مهم جدا، خصوصا فيما يتعلق بالسردية الإسرائيلية التي روجت لعدة عقود بأن الكيان يملك من الترسانة العسكرية والمنظومة الدفاعية ما يسمح له بأن يدخل في حروب مع الدول العربية ويخرج منتصرا.
السردية الصهيونية انهارت أمام منظومة الصواريخ الباليستية
ويبدو حسبه، أن هذه المقاربة أو المعادلة قد أطيح بها بعد طوفان الأقصى وصمود المقاومة الفلسطينية، ومن ثم الحرب الدائرة حاليا بين إيران وإسرائيل، والاختراقات الكبيرة التي قام بها الجيش الإيراني من خلال منظومة الصواريخ الباليستية التي أفشلت الدفاع الجوي الصهيوني أو ما يسمى بالقبة الحديدية الإسرائيلية من خلال سقوط عدد كبير من الصواريخ في كل من تل أبيب الكبرى، وحيفا، والمناطق التي كنا نعتقد بأنها منيعة عن النيران.
هذه التحولات الكبيرة في قواعد الاشتباك بين إيران وإسرائيل، وبين المقاومة وإسرائيل كشفت عن وهن هذه الدولة التي يمكن أن تهزم في أي لحظة لولا الغطاء والدعم الأمريكي، ومجموعة الترويكا الألمانية البريطانية الفرنسية، فهذه الدول هي التي تدعم بقاء واستمرار الجيش والحكومة والدولة الإسرائيلية، إلى جانب انخراط بعض الدول العربية.
على صعيد آخر، يعقب الدكتور علي ربيج، أن القول بتقهقر الرواية الغربية والسردية الغربية التي ترافع من أجل الديمقراطية، ونشر حقوق الإنسان، وحرية التعبير والدور الكبير لوسائل الإعلام الغربية في التكريس لها ممكن، بفعل تكشف هذه الروايات، ففي كل مره تقع هذه الدول في حالة حرج كبير بسبب الدوس على النظام الدولي، وعلى القوانين الدولية، والاختباء وراء حق الفيتو لإسقاط الكثير من مشاريع القوانين التي تنادي بها دول مثل الجزائر، لوقف إطلاق النار في غزة، وبين إيران وإسرائيل.
الرواية الأخلاقية الغربية أمام نهاية محتملة
ويضيف، بأن هذه السردية أصبحت تعاني من الهشاشة خاصة في ظل تبلور رأي عام على مستوى الدول الغربية كشف زيف الرواية، والسؤال الذي يطرح الآن، هو إلى أي مدى يمكن للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية حماية الدعاية المغلوطة والاستمرار في الكذب؟ وهل يمكن أن تتشكل دوائر نخبوية مثقفة مستقلة داخل هذه الدول، وحتى داخل دول الجنوب لمواجهة هذه الروايات؟
وكإجابة عن السؤال، يرى الباحث، أنه على مستوى القارة الإفريقية على الأقل بدأت النخب تخرج وتفكر بشكل علني وبشكل واضح، أنه يجب التحرر من سيطرة الغرب بداية بالتواجد الفرنسي في منطقه إفريقيا.
من جهة ثانية، يشير الدكتور علي محمد ربيج المحلل السياسي و النائب البرلماني، إلى تحد آخر يتعلق بسطوة رجال المال وسيطرة المؤسسات والشركات الكبرى متعددة الجنسيات على إدارة الشأن العام الدولي خصوصا مع عودة الرئيس ترامب، وبعث هذه الفكر «المركنتي» في الحلقات الدولية والذي يبحث دائما عن تحقيق المصلحة ورفع رؤوس الأموال على حساب الشعوب والسلام والأمن والاستقرار في العالم، فالتوجهات الامبريالية الرأسمالية حسبها، لا يهمها سوى الربح بدليل تصريح للرئيس ترامب حول أن ما يهمه هو المقابل المادي المالي للحماية الأمريكية لدول الخليج ولدول أوروبا بمعنى أن العالم يتعامل اليوم مع رجل يحكم العلاقات الدولية بمنطق الربح.
وأشار الباحث إلى أن هذا المسار أو هذا الطرح أصبح سائدا اليوم خاصة بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، واستعداده للدخول في حرب اقتصادية عالمية مع دول كبرى مصنعة تملك 80 % من ناتج الدخل العالمي.
موضحا، أن مستقبل العلاقات الدولية في الخمس والعشر سنوات القادمة على الأقل سيأخذ منحنى أكثر عنفا وأكثر صداما، بمعنى أن البقاء سيكون وكما كان دائما للأقوى على مستوى الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري.
ويمكن القول على حد تعبيره، إن العلاقات الدولية ستحكمها حروب وجودية للدول التي لن تستطيع حماية أمنها واستقرارها، وقوتها ستكون محل مساومة وضغوطات من قبل الغرب والدليل على ذلك فكرة التطبيع مع الدول العربية التي كانت فكرة للسيطرة ومساومة وتحقيق التنازلات على المستوى السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.
يمكن في المقابل حسب الباحث في العلوم السياسية، أن نقدم النموذج الجزائري والنموذج الجنوب إفريقي والنيجيري، وبعض دول أمريكا اللاتينية التي ترفض الاستمرار تحت سيطرة العواصم الغربية، وتحاول أن تبني لنفسها تحالفات إقليمية وعالمية لمواجهة الضغوطات والمساومات والإكراهات الأمريكية والغربية عموما.
الدكتور محمد هدير أستاذ جامعي ومحلل سياسي
الخطاب العالمي بات أحاديا وعنصريا خاضعا لسلطة المال و المصالح

يقول الباحث بالمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور محمد هدير، إننا نعيش مرحلة سقوط الأقنعة وهو أمر تنبأ به مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق طوني لانك سنة 1954، حيث قال إن الشعارات التي تصدرها أمريكا تحت مسمى الديمقراطية وحماية الأقليات، حرية التعليم، حرية التعبير والحرية المطلقة، سيكون له انعكاس سلبي مستقبلا، معلقا «سننكشف يوما ما أمام العالم بأننا نصدر قيما مزيفة، وإذا انكشفت هذه الأمور سنقع في ورطة وسيكون هناك هجوم على كل مصالحنا في العالم».
والواضح حاليا حسب الباحث، أن توقعات لانك، قد تحققت فعليا خاصة في ظل انهيار سلم القسم الأخلاقية في الحروب الأخيرة، وكذلك انهيار القانون الدولي الذي صار فيه الجلاد هو الضحية وصاحب الحق، بمعنى أننا أمام سقوط شبه كلي للمنظومة الدولية والمجتمع الدولي الذي أسس في بداية التسعينيات، مكونا من جمعيات ومنظمات حقوقية وغيرها، والدليل ما نراه في غزة من مجازر وإبادة يدير لها العالم ظهره.
وقال هدير، إن الخطاب الحالي بات أحاديا وعنصريا قاتلا، خاضعا لسلطة المال و المصالح التي تقود العالم، خاصة وأن مستوى الاستهلاك العالمي زاد مع التخوف من ظهور أوبئة جديدة ستعزل العالم أكثر من كوفيد19، ولذلك فإن العالم يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام التطورات القادمة والمرتبطة بالبحث على مصادر التموين بالغذاء والطاقة.
ولابد أن ندرك كما أضاف، أن عملية طوفان الأقصى كانت بمثابة نقطة تحول رئيسية في الأحداث في الشرق الأوسط، لأنها استهدفت بشكل غير مباشر المصالح الأميركية هناك، بمعنى أنها أوجعت أمريكا قبل أن توجع إسرائيل، لأنها صممت في غرف جد متطورة من حيث إدارة المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ الهجوم، و ضرب القوة القاتلة داخل الكيان.
كما كشفت أيضا عن منظومة السلاح الإسرائيلي و القضاء على سمعته التي بنتها الدعاية وقدمته كقوة مطلقة، كما أدركت أمريكا أن إيران كانت وراء إمدادات الطوفان، بالتالي فإن الإمبراطورية أصبحت تطوق المنطقة.
وعليه، فإن الولايات المتحدة تخوض حسبه، حربا بالنيابة في المنطقة وتضع إسرائيل في الواجهة، علما أن هذا الكيان نفسه بات يشكل خطرا على أمريكا لأن اللوبي الصهيوني يسيطر على السياسات الداخلية والخارجية في بلاد العم سام.
وأشار الباحث أن علاقة إيران وأمريكا كانت قوية خلال مرحلة الشاه، والواضح أن الطرف الأول يركز فقط على تغيير النظام في طهران وليس ضرب البنى التحتية، من خلال تنفيذه لأجندة « الفوضى الخلاقة» في المنطقة عموما.
مع ذلك، لا يمكن كما أضاف، قراءة الواقع السياسي بشكل واضح، لأن إسرائيل تقود حربا وجودية وتدرك أن إعادة هندسة الشرق الأوسط لها تداعيات خطيرة على أمنها واستمرارها، فإما أن تنجو وتتحول إلى الفاعل الأول في رسم السياسة بين النهرين وكل المنطقة، أو قد تكون هذه الحرب هي شهادة وفاتها.
حرب إعلامية أخرى أفرزتها هجمات أكتوبر و بعدها المعركة الدائرة بين إيران وإسرائيل اليوم حسب المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإعلامية، فالواضح كما قال أن السردية الإسرائيلية القائمة على احتواء صناعة الإعلام، وامتلاك القوة عن طريق السيطرة على المعلومة، قد تقهقرت منذ طوفان الأقصى، لأن القنوات الكبرى على غرار» سي أن أن»، فقدت سيطرتها على المعلومة.
و يمكن القول في رأيه، إن المعلومة انفلتت منها لصالح مواقع التواصل الاجتماعي و مؤسسات أخرى مثل «الجزيرة» التي كشفت قوة الضربات الإيرانية التي بلغت العمق الإسرائيلي، وهو ما قضى على أسطورة إسرائيل المنيعة التي لا تقهر.
تقدم هذه المعطيات مجتمعة حسب هدير، لمحة عن زوال نقطة الخوف لدى كل العام والدول المجاورة، ما قد يمهد لهبة شعبية أردنية مصرية وحتى مغاربية على إسرائيل، وهو تحديدا ما يخشاه الكيان، لأنه يعيش اليوم في فم الأسد ويدرك أنه إذا خسر الحرب فسيفقد حماية أمريكا، التي تورطت جدا مع اللوبي الصهيوني في الداخل.