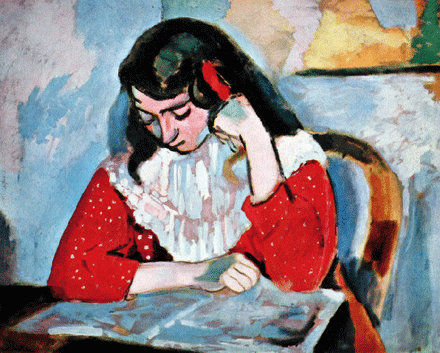
الذي يدمن القراءة ويعتادها، يجد، ولاريب، لذة في حمل الكتب وفي ملامسة الورق و شم رائحة المداد، فإذا نازعته تصاريف الدهر وشغلته تباريح الحياة عن إتيانها والإقبال عليها، جاهد وكابر حتى يسرق له صفحة أو صفحتين ينتشي بهما عقله ويتغذى على قطوفهما فكره، قبل أن يعاود الابتعاد عن لذائذ الكتب ليكابد أيامه وشواغلها، وكلما طال به زمن الفراق والبعد عن القراءة، كلما وجد ثقلا في نفسه وحسرة شديدة على كل لحظة مضت بلا قراءة ولا سياحة في عقول الحكماء والعلماء، والعقلاء والفقهاء، والمثقفين والأدباء، ويستبد به الشوق إلى موائدهم العامرة، فلا يستريح ولا يستكين حتى يأتيها ويتلذذ بما فيها، هاربا من زحمة الحياة والعمل والمسؤوليات. زواغي عبدالعالي
زواغي عبدالعالي
الشغف بالقراءة هو ما يطيل أعمارنا
إنك لو سألت كل من هذه هي حاله، عن جدوى هذا الهوس وجوهر هذه اللذة، لقال لك إنها لذة لو أدركها الكسالى والجهلة لنازعوني عليها بحد السيف.
لطالما قلت أن من أوتي حظا في أن يبقى مشدودا في عمله إلى الكتب والكتابة، كأنما حيز له شطر من السعادة، وأدرك من النعيم ما لا يدركه غير أمثاله، فالشغف بالقراءة هو ما يطيل أعمارنا الفكرية ويجعلنا يافعين على الدوام وإن هرمنا، فإذا استشعرت قلة الاهتمام بالكتب وخَفَّتْ لديك حمى التنقيب في مناجم الفكر والمعرفة الدفينة بين دفات الكتب، فأدرك نفسك وتحسس عقلك لربما أصابته الشيخوخة، فإن العقل إذا شاخ أتبعته شيخوخة الجسد.
إن القراءة حياة، فقد سئل صاحب العبقريات، الراحل عباس محمود العقاد: لماذا نراك تقرأ كثيرا، فقال: لأن حياة واحدة لا تكفيني.
والكثير من صناع التاريخ عُرف عنهم ولعهم الشديد بالقراءة، ففي شبابه كان "نابوليون بونابارت" مهووسا بقراءة الكتب، حتى أنه كان يقصد مكتبة كبيرة في باريس بانتظام، وكان آخر كتاب قرأه هو السجل الخاص بفهرست المكتبة، والمفاجأة أنه وجد العديد من الكتب غير مقيدة في السجل فما كان عليه سوى إضافتها بقلم الرصاص، أما الخليفة العباسي المأمون، فقد عرف عنه شغفه بالعلم والعلماء وكان يقبل على القراءة بشكل كبير، ولم يثنه عن ذلك لا شؤون الخلافة ولا البذخ الذي كان فيه، حتى أنه قال عن نفسه: "إني أحب التنزه في عقول الرجال"، ويقصد قراءة الكتب.
وبالنسبة لـ" شهيد الكتب" الجاحظ، فقد قتلته الكتب التي سقطت عليه، لكثرة عددها بالمكتبة التي كان يقضي معظم وقته فيها، وكلنا نعرف وزن هذا الرجل في حقل الأدب وكثرة تصنيفاته ومؤلفاته، التي لازالت إلى اليوم تلقى رواجا من طرف القراء ومتذوقي الأدب العربي الرفيع.
ولا عجب في من يهيم بقراءة كتاب، فبعض الكتاب يكتبون بأسلوب فخم جميل، يجرف الذهن إلى دوحة من البلاغة والجزل، ثم لا يلبث أن يشرب من ينابيع اللغة المتدفقة حتى يطرب و يسكر، فلا يملك بعدها، والحال هكذا، سوى أن يهيم وراء الحروف والمعاني والأفكار التي تحفل بها النصوص، وينتقل إلى عوالم جديدة قَصُر فكره عن العيش فيها، فيحلق حرا في سمائها مرتقيا في عليائها، ويجوب تلالها وسهولها ليشرب ويستزيد، حتى يطفح بالفعل والحركة والحرية التي حرم منها.
هؤلاء الكتاب، فعلا يمنحون حيوات جديدة لغيرهم، ويرشدونهم إلى ملاذات آمنة تحفظ الذوق من الفساد والوعي من النضوب.
لقد قلبت صفحات التاريخ، فما وجدت أحدا من العظماء والمشاهير، الذين تركوا بصماتهم في مختلف الميادين، ولا زالت أسماؤهم تلوكها الألسن إلى اليوم، فما وجدت أحدا منهم اعتلى صهوة المجد إلا عن طريق الغوص في بطون الكتب واكتساب المعارف بجد دون كسل، وقد سُئِل "أرسطو": كيف تعرف ثقافة الشخص؟ فاجأب: أسأله (كم كتابا قرأ وأي كتاب قرأ).
الرواية الرائجة ضدّ العقل؟
لكن هل توجد علاقة بين نوعية الكتب التي تروج وتقرأ داخل مجتمع وبين الرقي الحضاري ؟ هل إشاعة وتشجيع الكتاب الأدبي(الرواية العاطفية والتي لا تحمل بذرة فكرية) مقصود و ممنهج؟
في البداية يجب أن لا يظن بي الروائيون الظنون، فما سأكتبه هو عرض حال ومساءلة للواقع، فقد وجدت نفسي أطرح هذه الأسئلة، بعد أن تحسست طوفان الانتاجات الروائية التي غزت الساحة الثقافية في الجزائر والدول العربية بشكل مفرط وبدعم من الحكومات، على حساب الكتاب الفكري والعلمي، فصارت الروايات تهطل علينا كالغيث المنهمر، وتكاثر الروائيون حد التخمة، دون أن ننتقص طبعا من جهودهم، ودون أي حساسية نبديها اتجاه الأدب وأهميته في حياتنا.
الحقيقة المرة تقول أن هناك عزوفا كبيرا من طرف القارئ الجزائري والعربي على الكتب الفكرية والفلسفية، التي تحتاج لإعمال العقل وتحريك آلة الوعي والإدراك، وبذل جهد لفهم القضايا الإشكالية المطروحة من طرف كتابها.
وهذا العزوف، بالرجوع إلى التاريخ، هو نفسه الذي أدى إلى تراجع التقدم العلمي والفكري للحضارة الإسلامية، خصوصا في العصرين الأيوبي والسلجوقي، حيث شاع التأليف في سير الملوك والنوادر والقصص، وانصرف رهط كبير من الكتاب إلى حشو كتبهم بالأكاذيب لتمجيد حاكم أو سلطان طمعا في ما يصرف لهم من أموال نظير المدح والتمجيد، في حين تراجعت حركة الترجمة وقل الإقبال على كتب الفلسفة والحكمة الإغريقية التي كانت سببا في تطور الفكر والحضارة الإسلامية، رغم أن الفلسفة للمثقف، مهما كان اختصاصه الأكاديمي، بمثابة الفاكهة على مائدة المعارف والعلوم، إذا حُرم حظه منها فقد حُرم خيرا كثيرا، وبدونها يظل هذا المثقف جائعا طوال عمره الفكري و المعرفي، لا يحس بلذة الشبع أبدا.
التهمة.. فيلسوف
الذين لا تستفزهم الأسئلة حول الحياة وصيرورتها، والأحداث ومآلاتها، والحقائق و كنهها، محكوم عليهم بالعيش في العمى الفكري والروحي، مربوطين بقيود الأفكار المسبقة داخل دوائر وعي ضيقة، لا تسمح لهم بالتطلع لما وراء إدراكهم المحدود، فكم هي الأحداث المفصلية التي تتداعى من حولنا بتسارع مثير، لكننا نغفل عن التساؤل عن خلفياتها وأبعادها وحقيقتها، و نعجز عن ربطها بسياقها وجذورها وارتباطاتها بمعتقداتنا الأصيلة، ما يسمح بتوسيع نفوذ وسيطرة أولئك الذين يستوعبون أكثر منا، ويسألون أكثر.
لعل جزءا غير ضئيل من المسؤولية عن المآلات التي وصلت إليها مجتمعاتنا، يرجع إلى عزوفها عن تحصيل العلوم والمعارف، وبصورة خاصة تخليها عن الفلسفة كعلم يروم الحكمة و يتوسل العقلانية، وإمكانية تعلمها وممارستها في حياتنا اليومية كفن للعيش، فلطالما كان التطور الفكري والحضاري من مخرجات التفلسف وشيوع التفكير المنطقي القائم على قواعد عقلانية بحتة، بدءا من موطن الفلسفة في اليونان القديمة التي أنجبت أعظم الفلاسفة في تاريخ البشرية، إلى الحضارة الإسلامية التي عرفت في عصورها الذهبية ازدهارا للفلسفة وبروز فلاسفة نجحوا في إخراج العقل العربي والإسلامي عموما من قوقعة التقليد والتخلف الفكري، وصاروا مرجعا فيما بعد لفلاسفة الغرب الذين شقوا ظلام أوروبا للسماح ببروز عصر الأنوار، وصولا إلى العصر الحديث الذي تعملقت فيه الفلسفة نظريا بشكل كبير.
الحق أن نخبنا عموما والمشتغلين بالفلسفة على وجه التحديد، جميعهم لم يوفقوا في تبسيط الفلسفة وربطها بحياة الناس اليومية، فلازالت النظرة إليها في الأوساط الشعبية قاصرة، فإما أنها تقود إلى الكفر البواح أو هي ضرب من ضروبه، وإما أنها، في أحسن أحوالها، ترف علمي تمارسه النخبة المثقفة، بينما هي في الأصل ترتبط ارتباطا وثيقا بأخلاقنا وتفكيرنا وممارساتنا اليومية الأخرى، فهي باعتبارها حب الحكمة، لها القدرة على تأطير سلوك الإنسان بالخير أو الشر، ومعرفة الفرق بينهما، فتعلمنا كيف نقوم بسلوك خيّر ونتجنب سلوكا شريرا، فمن يمارس العنف مثلا مهما كان شكله، لو كان متمكنا من نواميس الفلسفة-المبسطة- وقواعد المنطق لما مارس عنفه، وهكذا.
طبعا الفلسفة تعاني على المستوى العالمي، وإن كنا نحن الأكثر تضررا، بسبب تلكؤ أصحابها في نشرها و فشلهم في تفعيل دورها، وإيجاد مخرج لمأزق الإنسان الغارق في المادية والفاقد لجوهره كإنسان "أخلاقي"، خصوصا بعد أن وصل العلم إلى آفاق بعيدة جدا، وإلا لما كانت الفلسفة – كما يقول الفلاسفة، تبتدئ عندما ينتهي العلم، أي عندما يفقد الإنسان القدرة على طرح الأسئلة والبحث عن إجابات، فهذا في اعتقادي هو العصر المناسب لعودة الفلسفة وبقوة لتحل مشاكل الإنسان الأخلاقية.
الفلسفة في مجتمعاتنا محصورة بين جدران الجامعات وكليات الفلسفة، ودور أصحابها في إشاعة التفكير النقدي في المجتمع محتشم، ولو من خلال تبسيط مفاهيم ونظريات الفلاسفة في الأخلاق والعمل والمعرفة، حتى تكون لصيقة بسلوكياتهم ويومياتهم (فقه الواقع)، عكس ما يلاحظ في الغرب، حيث نجد أن الكثير من الفلاسفة طلقوا أسوار الجامعات وخرجوا لينشروا الفلسفة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الجرائد وبرامج الميديا بمختلف أنواعها، فهذا يكتب مقالا يوميا في جريدة عن مباراة في كرة القدم مثلا، ويعطي تحليلا مغلفا بنظرية فلسفية، وذاك يؤسس موقعا إلكترونيا للغرض نفسه، وآخر يظهر بشكل متكرر على شاشات التلفزيون يحلل ويشرح ويشعل عقول المشاهدين بعشرات الأسئلة وعلامات الإستفهام والتحاليل المنطقية.
ما أحوجنا فعلا أن نسترد ملكة التفكير الفلسفي ولذة التفلسف التي رافقت ازدهار حضارتنا في عصور مضت وبهت وهجها، بعد أن أدت إلى بلورة مجتمعات عقلانية منتجة للأفكار فاضت إنتاجاتها على غيرنا من الأمم، حتى أن العالم الفيزيائي بيير كوري، اعترته دهشة كبيرة من ثقل التركة العلمية التي خلفها المسلمون في الأندلس، رغم ما اعتراهم من بطش ومذابح عقب محاكم التفتيش، التي أحرقت حتى مكتباتهم وكتبهم، فقال قوله المؤثر جدا: " لدينا ثلاثون كتابا بقيت من الأندلس المسلمة وهذا مكننا من تقسيم الذرة ، ماذا لو بقي النصف مليون كتاب التي أحرقناها من تلك الحضارة! لو لم نحرقها لكنا الآن نسافر بين مجرات الفضاء"، فأن تحرق إنسانا أو كتابا، الأمر سيان، لأن الكتاب ليس مجرد أوراق جافة ومداد ميت، فهو في الأصل يضم بين دفتيه روح إنسان وعصارة فكره، إنه حياة أبدية لكاتبه لا تبليها العصور، كما أن إحياء نفس أو إحياء كتاب، سيان أيضا، فمن يحيي كتابا مفيدا هو بمثابة إحياء مئات أو ملايين العقول الجامدة التي تقرأه.
و الحق أننا نقتل فلاسفتنا ومفكرينا وكتابنا في عالمنا العربي مرتين، نقتلهم أحياء وأمواتا، فأما قتلهم أحياء فبالتهميش والتهجير وترتيبهم في أدنى الهرم الاجتماعي، برهنهم إلى أراذل القوم ليتحكموا في رقابهم وأرزاقهم، وأما قتلهم أمواتا فبالصمت الإعلامي والتغييب المقصود عن الفضاء العام، و بتجاهل معاناتهم في بلدانهم أو في المهجر، فكم من فيلسوف أو مفكر لم تحظ حادثة اغتياله أو مرضه بخمس التغطية التي تحيط بنزلة برد تتعرض لها مغنية مشهورة أو ضحكة راقصة ممشوقة القوام، أو كسر في كاحل لاعب كرة يصنع الفرجة.
مسؤولية الإعلام
إن الإنتاج الفكري والأدبي الركيك، قد يتحول بقدرة الإعلام، إلى إبداع قل نظيره، يتهافت عليه القراء بشراهة بفضل التركيز والحملات الترويجية التي تطرق العقول والعواطف، والهدف صناعة نجوم وقدوات وتقديمها للجمهور على أنها شخصيات كبيرة ومثقفة ومتعلمة ومتنورة، ليتبعها الناس ويقتفون آثارها وأقوالها ومواقفها، ويسهل بذلك جرها نحو الغايات التي يريدونها، والتاريخ يزخر بالكثير من الأدباء والمثقفين الذين ذاع صيتهم بفضل الإعلام قبل أن يتضح أنهم لم ينتجوا لا أدبا ولا فكرا، وإنما أنتجوا عفنا لا يليق بذي لب أن يقرأه أو يقتفي أثر كاتبه، بل أكثر من ذلك بكثير، فقد اتضح أن بعض هؤلاء ما هم في الحقيقة سوى صناعة مخابراتية داخلية أو خارجية.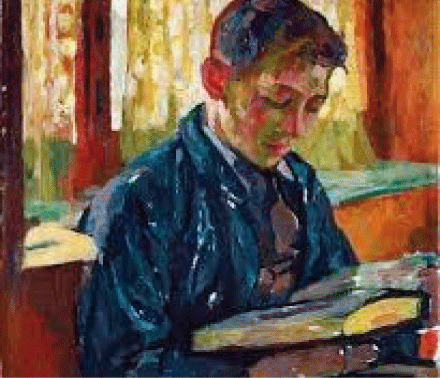
فالإعلام سلاح العصر، القوة الناعمة الصموتة التي تتداعى أمامها الدول وتنهار تحت وطأة محتواها العقول والأفهام، وتنقاد لها العواطف وتستسلم بلا مقاومة، والخَلَاص من رِبقتِها لا يكون إلا بامتلاك ثقافة نقدية لا تُسلم بظواهر الأشياء على أنها حقائق مطلقة ويقينية، وعقول تناقش وتحلل، ذات مشارب معرفية وفكرية متعددة، خصوصا أن الإعلام العربي بشكل عام بلطجي، يفرض على جماهيره واقعا ملوثا، لاشتمال مضامينه ومحتوياته ورسائله الإعلامية على الكثير من التجاوزات غير الأخلاقية، حيث يمارس هذا الإعلام تأثيرا سلبيا واعتداء ممنهجا على منظومة الأخلاق العربية الإسلامية، ويساهم بشكل محسوس في تسطيح اهتمامات الإنسان العربي وإعاقة نموه الثقافي والإجتماعي والسياسي، إضافة إلى تغييبه عن واقعه.
قديما قالوا :"ما أهلك العرب غير الطرب"، يتعزز هذا القول في زمن السماوات المفتوحة والواقع الافتراضي الذي نعيش في فلكه اليوم، فلو جئنا لعد القنوات الغنائية والبرامج الطربية التي تبث العفن لا الفن، وما يُنفق على حفلات القينات والغلمان وأهل الغناء، وأحصينا الجمهور وعدد المتابعين لهذا الزخم المفرط، لوجدناه يفوق بأضعاف مضاعفة ما يُخصص للمعرفة والثقافة والدين والفلسفة، ولوجدنا جمهور المحاضرات العلمية وحلقات النقاش الفكري، والمنتديات الثقافية، والقنوات التعليمية، لا يعدو أن يكون مجرد نقطة في بحر، مقارنة مع مايعرفه مجال الغناء.
ومن نتائج هذه الغَلَبَة، تتفيه عقل الإنسان العربي وتحجيم دوره، وفك لجام غرائزه لتقوده بلا ضوابط، وانحسار دور المعرفة والوعي في حياته، ولا أخال أحدا يجهل كيف صارت الأجيال الجديدة أسيرة الهوى والتقليد الأعمى لفنانات وفنانين تخرجوا من بيوت الخلاعة، تقليد أورثهم شخصية مهزوزة تفتقد للثقة في النفس والرزانة في مواجهة عقبات الحياة، مع الاستغراق في اجترار الأوهام وابتلاعها، والانصراف عن تحصيل المعارف و العمل والإنتاج والتعلم.
إننا اليوم أمة احترفت تسمية الأسماء بغير مسمياتها، أمة تخنق المصطحات حد التضييق على معانيها، حتى جرى على الألسن تسمية راقصات المواخير بالفنانات، وكل من يطلق لحيته نسميه شيخا ونحيطه بهالة من القداسة وإن كان جاهلا بأمور الدين، ومن يتمسك بدينه نسميه أصوليا متطرفا، ومن يسرق البنوك ويؤسس شركات نسميه رجل أعمال، ومن يبيع الأوهام ويحترف الكذب على الناس نسميه سياسيا بارعا يسوق الناس إلى الجنة الموعودة، ومن يكتب خربشات و هلوسات مقززة أو يظهر بربطة عنق على الشاشات،فهو مثقف أو إعلامي لا يشق له غبار، لذلك، فإن الخروج من العتمة إلى النور يتطلب فهما دقيقا للمصطلحات والمسميات، وإنزال الناس منازلهم، بل وأن نفهم أولا ما هو معنى العتمة وماهو معنى النور.
إن الكثير من البلدان، ومنها بلداننا، تمتلك ذخيرة حربية كثيرة، لكنها للأسف تفتقد للذخيرة الفكرية والإعلامية "النوعية"، التي بدونها تتهاوى العروش والصروح والدول والأنظمة بكبسة زر، وليست بالسلاح فحسب.
اليوم، نحن بحاجة لذخيرة فكرية وإعلامية حقيقية، تقتل الأفكار البالية والقديمة غير المنتجة، التي جعلت منا مجتمعات مريضة ومنهكة يسهل قتلها بالصور والكلمات والرموز، مجتمعات مرتهنة إلى العنف الديني والسياسي والاقتصادي الذي تمارسه الأنظمة الشمولية وتُسلِّطه على رقاب الخلق باسم جماعات رمزية، زيادة على الأطر الإعلامية التي تقيد الإنسان ضمن رؤية أحادية مقصودة للواقع والحقائق تحت شعار " ما أريكم إلا ما أرى"، صارت اليوم بمثابة غابة من الفزاعات التي تخيف طائر الفكر وتمنعه من التحليق بحرية في سماوات الإبداع.
لسنا بحاجة للبكاء على مجد وحضارة صنعها الأجداد في غابر الأزمنة، يوم كانوا أصحاب فهم عميق للحياة وقوانينها ومتطلباتها، بقدر ما نحن بحاجة إلى إعادة تكوين نسق تفكيرنا وآليات عملنا ونظرتنا للواقع، فالأمة التي لا تأكل مما تزرع، ولا تلبس مما تنسج، الأمة التي تستورد البنائين والخياطين والإستشاريين، ليست أمة الريادة، الأمة التي لا تعلي من شأن العلم والعمل ليست أمة قادرة على صناعة حضارة، الأمة التي لا ترفع سوى الشعارات كعنوان لإنجازاتها، وتقبل على ما ينجزه الآخرون، أمة لا تستحق النهوض حتى يأتي جيل يعاكس النمط التقليدي البائس الذي جبل عليه الجيل الحالي، وأي ثورة تروم تغيير الأوضاع، لا يكتب لها النجاح إذا لم تواكبها وترافقها، على نفس الدرجة من الراديكالية، ثورة فكرية تؤطر المجتمع في وقت متزامن، بل إن الثورة الفكرية المتشبعة بأفكار مستحدثة وجديدة،وغير منفصلة، في نفس الوقت، عن التراث الفكري "المُنقَّى"، واجبة ومقدمة على أي ثورة سواها.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.













 في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...
في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...