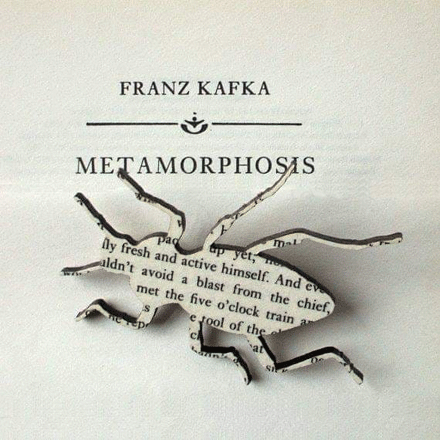
كثيرا ما يبدو الشرخ عميقا جدّا بين ما يقتضيه العمل الواقعيّ من لصوقٍ بمنجزات السائد واليوميّ، والعاديّ، وما يقتضيه النزوع العجائبيّ من تشكيكٍ في هذه المنجزات، ومن اقتحام لها، وسعي دائب نحو اختراقها وتجازوها؛ فبعكس الرواية الرومانسيّة المعتمدة – كأيّ فرع من فروع الفنّ الرومانسيّ – على سلطة الخيال، وشطحات الذات، وميولها الإلحافيّة نحو التحرّر من جميع القوانين، والمواضعات، فإنّ الرواية الواقعيّة والفنَّ الواقعيّ بشكل عام، إنما تستقي أهمّيتها من مدى اتصالها بالواقع، أي بالمألوف، وبمدى تعبيرها عنه، واستيعابها لمختلف إشكالاته، ولا نعني بضرورة التعبير عن تلك الالتباسات اليوميّة أن يصبح العمل انعكاسا للخارج، أو مرآةً بليدة، لا تزيد مهمّة الكاتب فيها على نقل ما يراه، وما يسمعه، دون أيّة محاولة أو جهد صادق للارتفاع بأدواته من مستوى الببغائيّة، والنقل الحرفيّ إلى مستوى التحليل والإضافة، أو التحديق في الإشكالات القائمة، وإضافة إشكالات جديدة عليها، غايتها فهمُ جميع الأسئلة المحدقة بوجودنا، والسعي نحو تلمّس طريق الخلاص من قسوة تداعياتها، وأثقالها.
بهاء بن نوار
وهنا يتضخّم السؤال عن أبرز أدوات الكاتب الواقعيّ في التصدِّي لهذه المهمّات: هل هي في التشبّث، وفي معانقة جميع سياقات الواقع، والوفاء النمطيّ لجميع إجراءاته؟ أم أنّ هذا التصدّي لن ينجح إلا بابتكار أدواتٍ جديدة أشدَّ مضاءً، وبسلوك طرق بكر، غير مطروقة، سمتها الأولى أنها التباسيّةٌ، وغامضة، ومتمنّعةٌ على محاولات الحصر والتكهّن، وهنا يمثل أمام أذهاننا الحلّ السحريّ، الذي يعلي من طاقات الحلم والخيال، ويشحذها سلاحا يخترق تبلّد العاديّ، ويتحدّى جفافه، بل يمكننا القول دون مبالغة إنّ حاجة الكاتب الواقعيّ لجرعات الخارق والعجيب تفوق بكثير حاجة الرومانسيّ، وتفيض عليها، ذلك أنّ حالة التوحّد التام بين الواقع والفنّ، والتماثل المطلق بين مضامينهما وموضوعاتهما باتت من ضرورات أيّة مغامرة إبداعيّة تروم تحديث تشكلاتها الفنيّة، واقتحام مجالات تلقٍّ جديدة، تتطلب أدوات قرائيّة جريئة، مختلفة عن الأدوات الثابتة القديمة.
وتتفاوت تجربة الكاتب الواقعيّ – وأعني تحديدا الكتّاب المندرجين ضمن اتجاه الواقعيّة النقديّة أو النقديّة الأم المتزامنة تاريخيّا وحضاريّا مع تبلور الاتجاه الرومانسيّ– من حيث ارتكازه على اعتماد الإجراء اللاواقعيّ، أو محافظته على التشكيلات القديمة؛ ففي الوقت الذي تلجأ فيه «إيميلي برونتي» (E. Bronty) (ت1848) المعروفة بتأثرها بعوالم ألف ليلة وليلة إلى توظيفٍ ضئيلٍ لهذا العنصر في روايتها الوحيدة «مرتفعات وذرينغ» (Wuthering Heights) من خلال ما ورد في بداية العمل من إشارةٍ إلى ظهور طيف الشخصيّة المحوريّة «كاترين لينتون» المتوفاة منذ عشرين عاما، والذي يقلق راحة أحد ضيوف حبيبها السابق «هيثكليف»، ويأتي ذريعةً تروي من خلالها مدبّرة المنزل قصّة كاترين وغرامها اليائس بربيب أبيها هيثكليف، وما حدث من زواجها بشابٍ آخر، وموتها ساعة إنجابها طفلةً – حملت الاسم نفسه: كاترين – وما إلى ذلك من أحداث واقعيّة، تنصبّ بؤرة النقد فيها على محيط التفاوت الطبقيّ، وما تنطوي عليه قلوب كثير من البشر من قسوة، وحقد، لا يلتهم لهيبه الآخر فحسب، بل يمتدّ إلى الذات نفسها، أي أنّ أحداث هذا العمل لم تكن لتروى، ولم تكن لتستعاد لولا ذلك الطارئ السحريّ، الذي فتح ثغرة في أنسجة الأحداث، لم تلتئم إلا بموت هيثكليف، الذي لم يلبث أن تحوّل إلى طيفٍ ثانٍ، يرافق طيفَ الحبيبة كاترين، ويثيران معا رعبَ العابرين، وتوجّساتهم.
ويبدو الخارق في هذه الرواية عنصرا طارئا غير مقصود لذاته، وإن كان ذا تأثير مفصليّ في سيرورة الأحداث وتطوّراتها.
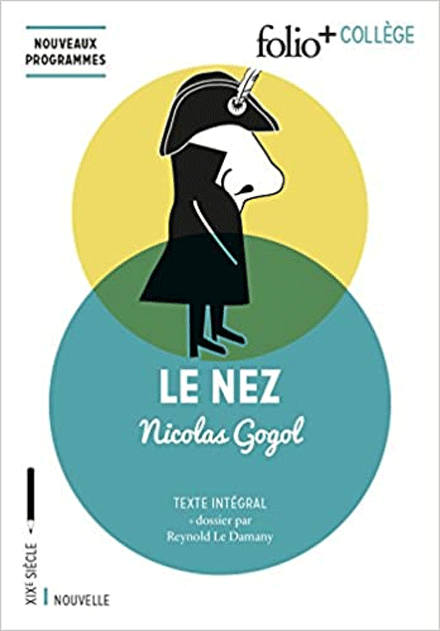
ويبدو هذا النزوع الذرائعيّ لدى الكاتب الروسيّ «نيكولاي غوغول» (N. Gogol) (ت1852) في نهاية قصّته الشهيرة «المعطف»، التي بلغ من إعجاب دستويفسكي (Döstoevsky) بها أن قال بأنّ «جميع الروايات الروسية إنما خرجت من معطف غوغول»، والتي يتضخّم فيها اتجاهٌ نقديّ لاذعٌ يصبّه هذا الأخير على المتنفذين في بلده، ويجعل من بطله «أكاكي أكاكيفيتش» قربانا رمزيّا، يلتهمه البرد والصقيع بعد سرقة معطفه الوحيد، وتنكر رجال السلطة له، وعدم إقدامهم على ملاحقة المذنب، ويتحوّل في نهاية القصة إلى طيفٍ يهاجم العابرين، ويسلبهم معاطفهم، مكرّسا بهذا مبدأً أخلاقيّا – يكاد يكون رومانسيّا – أساسه حتميّة انتصار الخير، وبلوغ الحكاية غايتها الوعظيّة، ومغزاها الإصلاحيّ.
وهو ما يمكن أن نلاحظه ولكن بشكل مغاير على قصة أخرى له، عنوانها «الأنف»، تبدأ أحداثها بفجوة لامعقولة، هي حادثة عثور الحلاق «إيفان ياكوفليفيتش» على أنفٍ بشريّ في قطعة خبز حار، اتضح فيما بعد أنه يعود إلى مساعد مستشار ذي مركز اجتماعيّ مرموق، هو الماجور «كوفاليوف»، وتزداد جرعة العجب واللامعقول حين يُصادف هذا الأخير أنفه مرتديا سترةً رسميّة محيكة بالذهب، بياقة كبيرة منتصبة، يتجول في أماكن عديدة، متقمّصا دورَ سيّدٍ رفيع المستوى، ولا يجد الماجور من تفسير لهذا الحدَث الغريب والمأساويّ في وقت واحد سوى تفسير سحريّ، هو أنّ واحدةً من زوجات الضباط اللواتي يعرفهن، والتي رفض الزواج من ابنتها، هي مَنْ دبّر له مكيدة تشويهه وإخفاء أنفه بنيّة الانتقام، وتنتهي هذه الأحداث والتخمينات اللامعقولة نهايةً لامعقولة أيضا، هي عودة الأنف إلى مكانه الطبيعي بين خدَّيْ صاحبه، ليثير باختفائه وعودته كثيرا من التأويلات حول المغزى العميق لاختيار الكاتب ذي التوجّه الواقعي المعروف مثل هذه الفكرة الفانتازيّة، ونسجه أحداث قصّته كلها حولها، مع ملاحظة ما امتلأت به من جرعات سخرية مريرة، أتت لتؤجّج السؤال حول جدوى اختيار الأنف دون بقيّة أعضاء الجسم ليؤدي ذلك الدور الخارق، وينفصل – ولو مؤقتا – عن جسد وكيان صاحبه، مكوّنا لنفسه كيانا خاصا، ومجسّدا حضورا انفصاميّا، مستقلا، ولعلنا لا نجانب الصوابَ إن ربطنا بين الأنف عضوا حيويّا وجماليّا بارزا وبين ما يرتبط به من معانٍ أخلاقيّة وحضاريّة يرتبط أغلبها بمعاني العزة، والكرامة، و»الأنفة»، والكبرياء، وما إلى ذلك ممّا يعلي قيمة الذات، ويصعّد طاقاتها، فضلا عن تموقعه وسط مساحة جسدية على قدر خالص من الأهمية، هي الوجه، الذي يُعدّ موطن هوية الفرد وتميّزه، فكأنما افتقاد كوفاليوف لأنفه إنما هو افتقادٌ لجميع هذه المعاني، والقيم السامية، بل لعلّه افتقادٌ لإنسانيّته نفسها، التي لم يهدرها تعسّفُ الآخرين وقسوتهم كما هو الحال مع بطل المعطف، بل أهدرتها طباعه السيّئة، وعاداته القبيحة، القائمة على الخسّة، والسطحيّة، والتعجرف.
ولنا أن نتساءل: هل بعودة ذاك الأنف تغيّر هذا الماجور؟ وتعلم من أخطائه السابقة؟ فتكون الإجابة: كلا لم يتغيّر، بل بقي كما هو تافها، متغطرسا، مغرورا.
وهنا يمكننا القول بأنّ العنصر السحريّ في هذه القصّة إنما أتى لإضفاء قيمة رمزيّة ذات سمة أخلاقيّة، بها ومن خلالها يتأكد المغزى التأويليّ العميق للحكاية، الذي تخفى وراء أقنعة التشويه، والامتساخ الجسديّ ليعكس حالةً أقسى من التشوّه الروحيّ والانفعاليّ، وهو المغزى الذي نلمسه لدى الكاتب التشيكي الشهير: «فرانز كافكا» (F. Kafka) (ت1924) في عمله الشهير «المسخ» – أو التحوّل حسب بعض الترجمات* – الذي يرصد كذلك امتساخا جسديّا هو امتدادٌ لامتساخ روحيّ أشدّ هولا وفداحةً، يبدو معه عنصر المباغتة متسيِّدا سيرورة الأحداث، التي تبدأ بتحوّل مرعب، وغير معقول يطرأ على البطل "غريغور سامسا" (Gregor Samsa) الذي يجد نفسه ذات صباح وقد تحوّل إلى حشرة ضخمة، فجأة، ودون أيّة مقدمات، يطرأ هذا التحوّل أو المسخ الرهيب، ويرافقنا غريغور طيلة فصول الرواية وهو حشرةٌ لا تلقى من بقيّة أفراد الأسرة – عدا أخته – سوى التهميش والاحتقار، ولا تنتهي سلسلة الأحداث اللامعقولة إلا بنهاية معقولة واحدة، هي موت غريغور/ الحشرة/ المرفوض من الجميع حتى من والديْه.
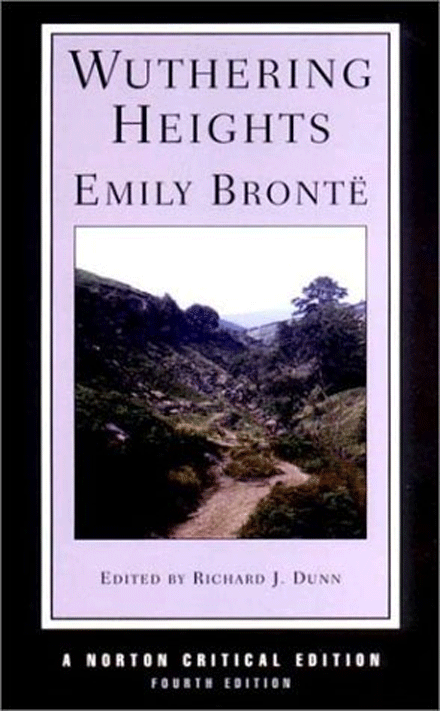
وتبدو هذه الرواية في هيكلها الظاهريّ قريبة الشبه من قصة غوغول الآنفة الذكر، من حيث عنصر المباغتة، واللامعقول، وامتساخ جزء مهمّ من الجسد، أو امتساخ الجسد كله، غير أنّ الهوة واسعةٌ جدّا بين العمليْن، والبعد السحريّ في عمل كافكا يبدو أشدّ فداحةً، وقسوة، وغموضا، ويتجلّى إلغازه الأكبر من خلال خنوع هذا البطل الكافكاويّ، ومعاملة جميع مَن يعرفونه له كحشرة، أي أنّ حالة التهميش والاحتقار لم تكن طارئة على غريغور بمجرد تحوّله، بل كانت ملازمة له منذ البداية: فهو حشرةٌ قبل التحوّل، وحشرةٌ بعده، حتى أنّ أسرته حين تكتشف في النهاية وجود الحشرة الهائلة في غرفته لا يساورها أدنى شكّ بأنّ الوحش قد قضى على غريغور، بل تدرك على الفور أنّ تلك الحشرة هي غريغور" والأفظع من هذا أنّ غريغور نفسه لا يهتزّ لهذا الحادث المريع الذي يعتريه، ولا يني يتساءل بقلق – وهو في تلك الحال – عمّا إذا كان بمقدوره اللحاق بقطار الخامسة صباحا، وعمّا إذا كان تحوّله ذاك مسوّغا كافيا لتأخره عن العمل! وهو ما يصوغ مأساويّته، ولامعقوليّته النابعة أساسا من تكريس الكاتب أغلب إبداعاته – حسب ما يراه جارودي – لنبش موضوع الاغتراب، وشقاء الإنسان، وعذاباته الوجوديّة الأزليّة.
وعليه يمكن القول بأنّ موضوعة المسخ في هذا العمل إنما أتت لأداء وظيفة إيحائيّة، ترتبط أوشج الترابط بهاجس الوعي بالذات، ولامعقوليّة الوجود، اللذيْن يلاحقان هذا البطل الكافكاويّ، وينسجان مأساة حياته العبثيّة، التي لم ينهها سوى موته، الذي به وحده تحلّ اللاجدوى، وتنتفي الحاجة إلى مناطحة الواقع، ومحاولة تفكيك منجزاته، أو التعالي عليها.
* مِن بين مَن اعتمد مصطلح "التحوّل" الأستاذان: حليم طوسون مترجم كتاب واقعية بلا ضفاف لجارودي، والأستاذ صبّار سعدون السعدون مترجم كتاب أدب الفنتازيا لأبتر. وأفضِّل استخدام مصطلح "المسخ" لأنه الأكثر انسجاما مع مضمون العمل.













 في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...
في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...