
يلاحظ المتأمّل أسفارَ العهد القديم، وحكاياته احتشادَه بأنواعٍ كثيرةٍ من القصص المأساويّة، ذات البناء الدراميّ المحكم، والمشبع غالبا بأنفاسٍ عاليةٍ من العنف، والتمزّق، والخطيئة، والانتقام، الذي ينشطر في شقٍّ كبيرٍ منه طرفا الحكاية، بين العنصر المركزيّ، اليهوديّ، المضطهَد والمظلوم، والعنصر الأجنبيّ، العدوانيّ، والمعتدي، الذي يُنتقَم منه، ويلقى جزاءه على يد الربّ الغاضب نفسه، أو على يد أحد مخلوقاته، التي تضرب بيده، وتنطق بصوته، والممثلة غالبا في ذات المرأة – اليهوديّة – التي تضطلع بأداء دور القاتل، والمنتقِم، في حين يتخذ الرجل – المنتمي إلى قوميّةٍ أخرى معاديةٍ لليهود؛ كالبابليّة، والآشوريّة، والكنعانيّة، والفلسطينيّة وغيرها – وضعَ الضحيّة المغلوبة على أمرها، والمسفوك دمها، أو في الأقلّ المخدوعة، والمغرَّر بها.
* بهاء بن نوار
ومن أمثلة هذا ما ورد في «سفر القضاة» من حديثٍ عن مقتل «سِيسَرا» الكنعانيّ على يد «ياعيل» التي غافلته بعد أن نام، ودقّت في صدغه وتدَ خيمةٍ، وحديثٍ آخر عن قصّة «شمشون» الشهير، الذي غدرت به الفلسطينيّة «دليلة»، وجرّدته من شعرته السحريّة؛ مصدر قوّته العجيبة، و»أستير» التي تتمكّن بفضل فتنتها وجمالها من ترويض زوجها الملك الفارسيّ «أَحشْويِروُش»، وجعله يتراجع عن قرار إفناء جميع اليهود.
في حين لا نكاد نجد في العهد الجديد من هذا النوع الدامي من القصص سوى إلماحٍ عابرٍ إلى قصة «سالومي» ابنة هيروديا مع يوحنا المعمدان، لتجسّد بدورها فداحة انتقام المرأة، وقسوة أحقادها، ومرارة مكرها، ودهائها.
وقد اخترتُ من العهد القديم ما جاء عن تعرّض اليهود لحصار جيش نبوخذنصر في «بيت فلوى»، الذي قطع عنهم الماءَ ومصادرَه مدّة أربعة وثلاثين يوما. عانوا خلالها كثيرا، وكاد اليأسُ أن يستولي على نفوسهم، لولا أن تدخّلت الأرملة التقيّة يهوديت/ جوديث التي تتأثّر كثيرا لمصيبة قومها، وتدبّر خطةً للإيقاع بخصمهم، فتتزيّن، وتغادر مع وصيفتها المدينةَ قاصدةً معسكرَ العدوِّ، حيث تتاح لها فرصة لقاء قائد الجيش؛ أليفانا/ هولوفيرن، الذي يسحره جمالُها، ويضمر في نفسه الاختلاءَ بها والتمتّع بجمالها. وهنا يبلغ التحدّي أقصى غاياته؛ فعلى جوديث أن تغوي هذا الرجلَ المتهالك على الملذّات دون أن تسمح له بالظفر بها، أو النيْل من عفافها، وهو ما تتمكّن من تحقيقه بعزمٍ وحنكةٍ، حين يغلبه السكرُ، فتنتزع خنجره المعلّق على عارضة السرير، وتهوي على عنقه بضربتيْن، قطعت بهما رأسَه، ودحرجتْ جثّتَه، فتمّ لها الانتقامُ بسلاحه هو، إيماءً إلى ارتداد ظلمه عليه، وإحباط مكره بمكرٍ أعلى. وكما نتوقّع تماما، فقد استطاعت التسلّل عائدةً إلى قومها مع وصيفتها التي تحمل الرأسَ في جعبتها دون أن يُشكّ في أمرهما، لتتغيّر بهذا مجرياتُ الصراع، وترتفع معنوياتُ اليهود عكس أعدائهم الذين انهاروا، وانكسروا شرَّ انكسار، ممّا يكرِّس نزوعا حُلميّا، تضطلع فيه المخيّلة الجمعيّة بقلب وقائع التاريخ، وتحويل الفجائع المنكَرة إلى انتصاراتٍ مُدوّيةٍ، تشكّل تاريخا افتراضيّا موازيا، كثيرا ما يمتدّ محاولا تناسي التاريخ الحقيقيّ، وإقصاءَه.
وقد تسرّب هذا الموضوع إلى كثيرٍ من فنّاني عصر النهضة، مما يمكننا تلمّسُه على سبيل المثال لدى بوتيتشيلّي في ثلاثٍ من لوحاته، حيث اِلتقط في أولاها: «عودة جوديث إلى بيتوليا»(1472) لحظة عودتها إلى الديار، تحمل في يمينها السيفَ الذي مسحته تماما من الدماء، وفي شِمالها تمسك غصنا طريّا، الأرجح أن يكون غصنَ زيتونٍ، إيماءً إلى السلام القادم الذي سينعم به قومُها، وخلفها مباشرةً وصيفتُها تثّبت على رأسها السلّة التي بها الرأسُ المقطوعُ، وترفع بيمناها طرفَ ثوبها الطويل، وقد علّقت بها زقّيْن، هما حتما زقّا الخمر والزيت، اللذيْن كانا بعضَ زادهما الذي حملتاه معهما. ولعلّ إثباتهما هنا أتى من باب الحرص على الإيحاء بأجواء التنقّل، وعناء الارتحال، حيث لا يمكننا تصوّر مُرتحِلٍ يمضي في طريقه دون زادٍ ما، أيّا كانت المسافة التي سيقطعها هيّنةً، وقصيرة، فهما في هذه الحال مجرّد لازمةٍ بصَريّةٍ، لا أكثر. ولكنْ، يمكننا من جهةٍ ثانيةٍ أن نمعن النظرَ فيهما أكثر، فنلاحظ أنّهما ومن وضعهما المنحني أفقيّا يبدوان فارغيْن، أو في الأقلِّ ليس فيهما سوى بقايا ضحلةٍ جدّا، فما الغاية من حملهما، وتجشّم عناء العودة بهما إلى الديار؟ 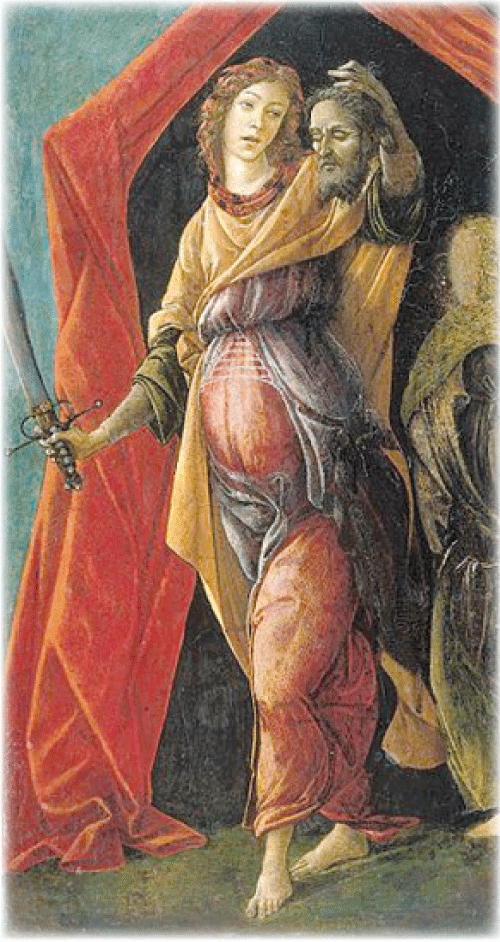
قد يكون في هذا إيماءٌ إلى عجلتهما، وفداحة الخطر المحدق بهما؛ فجوديث الحريصة طوال تواجدها في المعسكر على عدم تناول زادٍ آخر عدا ذاك الذي أعدّته وحملته معها من بيتها، لن تسمح لنفسها بكسر هذا العهد يوم الوليمة الأخيرة، فقد نادمت القائدَ، وشاركته عشاءه، ولكنْ، من زادها هي، لا زاده هو، وما أن أتمّت المهمّة، وقتلته، حتّى خرجت هي والوصيفة تحملان غنيمتهما: رأسَ الغريم وسيفَه، وبقايا زادهما: الزقّين شبه الفارغيْن، فلم يكن الوقتُ ليسعفهما بالعودة إلى خيمتهما، بل من خيمة العدوِّ نفسها خرجتا، وقد لا نغالي إن قلنا إنّ دافعهما إلى هذا هو: الوازعُ الدينيُّ، والهوس القوميّ؛ فلا يستحقّ الآشوريّون/ الوثنيّون أن يبقى عندهم أثرٌ يهوديٌّ ما ولو كان مجرد زقٍّ فارغ، ومهمَل!
وممّا يلفت النظرَ في هذه اللوحة، ملامحُ الحزن الشفيف البادية على وجه جوديث، وهي تميل بطرف وجهها إلى الخلف؛ إنّها منكسِرة جدّا، ويائسة: هل هي نادمةٌ على ما فعلت؟ هل هي عاشقةٌ لذلك الذي غدرت به؟ هل هي وجِلةٌ من ذلك التبجيل الذي ينتظرها من قومها، وتفضّل بدلا عنه لو حظيت برجلٍ يعشقها أو في الأقلِّ يشتهيها وإن كان عدوّا؟ هل سيجرؤ أحدٌ من بني جلدتها على أن يحبّها وقد حكمت على نفسها أن تظلَّ طول حياتها قدّيسةً، وبطلة؟ هل ستعود امرأةً كبقيّة النساء وقد حلّ «الربُّ» بكامل جلاله وعظمته في جسدها، وغدت يدُه القاطعة يدَها؟
أمّا لوحته الثانية: «اكتشاف جثّة هولوفيرن» المؤرّخة في السنة نفسها، فلا نجد فيها ظلا أو طيفا لجوديث، بل نلمح جثةً فاقدةً رأسَها، وما يزال الدمُ طازجا يسيل من أعلى العنق، يحيط بها بعضُ القادة المشدوهين، وقد غطّى أحدُهم وجهَه من هول ما رأى، فيما رفع آخر كفّيْه مصدوما، وجحظت عينا ثالثٍ، وغضّ أغلبُهم أنظارَهم. ومن مدخل الخيمة، يلوح ضوءُ النهار بوضوحٍ، ويبدو أحدُ الفرسان على صهوة حصانٍ أبيضَ أصيل، ممّا يثير في أنفسنا السؤال: هل سينطلق هذا الفارسُ للبحث عن الجانية وشريكتها – وما أسهل الظفر بهما وهما المترجّلتان – أم أنّه سيبقى أسيرَ ذهوله وانشداهه ذاك؟ ورغم علمنا بالجواب، فإنّ مجرد النظر إليهما: الفارس وحصانه، يثير في النفس التوجّس: سيقبضان حتما عليهما، لو أنّهما ينطلقان؛ فضوء الصباح البازغ سيرشدهما، ودم الجثّة الحارّ ينبئ بأنّهما لم تبتعدا كثيرا... ربّما!
ويعود هذا الموضوع مجدّدا في لوحته الثالثة (1497) فنرى جزءا من جسد الوصيفة التي أولتنا ظهرَها عند مدخل خيمة هولوفيرن، بينما تخرج جوديث حاملةً رأسَه بيدٍ، وسيفَه بيدها الثانية، وهي تنظر بتشفٍّ نحوه، ممّا يرصد وجها نقيضا للوحته الأولى، التي ركّز فيها على البعد الإنسانيّ والهاجس الأنثويّ في شخصيّتها، فبدا الوجهُ القوميُّ عاليا جدّا في هذه اللوحة، وتكرّس أكثر بما نراه على الرأس من ضآلةٍ ملحوظةٍ، فبدا حجمُه صغيرا جدّا، لا يكاد يجاوز حجمَ كفِّ اليد، ممّا يُلمِح إلى نزوعٍ حادٍّ نحو استصغاره، والتهوين من شأنه.













 في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...
في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...