 تقليم أظفار الحزن وأشياء أخرى
تقليم أظفار الحزن وأشياء أخرى
لا يكتب «عبد الرزاق بوكبة» حين يكتب، ولا يؤلف حين يؤلف، ولكنه يبذر قمح المحبة في مساحات الروح فتنبت زنابق وياسمين وفلاّ...ومن تكون هذه حاله، وهذه هوايته ومهنته التي نذر لها حياته، فلن يلجمه نمط بعينه أو نسق بنفسه، لذلك فقد رأيناه في سنوات قليلات، ينوّع بين كتابة الرواية (ندبة الهلالي مثلا) والزجل (يبلّل ريق الما) أو (الثلجنار) وقبلهما نصوصا متنوعة في أدب الرحلة والمسرح وغيرهما (عطش الساقية وهي نصوص متميزة تستحق الكثير من القراءات) ونصوصا مفتوحة (من دسّ خفّ سيبويه في الرمل)، لذلك فإنّ تجربته الجديدة في القصة القصيرة «كفن للموت» الصادرة هذه الأيام عن دار العين بمصر، شكل جميل جديد من أشكال الحياة (حياة الحرف) عند الكاتب.
ياسين سليماني
في «كفن للموت» نلهث وراء القصص بقلب خافق وأنفاس متقطعة، سارة التي كان الهاتف الوفي يوصل صوتها، الزبير العاشق الذي يقف على قمة الحزن عندما يرفض استقبال جثتها ويعود إلى الهاتف منتعلا قلبه ورزمة من الأمنيات في انتظار مكالمتها. أو ما يتراءى لنا في قصة «الزجاجة» أو في «الحذاء أو الرسالة. حكايا الحب و السياسة، الاغتراب و الإرهاب..إلخ، مما يجعل المجموعة الجديدة إضمامة ورد، تشبه المحطات القصيرة في رحلة سريعة، لا تقول كل شيء، ولكنها تترك الكثير من البياض للقارئ ليملأه بما لديه من خيال اتّسع أو ضاق.
هناك تيمتان، أحب أن أتحدث عنهما في هذا العمل. أولاهما من ناحية الشكل: القصة كجنس يعود إليه بوكبة في تجربة ثانية، بعد تنقله في العديد من الأجناس الأخرى ليس أولها الرواية، كما ليس آخرها أو قبل آخرها الشعر. وآخرهما، موضوع الموت. كتجربة وجودية ينخرط الكاتب فيها ليس لمرة أولى ولن تكون الأخيرة أيضا.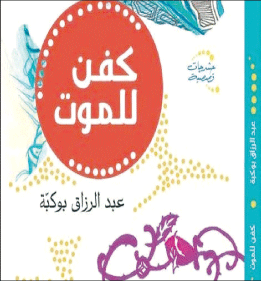 المجموعة مكتوبة بنفس متسارع، كتبها الرجل في ميترو، أو قطار، فكانت تشبه مكان كتابتها، عجولة، تومئ وتلمح، إنها تضيء كابتسامة عاشقة لتختفي على عجل..تترك الأثر بينما الكلمات «كمشة» لا تطيل. قد يكون هذا الاختيار، أو هذا التورط، متناسقا مع هذه الحياة بارتباكها وسرعة دقاتها بقصرها وبتوتراتها العالية. حيث لا تركن لخط أفقي ظاهر، ولكنها ترتفع في قلقها الوجودي، تنزل قليلا إلى العادي..تنزل لبرهة، لترتفع مجددا في دفق جمالي خالص. كما الأرجوحة عند دفعة قوية..ترتفع كثيرا، لتصل إلى رحابة السماء، وتنخفض بشدة لتلامس الأرض والتراب...إنها مجموعة تخلص جيدا للتوتر الزمني، حيث يشكل «الحذف» أحد أهم مظاهره. إذ يتم القفز على الكثير من المساحات، فلا يقف عند محطة إلا ليعبرها، بينما الأثر باقٍ: أثر الصدمة.
المجموعة مكتوبة بنفس متسارع، كتبها الرجل في ميترو، أو قطار، فكانت تشبه مكان كتابتها، عجولة، تومئ وتلمح، إنها تضيء كابتسامة عاشقة لتختفي على عجل..تترك الأثر بينما الكلمات «كمشة» لا تطيل. قد يكون هذا الاختيار، أو هذا التورط، متناسقا مع هذه الحياة بارتباكها وسرعة دقاتها بقصرها وبتوتراتها العالية. حيث لا تركن لخط أفقي ظاهر، ولكنها ترتفع في قلقها الوجودي، تنزل قليلا إلى العادي..تنزل لبرهة، لترتفع مجددا في دفق جمالي خالص. كما الأرجوحة عند دفعة قوية..ترتفع كثيرا، لتصل إلى رحابة السماء، وتنخفض بشدة لتلامس الأرض والتراب...إنها مجموعة تخلص جيدا للتوتر الزمني، حيث يشكل «الحذف» أحد أهم مظاهره. إذ يتم القفز على الكثير من المساحات، فلا يقف عند محطة إلا ليعبرها، بينما الأثر باقٍ: أثر الصدمة.
قد يكون تنويع الرؤى داخل البنية السردية الواحدة وتقطيع الأجزاء والمشاهد بطريقة سينمائية، تجعل من الحدث الواحدة متنوع الدلالات والمفاهيم أهمية جيّدة في توكيد هذا التوتر.
هكذا فإنّ الارتباط أو التضافر التام بين القصة كنوع أدبي يختاره الكاتب في هذه التجربة، وبين اللغة في حد ذاتها، تُظهر بشكل جلي هذا المظهر من الصراع. حيث تتساوق حبكات القصص بتنوع وتكامل، بل في تعدد ووحدة في آن.
التيمة الأخرى في هذه العجالة، هي موضوعة الموت. لاشكّ أنّ هذه الموضوعة موجودة في مدونة الكتاب الجزائريين، بشكل لافت، كما لاشكّ أنّ بوكبة، قد تناولها في أكثر من كتاب وبأكثر من جنس أدبي. غير أنّ اللافت، أنّ المنحى الوجودي، حاضر حضورا جليا، بمعناه الفلسفي، الذي بقدر ما يتماس مع يوميات الحياة، في الجزائر على وجه التخصيص، بقدر ما يتعالى عن الجزئي نحو الكوني، للانضمام إلى الأسرة الإنسانية بالكتابة عن المشترك بين كل هذا الجنس البشري. إنها احتفاء بالموت كما أنها احتفاء بالحياة. وحديث مع الظلام، أو عنه، كبداية لأفق شاسع اللون رائقه. الاحتفاء بالموت بما هو عتبة نحو الكلّي والدائم واللانهائي: (خفّفت سيّارة رباعية الدّفع سرعتها، وهي تقترب من البئر/ قفز منها شباب يحملون راية سوداء/ بادروا الناقة بالذّبح، فبادرت بدفع وليدها إلى الحياة، وراحا يتخبّطان معًا في الرّمال-ص 58) لا يُعلن الموت بهذه القساوة على رغم اللغة المقتصدة بشدة، كدواء طبيب يعرف جدا مواطن الخلل، إلاّ ليصيح بشدّة بأن المجد للحياة. (قالوا إنهم لم يأكلوا منذ أسبوع، ولم يجد ما يقول سوى الصمت،وهو يصدّ الدّم عن حاشية البئر.ص 58) حتّى في أشدّ حالات انتكاسة القيمة، لأعداء الحياة والألوان. يأتي رد الفعل بصد الدم عن حاشية البئر كما يكتب بوكبة أي: على رغم الموت فإنّ صاحب الناقة مكسور الخاطر يمنع وصول موت آخر (الدم) للبئر (الماء الذي به تكون الحياة). إنه برغم فيزيائية الموت، ومرئيته، برغم نكبته، يفتح بابا تتنفس منه الحياة. وهو ما يتأكد في قصة (جلسة اعتراف أولى): (أخاف أن يضيع مخطوط روايتي، أكثر من خوفي على ضياع البيت-ص 62)، حيث تصير الرواية مشروعا للامساك باللحظات الهاربة من زحام الدنيا والعالم. لحظة نحت لتمثال الحياة بل قل: دعوة لأعراس الحياة لا خنق وسجن لها.
الكتابة بهذا المعطى كما تقول المجموعة القصصية، حياة أخرى لحياة أولى قد لا تكون قابلة للعيش بالقدر الكافي !! إنها بين اليومي والعادي، في مفاصلها الدقيقة، لكنها تلج ولوجا ساحرا للمشترك الإنساني. بوكبة يوجع قارئه إذ يكتب. يؤلمه بمصداقيته أو حرفيته العالية. إنه يكفّن الموت، لكنه بالمقابل، يعرّي الحياة لتبدو سوأتها (بل سوآتها) هل بوكبة الكاتب هو ذاته السارد هنا؟ لا يهم. يكفي أن تقرأ: (هل تدري أنني أنتظر يومًا يقال لي فيه: «آسفون يا أستاذ.. أنت لست من هذا الوطن؟»- ص 65) بل يصل الاغتراب عن الدنيا والعالم والناس، عن الوجود بكلمة أخرى إلى أن تسمع هذه العبارة: (آسف سيّدي..أنت لست من هذا العالم.-ص67) وهو أقسى ما يمكن أن يحدث لعلاقة الإنسان بنفسه ومع الوجود.
يبدو الكلام عن «كفن للموت»، كما عن أعمال بوكبة الأخيرة، التي قرأتها وكتبت عن بعضها وتحدثت عنها مع الأصدقاء محفوفا بخطر الانزياح نحو التبسيط فبوكبة في نصوصه السريعة يختبر قراءتنا لعمقه المتخفي وراء لغة غير متعبة. فكثيرة هي المعاني التي لا تبوح بسرها لأول مصافحة قرائية، لأول نظرة عين. وإذا كان بوكبة في آخر المدونة يكتب عن القصة المكسورة التي أسرع بها إلى مستشفى الكلمات: (تأوّهتْ...أغمي علي...ولم أصْحُ إلا بعد أن صارتْ ساقي جبسًا معلقًا في عمودٍ من النّحاس-ص 132) فإننا نقول: لم نصحُ إلاّ بعد أن أغلقنا دفتي الكتاب...وصارت حكايات الزبير وسارة، وما جاورها، وساوقها، حمائم تطير وعصافير تحوم في غابة المعنى...
هكذا يرتدّ إلينا صوتنا الذي صمت عند فعل القراءة، فننطق ببحّة أو بهمسة في أذنه لنقول كما قالت إحدى شخوصه: (أتعبنا الموت أيّها الكاتب، فهل تريحنا بأن تنشر أوراقنا؟-ص 122)

 في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...
في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...