
هل يمكن لجوائز الرّواية العربيّة أن تنطلق -حقًا- بالرّوايّة العربيّة نحو العالميّة؟، وفق ما يجري الترويج له. (من خلال ترجمات للروايات الفائزة للغات أخرى، مثل الإنجليزية والألمانية وغيرهما). وهل هذه تصورات في صالح وصول الرّوايّة العربيّة إلى العالميّة. أم أنّها تصورات لا تعدو كونها «وهمًا» من أوهام العالمية لدى الكاتب العربي. أو لدى القائمين على الجوائز؟
أعدت الملف: نوّارة لحرش
و هل بإمكان هذه الجوائز أو الترجمات أن تفتح بابًا نحو التناول/ أو التداول العالمي للرواية العربية وتمنحها فرصة التواجد في المشهد الثقافي العالمي، وبالتالي تُساهم في اِنتشارها أو عالميتها؟ بمعنى آخر هل الاِعتقاد بأنّ الجوائز أو الترجمة لوحدها قد تكون قادرة على جعل النصوص الفائزة نصوصًا عالمية؟، أو أنها يمكن أن تكون عاملاً أساسيًا في جعلها ذات قيمة عالمية؟

* الناقد والمترجم محمّد داود
الأدب عالمي بطبعه والترجمة هي التي تمكنه من الانتشار
يقول الناقد والمترجم الدكتور محمّد داود من جامعة وهران: «في البداية لا بدّ من تحديد مفهوم العالمية في الأدب، أي الاِنتقال من المحلية إلى فضاءاتٍ أرحب حيثُ يُقبِل القُرّاء الأجانب ومن مُختلف اللُغات والأوطان على قراءة الأدب المحلي، وفي هذا السّياق تمكن الترجمة من هذا الِفعل الثقافي الهام.
مُضيفًا: «ولعل الفوز بالجوائز الأدبية التي تُمنح للأدباء العرب في الدول الخليجية بصفة خاصة، قد يجعل من النصوص الفائزة بالتتويج تمتلك صدى في الكثير من الدول، وبخاصة وأنّ هذه المؤسسات الثقافية المانحة تسعى إلى ترجمة هذه النصوص. وهنا تلعبُ الترجمة دورًا كبيرًا في الترويج للأدب العربي، ويجب التذكير أنّ فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل الأدبية كانت وراءه الترجمة إلى اللّغة الإنجليزية».
ثم أردفَ: «وضمن هذا السّياق، فالأدب -ومهما كانت لُغته أو موطنه- فهو عالمي، لأنّه يتضمن التنوع اللغوي والثقافي والاِجتماعي والبشري، ومع ذلك فالبشر يشتركون في العديد من المشاعر، مثل المحبة والسعادة والألم والوفاء والصداقة، أي القيم الإنسانية النبيلة، كما يتوحدون حول الكثير من القضايا الإنسانية العادلة، مثلما يُناهضون العنصرية والتمييز والحروب وغيرها من الكوارث التي يُعاني منها الإنسان منذ الأزل. فالنصوص الأدبية تعج بمثل هذه المشاعر والمواقف، مِمَا يجعل منها نصوصًا عالمية حتى وإن لم تنتقل إلى فضاءات غير الفضاءات الوطنية والمحلية».
وهنا يستدركُ مُوضحًا: «ولعل أوّل من أشار إلى فكرة الأدب العالمي، هو الكاتب الألماني (غوته) بعد أن قرأ رواية صينية مُترجمة إلى اللّغة الألمانية، ما يعني أنّ الترجمة تلعبُ دورًا أساسيًا في التعريف بالآداب الأجنبية المكتوبة بلغات أجنبية، والترويج لها، فالترجمة هي الجسر الّذي يربط بين الشعوب والثقافات، ولنا في ترجمة كتابي (ألف ليلة وليلة) و(كليلة ودمنة) أحسن مثال على الإشعاع الثقافي للأدب العربي القديم وتأثيره في الأدباء والقُرّاء الغربيين، وقد نَتَجَ عن ذلك الفِعل الكثير من المواقف الفكرية والتصورات الجمالية مثل الرومانسية والغرائبية، ولا تزال قصص (ألف ليلة وليلة) تُؤثر في المخيال الغربي إلى حد الآن».
وواصل قائلاً: «وبالعودة إلى الجوائز الأدبية التي ظهرت مع نهاية القرن العشرين في العالم العربي، يمكن القول أنّ دول الخليج العربي قد أصبحت قِبلة للعديد من المبدعين العرب، بعد أن تراجعت، ولأسباب مختلفة، المراكز الثقافية العربيّة التقليدية عن لعب هذا الدور، مثل دمشق وتونس وبغداد، في حين لا تزال القاهرة تُصارع في البقاء ولعب دور الريادة في هذا المجال».
وفي هذا السّياق -حسب ذات المتحدّث- يمكن الإشارة إلى جائزتين ذات أهمية قصوى وهما جائزة «البوكر العربية»، ويسعى أصحاب هذه الجائزة إلى التعاون مع جائزة البوكر البريطانية، إذ يُشجعون على ترجمة الأعمال الأدبية المُتوجة إلى مختلف اللُغات الأوروبية مع تسويقها عالميًا، وجائزة «كتارا» للرواية العربية.
وتَمْنَحُ هذه الجوائز -حسب رأيه دائماً- بُعدًا عربيًا أوّلاً للأعمال الأدبية ثم بُعدًا دوليًا ثانيًا، لَمَا تُتَرْجَمُ إلى لُغات أجنبية.
مُضيفًا في ذات المعطى: «ومع ذلك لا نستطيع أن نقوم بتقييم حقيقي لاِستقبال وتلقي هذه النصوص لدى القُرّاء الأجانب، لكون الدراسات الأدبية وبخاصة في تخصّص الأدب المُقارن أصبحت شبه مُنعدمة في جامعاتنا العربية، مع الغياب شبه التام للاِنفتاح على الفضاءات الثّقافيّة الغربية، بغية التعريف بالأدب العربي والترويج له إعلاميًا وأكاديميًا».
مُشيراً في الأخير، إلى «تراجع الدراسات الاِستشراقية حول الأدب العربي في الجامعات الغربية أو اِكتفائها بدراسة الأدب العربي القديم، أو تحول مُعظمها إلى الدراسات السياسية والأيديولوجية التي ترتبط بما يعيشه العالم العربي من حروب داخلية وفتن، مِمَا يجعل التحولات الراهنة للمجتمعات العربيّة والتي يصورها الأدب العربي المُعاصر غائبة عن المخيال الغربي، وهذه إشكالية أخرى تحتاج إلى وقفة طويلة».

* الباحثة والناقدة منى صريفق
الاِعتقاد بأنّ الترجمة تجعل النصوص الفائزة عالمية فكرة خاطئة
تقول الباحثة والناقدة الدكتورة منى صريفق: «إنّ ثقافة الجوائز الأدبية في الوطن العربي تتبنى منهجيات مُتعدّدة في مُعظم الأحيان لأجل تحقيق بعد شامل للتعريف بالأعمال الأدبية الفائزة ومبدعيها -على حد السواء- في عديد دوراتها، ولن ينكر دور هذه الجوائز إلاّ من رأى فيها نمطًا يخدم أجندات خفية مُتعلقة بأبعاد غير ثقافية».
وأردفت في ذات السّياق: «وبالرغم من أنّ الواقع والأحداث والاِختيارات تُعزّز من هذه الفكرة؛ إلاّ أنّنا لن نتبع مسارات هذه الإيديولوجية الخفية التي تتوجهُ بنا نحو مناطق مظلمة لا تخدم مناقشة الموضوع، بل تزيد من ضبابية الرؤية ليس إلاّ».ثُمَ اِستدركت وهي تقول: «أوّد أن أركز على فكرة ترجمة الأعمال الأدبية الفائزة لعديد اللّغات، إذ نجدها من أفضل القرارات المُتخذة من قِبل هيئات هذه الجوائز. إنّه عملٌ يستحق الإشادة ويستحقُ فعلاً التنويه إلى أهميته في التعريف بالعمل الأدبي عند كلّ القُرّاء على اِختلاف لُغاتهم وثقافاتهم؛ حيثُ إنّ الترجمة ليست مجرّد نقل للكلمات، بل هي جسر حيوي يُمَكِّنُ الأعمال الأدبية الفائزة بالجوائز من الوصول إلى جمهورٍ أوسع، وتحقيق قيمة التبادل الثقافي المُثلى».وفي ذات النقطة تُضيف: «ولكن الأمر لا يتوقف عند هذه الفكرة المثالية. فالترجمة تقريبًا ليست العُنصر الحاسم الوحيد لجعل هذه الأعمال الأدبية عالمية الصدى. فالوظائف الأساسية لهذه الجوائز -في نظرنا- هي التحفيز على القراءة، الكتابة، الإبداع. والتعريف بالكاتب وأعماله السابقة والتعريف بالأدب العربي على وجه الخصوص».
في حين -حسبَ رأيها دائمًا- تطرح فكرة العالمية سؤالاً واسع المجالات. ولنجيب عليه علينا أن نأخذ بعين الاِعتبار أنّ نقطة محورية كجودة العمل الأدبي، أصالته ومدى اِنتمائه إلى الثقافة العربية قد يُغير المعادلة جذريًا.
وهنا تُؤكد قائلة: «فالتتويج في أحيان كثيرة يعني تطابق العمل الأدبي مع معايير اِختارتها لجنة القراءة النقدية لهذه الجوائز، وهذا لا يغنينا عن قراءة العمل والتمحيص فيه وفي أبعاده كقُرّاء منفصلين عن هذه الهيئات. وإن نجح النص في تخليد نفسه سيكون مستقبله العالمية لا محالة».بالإضافة إلى هذا العنصر الحاسم، تُضيف المتحدثة: «نجد كذلك أنّ فكرة الترجمة تُكملها بالضرورة الخطة التسويقية المُتَبَعَة في الترويج للنصوص الفائزة ومبدعيها، إذ من غير المعقول أن نجد ترجمات للمؤلفات لا تُعرض في المعارض الدولية، وهذا ما يُحيلنا كذلك إلى أنّ الأمر لا يقتصر على اِهتمام الهيئات العامة للجوائز فقط، بل على دور النشر العربية والعالمية أن تُساهم في هذه الخطة التسويقية ليصل العمل الأدبي إلى القارئ بكلّ اللّغات».
وأردفت في ذات النقطة: «إنني أعتقد يقينًا أنّ تصورات الهيئات المُنظمة لجوائز الرواية العربية التي تهدف إلى جعل الرواية العربية عالمية، قد اِعتقدت أنّ فكرة الترجمة لوحدها قد تكون قادرة على جعل النصوص الفائزة نصوصًا عالمية؛ في حين أنّ تجديد المعايير التي نقرأ بها النصوص ضمن اللجان المُتعاقدة للقراءة لهو من أهم النقاط التي تجعل هذه الهيئات تتفادى السقوط في وهم العالمية».
وفي الأخير اِختتمت بقولها: «كما أنّ سياسة الترويج للنص من دون حضور النقد قد يجعل هوة الوهم تتسع شيئًا فشيئًا لتجد نفسها قد خرجت عن سبيل أرادت المضي فيه بثبات. وأقصد حضور النقد في الوقت ذاته الّذي تُقرر فيه هذه الهيئات الترويج للنصوص الفائزة. لتعقد في حقها جلسات قرائية لتُضاعف قيمة القراءة وأبعاد الاِختيار وتحسين فلسفة الاِختلاف».

* الناقد والأكاديمي محمّد الأمين بحري
بعض الوسائل إلى العالمية قد تعدم مفهوم العالمية
يقول الناقد والأكاديمي الدكتور محمّد الأمين بحري: «من حيثُ المبدأ، لا يمكن تسمية طموح المُبدع أو الفنان في اِرتياد أو بلوغ أفق العالمية، وهماً، بل هو مشروع مشروع، وحلم إيجابي، وهدفٌ نبيل، إن تَمَ الاِشتغال عليه بجد، حتى وإن لم يتحقّق، فإنّه يزرع في الوجود الثقافي مُبدعاً مُثابراً. ربح فنه وأَوْصَلَ عمله إلى أقصى حدود الذيوع بين الجمهور القارئ».
مُضيفاً في ذات السّياق: «هذا على الرغم مِمَا طال كلمة (عالمية) من اِبتذال إعلامي، وعلى مواقع التواصل الاِجتماعي، وإنّما علينا أن نسأل عن مواطن الاِختلال في فهم ومُمارسة وسلوك هذا المسعى، واِنحرافه عن المسالك الطبيعية للوصول إلى عالمية تنطلق من داخل العمل فنياً وقضايا الإنسانية محاكاتياً، ورؤى فكرية وفنية من صلب الهم الشخصي للمُبدع وليس باِستيرادها أو ركوب موجات رائجة، أو كتابة وفق توجه الجوائز أو المنابر أو تحت الطلب، وهي الطُرق التسلقية المُشينة بالإبداع وأصحابه، كطُرق اِجتنابية وخلفية، وهجرات غير شرعية (حرقة)، تسيرُ وفق الغاية التي تُبرر الوسيلة لبلوغ العالمية».إذ إنّ الغايات، -يقول الدكتور بحري- حتّى وإن كانت مشروعة، ونبيلة، فإنّ الوسائل إليها قد لا تكون كذلك، وهذا ما من شأنه أن يعدم مفهوم العالمية من الداخل، ليصبح شكلاً وشعاراً خارجياً أجوفاً يتردّد على ألسنة المُتسلقين، وراكبي الموجات والموضات المكرسة والرائجة.فحين تُصبح الجوائز -حسب المُتحدث- غاية نهائية للكتابة، ينتهي الإبداع وتبدأ الهرولة نحو العزف على إيقاع توجهات الجوائز، وهوى منظميها، وحين تتفشى هذه الروح النادلية (الكاتب النادل) التي تجعل من القلم تحت قانون العرض والطلب، فإنّ سوق هذا النوع من الكُتّاب تُصبح فاسدة وتجارتهم كاسدة، بمجرّد بروز آفة التزلف للجوائز في الأسلوب العازف على نقاط معينة يعتقد أهلها أنّها نقاط عزف وأقطاب اِهتمام عالمية.
وأضاف مُستطردًا: «وليس ببعيد عنا فلول العازفين على وتر محاباة السامية، وذِكر أسماء شخصيات يهودية على أغلفة الروايات، لكي تُحظى بترجمة هذه الجهة أو بجائزة ذلك المنبر، أو بالحظوة لدى ذلك التيار. كما أنه ليس ببعيد في بداية الألفينات حين شهدنا موجة العزف على أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، التي ما كادت تكمل عامها، حتى ركبت بعض الأقلام الروائية لدينا (تلك الأسماء التي طلبت اللجوء إلى الغرب أو سافرات واستقرت هناك، أو تلك التي حاولت الهروب ولم تستطع)، أقول ركبت موجة الحديث عن هذه الحادثة (اِنهيار البرجين التوأمين في نيويورك)، وركزت بتبئيرٍ لافت على ثيمة الإرهاب الإسلامي، أو أرهبة الإسلام، والإرهاب. ورافعت بعدها على حقوق المثلية الجنسية في شخصياتها التي سعت إلى تهجينها لتصبح بأسماء تغريبية، لعلها تكون أقرب إلى ذائقة التلقي الغربي».وهنا يُؤكد المُتحدث قائلاً: «وإذ نال بفضل هذه النادلية التي لم تعرف أي تجاوب في البلدان الأصلية لهؤلاء الكُتّاب، بعض الجوائز التي ردت جميل عزفهم المضني على أوتار بعض الأقطاب الإعلامية أو الأقليات الإثنية التي لا علاقة لهم بها، ولكن من باب حقوق الإنسان وحماية الأقليات ونبذ الإرهاب الملتصق بالإسلام، ومحاباة السامية، وغيرها من القنوات الموضوعاتية العابرة للبحار، كوسيلة حرقة أو لجوء سياسي بالكتابة، فقد وجب على تلك الأقطاب أن تكافئ جهودهم، وتمنحهم بعض الوجاهة التي كانوا في أمس الحاجة إليها إعلامياً على الأقل».
وخلص في الأخير إلى القول: «أمّا الجائزة كمعيار اِجتهاد فني وأدبي قبل أي شيء، فهي حلم وليست وهماً، لدى من يكتب لغاية التواصل الفني والإمتاع والتأثير في القُرّاء، وكسب قاعدة جماهيرية، محلية وقطرية قبل أن يكتسبها إعلامياً».
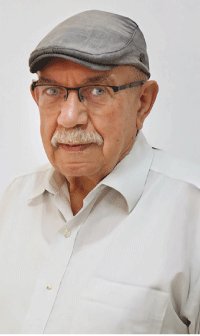
* الناقد والمترجم عبد الحميد بورايو
للجوائز دورٌ في نشر الروايات على نطاقٍ واسع أما عالميتها فشأن آخر
يرى الباحث والمُترجم الدكتور عبد الحميد بورايو، أنّ للجوائز دورٌ في تشجيع الكتابة الروائيّة، وفي نشرها على نطاقٍ واسع وترجمتها للغات الأجنبية، ولفت اِنتباه النُقاد لها. ويتوقّفُ هذا الدور عند هذه الحدود. أمّا عالميّتها فهي شأن آخر، يتعلّق بمدى قدرتها على فرض نفسها في سوق صناعة الكِتاب وفي الوسائط الثّقافية المختلفة، وكذلك في مدى مقروئيّتها في مُختلف اللُغات.
وهو أمرٌ يعودُ -حَسْبَ قوله- إلى مدى اِستجابتها للذوق العامّ العالميّ وتحقيقها لشروط الكتابة الروائيّة المطلوبة في هذا النوع من الإبداع الأدبي. وهي شروطٌ يصعب اِكتشافها إذا لم تتوفّر الإحصائيات الصحيحة المُتعلّقة بالمقروئية وبردود فِعل النقد الأدبيّ في مُختلف اللُغات.
مُشيراً إلى أنّ الجوائز الأدبية تخضع لوجهات نظر قوميّة وقطريّة، قد تعكس الرأي العام الأدبي في قُطْرٍ مُعيّن أو في لغة قوميّة معيّنة، وهي وجهات نظر لا تكون بالضرورة عالميّة، وبالتالي يكون الوصول إلى العالميّة مرهونًا بشروط أخرى غير الشروط القطْرية والقوميّة.
ومُواصلاً في ذات السّياق يقول: «يتولّى الإشراف على الجوائز عادةً أفراد من النخبة القوميّة أو النخبة القطريّة تختارهم المؤسسة الثّقافية الرسميّة عادةً من النُقاد والمبدعين في مجال الكتابة الروائية، يكون للمؤسسة الرسميّة دورٌ في اِختيار هؤلاء الأفراد، وبالتالي هم لا يمثّلون أفضل العارفين بشروط الكتابة الروائيّة وكثيرًا ما يكونون غير مُطلعين على الكتابات الروائيّة ذات القيمة العالميّة، وبالتالي قد لا تكون اِختياراتهم مُتطابقة مع شروط عالمية الرواية».
بالإضافة إلى أنّ عوامل اِختيارهم -حسب ذات المُتحدّث- قد لا تكون لها علاقة بعُمق معرفتهم في مجال الكتابة الروائيّة أو بإطلاعهم على الرواية العالميّة، وهو ما يُقلّل من حظوظ تطابق خياراتهم مع ما يطلبه القارئ في مُختلف لُغات العالم.
مُؤكدًا في هذا المعطى، «أنّ الجوائز تخضعُ عادةً للتوجيه السياسي والثقافي الّذي تفرضه المؤسسة الرسمية عادةً، ويكون أعضاء لجنة التحكيم خاضعين لنوع من الرقابة، إن لم تكن صادرة عن الجهة الوصية، تكون ذاتيّة، ولاءً للجهة التي اِختارت الشخص الْمُحَكِّم. في نفس الوقت تتحكمُ في اِختياراتهم ميولاتهم الشخصية وإيديولوجياتهم ومواقفهم ومدى جدّيتهم في القراءة والحكم، وكذلك المدة الزمنية المُخصّصة للقراءة الجادة وللفرز، وخاصةً في المراحل الأولى».
بناءً على ما سبق، -يُضيف المُتحّدث-: «لا يمكن أن تكون الجوائز عاملاً أساسيًا في جعل الرواية ذات قيمة عالمية، بالنظر لِمَا ذكرتُه سابقًا، وبالتالي يُصبحُ من باب الوهم القول بذلك. تتوقّف عالميّة الرواية على مدى إدراك كاتب الرواية المُتمرّس للبُعد الإنساني في العمل الأدبي، ولمَا تتوفّر له من فرص الكتابة في لُغة منتشرة بين شعوب معروف عنها أنّها تقرأ ما يُكتب في لغتها، وفي ما يُتَاحُ له من ترجمة لروايته في لُغات أخرى، إلى جانب تمثّله لفنّ الكتابة الروائيّة في تراكماتها عبر العصور، ومن خلال أبرز نماذجها في مُختلف الآداب واللُغات، إلى جانب تعبيره عمَّا هو مشترك مع الإنسانيّة في مجتمعه المحلّي».
وهي شروطٌ -حسب رأيه» قد لا تُراعى عادةً في الجوائز الأدبيّة ذات الطابع القومي أو القطري.
ثم اِختتمَ قائلاً: «هكذا تكون الجوائز عاملاً مُساعدًا للتشجيع على الكتابة وعلى تراكم الإنتاج القطري والقومي. أمّا الطموح إلى عالميّة الرواية فيتطلّب شروطًا أخرى، قد تتجاوز ذلك، وقد يتمّ تحقيقها قبل نيل الجوائز».

* الأكاديمي والناقد محمّد الأمين لعلاونة
الجوائز وحدها لا تضمن العالمية
يرى الأكاديمي والناقد الدكتور محمّد الأمين لعلاونة، أنّ السؤال عن قدرة الجوائز الأدبية العربية على دفع الرواية نحو العالمية، من خلال الترجمة والاِنفتاح على اللُغات والثقافات الأخرى، سؤالٌ مشروع وراهن وواقعي. وهو يُلامس جوهر العلاقة بين المحلي والعالمي في الأدب، وبين الاِعتراف الذاتي والاِعتراف الخارجي. لكن لا بدّ من التمييز بين العالمية كحلم مشروع، والعالمية كـ»وهم» قد تُسوّقه بعض المؤسسات الثقافية أو حتى بعض الكُتّاب أنفسهم.
مُضيفاً: «العديد من الجوائز العربية، كالجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة إعلاميًا بالبوكر العربية، أو جائزة الشيخ زايد، أو كتارا، وغيرها من الجوائز غالبًا ما تتبنى في خطابها فكرة دعم الرواية العربية للوصول إلى العالمية، مُستندةً إلى ترجمات الروايات الفائزة إلى لُغات أجنبية، وعلى رأسها الإنجليزية والفرنسية والألمانية. هذه المُبادرات تُحسب لها، دون شك، لأنَّها تفتح بابًا نحو التداول العالمي للرواية العربية، وتمنحها فرصة التواجد في المشهد الثقافي العالمي».
لكن السؤال الحقيقي -حسب المُتحدث- هو: هل الترجمة وحدها كافية لتأكيد هذا الاِنتقال إلى العالمية؟
وهنا يقول مجيباً: «الحقيقة –حسب رأيي- أنّ الترجمة، رغم أهميتها، ليست نهاية المطاف. هناك فرقٌ كبير بين (وجود رواية مترجمة) و(تحقّق الرواية في الثقافة الأخرى). الأولى مجرّد فِعل تقني قد ينتهي برفّ مكتبة، بينما الثانية تعني تفاعلًا نقديًا وجماليًا وثقافيًا مع النص، واندماجًا له داخل منظومة القراءة الجديدة. هذا ما لم يتحقّق بعد بالشكل الّذي نرجوه، رغم وجود بعض الاِستثناءات المحدودة التي تفرض نفسها لجودتها الفنية أو لفرادة صوتها السردي».
ومُستدركًا يُضيف: «ثمّ إنّ العالمية ليست جائزة أو ترجمة، بل هي مسار مُعقد يحتاج إلى شروط تتجاوز الحدث الأدبي نفسه. يجب أن تكون هناك إستراتيجية ثقافية واعية، تشمل النشر الدولي، العلاقات الثقافية المُتبادلة، النقد الأدبي المُواكب، والدفع بأسماء أدبية عربية نحو حضور فعلي في المحافل العالمية. وحتى على مستوى الكاتب، العالمية تتطلب خطابًا سرديًا قادرًا على تجاوز المحلي الضيق، دون أن يفقد عمقه واِنغراسه في التربة الأصلية».مشيراً بالموازاة، إلى أنّ ما نراهُ اليوم، في كثير من الأحيان، هو تسويق إعلامي لـ»وهم العالمية»، بحيثُ يُخيَّل للكاتب العربي أنه بمجرّد فوزه بجائزة وترجمة روايته، فقد بلغ العالمية، في حين أنّ هذه العالمية الحقيقية تتطلب تراكمًا طويل الأمد، وشروطًا تتجاوز قدرته الفردية.
مُؤكداً في الأخير: «يمكن القول إنَّ الجوائز الأدبية العربية تلعبُ دورًا مُهمًا في تسليط الضوء على الرواية العربية، لكنها لوحدها، لا تضمن العالمية. بل قد تتحوّل إلى مرآة زائفة، إن لم تُرفق برؤية إستراتيجية، ومشروع ثقافي جادّ، ومُتابعة حقيقية لمسار الرواية بعد فوزها. فالعالمية ليست وهمًا، لكنها أيضًا ليست ثمرة ضربة حظ، بل هي عملٌ دؤوب، ثقافي وجمالي، طويل النفس».
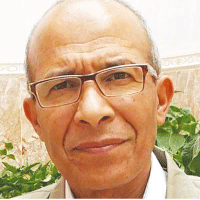
* الكاتب والناقد عبد الحفيظ بن جلولي
معايير الجوائز ليست بالنزاهة التي يمكن أن تساهم في عالمية المبدع
يقول الكاتب والناقد عبد الحفيظ بن جلولي: «إنّ من يُبدع ولا ينتظر جائزة فهو خارج مجال تغطية الفرح بالكتابة، لكن ليس على منوال ما يحدث راهنًا في عالم الجوائز. لأنّ الجائزة معناها العميق تقدير العمل مهما كان نوعه، اِعترافًا بأنّه تعثر وتقدّم واشتدّ عوده وأصبح من الواجب الاِلتفات إليه، وليس هذا الّذي نراه بأم أعيننا، لأنّ السياسي والمناطقي والطائفي والقبلي كلها عوامل أصبحت تُحدّد المقاييس التي على أساسها تمنح الجائزة، فكُتّاب كانوا مغمورين لكن لمجرّد الكتابة في مجال معيّن نالوا جوائزا مهمّة، وقبلوا بها رغم إنّها ضدّ مبادئهم».
مُضيفاً: «أصبح مفهوم اللوبي واضحًا وجليًا في معظم الجوائز، كأن يُفرط في إغراق جهة ما بالجوائز. تخيّل أنّ لجنة تحكيم جائزة ما في القصة القصيرة مثلاً ليس فيها ناقد واحد، هذا لا يعني أنّ المُبدع القاص مثلا ليس قادرًا على التحكيم، بعيدًا عن هذا، فهو يتذوّق النص ويشعر بإبداعياته التي اِنبثق منها، لكنّه لا يمكن أن يصل إلى مفاصل النص التي تُشكل مناطق حركة السرد فيه، ولهذا كانت اللجنة ستكون أكثر منطقية إذا هي تشكلت مناصفةً بين نُقاد ومبدعين».
مشيراً هنا، إلى أنّ جائزة نوبل وهي أرفع الجوائز العالمية، فتحت حولها نقاشات كثيرة حول الطُرق التي تُدار بها، واتُّهم فيها أشخاص من لجنة التحكيم، وأصبح من العادي أن ترى أسماء من الظل تسبقها أسماء كبيرة ولم يُحالفها الحظ في الجائزة، بينما تلك التي لا تكاد تعرف أو إنتاجها الأدبي مُتواضع تتصدّر قوائم الترشح وتفوز بالجائزة.
ومنه يُصبح السؤال مُلحًا -حسب ذات المُتحدّث- عن الشروط الواجب توفّرها في العمل؟مُضيفاً في ذات السّياق: «لنضرب مثلاً فقط بنجيب محفوظ، رغم أنّ أعماله أَدْخَلَت الرواية العربية فضاء العالمية إلاّ أنّ، وكما يذكر العديد من النُقاد، وهذا لم يعد سرًا، ربّما تكون مراسلاته مع سان سوميخ الإسرائيلي سببًا في حصوله على الجائزة، لأنّ ذلك يُعتبر تطبيعًا ثقافيًا».
إذن الجائزة، أو أغلب الجوائز -حسب بن جلولي دائماً- في أحد وجوهها تركز على الأعمال التي تُخلخل الثابت. بن جلولي، يؤكد في مقابل هذا، أنّ المعايير المُحدّدة من قِبل الجوائز ليست بالنّزاهة التي يمكن أن تُشكل فرقًا في حياة المبدع، على أساس أنّ الجائزة تكشف عن مدى نضالية الكاتب إبداعيًا ليصل إلى مرحلة من المراحل يُصبح الاِعتراف له بالجدية والاِعتراف به عالميًا أو محليًا أو إقليميًا أكثر من ضرورة. واختتم قائلاً: «ولأنّ الجوائز أصبحت تُمنح جزافًا ولمن يتنازل أكثر، فإنّها أصبحت لدى الكثير تُثير سؤال الـ(لماذا) المُتشكك في جدارة المتحصّل عليها وجدوى الجائزة ذاتها. ولأنّ حال الجوائز وصل إلى هذا المستوى طالب الكاتب والمترجم الجزائري المغترب بإنكلترا مولود بن زادي في مقال له بلجان تحكيم يتولاها الذكاء الاِصطناعي، ولاقت الفكرة رواجًا كبيرًا».