
قــراءة في فيلم المراسـلـة
«الحب أنانيّة اثنيْن» مدام دوستايل
إنّهما «ثاناتوس» و»أيروس» مجسّديْن في شخصيّة كلٍّ من الرجل: «إدوارد فيرم» والمرأة: «إيمي رايان»، اللذيْن تبدأ الأحداثُ بمشهد عناقهما الحميم، في غرفةٍ بأحد الفنادق العابرة.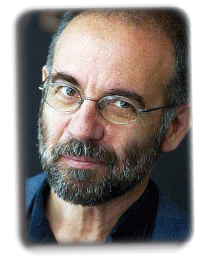 بهاء بن نوار
بهاء بن نوار
إدوارد رجلٌ تخطّى مرحلة الشباب بسنواتٍ كثيرة، وإيمي شابّةٌ يافعةٌ، تشقّ طريقَها بثقةٍ في دراستها الجامعيّة في مجال الفيزياء الفلكيّة، وتعمل على هامش الدراسة ممثّلةً مختصّةً في تأدية مشاهد العنف والخطر، وهي سعيدةٌ جدّا بعلاقتها الراهنة، رغم أنّها لا تحيا إلا على الهامش من حياة حبيبها، المنشغل بأبحاثه، ومحاضراته، وأسفاره، وأسرته، فلا تحظى منه إلا بلقاءاتٍ خاطفةٍ سريعة، تتخلّلها اتصالاتٌ كثيرة، ودردشاتٌ شبه يوميّة، تنسيها وحشة المسافة، وتنصهر من خلالها السنواتُ الكثيرةُ الفارقةُ بين عمريْهما.
كلاهما متيّمٌ بالآخر حسبما يبدو، وراضٍ بما تتيحه العلاقة من سعادة هشّة وفرح قصير، إلى أنْ يأتي ذلك اليومُ الذي تُصعَق فيه إيمي بخبر وفاة الحبيب، ولا تصدِّق الأمرَ بدءا، فقد كانت تتلقّى رسائلَه الإلكترونيّة دون انقطاع! تشكّ في الأمر كثيرا، وتحاول التأكّد، ولكنّ الحقيقة قاسيةٌ جدّا، وثابتة: لقد مات «إدْ» فعلا بعد صراعٍ طويلٍ مع ورمٍ خبيثٍ في الدماغ، وأحرق جثمانُه منذ فترة، فما تلك الرسائلُ المتواصلة إذن؟ وما تلك الهدايا الجميلة؟ والتسجيلات الحميمة؟
إنّها خطاباتُ ما قبل الموت، وحشرجات ما قبل الوداع، وقد عكف «إد» على إعدادها طوال الأشهر الثلاثة السابقة لرحيله، فاتّفق مع محاميه على وصول باقات الورود، وتسجيلات الفيديو، والرسائل الورقيّة، وطوّر برنامجا حاسوبيّا دقيقا تصلها من خلاله الرسائل الإلكترونيّة، وفق توقيتٍ مدروسٍ، لا مكان للمصادفة فيه، فكان بهذا يؤكد حضورَه، أو بالأحرى خلوده، ويُحكم احتواءه لإيمي المصدومة من ذلك الرحيل.
تبدو حقّا قصّةً حزينةً، ومؤلمة، غير أنّ في خضم هذا الحزن ثمّة معانٍ مبطنة، وأسئلة غائرة كثيرة عن هذه العلاقة الغريبة، التي يضمحلّ فيها التواصلُ ويتهافت؛ فأحدُ الطرفيْن جائعٌ للكلام، فهو يتكلّم، ويتكلّم، حذر حلول لحظة الرحيل، التي يُحرَم بعدها من حقّ الكلام: «إد» والثاني جائعٌ للاستماع، فهو يستمع، ويستمع، وما من قوتٍ لروحه إلا على فتات كلمات الطرف الأول ومفاجآته: «إيمي».
وهو ما يمكن تفصيله من خلال إصرار «إد» على تحدِّي الموت والبقاء حيّا، لا في ذاكرة ووجدان حبيبته فحسب، بل في تفاصيل حياتها، ويوميّاتها التي يعرفها جيِّدا؛ فقد أمضى وقتا طويلا في تتبّعها، ودراسة حالاتها، وأصبح بإمكانه التنبّؤ بجميع أفعالها وأفكارها، فلم يبخل عليها بالدعم، ولا بالعطف، أو المساعدة: ورود جميلة تصلها بين الحين والحين، وكلمات حب رقيقة تداعبها، واهتمام نادر يطوّقها، ويرافقها في أصعب اللحظات: قبيْل امتحاناتها الجامعيّة التي يتطوّع بمساعدتها في التكهّن بأسئلتها، وبعيْدها، حيث يكافئها على تفوّقها بمزيدٍ من المساندة، فيرشدها إلى كثيرٍ من المراجع المفصليّة في أطروحتها، ولا تني روحه المشوقة تتتبّعها، وتحنو عليها من بعيدٍ، متقمِّصةً حينا جسدَ كلبٍ وديعٍ، وحينا آخر ورقة عنبٍ هائمة، أو طائرا محلِّقا، بل إنّه لشدّة حرصه على مصلحتها يتجرّأ على عتابها على برودها الشديد نحو والدتها، ومقاطعتها لها، ويحاول جاهدا إصلاح علاقتهما.
وهو في أثناء هذا كلِّه، لا يفرض أبدا نفسه على حياتها، بل يمنحها حريّة الاختيار، ويتيح لها فرصة التخلّص منه بشفرةٍ صغيرةٍ ترسلها إلى بريده الإلكترونيّ.
ولكنْ، هل ترك لها حقّا حريّة القرار؟ هل هي مخيَّرة تماما في وضعها الغريب هذا؟
أعتقد أنّ لي في هذا الأمر نظرا: لم يتخلّ «إد» بعد موته لحظةً عن «إيمي» بل ظلّ معها؛ يدعمها، ويساندها، لكنّه في سبيل ذلك كان يحكم خناقَه حولها، ويجعلها في حالة ترقّبٍ دائمٍ لرسائله، وتغافلٍ تامٍّ عن حقيقة موته، وفي سبيل تحقيق حالة «الخلود» المطلق أمامها، كان يستعمل الجميعَ جنودا وبيادق تنفّذ أوامرَه. إنّه – حسب شهادة طبيبه – أنانيٌّ، شديدُ الأثرة، نجح في جعل الجميع تعساء، وأوّلهم «إيمي» التي بقيت حياتُها معلَّقةً إلى ذلك الخيط الرفيع المتأرجح بين الحياة والعدم، فلا همّ لها إلا هاتفها الذكيّ، تتصفّحه كلَّ حينٍ، ولا تطمئنّ نفسُها إلا بسماع رنينه، وقد كاد أن يخلو من أيِّ اتصالٍ آخر عدا اتصال الحبيب! وهي لشدّة تعلّقها بطيفه البعيد، لا تكاد ترى غيره، أو تستمع إلى أيّ صوتٍ غير صوته، فها هي لا تنتبه إلى زميل عملها الشابّ: «جايسون» الذي يكنّ لها مودّةً خاصّةً، كان من الممكن أن تتطوّر لو منحته الفرصة إلى حبٍّ واقعيٍّ متين.
وهو – فوق هذا – بارعٌ جدّا في استدرار عطفها، ودموعها، فينجح في أن تقع بين يديْها تسجيلاتُ الألم، وعذاباتُ المرض، وقد بدا الأمرُ مجرد مصادفة، غير أنّه ليس كذلك، فقد جُمِعت كلّها بقصدٍ، وكان بإمكانه إتلافُها كلّها، لا التظاهر بإيقاعها، لتصل إلى يديْ صاحب القارب، الذي سيسلّمها حتما إلى «إيمي» المعذّبة.
ولكنْ، هل يمكن إعفاء «إيمي» من مسؤوليّة هذا الوضع الغريب؟ ألم تكن أشدّ حرصا من «إد» نفسه على استلام رسائل الموت تلك؟ ألم تبذل أقصى طاقتها لمعاودة الاتصال به بعد أن قطعته في لحظة غضبٍ جارفة؟ ألم تفكر فيما ستؤول إليه حالُها بعد أن تنفد تلك الطرود، ويجفّ حبرُ الرسائل؟ هل تعتقد أنّ خزينة المحامي ستظلّ ملأى دوما بالمفاجآت الجميلة، تروي ظمأها كلّما امتدّت الصحراءُ أمامها؟ أليس الحبّ هنا مجرّد مخدِّرٍ من الكلمات الهشّة، تقتات بها هذه التعيسة، وتقاوم وطأة أيّامها القاسية؟ ألم تنتبه لبؤس حالها، وهي تمعن في الوفاء للذكريات، والتشبّث بها، ونبشها، فتقصد احتفالا بيوم مولده قريته الصغيرة، وترتاد مطعمهما الأثير، حيث تجلس على الطاولة نفسها، وتختار الطبقَ نفسه، وتسأل النادلَ عن سرِّ موته الذي يعرفه الجميعُ، ولا تعرفه هي، غير منتبهةٍ وهي الشابة المفعمة بالحياة إلى أنّها متخمةٌ برائحة الموت والغياب، وغير بعيدٍ عنها يجلس زوجان هانئان، صحيحٌ أنّهما عجوزان، لكنّهما سعيدان جدّا ببعضهما عكسها هي!
وكأنّ هذا العذاب الروحيّ الفادح غير كافٍ، فلا تني تضيف إليه عذابا آخر جسديّا، فتمعن في تصوير مشاهد العنف والعدوان على الذات؛ فتارةً تلتهم جسدَها الجميلَ النيرانُ، وتارةً تتطوّع لسجنه في قالبٍ جبسيٍّ ثقيلٍ، يكاد يخنقها، وأخرى تلفّ حول عنقها الهشّ سلكا معدنيّا بغية الانتحار: إنّها كاميكازي حقيقيّة، كما كان يناديها حبيبُها دائما!
أليست بهذا المعنى أنانيّةً أيضا، وشديدة الأثرة، ومفلسة الروح؛ تبحث عن كلماتٍ تدفئ صقيعَها، وقد وجدتها في خطاباتٍ قادمةٍ من رجلٍ ميتٍ، مجرّة حياتها التي كانت – كما تناجيه – متماسكةً جدّا بحضوره، أصبحت الآن بغيابه تتّجه نحو العدم.
ومع كلِّ هذا، أليس من القسوة الشديدة محاسبتهما بهذه الصرامة على هذه المشاعر الإنسانيّة التي هي أنبل ما فيهما؟ هل كان «إد» أنانيّا إلى ذلك الحدّ؟ وهل «إيمي» مغاليةٌ كلّ المغالاة في جلد ذاتها؟
ليس الأمرُ هكذا تماما، ولنحاول النظرَ إليه من زوايا أخرى:
لم تكن «إيمي» بالشخصيّة المتوازنة نفسيّا، فهي تعاني شعورا فادحا بالذنب، لأنّها تسبّبت في مقتل أبيها لدى تهوّرها في قيادة السيارة، ولحماية نفسها من هذا الشعور المرير لم تجد سوى «الإسقاط» سبيلا؛ فهي تفترض أنّ أمّها تكرهها بسبب ذلك، وتتمنّى لو كانت هي الميتة لا أبوها، ممّا يبرّر لها هجرها، والبحث عن أبٍ بديلٍ، تجسّد في «إد» وكان من الممكن أن يستمرّ البعد والجفاء بينها وبين أمّها، لولا تدخّله بالنصح، فعادت العلاقة شيئا فشيئا إلى رونقها وصفائها الطبيعيّيْن.
حاولت «إيمي» من خلال مهنتها الخطرة، ومن خلال مشاهد الموت اليوميّة التي تخوضها تحت الكاميرات أن توقع بنفسها عقابا رمزيّا، تستعيد به شيئا من توازنها الروحيّ، ولم تتخلّص من هذا الوضع إلا بعد تصالحها مع أمّها، وبعد اعترافها لحبيبها الميت بجميع ما يعتري نفسَها من ألمٍ وعذاب.
تبدو مشاهدُ مراسلة “إيمي” لحبيبها الميت، وفضفضتها الحميمة له بأخطر أسرار حياتها شديدة العبث والتراجيديا، لولا أنّها أيضا علاج ناجع جدّا لمثل حالها؛ فما أحوجها إلى الاعتراف أمام مَنْ تشعر أنّه يسمعها، دون أن يقاطعها، أو يشتّت ذهنها، أو يحكم عليها.
لم يستمرّ احتواءُ “إد” الميت لإيمي الحيّة أكثر ممّا يجب، بل لقد عرف بالضبط متى ينسحب، ويتركها لتبدأ حياتها، وكان هذا بعد أن تخرّجت، وأنهت دراستها بامتيازٍ، وبعد أن نضجت، وتطهّرت روحُها من عقد الماضي وأعبائه؛ بعد أن استوعب عقلُها وقلبُها معا أنّ بإمكانها أن تنفتح على الفرح والحياة دون التعويل على “أب” رمزيّ يسندها، بل بالانفتاح على شريكٍ حقيقيٍّ، أُلمح إليه بجايسون، الذي يبدو أنّ قصّة جميلة تنتظرهما قريبا، وكان الترميز السينمائيّ لهذا بالإشارة إلى تغييرها رقم هاتفها، وقصّها شعرَها، ممّا يذكّر بعملٍ سابقٍ للمخرِج نفسه، هو رائعته الخالدة: “مالينا”
وبعد، يمكن تقديم وصفٍ أخيرٍ لهذا الفيلم الجميل، هو أنّه جذوة المشاعر الإنسانيّة الأصيلة، وقد قبضت عليها عبقريّة “تورناتوري” وقدّمتها في التحفة الفنيّة المدهشة!
(La Corrispondenza) فيلم سينمائيّ للمخرج الإيطاليّ “جوزيبّي تورناتوري”(Tornatore) قدّم سنة 2016.













 في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...
في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...