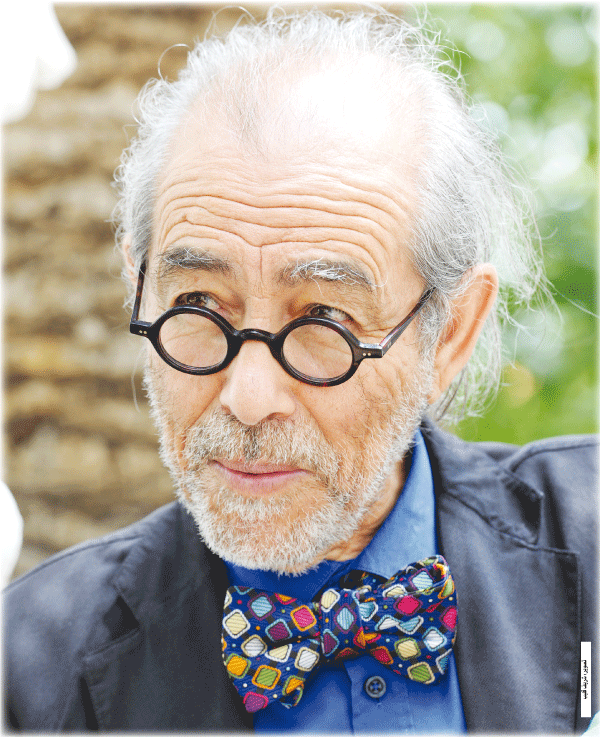
أحمد بن يحيى .. فنان بألوان الطيف
أنيقٌ بربطةِ عُنقٍ تميّزها الألوانُ ومنديلٍ حريريٍّ يزيّنُ جيب الصّدر، عمرُ ريشتِه يزيدُ عن ستّين سنة، يرسمُ الحياةَ من منظورِ شابٍّ عاش زمن الاستقلال و عرف السّنوات التي سبقته، يطوّع المعادن ليصنعَ منها منحوتاتٍ تروي الحب و البطولات و تُترجم معاني الألم. أحمد بن يحيى فنان بألوان الطيف، تُشيرُ لوحاته إلى قسنطينة و جسورها و تُعبّر منحوتاته عن تاريخ الجزائر ورجالاتها، يمزجُ الفنَّ بالسيّاسةِ كما تمتزج الصور و الألوان في خياله، لتنتج لوحاتٍ فيها بعض الكلام و كثير من ضوء و ضوضاء المدينة و الوطن.
هدى طابي
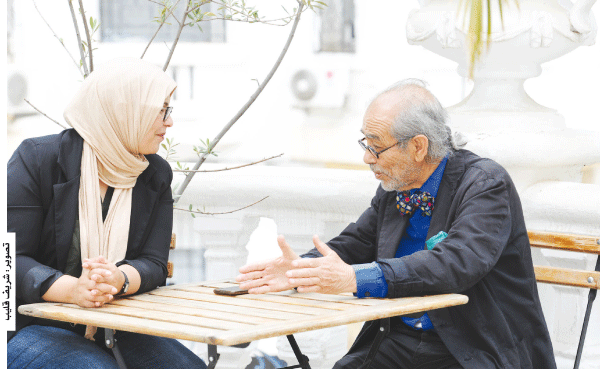
معالم اللوحة المتمردة
ولد أحمد بن يحيى، سنة1943 بشلغوم العيد، وقد نضج حسّه الإبداعي مبكرا، كما أخبرنا خلال لقاء جمعنا به مؤخرا، ففي سنّ الثامنة و هو تلميذ صغير بمدرسة جول فيري بقسنطينة، وقعت أول برتقالة على ورقته البيضاء في حصة الرّسم ففجّرت حقلًا من الجاذبية الفنيّة، و هكذا سحبه عشق الألوان تدريجيا وصار متيّما بها و طالبا للتفوّق و التميّز في المجال. قال لنا، بأنّ معمّرًا صديقًا لوالده هو من فتح له باب مدرسة الفنون الجميلة ببلدية قسنطينة وعمره لا يتعدى 13سنة، وقد كان مقرّها آنذاك بناية المسرح الجهوي، حينها كان أحمد بن يحيى، الفتى الجزائري المسلم الوحيد الذي يحمل لوح التلوين بين أبناء المُعمّرين، وهو أمر لم يستسغه زملاؤه في الصف ولا أهاليهم، حتى أنه واجه كثيرا من الكراهيّة والرّفض في بدايته.
واصل حديثه عن تلك المرحلة قائلًا، بأنّه استطاع بين سنوات 1956 و 1962 أن يفرض نفسه بفضل تميز رسوماته و تفرد موهبته واستحق الاحترام و التقدير من محيطه، وفي بداية الاستقلال عند مغادرة الفرنسيين اقترح مدير المدرسة على رئيس بلدية قسنطينة آنذاك، عبد السلام راشي، أن يخلفه أحمد الفنان الشاب على رأس المؤسسة وهكذا أعاد بن يحيى فتحها من جديد وساهم على حد تأكيده، في تكوين أول جيل من الفنانين الجزائريين الشباب في زمن الجزائر المستقلة بين 1962 إلى 1963، إلى جانب عمله كمدرس للرسم وتاريخ الفنون بثانوية حيحي المكي، قبل أن يغادر إلى العاصمة ليصقل موهبته أكثر ويطلب الاحتراف.
في المدرسة الوطنية للفنون بالعاصمة، كانت شخصيّة الفنان المتمردة طاغية، و قد انعكس ذلك كما أخبرنا من خلال مساره الدراسي و مغامرات شاب ترفض ألوانه أن تهدأ، حيث شارك على حد قوله، دون علم أساتذته في مسابقة للطابع البريدي و الملصقة، نظمت على هامش أول معرض دولي اقتصادي احتضنته الجزائر سنة 1964، و تفوّق فيها، الأمر الذي لم يغفر له وكان حسبه، سببًا غير مباشر في طرده من المدرسة لاحقا إلى جانب اتهامه بالتشويش خلال مرحلة التصحيح الثوري في 19 جوان 1965 بوصفه واحدا من الرافضين لعملية الانتقال السياسي.
قال الفنان، بأنه اجتاز بعدها اختباراته النهائية كمترشح حر، وفي سنة 1966 تخرج بشهادة ناجح من المدرسة الوطنية الفنون، قبل أن يغادر نحو المدرسة العليا للفنون بباريس بسبب ظروف معينة لم يفصل فيها كثيرا.
في مدينة الجن والملائكة بين سنوات 1966 و 1969 عانق بن يحيى فنّ النّحت لأول مرة، كما قال، وهي موهبة اكتشفها و غذاها في ورشات متخصّصة أشرف عليها نحاتون مهمون من أمثال «أدون» و «سيزار بالداتشيني». وفي سنة 1968، شهدت فرنسا إضرابات عارمة عاش الفنان أحداثها وكان شاهدا عليها، فقرر، أن يلبس كل منحوتاته ثوب النضال و التحدي وأن لا يعريها أبدا من خيالات السياسة.أخبرنا، بأن النحات الفرنسي سيزار بالداتشيني الذي كان أستاذه في المدرسة الفرنسية، راسل لاحقا أحد أشهر المهندسين الأوروبيين العاملين في الجزائر وأوصاه به وبفنه، فعاد إلى الوطن بناء على ذات التوصية، و عمل على مشاريع مختلفة أهمها تمثال زيغود يوسف، الذي يرتبط بقصة صراع يروي تفاصيلها في كل مرة بكثير من التأثر و الحسرة وهي قصة بدأت من بلدية صغيرة شمال شرقي ولاية قسنطينة وانتهت على طاولة الرئيس بومدين.
الأزرق يعرفني
يتحدث الفنان عن نفسه فيقول: « يعرفني اللون الأزرق و يشبهني لأنه عميق جدا مثل المحيطات، الأزرق لون اللانهاية يمتد بامتداد السماء و الأفق». يحب بن يحيى الفوشيا كذلك لأنه يشبه الخيال في جماله، أما الأصفر فهو في نظره لون العاطفة، وهو ذلك لون يمثل الأنثى في لوحاته. 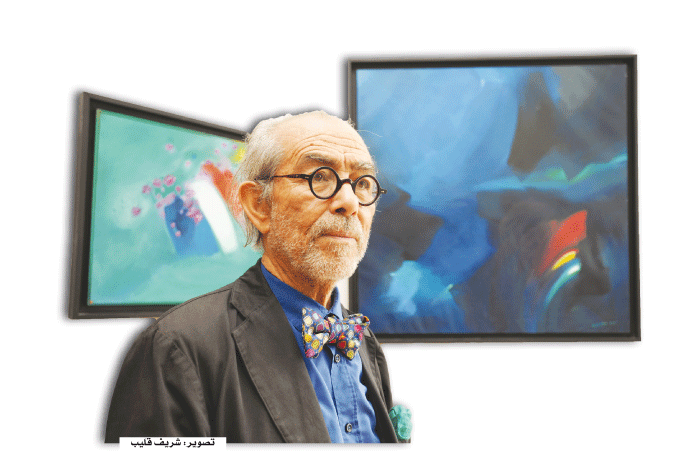
تجتمع في قبضته روح النحت و رائحة الألوان الزيتية و تتناغمان معا لتشكلا صورة مبدع يؤكد، بأنه يتحدث لغة الإحساس و الحرية، فنان عصي على التصنيف و لا ينتمي إلى مدرسة واحدة، يعتبر بن يحيى نفسه نحاتا متفردا لا يحتاج كما عبر، إلى الآلة ليصنع نصبا ثلاثي الأبعاد، بل يترجم من خلال أعماله نظرته للحياة بعيدا عن القوالب التقليدية و يسرد بعضا من تجاربه ليوسع آفاق التفكير و يساعد على تبني أبجديات الجمال في الخطاب المجتمعي.
يصف فنه، بأنه جامع لمفاهيم مختلفة هي الحب و الحياة و التمرد و الشغف والألم و الوطن و قسنطينة، المدينة التي سكنته بتضاريسها منذ أن كان طفلا صغيرا يجوب شوارع حي «ربعين شريف»، وأجبرته على مغادرة باريس، ليعود إليها و يعلق الآمال والأحلام على حبال جسورها. ورغم أنه درس الفن في الداخل والخارج، لكنه يرفض أن يحشر فنه في خانة الأساليب والاتجاهات الضيقة على تعددها، أو أن يكون نسخة مقلدة عن فنان آخر، مع ذلك يقول بأن لديه عملين اثنين يفكان شيفرة ريشته هما « الهجرة» و « فلسطين». لوحتان تعرفانه تماما كما تعرف لوحة « غيرنكا» بيكاسو، و تشكل لوحة « الحرية تقود الشعب» هوية دولاكروا، فنانه المفضل.
تماثيل لم تنصفها الذائقة

شكلت الشخصيات الوطنية تحديا دائما بل هاجسا لبن يحيى، ولعل أشهر منحوتاته هو تمثال زيغود يوسف الذي انصهرت في قالبه قطع من نصب الديك الكولونيالي الذي كان يزين ساحة لابريش بقسنطينة ولهذا التمثال رمزية خاصة كما قال الفنان، لأنه مثقل بالقصص و الحقائق و التجاذبات السياسية والفكرية أنجز التمثال سنة 1968، و استعان في تحديد ملامحه بما احتفظت به ذاكرة زوجة الشهيد و شقيقته إلى جانب الوصف الذي قدمه كل من لخضر بن طوبال و بولعراس.
حضر موكب تدشين التمثال في 20أوت 1969 أزيد من 20 ألف شخص، ثم حملته رياح السياسة من مكان إلى آخر، إلى أن انتهى به المستقر في مقبرة الشهداء التي أكد بن يحيى، بأنه هو من وضع مخططها و اقترح موقعها الحالي.
وكما حاول أن يعيد قائد المنطقة الثانية إلى الواجهة رحل الفنان بذكرى الأمير عبد القادر إلى مكسيكو و عمل على مشروع نصب يخلده في أرض الأزتيك و المايا، انطلاقا من تصوره لشخصية الرجل. و للفنان أعمال نحتية أخرى مشبعة بالعناصر التاريخية منها منحوتة حول الثورة الزراعية أنجزها سنة 1973، وهي مهملة اليوم بأعالي منطقة الغراب بقسنطينة، إضافة إلى نصب تذكاري حول مجازر 8 ماي 1945 بقالمة، قال بأنه تعرض للتخريب وشوهت معالمه الحقيقية.
مجلة مالك حداد ولوحة كاتب ياسين
جمعته بمالك حداد تجربة مختلفة، حيث أوكل إليه سنة 1963 مهمة إعداد واجهة للعدد الوحيد من مجلته « كونسطانتين»، فرسم العنوان على شكل قوس جسر سيدي راشد، أما مقدمة العمل فصف حروف كلماتها لتشكل مفتاحا، مستوحيا الفكرة من عبارة « مفتاح لسيرتا» وهو عنوان عمود صحفي لمالك حداد في جريدة النصر قبل تعريبها.
أما لقاؤه بكاتب ياسين، فكان بباريس خلال عرض لمسرحيته « مسحوق الذكاء»، أين تعارفا كمبدعين من الجزائر، ولم يتجدد اللقاء إلا خلال عودة صاحب « نجمة» إلى فرنسا مجددا لعرض عمله المسرحي « محمد خذ حقيبتك «، وكانت تلك محطة مهمة في تاريخ بن يحيى الفني، لأن المسرحية فجرت شلالا من العاطفة في داخله و غذت هاجسه بقضية الهجرة والعمالة وعبودية العصر الحديث، فرسم انطلاقا من وحيها واحدة من أشهر لوحاته « الهجرة»، وهي لوحة رفض بيعها، كما رفض التخلي عن تمثال وأعمال زيتية قال، بأنه أنجزها بعد تجربة في مستشفى قسنطينة الجامعي، لأنها تضمنت أعمق تعبير عن الألم والمعاناة الإنسانية.
«فلسطين» في رواق بيار كاردان
رسم الفنان كثيرا، وقال بأن ذاكرته لا تكاد تحصي كل ما أبدعته ريشته حيث أهدى أعمالا ولا يزال يحتفظ بأخرى، مع ذلك هناك لوحات تركت بصمتها في مساره على غرار لوحة رسمها للبنان أيام الحرب الأهلية و لوحة "فلسطين" التي كانت خلفية لوقفة شعرية لمحمود درويش بباريس سنة 1976.
تعرضت هذه اللوحة تحديدا لمحاولة سرقة سنة 1980 عند عرضها في رواق لبيار كاردان، احتضن معرضا للفن التشكيلي العربي، و قد تسبب عرضها حسب الفنان، في مشاكل للمصمم العالمي على خلفية مدلولاتها السياسية، إذ واجه ضغوطات من اللوبي الصهيوني في باريس.
جمعت الفنان علاقة بكثير من الشخصيات الجزائرية و العربية التي قدرت فنه على حد تعبيره، منهم الملكة فريدة زوجة الملك فاروق، التي قال بأنها كانت من المعجبين جدا بريشته وألوانه، كما تبنى الرئيس الراحل هواري بومدين، مشاريع اقترحها محدثنا على غرار مشروع مركب ثقافي بميناء سيدي فرج، كان كبيرا ولكنه توقف برحيل الرئيس.
متحف ستحتضنه جدران بيتي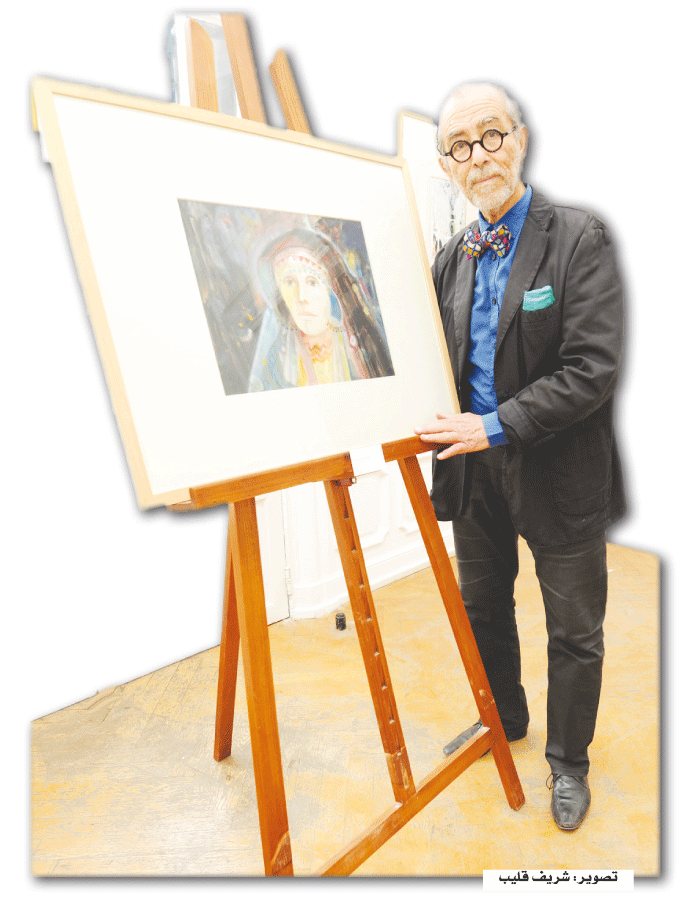
لم يحبس أحمد بن يحيى نفسه يوما بين قوالب النحت وعدة الرسم، فقد خاض تجربة التمثيل وأدى سنة 2008 دور الدكتور لمين دباغين، في فيلم كريم بلقاسم للمخرج أحمد راشدي، كما اشتغل أيضا، إلى جانب المخرج بدر الدين ميلي، و كان دائما فنانا حالما صاحب أفكار اقترح بعضها و ساهم في نجاح أخرى.أخبرنا، بأنه كان يحلم بإنجاز متحف للذاكرة على مستوى مقر سجن الكدية حاليا، و كان أيضا حارسا لنصب الأموات وحاميا له، حيث أحبط سعي جمعية للأقدام السوداء كان أعضاؤها مستعدين لدفع الكثير من أجل اقتلاع النصب من قسنطينة و ترحيله نحو مارسيليا، كما حال دون قرار هدمه في سنوات لاحقة.
اليوم، يخطط أحمد بن يحيى، لتحويل بيته العائلي إلى متحف يضم كل أعماله الزيتية والنحتية و يترجم فلسفته كفنان تشكيلي و نحات، أورث الكثير من جينات الإبداع لابنه رسيم باي و تقاسم البعض منها مع شقيقته الفنانة التشكيلية صامتة بن يحيى.












 في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...
في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...