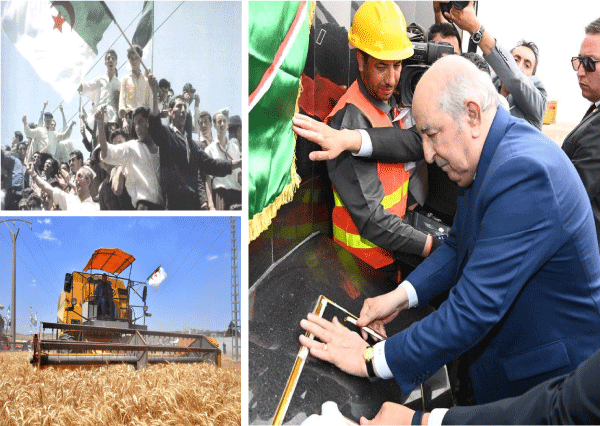
تحيي الجزائر الذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية في سياق يتميز باستكمال مسار بناء جزائر جديدة منتصرة وفية لمبادئ أول نوفمبر 1954، سيدة في قراراتها، ترتكز على قاعدة مؤسساتية صلبة وممارسة ديمقراطية حقيقية وصولا إلى تجسيد الأهداف التي حددتها رسالة الشهداء بصون وتعزيز السيادة الوطنية، والمواصلة في مشروع البناء الوطني استجابة لطموحات الشعب الجزائري.
تحتفل الجزائر هذا الخامس من يوليو بالذكرى 64 للاستقلال والسيادة الوطنية، والتي أخذت كل معانيها مع استكمال بناء أسس «الجزائر الجديدة والمنتصرة» الوفية لمبادئ الثورة التحريرية ومرتكزة على الثوابت التي ترسخت منذ 1962، تعزيزاً للسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، رغم المناورات والدسائس التي حيكت في الخفاء من قبل دوائر أجنبية معادية وجهات متربصة.
وقد وضع رئيس الجمهورية على رأس أولوياته استكمال دعائم السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي عبر تسريع وتيرة التنمية وشموليتها لتمس كافة التراب الوطني وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع هيكلية ستغير وجه البلاد في السنوات المقبلة، وعيا منه بأن التحدي الحقيقي للبلاد بعد استرجاع سيادتها يكمن في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في ظروف إقليمية ودولية تستوجب تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية.
وقد أكد رئيس الجمهورية، في تصريح سابق، أن السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على جيش قوي مهاب واقتصاد متطور وأن التطور الذي تشهده الجزائر أمر ملموس لا ينكره إلا جاحد. وبطاقات شبانية متشبعة بالروح الوطنية ومتفتحة على العالم، مع العمل المتواصل لرص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة المحاولات التي تسعى لضرب سيادة واستقرار البلاد.
وإذا كان الطابع التاريخي والعاطفي يغلب على الاحتفال بعيد الاستقلال، فإن التطورات الراهنة التي يشهدها العالم والتحولات الجيو ستراتيجية التي يشهدها العالم وسط حروب ونزاعات وانتهاك للسيادة الوطنية لعدة دول سواء عبر الحملات العسكرية أو إثارة النعرات الداخلية أو من خلال عصابات من المرتزقة، يفرض على الجميع التفكير في التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد بسبب الإضرابات المحيطة بها، وكذا التحديات الاقتصادية بعد 63 سنة من الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، لأن الجانب الاقتصادي جزء مهم من السيادة الوطنية خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.
وبالنسبة للجزائريين فإن مبدأ السيادة الوطنية سيبقى دوما أحد المقومات الأساسية للدولة وخطا أحمر لا يسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف أو مسمى، فالجزائر، التي دفعت الملايين من الشهداء ثمنا لاستعادة سيادتها، «تصر اليوم على صونها والدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة والمضي في طريق تعزيز المكتسبات التي تحققت على خطى بناء الدولة الجزائرية على أسس قوية.
الحفاظ على الذاكرة والتطلع لجزائر قوية ومنتصرة
وقد جعلت الجزائر من الحفاظ على الذاكرة الوطنية والعرفان لتضحيات المجاهدين والشهداء واجبا مقدسا وواحدة من أهم الأولويات، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية الذي أكد في عديد المناسبات حرصه على ملف التاريخ والذاكرة، والذي ينبع من تلك الصفحات المجيدة ومن تقدير الدولة لمسؤوليتها تجاه رصيدها التاريخي، باعتباره أحد المقومات التي صهرت الهوية الوطنية الجزائرية.. وهو حرص ينأى عن كل مزايدة أو مساومة لصون ذاكرتنا بعيدا عن الاستغلال السياسي.
ويحتفي الجزائريون هذا العام بذكرى استرجاع السيادة الوطنية، وهم يشهدون تجسيد معالم عهد جديد، يستند إلى إرادة سياسية قوية كرست القطيعة مع ممارسات الماضي واختارت الاندماج في مشروع وطني واعد. وقد عمل رئيس الجمهورية، على التأسيس للجزائر الجديدة انطلاقا من الإرث التاريخي والوطني الذي يعد أساسا صلبا تقوم عليه اليوم الدولة الوطنية المستقلة التي صمدت وانتصرت بمرجعية نوفمبرية أمام الهزات والمحن، حيث نجح في إعادة الثقة بين الجزائريين ودولتهم، وتكريس الدولة الاجتماعية التي تضمنها بيان أول نوفمبر.
كما نجحت الجزائر في استعادة مكانتها دوليا وتواجدها الوازن في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، بفضل مواقفها المتوازنة البعيدة عن كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودورها الريادي في نصرة القضايا العادلة في العالم، وترجيح الحلول السياسية على الخيارات العسكرية التي تكون سببا في دمار الدول على غرار ما عرفته عديد الدول في المنطقة العربية.
وتولي الدولة الجزائرية أهمية بالغة لتعزيز استقلالية القرار السياسي ودعم المواقف السيادية لاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية في إطار مبادئ الجزائر المساندة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذا دعم الحلول السلمية للنزاعات والخلافات وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إضافة إلى مساهمتها الفعالة كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، وفاعل مؤثر في ترقية التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الإطار متعدد الأطراف البناء والحيوي هو السبيل الوحيد لضمان علاقات دولية متوازنة وعادلة، بعيدا عن كل توجهات أحادية ومهيمنة.
برامج تنموية ستغير وجه الجزائر
وحرص رئيس الجمهورية على ترسيخ دعائم جزائر قوية ماضية في مسارها التنموي الشامل نحو تعزيز السيادة الوطنية بمفهومها الواسع لتشمل عديد المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية كما تفرعت إلى الأمن المائي والغذائي والمالي للحفاظ على استقلالية القرار وسيادة التوجه وتفادي السقوط في فخ الإملاءات الأجنبية تحت ذريعة الدعم الاقتصادي والمالي، وهي ذريعة عادة ما تستعملها الدول الكبرى لفرض منطقها وهيمنتها دوليا.
وشهدت الجزائر إطلاق ورشات تنموية للقضاء على الفوارق وإخراج مناطق واسعة من البلاد من «الظل إلى النور»، إضافة إلى استحداث الولايات الجنوبية العشر وتدعيمها بالموارد الضرورية للإقلاع التنموي، إلى جانب البرامج التكميلية للتنمية المقررة لفائدة عدد من الولايات والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع جاذبيتها.
واستطاعت البلاد في ظرف سنوات قليلة أن تقطع أشواطا هامة في كافة المجالات، بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يحرر المبادرات ويشجع على خلق الثروة، كما أطلقت الجزائر مشاريع ضخمة في قطاع المناجم، وهي مشاريع هيكلية حقيقية ستمكن البلاد من تحقيق قفزة تنموية كبيرة، كما ستغير وجه المناطق التي تحتضن هذه المشاريع، من خلال إطلاق العديد من المشاريع الكبرى على غرار مشروع غار جبيلات الذي أصبح حقيقة ولم يعد مجرد حلم، ومشروع السكة الحديدية تندوف – بشار الذي شُرع في إنجازه، ومشروع إنشاء أكبر مزرعة في العالم لإنتاج الحليب مع الأشقاء القطريين، إلى جانب تشجيع وتسهيل الاستثمار، مع إيلاء عناية خاصة بالشباب.
كما شكل الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، أحد أبرز الأولويات كونه من المبادئ الثابتة والراسخة للدولة الجزائرية والذي حافظت عليه منذ الاستقلال، وتم التأكيد مرارا على أن «اجتماعية الدولة الجزائرية تعد مبدأ ثابتا متجذرا ببيان أول نوفمبر 1954»، وعملت الجزائر على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية لاسيما بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020. وعلى هذا الأساس تم إدراجه، بالنظر إلى أهميته القصوى، ضمن الأحكام الصماء للدستور، أي النصوص غير القابلة للمراجعة.
كسب معركة الأمن الغذائي والمائي
ويعد ضمان الأمن الغذائي للبلاد ضمن الأهداف الرئيسية التي يتم العمل على تحقيقها لاستكمال أسس السيادة الوطنية وإبعاد البلاد عن كل مخاطر التبعية الغذائية، ولهذا جاءت تحديات الأمن الغذائي في صلب اهتمامات السلطات العمومية من خلال برامج لدعم الإنتاج الفلاحي والمضي قدما في ضمان الأمن الغذائي للبلاد في أقرب الآجال الممكنة ما يجعل الجزائر بمنأى عن تقلبات الأسعار، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
ويعد الأمن الغذائي والسيادة الوطنية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، حيث يشكل الأمن الغذائي جزءًا أساسيًا من السيادة الوطنية. فالقدرة على توفير الغذاء الكافي والآمن والمغذي للشعب، دون الاعتماد على الآخرين، تعزز استقلالية الدولة وتزيد من قدرتها على اتخاذ القرارات السيادية بحرية. وبالتالي، فإن تحقيق الأمن الغذائي يساهم في تعزيز السيادة الوطنية، بينما السيادة الوطنية توفر البيئة المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي.
وقد وضعت الجزائر تحقيق أمنها الغذائي والمائي وتوفير كافة الظروف لتجسيده في صلب استراتيجياتها لما لذلك من تأثير على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبشكل أخص على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي للدولة. وقد صنف برنامج التغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجزائر، الأولى إفريقيا في مجال الأمن الغذائي. حيث تم إيلاء أهمية خاصة للفلاحة، وتم تسطير إستراتيجية لتوسيع المساحات المزروعة خاصة بالجنوب وتشجيع الاستثمار ومساعدة الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وإطلاق برنامج ضخم لإنشاء صوامع لتخزين الحبوب، وهي كلها عوامل ساهمت في رفع أداء القطاع الفلاحي.
كما تقدمت الجزائر بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي، من خلال استراتيجية ورؤية استشرافية سمحت باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل التوصل إلى تحقيق الأمن المائي، وتم بهذا الخصوص إطلاق برامج استعجالية لمواجهة شح التزود بالمياه متمثلة في إنجاز الآبار في عديد الولايات، فضلا عن برنامج إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، الذي سطر على المديين المتوسط والقصير.
كما تحرص السلطات العمومية على ضمان الأمن السيبراني واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات وكذا توظيف الكفاءات الجزائرية ضمن مشروع الرقمنة, على اعتبار أن حماية الأمن القومي تبدأ من ضمان السيادة الرقمية. ولهذا الغرض تحضر الحكومة لمشروع قانون تمهيدي جديد للأمن السيبراني لحماية الأنظمة المعلوماتية في البلاد من أي هجمات سيبرانية مع تعزيز البنى التحتية والتبليغ السريع عن المعنيين وحماية المعطيات الشخصية والتكوين المستمر للموظفين المكلفين بالأنظمة المعلوماتية.
والمؤكد أن الاستقلال السياسي الذي جاء بدماء ملايين من الشهداء على مدى 132 سنة، لن يكتمل دون تحقيق السيادة الاقتصادية واستقلال القرار بعيدا عن الضغوطات والاملاءات التي تحاول فرضها الدوائر الأجنبية والجهات المعادية التي تسعى لضرب وحدة الشعب وزرع الفتنة والتفرقة وضرب مؤسسات الدولة، وعملت بلا هوادة على التشكيك في الأرقام والمنجزات المحققة وروجت الأكاذيب والمغالطات وهو ما يستوجب تقوية الجبهة الداخلية حتى تبقى الجزائر على الدوام قوية مزدهرة باقتصادها ومقدراتها، صلبة موحدة بشعبها ومؤسساتها، آمنة بجيشها الوطني الشعبي صائن وديعة الشهداء.
ع سمير