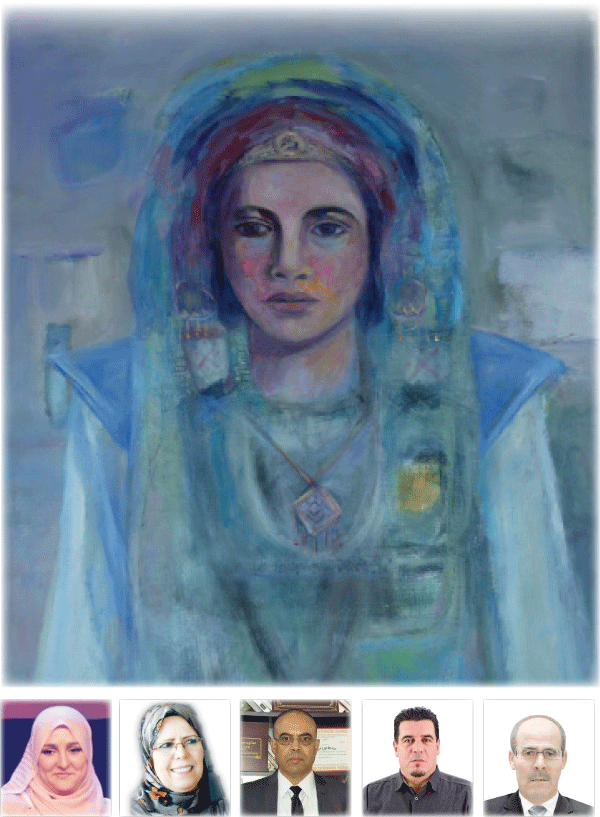
روايات كثيرة تناولت وعالجت الهوية والذاكرة. وكان التناول متعدّد الرؤى والسياقات، متعدّد المحاكاة والاستحضار، ومتعدّد التمثلات والتنويعات. كما شكّلت موضوعة الهويةوالذاكرة جوهر الرواية الجزائرية في مرحلة البدايات خاصةً (وحتّى اليوم)، فاشتغلت عليها وقاربتها سرديًا وفنيًا بإبداعية خالصة أحيانا، وبإيديولوجية لافتة أحيانا أخرى.
إستطلاع/ نــوّارة لحــرش
وهذا ما يجعلنا اليوم نطرح أسئلة ذات صلة بهذا الموضوع، أي (الرواية الجزائرية وتيمة ورهانات الهوية والذاكرة)، أهمها: كيف حضرت الهوية والذاكرة في الرواية الجزائرية؟ وكيف عالجت هذه الثنائية/ الإشكالية، أو هذه المسألة/التيمة؟ كيف قاربتها/ كيف تمثلتها؟ وكيف كانت درجة أو مستويات محاكاة واستحضار الذاكرة ومساءلتها؟ وإلى أي حد أصبحت علاقة الرواية بالهوية والذاكرة مربكة أو مزعجة في أطر وسياقات مختلفة ومتباينة؟
حول هذا الشأن "الرواية الجزائرية وتيمة الهوية والذاكرة". كان ملف هذا العدد من "كراس الثقافة"، مع مجموعة من الأساتذة و الباحثين والنقاد الأدبيين.

قلولي بن ساعد: الرواية أرض التعدّد و الهوية يتنازعها منظوران في الجزائر
عندما نتحدث عن الحضور الطاغي أو النسبي لقضايا الهوية والذاكرة في الرواية الجزائرية فينبغي أن نضع بعين الاِعتبار بأنّ هذا الحضور لا يخص فقط رواية الأطروحة الإيديولوجية المكتوبة في السبعينيات من القرن المُنصرم والتي يتجلى فيها المحمول الإيديولوجي لأشكال وتمثلات الهوية الجزائرية ببعديها اللساني والثقافي في سياقٍ مُربك، هو السياق الثقافي لجزائر ما بعد الاِستعمار.
وهي التي خصص لها الناقد الجزائري الدكتور مخلوف عامر كتابًا مُهمًا، هو "الهوية والنص السردي". وربّما اِهتم مخلوف عامر بنوعٍ مُحدّد من أنواع الهوية وهو الهوية الثقافية بمكوناتها التاريخية والنفسية والأنتروبولوجية.
وهي عندما تحضر في النص الروائي الجزائري والمغاربي عمومًا تحضر بوصفها هوية خطابية بالمعنى الّذي يقترحه الناقد الهندي ما بعد الكولونيالي "هومي بابا" عندما يرى أنّ الأُمم سرديات. ومعنى ذلك أنّ الهوية الخطابية ليست هي الهوية الواقعية كما تتجلى في الخطابات الدينية والإعلامية والسياسية أو كما يشعر بها المواطن والقارئ محدود التكوين. فالأمر يتعلق بهويةٍ أخرى هي هوية (الجماعات المُتخيلة) كما اِفترض اِنتشارها بينيديكت أندرسون في كتابه القيم "الجماعات المتخيلة: تأملات في القومية واِنتشارها".ذلك أنّ الأمة كما يرى الناقد الثقافي البريطاني ستيورات هول "ليست كيانًا سياسيًا فقط إنّما هي أيضًا شيء ينتج معاني، أي أنّها نظامٌ من التَمَثُل الثقافي أو جماعة رمزية، وهذا هو الشيء الّذي يُفسر سلطتها في توليد حِسها بالهوية والولاء".
ثُمَ هناك الهوية التي تحضر في النص الروائي الجديد/النص بوصفه حكاية/الحكاية التي تحتلُ موقعًا مُتقدمًا في الكتابة الروائية في العالم الثالث وفي رواية الأطراف. لأنّ كتابة السردية المُضادة هي مُبرر وجودها بعيداً عن ثقافوية السردية الاِستعمارية التي حاولت لَيّ عُنق التاريخ بِمَا يستجيبُ لإرادة "الهيمنة بالتخييل" بمفهوم وحيد بن بوعزيز في مهمةٍ عسيرة تطلبت من الروائي الحكاء التعويل على تسريد التاريخ أو الوعي بالكتابة الروائية بوصفها تاريخًا هو "التاريخ من الأسفل" حسب المفهوم الّذي وضعه الناقد الهندي ما بعد الكولونيالي ديبيش شاكابراتي في كتابه المُهم (مواطن الحداثة.. مقالات في صحوة دراسات التابع). وأنّ هذه الحكاية إذ تحضر في النص الروائي فهي تتسمُ بنوع من العودة إلى بعض الإحداثيات التي تُشكلُ المكون الأساسي لتراثنا الشفوي والأسطوري والسردي فيما يُشبهُ المطابقة والاِختلاف.
في نفس الوقت ترفدها في ذلك خبرة الروائي السوسيولوجية والأنتروبولوجية وثقافته التي تجمع الأسطوري بالمُتخيل بالواقعي بالفانتازي كما في "التراس" لكمال قرور، و"الغيث" لمحمّد ساري، و"تلك المحبة" للحبيب السائح، و"حروف الضباب" للخير شوّار، و"جبال الحنّاء" لعبد القادر برغوث، و"وحده يعلم" لعايدة خلدون. وهي شتات حكايات وأحداث مُحتملة في الحياة والعالم الماورائي الميتافيزيقي.
ذلك أنّ شخوصًا مثل الزواوي في "حروف الضباب"، وميرة في "جبال الحنّاء"، وسطورة واِبن عمها خثر في رواية "وحده يعلم" لعائدة خلدون، واللقلق ونانا خدوج والعرافة في رواية "التراس" لكمال قرور، وما تُحيلُ إليه من وقائع غرائبية وحالات أقرب إلى الفناء والتجلي بالمعنى الصوفي.
بِمَا يجعلُ الروائي يختبر فِعله الإبداعي الجديد عبر العودة إلى بعض إحداثيات التاريخ ومكونات المجتمع الهوياتية وتراثه السردي وملاحمه الشعبية التي تعود بجذورها في التراث الروائي الجزائري إلى تلك التجربة المفصلية التي دشنها الأعرج واسيني بنصه الروائي "نوّار اللوز-تغريبة صالح بن عامر الزوفري" كمرجع نظير يُحيل إلى رغبة الروائي العربي في اِستدعاء التراث السردي ومنحه بُعداً معاصرا.
وهي عودة أشبه بالعود الأبدي عند نيتشه كما يراه رولان بارت "إيذانٌ بعودة المعنى كاِختلاف وفرق وليس كتطابق وهوية". بِمَا يعني الاِقتراب مِمَا يُسميه الناقد الثقافي البريطاني ستيورات هول "الهوية المنزوعة المركزية" في اِرتباطها بقضايا الهجنة الثقافية في ضوء النظرية ما بعد الكولونيالية الميالة لنقد الأنساق الثقافية المضمرة في الخطاب الهوياتي من داخل الرواية بوصفها "الفضاء المتنازع عليه" كما يتمظهر في النقد الثقافي عند إدوارد سعيد.
وليس من قبيل الصدفة أن نجد هذه السردية/سردية "الهوية المنزوعة المركزية" أو "الهوية المنشطرة" بمفهوم "هومي بابا" تحضر بقوّة في النصوص الروائية الجزائرية المكتوبة باللّغة الفرنسية، بينما هي قليلة الحضور في الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية.
كما لو أنّ هذه الهوية تكاد تكون محسومة في نظر المثقف المعرب بينما هي محل نقد ومراجعة لدى المثقف الفرانكو جزائري بحكم المنفى أو إقامته داخل ذلك الّذي يسميه "هومي بابا" -الفضاء الثالث- فهو هنا وليس هنا بحسب تعبير إدوارد سعيد لدرجة الاِنسياق وراء ما يُحيل إليه فيلسوف الاِختلاف جاك دريدا عندما يتحدث في كِتاب حميمي عن "أحادية الآخر اللغوية".
طالما أنّ الرواية هي ذاتها فضاء الهجنة والتعدّد على ما يكشف ذلك عمل مهم هو "الخطاب الروائي" لميخائل باختين. وهذا أمرٌ يحتاج إلى قراءة أخرى كفيلة بأن تستدعي نقاشًا حرا ليس هنا مجاله ولا المقام يسمح باِستقصاء ما يتوارى خلف ماكنة "النقد المزدوج" للسرديتين سردية الهوية المحسومة في نظر الروائي المعرب و"سردية الهوية المنزوعة المركزية" عند الروائي الفرانكو جزائري.

عبد الحميد ختالــــة: الهوية كقيمة سردية بارزة في الرواية الجزائرية
يُعدّ موضوع الهوية من أكثر القضايا التي تستفز العقل البشري بمختلف اِنتماءاته سواء أكانت الدينية أم العرقية أم الوطنية أم الاِجتماعية أم السياسية...، هذا ما أنتج تداخلاً عميقًا في ما يُحيط بهذه القضية من أفهام ومفاهيم، خاصةً لما يتعلق الأمر بالاِشتغال عليها كمؤثث تخييلي في النص الأدبي، وقد تُدْرج موضوعة الهوية كمُحفز جوهري لتوسيع مساحات الذاكرة في مختلف الفنون السردية والشِّعرية والأدائية كذلك.
وقد شكّلت موضوعة الهوية جوهر الرواية الجزائرية في مرحلة البدايات بوصفها سيرورة سيكولوجية تتوسل الذاكرة، هذه التي ما فتئت تُمثل المُتكأ السردي الّذي يُحاور الفرد في أناه وتاريخه، وقد كانت الرواية الجزائرية وقتئذ حديثة عهدٍ بالثورة التحريرية ما عزّز سؤال الهوية لدى المثقف وكذا الفرد العادي، حيثُ لا يخفى على قارئ روايات الطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة ذلك الدفق الوطني الّذي تكثّفَ على مساحات واسعة سرديًا.
لكن الّذي وجبت الإشارة إليه هو أنّ الهوية في الأدب عامة وفي الرواية خاصة قد تُقرأ من زاويتين، الأولى هي توظيف الهوية كقيمة سردية يشتغل عليها النص الروائي اِجتماعيًا وثقافيًا، وهذا الّذي لم يغفل عنه الدرس النقدي في قراءته للمنجز الروائي الجزائري، خاصةً عندما يتم المزج فنيًا بين الهوية والذاكرة أو لنقل عندما تتوسل الرواية الذاكرةَ من أجل تبئير قيمة الهوية، مثل الّذي نقرأه في كتابات جملة من الروائيين الجزائريين مثل وطار، بن هدوقة، بقطاش، وجيلالي خلاص، وكذلك من لحقهم من الجيل الثاني من الروائيين مثل عز الدين جلاوجي ومحمّد مفلاح وأحلام مستغانمي.
أمّا الزاوية الثانية التي نُشدد الاِهتمام بها وهي الهوية التي يكتسبها النص الروائي نفسه، من خلال جملة من المُرتكزات السردية مثل اللّغة والشخصيات وأسماء الأماكن، هذه التي تُعطي للنص هويته بغض النظر عن معرفة كاتبه وانتمائه، وهنا نستحضر قول "هايدوغر": "اللّغة بيت الوجود في بيتها يُقيم الإنسان وهؤلاء الذين يفكرون بالكلمات ويحلقون بها هُم حرّاس ذلك البيت"، فالّذي اِشتغلت عليه ثلاثية "الأرض والرّيح" لعز الدين جلاوجي أكبر من أن يصنفها ضمن الرواية التاريخية فحسب، سيما وقد برزت فيها كلّ عناصر الهوية الجزائرية تاريخيًا وعقديًا وسياسيًا، وبخاصة على مستوى القيمة الثقافية المكثفة جداً على مستوى اللّغة الناطقة في الرواية.
إنّ الرصيد التاريخي والثقافي الّذي يتمتع به المجتمع الجزائري لكفيلٌ بأن يجعل منه أمة مُتفردة بماضيها المُعتق وتاريخها المجيد، هذا الرصيد كفيلٌ بأن يُحدّد المرجعيات السردية للرواية الجزائرية ليظهر خط الاِنتماء بارزاً في التحوّلات السردية داخل أي نص روائي جزائري، حيث يُشكل التاريخ المُشترك لأي جماعة بشرية مُنطلقا لتحديد هويتها الدينية والوطنية والثقافية. فيكفي أن تقرأ أي رواية جزائرية تستحضر شخصية الأمير عبد القادر الجزائري لتستعيد الذاكرة الجمعية للمجتمع الجزائري، وهذا الّذي سيحيلك مباشرةً على قضية الهوية بكلّ تفريعاتها.
نعم، لقد اِشتغلت الرواية الجزائرية على موضوعة الذاكرة واستبطنت فيها سؤال الهوية كقيمة سردية بارزة، ولا أحسب هذا غريبًا عن الكتابة السردية، حيثُ تبقى الرواية تشكيلٌ آخر للحياة ولا منأى لحياةٍ عن قيمة الهوية كمعطى إنساني وديني وثقافي. ثمّ إنّ النصوص التي لا تشتغل على الذاكرة قد اِستثناها الدرس النقدي تحت مُسمى الاِستشراف.

محمّـــد داود: النصوص الأدبية تتضمن تأويلا للذاكرة
إنّ أهمية التاريخ والذاكرة بديهية بالنسبة لجميع الشعوب فكلّ منهما يُؤسس لمفهوم الأمة ويُحدّد معالم البنية الاِجتماعية والثقافية والهوياتية للدولة الوطنية، ولهذا السبب فإنّهما محل صراع بين مختلف القِوى التي تشتغل في الساحة السياسية بِمَا يمنح لكلّ منها الشرعية في تولي السلطة أو الاِحتفاظ بها، ولذا نجدهما دائمًا محل رهانات سياسية وأيديولوجية كبيرة.
مع العِلم أنّ هناك فرقا بين الذاكرة التي هي القدرة على الاِحتفاظ بآثار الماضي وبالتالي إمكانية الرجوع إليها وفق أوضاع الحاضر وتوظيفها وِفق مقتضيات الحال، مِمَّا يجعلها ترتبط بالخطابات الهوياتية التي هي محل نقاشٍ واسع بين الفاعلين، لِمَا تحمله من ذاتية وتأويل منحاز لطرف دون آخر يسهل التلاعب بها والسعي إلى اِحتكار خطابها. ولكون خطاب الذاكرة دائمًا خطاب عاطفي وانتقائي فهو قابلٌ لتشويه التاريخ ولاِرتكاب الأخطاء وللتزييف. أمّا التاريخ الّذي هو بحثٌ عن الحقيقة وفق قراءة موضوعية مبنية على منهجية علمية وبالاِعتماد على الأدلة والوثائق التاريخية التي وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى العديد من الإسهامات الفكرية التي حاولت التمييز بينهما تعتبر بمثابة شهادة حية على الوقائع والأحداث، إذاً هناك فرقٌ واسعٌ وشاسعٌ بين الذاكرة والتاريخ، وكلّ شيء يجعلهما متعارضان. وعليه فكلّ طرف يملك ذاكرته، بل كلّ زمرة اِجتماعية أو سياسية تملك ذاكرتها، لكن هل يمكن للتاريخ بوصفه تخصصًا علميًا أن يصل إلى الحقيقة المبنية على الدراسة والتحليل والخطاب النقدي، مِمَّا يطرح كذلك مسألة ذاتية المُؤرخ الّذي قد لا يلتزم أحيانًا بالموضوعية في معالجته بعض الأحداث، ومن هنا النسبية التي قد تطبع كتابة التاريخ، الّذي هو غير الذاكرة التي تتعامل مع الأحداث والشخصيات من منطلق التقديس المُطلق، وعليه فالذاكرة مُتعددة بتعدّد المجموعات الحاملة لخطاباتها، إنّما التاريخ هو ملكية للجميع، وإن بدا ناقصًا في بعض جوانبه. وإذا كان الأمر جدُ معقد، من الناحية النظرية والعملية، بالنسبة لهذين العنصرين، فإنّ الأمر يزداد تعقيداً عندما يتعلق الأمر بعلاقة هذين العنصرين بالكتابة الأدبية، على اِعتبار أنّ النصوص الأدبية تُعبر عن ذاتية الكاتب وعن خلفيته الثقافية والأيديولوجية وعن الرسالة التي يودُّ تمريرها للقارئ، وقد يضيف إلى ذلك البُعد الخيالي الّذي هو أساس العمل الأدبي الّذي يُوظف التاريخ، مِمَّا يجعله يركز كثيراً على الذاكرة، ولهذا التعامل مع النصوص الأدبية لا يمكن لها أن تكون تاريخًا، بل هي تنويعات على الذاكرة التي قد تكون جماعية أو ملكية بعض المجموعات الثقافية أو السياسية. ولعل ما يُميز الأدب هو تعارضه مع الكتابة الرسمية للتاريخ ومع الحس المُشترك بين النّاس، لأنّه يتناول المسكوت عنه والمحظور. وقد يقوم بتوصيف للمجتمع في مرحلة من مراحله التاريخية ولعل الحدث التاريخي العظيم المُتمثل في الثورة التحريرية هو الّذي اِستقطب اِنتباه الكُتّاب في مُجملهم، ومنهم عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار وواسيني الأعرج والحبيب السايح ورشيد بوجدرة وبشير مفتي وحميد عبد القادر وغيرهم مع كُتّاب آخرين يكتبون باللّغة الفرنسية، فالخطاب التاريخي كان مُوجهًا ضدّ الآخر الفرنسي ومقاومًا له وباحثًا عن هوية حاول الاِستعمار طمسها. ولعل رواية "اللاز" للطاهر وطار هي النموذج المثالي لما نتحدث عنه، لكونه يميطُ اللثام عن جزء من المعارك التي كانت موجودة بين رفقاء السلاح... والنماذج في هذا السياق كثيرة؟ ونذكر منها رواية "الأمير" لواسيني الأعرج الّذي اِستغل التاريخ للدعوة لحوار الحضارات والأديان من خلال العلاقة الطيبة التي أقامها الأمير مع القس المسيحي "مونسنيور ديبوش" وقد عبرت الرواية عن رؤية للعالم كانت محل نقاش فيما بين الضفتين (الجزائر وفرنسا) حول الإرهاب والتسامح، العيش المشترك والذاكرة المشتركة، مِمَا أثار حفيظة الكثير من النُقاد الذين لم يرق لهم هذا الخطاب الروائي، وهناك رواية أخرى مكتوبة باللّغة الفرنسية وهي "قرية الألماني" لصاحبها "بوعلام صنصال" الّذي اِنخرط في الدفاع عن ضحايا النازية ، وهي إستراتيجية تسويقية اِعتمدها الكاتب للتموقع في الحقل الأدبي الفرنسي الّذي تُسيطر عليه اللوبيات المُختلفة، إلاّ أنّ هذا الروائي قدم تشويهًا متعمداً للثورة الجزائرية التي لم تتحالف مع القِوى النازية كما يدعي خطابه الروائي من خلال تصويره لمشاركة المخابرات النازية بالتعاون مع المخابرات المصرية في مساعدة جيش التحرير الوطني، وهذا في حد ذاته نزعة مراجعاتية تنحرف بالتاريخ الثوري عن مساره الطبيعي والمنطقي، وهو الأمر الّذي أفرح الكثير من الفاعلين الاِجتماعيين من ذوي النزعة الصهيونية وتلك الحاقدة على الثورة التحريرية من اليمين الفرنسي، المعتدل منه والمتطرف.
كما نذكر رواية "كولونيل الزبربر" للروائي السائح الحبيب الّذي أعاد زيارة هذه المنطقة باِعتبارها كانت معقلاً للثوّار في مقاومتهم للاِستعمار الفرنسي في الخمسينيات لتتحوّل إلى معقل للإرهاب في التسعينيات أي بعد حصول الجزائر على الاِستقلال بحوالي ثلاثين سنة، ويتعرض الروائي إلى العديد من المواقف التي ظلت في عداد المسكوت عنه وفي باب المحظور. إنّ توظيف التاريخ في الأدب الروائي هو تأويل للذاكرة يعبر عن رؤية العالم التي يحملها الأديب كما تعبر عن زمرته الاِجتماعية والسياسية وعن الأيديولوجية التي يتبناها وعن أهدافه الشخصية للتموقع في حقل من الحقول الأدبية سواء كانت وطنية أو عالمية، ونيل الشهرة، وهذا من حق الأدباء.

آمنـــــة بلعـــــلـى: وسائل الإعلام والتكنولوجيا أصبحت تتحكم في صيّاغة الكون الروائي
تُثير علاقة الرواية بالذاكرة والهويّة عدة إشكالات يتحكم فيها، مبدئيًا، الإقرار بأنّ الرواية إذا لم تكن أمامها ذاكرة وهوية، فإنّها تصنع لنفسها ذاكرتها الخاصة التي تُؤسس كينونتها. ولعل اِرتباط الرواية العربية بالتاريخ، بدءاً بِمَا سُميَ بالرواية التاريخية مع جورجي زيدان، مروراً بإعادة كتابة التاريخ الفرعوني مع نجيب محفوظ، فتوظيف التاريخ بعد نكبة حزيران، واستعادة أساليب الكتابة التاريخية، لعل ذلك ما يُؤكد الصلة الوثيقة التي تعقدها الرواية بالتاريخ في كلّ مراحل حياة هذا الجنس الأدبي عند العرب، حتّى أصبحت الرواية والتاريخ والهوية علاقة مُركبة لا يمكن الحديث عن مكون إلاّ وجر معه المكون الآخر.
يمكن النظر إلى تجليات هذه العلاقة، على الرغم من تعقدها وتصارع تمثيلات الروائيين فيها من خلال مستويين اثنين نعتقد أنّهما يلخصان علاقة الرواية بالذاكرة وكذا الهوية، التي تبدو صفة لاحقة للذاكرة، قبل أن تكون موضوعًا للرواية منذ نشأتها إلى الآن، في الرواية الجزائرية كما هو الشأن في الرواية العربية عامة. وهذان المستويان يكشفان في الوقت نفسه عن آليات اِشتغال الذاكرة والهوية في الرواية، وطبيعة التقاطع بين الذاكرة باِعتبارها تاريخًا والرواية بوصفها متخيلاً، وعن المواصفات التي تُمثل الهوية الجديدة التي تنتج عن هذا التقاطع. وهذان المستويان لا يحيدان عن غرضين اِثنين هما: تخيل الذاكرة وتأويلها. حيثُ يجنح الروائي إلى أخذ المادة التاريخية المُتحققة سلفًا والاِشتغال على الحدث أو الشخصية التاريخية أو الموضوع التاريخي وتأويلها بِمَا يخدم مقاصده، نقرأ تاريخًا ولكن من منظور الروائي الّذي يُوجه القارئ نحو أحداث أو صفات لشخصيات تاريخها مُختلف عمَّا عهده المُتلقي، أي أنّه يُحوّر فيها ويُسائلها ويُحاور بعض قضاياها، فربّما حوّل المتن هامشًا والهامش متنًا، وهكذا فالتخيل والتأويل وإعادة قراءة التاريخ جوهر هذا الاِشتغال وهو رهانٌ أدبي جديد يتموضع ضمن حركة ثقافية تعتمد إعادة النظر في المركزيات التاريخية تحت تأثير ثقافات العولمة والحداثة وما بعد الحداثة التي اِعتقد كثير من الروائيين أنّها نوع من المغامرة التي تستحق أن تُخاض. فشهدنا هذه العودة إلى التاريخ والهوية والذاكرة، وخاصةً بعد مرحلة العنف، وبشكلٍ لافت في مطلع الألفية الثالثة، وها هي الرواية الآن وقد أصبحت كائنًا مُتحوّلاً كأنّها الحرباء، تُعيد النّظر في ذاتها كلّ صباح، تُغيّر لباسها ولا تُبالي، تلبس وتتعرّى، تستعمل لباس غيرها أو تستعيد لباسها القديم. الّذي تَستعيرهُ من ذاكرتها، وأصبحت كائنًا مُتمرداً مُغامراً، يهمّهُ أن يكون ولا يهمّه كيف يكون. وجودها أصبح سابقًا لهويتها. كلّ النصوص أصبحت تحجُ إليها، من ذاكرات مُتعدّدة وأحيانًا مُتناقضة، وتواريخ منسية، وأخرى معروفة لكنّها تسعى لكي تعرف بطريقة أخرى.
ولذلك فعلاقة الرواية بالذاكرة والهوية أصبحت اليوم تطرح أسئلة تعد رهانات وتحديات يُواجهها الناقد بالدرجة الأولى، والّذي لابدّ أن تتحوّل وظيفتهُ المعرفية المُتخصصة نحو المعرفة الموسوعية، حتّى يصبح النقد فِعلاً ثقافيًا باِمتياز. ويستخرج الرؤية التي يتموضع من خلالها الروائي وهو يتعامل مع الذاكرة والهوية، هل هو ينطلق من الداخل، أم يستورد رؤية من الخارج.
المُلاحظ على ما يُكتب من روايات في الجزائر، وبغض النظر عن مجريات الاِختلافات الفرعية، يرى أنّ أصحابها يتموضعون في اِتجاهين كبيرين يكاد يكون أحدهما مُناقضًا للآخر، الأوّل يشتغل على الذاكرة ويدخل إليها باِعتبارها خصمًا يُحاكمها، ويستنطق الهويات البائدة فيها، ويُحاكم رموزها، ويُغير مسار العلاقة بينها وبين الهوية، بحثًا عن يوتوبيا هوياتية، فيكون بذلك قد اِحتكم إلى رؤية مستوردة هي جزء من الحنين إلى الكولونيالية، ولذلك نرى رهطًا من الروائيين الذين يكتبون من أجل مُحاكمة الذاكرة والهوية ونزع القيمة، فتصبح معولاً للهدم وإثارة النزاعات حول الهوية، ولذلك تتعرض الهوية في الجزائر إلى رجّات كبيرة لا تهدأ إحداها حتّى تبدأ الأخرى، وتجعلها موضوعًا للخلاف والصراع والنزاع، يُساهم الروائي فيها.وهناك في المُقابل اِتجاهٌ آخر يكتب من منطلق من يمتلك ذاكرة وهوية، فيعيد كتابته روائيًا لكي يستدعي الوجداني والقيمي والإنساني فيها، ويقيم جسراً مع الماضي، لتصبح فيه الذاكرة فكرة مُنتجة، وليست مجرّد موضوع روائي، فيكشف عن مواطن العتمة، ويقدم للقراء وجهًا جديداً يجعل به الهوية قابلة لكي تُعاش في اِنسجام مع صاحبها، وتنمو باِستثمار القيم التي تم تناسيها، فتعيد الاِهتمام بها وتستأنفها، لتبعثها حالة أخرى من حالات الهوية الإنسانية.
وفي ظل موجهات التكنولوجيات الجديدة، والتدفق السريع للمعلومة، أصبحت الرواية تعلق كلّ المصائب على القيم، ومنها قيمة الهوية وأصبحت وسائل الإعلام والتكنولوجيا تُؤسس لطرائق تمثيلات الروائيين، وتتحكّم في اِستراتيجياتهم وتأويلاتهم وفي مواقفهم، بل لا نُبالغ إن قلنا إنّها تتحكم في صياغة الكون الروائي كله، القائم على هاجس التدفق بأسئلته الإشكالية الجديدة، كالعودة إلى المناطق المظلمة من التاريخ، ونفض الغبار على تواريخ أخرى كانت مُغيبة. لقد خلقت التكنولوجيات واقعًا جديداً، وخلق هذا الواقع كونًا روائيًا، تقول فيه كلّ رواية إنّ الأشياء والأوطان والقيم والذاكرة والهوية والتاريخ والذات والآخر هي أعقد مِمَّا يمكن أن يتصوّره الروائيون.

منى صريفق: المبدع الجزائري يعرف جيداً كيف يتغذى من الذاكرة
الرواية الجزائرية وتيمة الهوية والذاكرة، هي من أكثر المواضيع مناقشةً على مستوى الجامعة الجزائرية. تحديداً في طروحات الطلبة المتخرجين والدراسات العُليا بطوريهما التدرج وما بعد التدرج. إلاّ أنّ الأهم بالنسبة للقارئ الآن أن يُفرق بين معالجة تيمة الهوية والذاكرة بمنأى عن الإبداع الأدبي وهو الشيء الّذي يفرض أولويات وخصوصية مُتعلقة بالأمة والقومية والوطنية وكتابة التاريخ. وبين مُعالجة الهوية والذاكرة كتيمات يشتغل من خلالهما الكاتب لكي يُقدم للقارئ قصة/رواية تقوم أحداثها في الأساس على أحداث ذات صلة بالذاكرة والهوية في إطار تخييلي. ولن يستقيم المفهوم في عقل القارئ إن نحنُ لم نفصل في الأساس بين المصطلحات الأساسية لهذا الموضوع.
فما هي الهوية؟ وما هي الذاكرة؟ وهل الهوية بشكلٍ عام هي ما يتطابق مع ما يُعرف بالهوية السردية؟ وهل الكاتب المُبدع عند اِشتغاله بطريقة متخيلة يستعمل الذاكرة التي يستخدمها المؤرخ أم أنّه يستعمل مفهومًا أكثر قدرة على تطويع الكتابة الإبداعية لديه؟
فالهوية كما يعرفها القُدماء العرب وتحديداً الجرجاني "الحقيقة المُطلقة، المُشتملة على الحقائق اِشتمال النواة على الشجرة في الغيب المُطلق"، ومن هنا نجد تعريفًا يقتضي بفكرة مفادها أنّ الهوية تتطابق وفكرة بطاقة الهوية التي أصبحت تُستخرج للمواطن في عصر التمدن بالإضافة إلى أبعاد سوسيولوجية، نفسية، وعلاقات ذاتية مع الأنا والآخر. في حين الهوية السردية كما يزعم بول ريكور هي مسار تكوينيّ يُصاغ بفن سردي وبحركة تفاعلية بين الأنا والآخر تأسيسًا للوجود. أمّا الذاكرة فإنّ كِتاب "لوغوف" المُعنون "الذاكرة والتاريخ" معبر تمامًا بهذا الخصوص وفيه قد قِيل إنّ تاريخ الذاكرة هو جزء من تاريخ التاريخ، أي ما يُمثل المادة الأولية للتاريخ. ونجد منها الذاكرة الفردية والأخرى الجمعية. كما أنّ للذاكرة قصدية تتجهُ نحو الحقيقة السابقة أو الواقع السابق. ما جعل بول ريكور يُقدم لنا مُصطلحًا يختزل من خلاله الذاكرة والتخييل معًا ألا وهو الاِستذكار كجزء من الذاكرة إذ هو تقنية تقوم في الأساس على إدخال العنصر التاريخي للذاكرة بالإضافة إلى القصد الّذي ترمي إليه ألا وهو القص أو فِعل السرد الّذي يعتمد في الأساس على الجانب التخييلي داخل الرواية. ولو حاولنا الاِقتراب من الثيمتين "الهوية والذاكرة" فسنجد المبدع الجزائري قد تمثل أمرين أساسين في كتابته بهذا الخصوص: أوّلهما: هو أنّه فهم جيداً مشاكل الهوية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، وأصبح يطرح أسئلة وجودية قيّمة كأن نجد أبطال الروايات يبحثون عن ذواتهم في مقابل الآخر الّذي غالبًا ما كان المُستعمر أو فكرة مُعاكسة أو نظامًا مُتجذراً ومن ثمّة تظهر صور مختلفة لإثبات الذات في الهوية الفردية لتصل إلى الجمعية وقد تمّ تمثيل هذا التأزم في مختلف النصوص الإبداعية الجزائرية من بينهم نجد نص الروائي الطاهر وطار "اللاّز"، الروائي رشيد بوجدرة في نصه "ألف وعام من الحنين"، نص "سيدة المقام: مراثي الجمعة الحزينة" للروائي واسيني الأعرج، "أنا وحاييم" للروائي الحبيب السائح، وغيرهم كثيرون. ثانيهما: أنّ الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعية كانت بمثابة خزّان ينضخ بمختلف القصص التي أغرت الكاتب الجزائري للحديث عنها ولمُمارسة فِعل الاِستذكار من خلالها بطريقة تضمن للنص الروائي ميثاقه الفني مع القارئ، ولتسكت تهافُت الأحداث داخل مخيلة الروائي من جهة ثانية؛ وهذه الأحداث أغلبها أحداث تاريخية متعلقة بالاِستعمار أو مرحلة ما بعد الاِستعمار وسواء كان على مستوى الذاكرة الفردية أو الذاكرة الجمعية فالأمر سيان. إذ الكاتب الجزائري يرى أنّ همومه الشخصية وذاكرته التي يسجلها التاريخ -باِعتباره بناءً معرفيًا قاراً وثابتًا- له هوامش يجب عليه الاِستذكار والاِشتغال عليها بمساعدة آليته الرئيسية ألا وهي التخييل. ولن أجد مثالاً معاصراً من النصوص الجزائرية الإبداعية أوضح من رواية "فنجان قهوة وقطعة كرواسون" رحلة في اِتجاه واحد للروائي "سالمي ناصر" والتي أنهيتُ قراءتها مؤخراً مستنتجةً أنّ المبدع الجزائري بعامة وسالمي ناصر بخاصة يعرف جيداً كيف يتغذى وينهل من فكرة الهوية والذاكرة الجمعية بطريقة تخلق لنا تساؤلات جديدة. وإمكانات فلسفية جديدة لمعالجة الثيمتين.












 في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...
في ربيع عام 2023 وبعد أشهر قليلة من صدور روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، نشر الرئيس التنفيذي لمنصة...