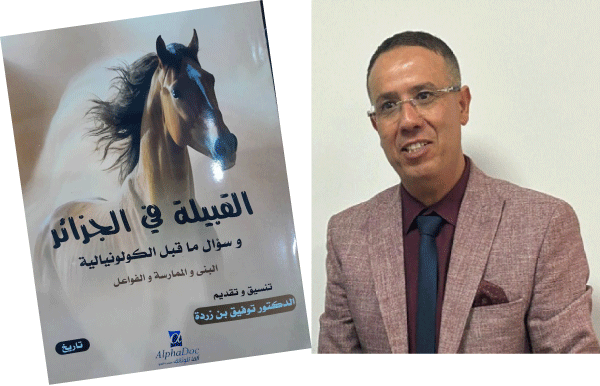
يعتبر الباحث في التاريخ الاجتماعي بجامعة أم البواقي، الدكتور توفيق بن زردة، أن نظام القبيلة لعب دوار بارزا في رسم معالم المجتمع الجزائري و تحديد مختلف تمظهراته قبل و إبان الاستعمار الفرنسي، و يصف من خلال عمل بحثي جديد له البنى و الممارسة و الفواعل التي تشرح طبيعة وأداء هذا النظام ما قبل الكولونيالية، وكيف استهدفه الاحتلال لإعادة تشكيل المجتمع عبر تفكيكه أولا ومن ثم إرساء نموذج قابل للاختراق و التحكم.
ويشرح الباحث في كتابه الجديد “ القبيلة في الجزائر وسؤال ما قبل الكولونيالية؟»، العديد من الجوانب المتعلقة بالنظام المجتمعي الذي سبق « الدولة».
يتناول عملك البحثي موضوع القبيلة في الجزائر- البنى والممارسات والفواعل، كيف حكم هذا النظام الجزائر في الفترة ما قبل الكولونيالية، وأي الأسس قام عليها تحديدا ؟
توفيق بن زردة: تبدو القبيلة في الجزائر والعالم العربي ظاهرة سوسيولوجية يطبعها المُطول والايقاع المكرر، ومحكومة بالاستمرار والتواتر، بفعل خلود الإلحاح الذي مارسته بديناميات مُتصاغة وسلط مستدام، لذلك قد تتراءى القبيلة اليوم كظاهرة مألوفة غير مسائلة وجزء لا يتجزأ من الكل الاجتماعي والسياسي، فتجرد من سؤال الماهية والتمرين في التفكير، بل ولا تستدعي حتى المجالسة واستجلاء المطموس كونها « بديهية عربية»، مرت بهزات وتعنيفات وتجربة اللحظة، لكنها سرعان ما تعود لليوم العادي.
إن أكثر ما يثير في هذه الظاهرة المتقدة، هو مدى تقاطعها مع الحداثي والوطني والهوياتي، وحجم خضوعها لمفاعيل الدولة والعقل الاستراتيجي المنافي للعقل الراتب المسكون بلحظة الانتظار وزمانية التكرار ؟ عندها ستتكشف القبيلة كجيوب من القلق الابستيمولوجي، ونتوءات راتبة قد تنذر بعجز البراديغمات السائدة عن استيعابها معرفيا، وهو ما دفع بالمجموعات العلمية في العالم العربي إلى إشهار دراسات «يقظة» و علائقية بالقبيلة، حيث تنبش في تكلساتها وتمظهراتها وتكيفاتها، تفاديا للصدفة ومباغتة العرضي، فتحولت أسئلة القبيلة والهوية، القبيلة والمواطنة، القبيلة والتنمية، القبيلة والأفق السياسي، القبيلة وإعادة المتشكل الاجتماعي ، القبيلة والبراغماتية الوطنية ؟ وغيرها من الأسئلة إلى مواضيع مُؤشكلة ضمن حقول بحثية وحوافز علمية انتقائية استوجبت الحفر والتدبر في واقع اجتماعي يرخي بحباله القديمة.
لذلك وأنا أحاضر بالجامعة الجزائرية تملكني ويتملكني سؤال كيف تكتب القبيلة في الجزائر أكاديميا؟
إن هذا السؤال هو نوع من التمرين في التفكير حول القبيلة في الجزائر -ما قبل الكولونيالية-، من خلال محاولة تجميع بقاياها كلها أو جزئها، فنقرأ ونعيد القراءة، و نتحسس هذه الظاهرة بشكل نقطي، مع استجلاب تمثلاتها ورمزياتها، و تموضعاتها الجوهرية والشكلانية خلال العهد العثماني، مع فرز شحنات الدفع التي أتت من طبيعتها الطوعية والتشاركية، إلى جانب حضورها كفاعل في شبكة المصالح السياسية والاقتصادية، لذلك جاءت البنية الابستيمولوجية لهذا الكتاب بفحوى إشكالييتضمن: القبيلة بين تمظهرات السلطة وممارسات المدينة، القبيلة والماء، القبيلة والمشيخة، القبيلة والتعمير الوظيفي، القبيلة ودورها في رسم ملمح المجتمع المحلي، القبيلة والممارسة الاجتماعية للتدين، القبيلة والانتجاع.
ما هي تمظهرات القبيلة بوصفها النواة التي شكلت النسق المجتمعي الجزائري قبل الاستعمار ؟
هيمن على معظم الدراسات الأوروبية تصورا مفاده أن معظم القبائل في الجزائر «سائبة ومتمردة»، لذلك طرحت الكولونيالية نفسها كقوة بديلة لإعادة النظام إلى هذا الحقل الاجتماعي، عبر محو علامات «الفوضى والاختلال»، بعد اعتبار القبيلة مثخنة بالصدع، وعائقا يحول دون تكون مجتمع دوْلتي، وبالتالي جرى تمطيط هذا النسيج حتى يتلاءم مع نظرياتهم الاستعمارية التي عمدت إلى دَوْلنة القبيلة، واخضاعها للشطط المدني ، غير أن هذا التصور كان مفعما باللبس الذي لم يراعي اللحظة العشائرية وتفسير التاريخ القبلي في البلاد الجزائرية الذي كان مؤطرا بوعي ومدبرا بتنسيق ، ضمن دينامية اجتماعية، شيدت بالتناسل الانشطاري والمُنجز السياسي، المسنود إلى عصبية تمرست في التموضع لبلوغ مراد السلطة، لذلك لا يمكن الحديث عن دولة دون قبيلة في البلاد الجزائرية قبل القرن التاسع عشر.
لذلك وبغية الانغماس الكلي للأتراك في حكم البوادي والأرياف، عمدت هذه القوة المفكرة إلى «قَبْلنَة الدولة» من خلال تفعيل دور المدونة القبلية، وجعلها مصوغا للتمدد السياسي و الضبط الاجتماعي، لذلك كانت أحد أوجه هذه الشمولية، هو النفخ في الفئوية كنبض عريق في علم الأنساب عند العرب، الذي كان يضم عندهم: الجذم، الجمهور، الشُعب، القبيلة، العمارة، البطن، الفخذ، العشيرة، الفصيلة، وأخيرا الرهط، حيث كانت تمثل هذه التراتبية ايقاعا نفسيا وعقليا ناتجا عن ذلك الانتماء، وما يصاحبه من شحنة اعتزاز بالذات والخصوصية، لذلك حافظ الأتراك على هذه التركة السوسيو- ثقافية، بل وجعلوا منها رأسمال مثمر، وبارقة سلطوية تستند إلى الزعامات المحلية والمشيخات.
ومن المطارحات الملفتة في موضوع القبيلة في الجزائر هو بروز سلطة الأتراك كحجم وقوة ونفوذ ، رسخت نفسها كبراغماتية واقعية ضبطت -إلى حد ما- إيقاع الريفي الجزائري، من خلال إشهار المجالية (نظام البايلك) كلملمة ترابية ، غرضها التأسيس لأجهزة الضبط الاجتماعي والأمني، وتركيب بطاقة سياسية للقبائل،لذلك تؤشر الخرائط القبلية عن وقوع تكيفات سلطوية أتت على الكتل الريفية في الجزائر، بفعل تشحيم مسلك التغيير لديها، فتمظهرت القبائل في شكل قصاصات اجتماعية تتخفى وراء الأصول الجينيالوجية، المسكونة بميثولوجيا الجد الواحد والسرديات البطولية، مع تجلي المجالية – الترابية كوعاء منفعي بأقدام راسخة، حيث يسود التجند الزراعي- الرعوي الموائم للأطر التفسيرية لقوالب التكامل الجماعوي.
تؤشر تحويرات سلطة الأتراك عن استهدفها للصلة العضوية المباشرة القائمة بين البويولوجي و السوسيولوجي، الذي فرخ عوارض المشاركة و الانتماء إلى إطار ثقافي واحد، بعدما فُعلت الزبونية، كأطر سلطوية استحدثت جراءها بطاقة قبلية ضبطت ايقاع عوالم الريف المسكون بشعور الذات والخصوصية العشائرية التي وجهت رؤى الأتراك نحو القطع بضرورة التمشي الذي يحفظ هامشا من ممارسة « القبائلية»، وما يلزمها من أرض ووجهاء وقيم.
ماذا عن السلطة والممارسات المدنية لهذا النظام وكيف ساهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي خصوصا في المرحلة الاستعمارية ؟
خلصت فلسفة منتصف القرن العشرين إلى إنكار الصبغة السياسية لمفهوم السلطة، حيث عارض الفيلسوف ميشال فوكو (1926- 1984) توظيف المذاهب الإنسانية الحديثة في دراسة التاريخ والسلطة، اللذين قاما على التقابل الرئيس بين المجتمع والحقوق من جهة، والدولة والقانون من جهة أخرى، معلنا بذلك بداية لأنموذج إدراكي جديد لجينولوجيا السلطة، هو وليد منهج « حفري» خلص فيه إلى أن السلطة لا تعني أجهزة السيطرة الحاكمة فحسب، بل هي تتخطى هذه المركزة الفوقية لتنبت في مختلف فاعليات الأجهزة الاجتماعية، بل هي موجودة في كل مكان، وهو ما أطلق عليه فوكو التصور الميكروفيزيائي للسلطة ( Microphisical Conception of Power)، وبالتالي الدولة عنده لم تعد اللحظة الحاسمة، ولا الدالة في السلطة، التي هي في حقيقتها – حسبه- ملازمة للوجود الإنساني منذ الولادة وحتى الموت، يمارسها الفرد متحكما أو محكوما بمختلف ميادين الحياة، ومنه خلص ميشال فوكو إلى صيغة “ انبثاث الخطاب السلطوي في مختلف أرجاء الشبكة الاجتماعية”.
انطلاقا من هذه المضامين السلطوية التي تتدفق داخل الجسد الاجتماعي والثقافي، يتكشف أن ابستيمولوجية القبيلة في الجزائر هي ليست وليدة الصدفة و اللامتوقع، بل هي ديناميات – تاريخية-سوسيولوجية قامت على الإستراتيجية التشاركية وعلى الإرث الاثنوغرافي، وبنت تصوراتها الانتاجية على عمل القبيلة بما هو فضائية وعمل القبيلة بما هو زمانية، لذلك تتملكها مفاهيم “ الدورة الزراعية “ بالنسبة لقبائل الحبوب، و “ الموسمية” بالنسبة لقبائل الخروف والماعز، وبالتالي أنت أمام كيانات انتاجية تكفر بالعطالة والبطالة، و تتسق جهودها وتمظهراتها مع الكل السلطوي الذي شهد تكيفات مع سوسيولوجيا القبيلة، وما يطبعها من تكثيف بنيوي- منفعي- قرابي، جعل منهام صدرا لرسم الملمح الجيوبوليتيكي الذي تقاطعت فيه ممارسات الحاكم مع التوازنات المحلية، ومنه بات الفعل السياسوي عجينة تتشكل وفق القالب القبلي الذي تسنى له أن يتحول إلى جبهة ممانعة ضد الفعل الكولونيالي.
لنتحدث عن القبيلة والمشيخة بين التكيف السياسي والتموضع الاجتماعي ؟ ما الدور الذي لعبته في رسم ملامح المجتمع الجزائري ؟
إن التجربة القبلية في الجزائر -وحتى في الوطن العربي- هي مُبيأة ، لذلك يعد تفكيك الزماني عن الفضائي في ديناميتها هو عمل مستحيل، كما تبدو الحوافز الرمزية ذات الطبيعة المعنوية والنفسية كمُتع التشارك، والرضا الناجم عن الدفاع عن القيم والمكتسبات، والإحساس بالقدرة على الفعل، وتأكيد الذات وتثمينها، من تفصيلية القبيلة، التي حملت على أكتافها عبئ الكولونيالية، عندما جعل منها الأمير عبد القادر الجزائري حاضنة اجتماعية تدفقت سيولها ضد الاحتلال الفرنسي . إن الاختلاط والولاء والالتجاء والتزاوج والاحتماء عقيدة قبلية تجاسر ت عليها الجماعة الواحدة، لضبط الإيقاع المحيطي والتكيف مع العوارض الخارجية إما بالمجابهة أو المعايشة، لذلك تتبادر أكثر الأسئلة عن مدى تكيف الفعل القبلي مع الفعل السلطوي، وحجم تكيف القبيلة مع المدونة المؤسساتية، والنظام التحديثي الذي أشهر خلال مرحلة حكم الأتراك للجزائر؟
في الواقع تناطحت المشيخات الكبرى مع السلط التركي على غرار الذواودة وآل المقراني والحنانشة في الشرق الجزائري، فإذا أخذنا الحنانشة كمشيخة كبرى تناولتها بالدراسة في رسالة الماجستير، حيث يحيل هذا النموذج المشيخي على تاريخية اتسقت والنموذج القبلي في البلاد المغاربية، فعلى امتداد الفضاء الطرفي – الجزائري- التونسي - انصهرت الكتل الاجتماعية السليمية- الهوارية معلنة عن ميلاد كتلة قبلية كبرى عرفت بالحنانشة، التي تحولت إلى ظاهرة سوسيو- ثقافية» عنترية» تستهلك السياسة على أبواب القصور وهو ما راكم من المعرفة حول تمظهراتها خلال القرن السادس عشر، فوصفهم مارمول كاربخال « بأسياد الريف»، أما خير الدين بربروس الذي دخل تونس(1534)، فبعث لشيخهم ببرنوس، والتزم بإعفائهم من الضرائب استجلابا لجبروتهم وعنفوانهم الظاهرة الحناشية التي نشأت بثنائية المشيخة والبارود تدفقت إليها الطموحات الكنفدرالية، التي تحولت إلى نواة لمشروع أسري- قبلي موسع على أرض نوميدية- قرطاجية، عززت من الثراء الجيو- اقتصادي لهذه القبيلة التي جمعت بين عالمي السمكة والجمل، متجاوزة بذلك حدود المتخيل القبلي، بعدما تدافعت إليها كتل اجتماعية وظيفية تحذوها ثلاثية الجهد والمكابرة والمحاربة، مشكلة لسوسيولوجيا مثخنة بكاريزما التفوق عبر المجال الطرفي الواقع بين الجزائر وتونس
لماذا استهدف الاستعمار هذا النظام و كيف أدى تفكيكه إلى اختراق التركيبة الأنثروبولوجية المحلية ؟
تصويب الأسهم ضد القبيلة في الجزائر كانت من مخرجات الفهم الابستيمولوجي الاستعماري للمجتمعات المحلية في شمال إفريقيا، حيث أدرك مؤطرو الفعل الكولونيالي قيمة الأرض في أنطولوجيا الإنسان الزراعي ، لذلك عمدوا إلى اجتثاث الساكنة من مواطنها الأصلية، وتوزيعها عبر محاور جفاء تاريخي،أدت إلى فصم روابطها المنفعية، وأدخلت الإنسان والأرض في علاقة تماهي، وكثيرا ما لازم هذا الغصب الكلولونيالي الثورات الشعبية في الجزائر، التي أيقن الاصطفاف المعرفي الأنثروبولوجي أن وراء هذه الثورات كتل اجتماعية صلبة بانسجام تاريخي وتداخل منفعي- قرابي، لذلك تحويل القبيلة إلى مُجمع فقراء و فلاحون بدون أرض كان من صميم الفعل الكولونيالي ، الذي أشهر أيضا حربا ناعمة تمثلت في القوانين العقارية التي عمدت إلى إبطال الفعل القبلي المحلي وإقحامه في مدنية غرائبية لا تنسجم مع تطور القبيلة العضوي ومواءماتها التاريخية.
إن القبيلة كموزاييك سوسيولوجي، يمكن أن تتحول إلى مبعث كربوني ، لذلك هي تحتاج من المجموعات العلمية إلى بناء خطاب تاريخي- أنثروبولوجي بوعي وطني يتكيف مع هذه « الثيمات الاجتماعية»، بحيث يمعن في تأهيلها من الداخل، ويحولها إلى وسيلة للقوة والمنعة، كما ينقلها من خطاب المناطقية والسرديات القبلية، إلى تحقيق متطلبات الاستدامة الوطنية، وراهن مَأْسسة الدولة المدنية الحديثة، تكون فيه القبيلة رصيف اجتماعي تصل من خلاله ارتدادات الرؤى الوطنية.
نور الهدى طابي