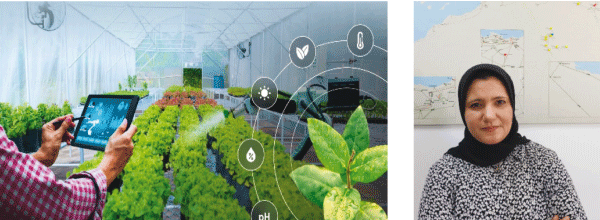
قالت الباحثة في مركز تنمية الطاقات المتجددة، الدكتورة سعيدة مخلوفي، إن الزراعة الرقمية أو الزراعة 5.0 تمثل خيارا استراتيجيا من شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي محليا وعالميا، بينما تلعب دورا أساسيا في تنويع الاقتصاد الوطني، في ظل تبني الجزائر سياسة منسجمة تدعم هذا التوجه من خلال تسخير كافة الآليات.
إيمان زياري
وترى الباحثة، أن الاستثمار في قطاع الزراعة لا يعالج مشكلتي الجوع وسوء التغذية فحسب، بل يمتد أثره لمعالجة مشاكل أخرى كالفقر، البيئة والتقليل من الانبعاثات الناتجة عن الزراعة، وكذا جعل الغذاء أكثر وفرة وأقل تكلفة من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتغير المناخ، وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام.
نمو ديموغرافي متسارع وزيادة في الطلب على الغذاء
بلغ عدد سكان الجزائر في 1 جانفي 2025 حوالي 46.8 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 51 مليون بحلول سنة 2030، ثم إلى 62 مليون نسمة في عام 2050، ليصل إلى 70 مليون نسمة بحلول سنة 2100، نمو ديموغرافي كبير ترى الباحثة بأنه يقابل زيادة في الطلب على الغذاء.
وحسبها، فإنه ومع التوسع الحضري وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ستزداد الحاجة إلى رفع الإنتاج الغذائي، مما يضع قطاع الفلاحة أمام تحديات كبرى.
وتشير محدثتنا، إلى أنه وفي ظل كل هذه التوقعات، مقابل ندرة الموارد المائية، أصبح تحسين كفاءة نشاط الزراعة ضرورة حتمية، حيث يواجه الفلاحون تحديات جديدة في الحصول على الموارد مثل الأراضي والطاقة والمياه، بينما تفرض الظروف البيئية كالاحتباس الحراري والتغير المناخي ضغوطا هائلة على نشاط الزراعة وسلاسل الإمدادات. إلى جانب ذلك، فإن الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة وانتشار الحرائق في عدة مناطق فلاحية، تسببا في تلف المحاصيل واحتراق الأشجار وتلوث التربة، و أثرا على إنتاج المحاصيل من حبوب وفواكه، مما يدفع الفلاحين اليوم لإعادة النظر في أساليب الإنتاج والبحث عن تقنيات متطورة في الزرع والري وغيرها.
وتتحدث الدكتورة مخلوفي أيضا، عن مشكل ندرة الموارد المائية الذي تعاني منه الجزائر بسبب التوزيع غير المتوازن لها، إذ تتركز في معظمها في الشمال، بينما تعتمد المناطق الصحراوية على المياه الجوفية المالحة والساخنة.
مضيفة، أن الدراسات تشير إلى أن 85 بالمائة من مياه الأمطار تتبخر بشكل طبيعي، كما تعاني شبكات توزيع المياه من خسائر كبيرة تصل إلى 40 بالمائة بسبب التسريبات وسوء البنية التحتية، مما يستوجب عملا مدروسا لتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة، خاصة وأن قطاع الفلاحة يستهلك 70 بالمائة من المياه الصالحة للشرب في الجزائر.
التكنولوجيا تقود التحول
من جهة ثانية، أثنت الدكتورة على النتائج المبهرة التي حققها قطاع الزراعة في الجنوب ومنطقة الهضاب على الرغم من كل التحديات التي واجهته، وأشارت إلى صعوبات الري التي تعترض الفلاحين خاصة الناشطين في المناطق البعيدة عن الشبكة الكهربائية، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة الديزل وصعوبة نقله. إلى جانب ما أسمته بالمخاطر العالية التي يواجهها الفلاحون الصغار نتيجة التغير المناخي، فضلا عن ارتفاع الحرارة الذي يوفر بيئة خصبة لتكاثر الآفات، مما يزيد من هشاشة سلاسل الإمداد الغذائي.
وتقول الباحثة، إن العالم يشهد ثورة زراعية جديدة تعرف باسم "الزراعة 5.0"، وهي الجيل القادم من الزراعة الذكية التي تعتمد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتعلم الآلة بهدف تحسين الإنتاجية والكفاءة والاستدامة.
وتضيف، أنها تستند على إنجازات الثورات الزراعية السابقة، مثل الثورة الخضراء التي اعتمدت على الأسمدة والمبيدات لزيادة الإنتاج، إلا أنها وكما توضح، تحتاج لتوظيف التكنولوجيا لجعل الزراعة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتسعى الزراعة 5.0 إلى التحول من نموذج المزرعة الذكية التقليدية إلى نظام زراعي يعتمد على الطاقة المستدامة باستخدام أدوات ذكية.
وتؤكد الباحثة، أنه بات من الممكن بفضل التقدم التكنولوجي إنتاج المحاصيل في بيئات خاضعة للرقابة تشبه نظيرتها الصناعية، مما يحسن الجودة ويرفع الإنتاج، ويساعد الفلاحين كثيرا عبر الممارسات المستدامة والإدارة الفعالة للموارد والابتكارات كخرائط صحة التربة، لبناء مستقبل أكثر مرونة والمساهمة في مكافحة التغير المناخي.
وأضافت، أن دمج التحليل الزراعي الذي يشمل تحليل التربة، وتشخيص أمراض النباتات، والزراعة الدقيقة، ورقمنة قطاع الزراعة، والاستشعار عن بعد، والتقنيات المستدامة، يمثل حجر الزاوية لتعزيز صمود قطاع الزراعة في الجزائر أمام تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
طريقنا نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الخسائر
لطالما واجهت الزراعة في الجزائر مشكلة تلف المحصول قبل وبعد الحصاد لعدة عقود، ولتحقيق هدف "صفر خسائر" و "صفر واردات" زراعية، تؤكد المختصة أنه يتعين على الجزائر تبني مفهوم "الزراعة 5.0"، بحيث يتطلب ذلك اعتماد تقنيات زراعية حديثة، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الثقة والوصول الرقمي، مع إنشاء منصات آمنة لتبادل البيانات بكفاءة، واعتبرتها ثورة زراعية خامسة ستسمح للفلاحين بزيادة الإنتاج في مساحات أقل وتلبية الاحتياجات الغذائية لعدد أكبر من السكان.
وأضافت مخلوفي، أن مساهمة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية من خلال توفير حلول مبتكرة إلى جانب المبادرات الحكومية الهادفة إلى تطبيق الزراعة الرقمية خلال كل المراحل من الزراعة إلى التسويق، سيمهد الطريق أمام تقنيات زراعية مستقبلية قادرة على جعل الجزائر مكتفية ذاتيا، وتقترح إنشاء جمعية تعاونية مدعومة بتكنولوجيا متطورة، تلبي المعايير العالمية وتفتح الباب أمام الجزائر لخلق علامات تجارية في مجال الزراعة.
وتقول الباحثة، إن الزراعة الرقمية والذكية تمثل منهجا واعدا يدمج تقنيات الاستشعار وتحليل البيانات والتشغيل الآلي المتقدمة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والربحية والاستدامة، وتؤكد على أن قطاع الزراعة في الجزائر يتعين عليه التحول نحو ثورة تكنولوجية موفرة للطاقة والماء مشيرة، إلى أن الإدارة الزراعية الحديثة تعتمد على نظم التموضع العالمي وبرامج الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط دقيقة للأراضي، مما يضمن توفير الاحتياجات الدقيقة لكل محصول لتحقيق أقصى إنتاجية.
زراعة المستقبل
وتؤكد الباحثة، على أن دعم قطاع الزراعة بتقنيات إنترنت الأشياء ومعالجة البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي والروبوتات، يسمح بتوفير بيانات مفصلة عن أنماط هطول الأمطار والدورات الهيدرولوجية، وجمع البيانات حول رطوبة التربة ومستويات الأسمدة لتحسين الري والتسميد والممارسات الزراعية، كما تستخدم لتحسين عمليات الإنتاج والمراقبة والحصاد والتسويق في الوقت الفعلي.
وتشير أيضا، إلى أن الزراعة الرقمية مدعومة بـ "البلوكشين" تحديد التقصير في العملية الزراعية وتأثيره على الجودة، كما يبرز دور الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لإدارة المزارع التنبؤية، وذلك من خلال دمج بيانات الطقس ومدخلات المستشعرات على الأرض، كما يمكن له إعلام الفلاحين بفترات الجفاف القادمة أو انخفاض الرطوبة، مما يسهل اتخاذ التدابير الاستباقية مثل السقي أو تعديل التغذية.
وتضيف، أن الروبوتات والطائرات المسيرة تلعب دورا متناميا في التشغيل الآلي لمختلف الأنشطة الزراعية، بحيث تحل محل العمليات اليدوية التقليدية كقطف الثمار، وإزالة الأعشاب الضارة والري.
وتؤكد الدكتورة مخلوفي، أن الفلاح لن يتبن تقنيات الذكاء الاصطناعي فقط لأنها متاحة، بل يجب أن تكون بسيطة وبتكلفة معقولة، وتقدم قيمة حقيقية، مضيفة أنه يحتاج أيضا إلى الانتقال من التكنولوجيا المغلقة إلى واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، ومن التجارب إلى منصات قابلة للتوسع.
الطاقات المتجددة تعزز قطاع الزراعة
تشير الدكتورة مخلوفي، إلى أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة في قطاعي الطاقة والفلاحة، إلا أنها ترى أن ضمان الأمن الطاقوي والأمن الغذائي والأمن المائي، يتطلب تبني سياسات متكاملة، وتقول إنها تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتعزيز مشاريع الري المبتكرة، مع تحسين إدارة موارد الطاقة والمياه.
وتؤكد، على أن تكنولوجيا الطاقات المتجددة تعد محركا جديدا لدفع قطاع الزراعة نحو الاستدامة، وذلك من خلال استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل أنظمة الري الذكية، والإدارة الرشيدة للموارد المائية وحفظ المنتجات وتشغيل المعدات الزراعية، بحيث يمكن لهذا القطاع أن يحقق استقلالية أكبر وكفاءة أعلى وانبعاث أقل، ما يجعله جزءا من الحل لمواجهة تحديات الغذاء والماء والطاقة والمناخ في آن واحد.
وتشير المختصة، إلى فعالية الطاقة الكهروضوئية في تجسيد العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء، إذ تعمل على تحسين صحة التربة، كما تحافظ على رطوبتها وترعى الأنواع المحلية وتنتج الغذاء وتوفر طاقة أقل تكلفة.
وقد تم تركيب عدة منشآت شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية بحوالي 4.73ميغاواط بحلول سنة 2023، وخلال هذه السنة تم تركيب قدرة إضافية قوامها +0.25 ميغاواط، موزعة على أنظمة الضخ الكهروضوئية بقدرة 179 كيلواط، ومجموعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتزويد المناطق المعزولة بالكهرباء بقدرة 65 كيلواط، وهي مشاريع قالت إنها تمنح رصيدا للادخار المالي في فواتير الكهرباء. إلا أن هذا غير كاف في نظرها، إذ لا يزال الطريق طويلا كما تقول أمام تعميم استخدام الطاقات المتجددة في المزارع والصناعات الغذائية، وتؤكد أنه ورغم تأخر الجزائر في تطوير الطاقات المتجددة في هذا القطاع، يمكن تدارك الوضع سريعا واغتنام الفرصة لتطوير مشاريع ذكية ومستدامة.
إ.ز

تعرفه الأقطاب الحضرية بالخروب
رمي عشوائي للنفايات يسبب تدهورا في المحيط البيئي
تشهد الأقطاب العمرانية الحضرية ببلدية الخروب في قسنطينة تدهورا في المحيط والبيئة، حيث ينتشر بأحيائها رمي النفايات ما أدى لخلق نقاط رمي عشوائية وسط نسيج عمراني أضر بالمحيط والساكنة، في وقت ذكرت مصالح البلدية أنّ نقص الإمكانيات حال دون تكفل أحسن بهذا الجانب.
وتحوّل رمي النفايات العشوائية علامة لافتة بالأقطاب الحضرية لبلدية الخروب، إذ يمكن للفرد أن يقف من خلال جولة بسيطة على حجم النفايات المتراكمة بهذه المناطق ومدى انتشارها، خاصة وأنّ الأمر يتعلق بوسط حضري ونسيج عمراني لا تحترم نقاط الرمي به ما يقدم صورة سلبية عن المنظر العام وكذا تحولها لبيئة حاضنة للحشرات وما يصاحبها من أمراض بالإضافة للروائح الكريهة، ووقفت النّصر بالقطب الحضري عين النحاس على تراكم كميات من النفايات في مواضع عشوائية منها نقطة تضم أكياسا عليها آثار حرق وكنبة بمحاذاة أدراج تبعد عنها 4 حاويات بأمتار قليلة، وصعدنا الأدراج لنلاحظ كذلك أكياسا مرمية على مسافة قليلة من الموقع الأول، وفي مشهد متناقض عند رصيف بذات القطب غرست به مجموعة من الأشجار لكن تنتشر خلفها نفايات ممتدة لأمتار.
واستمرّ تجوالنا أين لاحظنا بأعلى الطريق الرئيسي الثاني حاوية من الحجم الكبير تنتشر بمحيطها نفايات وبالقرب منها مخلفات تم حرقها، وأكّد مواطنون أنّ الحاوية غير كافية لاستيعاب المخلفات ما يتسبب في رميها بأماكن قريبة، مؤكدين أن هذا ليس عذرا يبرّر خطيئة الفعل، والتقينا بشخص آخر قال إنّ نقاط الرمي بعيدة عن بعض السكان فيلجؤون للرمي بأماكن أقرب ما أدى لتشكّل عدّة نقاط عشوائية.
وتتشابه الصورة بمنطقة الضريح حيث تنقلنا رفقة عضوين من ممثلي المجتمع المدني إلى المنطقة السكنية "ش" في منطقة تعتبر مركز المنطقة حيث تضم أرضية كبيرة الحجم تحيط بها العمارات من كل جانب وتتراكم بها المخلفات، ليذكر مرافقانا أنّها نقطة سوداء سببها قيام التجار الفوضويون بالمكان برمي مخلفاتهم حيث لاحظنا وجود كميات من الطماطم، إلى جانب أصحاب المحلات المحيطة، وسرنا مسافة قليلة وجدنا مساحة أرضية ثانية لا تقل سوءا عن الأخرى، كما يظهر أنّ الحاويات الموضوعة بالمنطقة ليست كافية لتغطية كامل المساحة، كما أنّ بعضها متدهور، وأخرى رغم وجودها إلا أنّ حجم المخلفات المنتشر بمحاذاتها يفوق بكثير ما بداخلها في صورة ما لاحظناه بالمنطقة السكنية "ل".
وأرجع مواطنون السبب إلى جامعي البلاستيك حيث يقومون ببعثرة الحاويات وترك محتوياتها منتشرة، وهو ما لاحظناه بمنطقتين، في المقابل اعترف مواطنون بأنّ مصالح البلدية تقوم برفع هذه النفايات والنقاط العشوائية كانت محل حملات تطوعية لكنها سرعان ما تعود لحالتها.
واشتكى مواطنون بماسينيسا القديمة من انتشار النفايات خاصة بالمنطقة السكنية "أ" أين يقع السوق الفوضوي للخضر والفواكه، معتبرين أنّ تجاره المسبب الأول في انتشار هذه القمامة بالمنطقة الذين يرمون مخلفاتهم دون مسؤولية، وصادف حضورنا بالمكان وجود مجموعة من الأبقار تتجول لوحدها وتطرح مخلفاتها في كل مكان تحط عليه أقدامها، وذكر مواطنون أنّ هذه هي وضعية ماسينيسا مؤكدين تضررهم من تدهور المحيط الذي يعود لسنوات، كما عبروا عن رغبتهم في تحويل التجار إلى مكان أكثر ملاءمة بطريقة نظامية.
80 بالمائة نسبة الرفع
من جهته اعترف مدير البيئة ببلدية الخروب، رياض العيفاوي، في اتصال بالنّصر بوجود نقائص واختلالات في ما يتعلق بمعالجة النفايات المنزلية، مرجعا الأمر لغياب المخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، وكذا عدم تحديث نقاط رمي القمامة نظرا لاتساع مجال التدخّل ما جعل الأمر يخرج عن السيطرة نوعا ما حسب وصفه، لافتا إلى أنّ الإشكال يطرح بشكل أكبر في الأقطاب العمرانية خاصة الضريح الذي يضم 50 ألف نسمة، كما أنّ حجم إنتاجه من النفايات مع القطب عين النحاس يفوق 50 طنا يوميا، مضيفا أنّ نسبة التكفل برفع النفايات المنزلية تقدّر بحوالي 80 بالمائة حيث لا يتم التكفل بكل النقاط وبالتالي فالنقاط السوداء العشوائية تزداد، كذلك بحكم نقص عتاد المؤسسة المسؤولة عن العملية بسبب اتساع المجال الذي يحتوي على حوالي 350 نقطة جمع، كذلك نقص اليد العاملة والإمكانيات المالية.
واعترف المتحدّث كذلك بوجود مشكلة اهتراء الحاويات قائلا إنّ المؤسسة لا تملك الحاويات لتجديدها، إلى جانب غياب نظام رسكلة النفايات، فضلا عن ضعف وعي المواطن وعدم احترامه لموعد مرور الشاحنات من جهة والباحثين عن البلاستيك وبعثرتهم للحاويات كذلك غياب الرّدع، كما أكّد عزم البلدية القضاء على السوق الفوضوي بماسينيسا القديمة، وتطرّق المتحدّث للحلول حيث ذكر وجود برنامج التسيير المدمج محليا للنفايات المنزلية وإنتاج الطاقة انتهت مرحلة التشخيص به ويتم العمل على مرحلة إعداد الحلول، كما أكّد أنّه تم الحديث مع المؤسسة المكلفة برفع النفايات لتعزيز وجود حاويات القمامة.
إسلام. ق

الخبير المعتمد الأستاذ هشام عداد للنصر
الرقابة البيئية لمكاتب الدراسات مطالبة بكسب رهان الرقمنة
يرى الخبير المعتمد من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة ورئيس لجنة مكاتب الدراسات للجمعية الوطنية للجغرافيا وتهيئة الإقليم والتخطيط والاستشراف الأستاذ هشام عداد، بأن عمل مكاتب الدراسات المعتمدين لدى وزارة البيئة يواجه اليوم عديد التحديات في زمن الرقمنة، أين تسعى هاته المكاتب لكسب الرهان المعلق عليها ضمن الخدمات التي تقدمها لعديد الشركاء في مجال البيئة، وخاصة المستثمرين الذين يعتبر محدثنا بأن الرقابة على مؤسساتهم وجب أن تتواصل حتى بعد اعتمادها ودخولها حيز الاستغلال.
وأوضح الخبير المعتمد بأن الرقابة البيئية في زمن الرقمنة بات من أكثر المواضيع إلحاحًا في سياق التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على دور مكاتب الدراسات، التي تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم بين التحديات التقليدية والرهانات المستقبلية، ويضيف المتحدث بأن التحولات الرقمية التي يعرفها العالم ، تُحدث اليوم تحوّلًا جذريًا في أساليب الرقابة البيئية، سواء من حيث المنهجيات أو الأدوات أو أنماط الإنتاج والتتبع، مشيرا بأنه وفي خضم هذه الثورة، تقف مكاتب الدراسات بصفتها طرفًا فاعلًا في منظومة الحوكمة البيئية، مطالَبة بإعادة تشكيل دورها، وتحديث مقارباتها، ورفع سقف جاهزيتها التقنية والبشرية، لتستجيب لمتطلبات عصر رقمي متسارع لا يرحم التراخي أو الجمود.
ويعرّف محدثنا الرقابة البيئية على أنها منظومة من العمليات والإجراءات التي تهدف إلى رصد وتقييم، وضبط الأنشطة البشرية التي قد تُحدث آثارًا سلبية على المحيط البيئي، سواء على مستوى الهواء أو المياه أو التربة، أو النظام البيولوجي، وهي تمثل أداة استراتيجية لضمان احترام التشريعات البيئية من قبل المؤسسات والمشاريع والمستثمرين، أين تشمل الرقابة البيئية مجموعة من الأدوات، على غرار التصاريح البيئية، والدراسات القبلية والتقارير الدورية، وكذا التفتيش الميداني والمعاينات، وصولا لإعداد نظام التصنيف البيئي للمؤسسات والأنشطة إضافة إلى نظام العقوبات والمخالفات البيئية، وعرفت الرقابة البيئية في الجزائر تطورا، فمنذ صدور القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، عرف الإطار التنظيمي للرقابة البيئية في الجزائر تطورًا تدريجيًا، غير أن التطبيق -بحسب محدثنا- بقي لسنوات رهين الوسائل البشرية التقليدية، مما خلق فجوة بين طموحات النصوص القانونية والواقع الميداني المعقد.
ويضيف رئيس لجنة مكاتب الدراسات للجمعية الوطنية للجغرافيا وتهيئة الإقليم والتخطيط والاستشراف التي تأسست سنة 2023، بأن الرقمنة كعامل تغييري شامل في الرقابة البيئية
تطورت من الرقابة الورقية إلى الرقابة الذكية، ففي العالم الرقمي، لم تعد الرقابة البيئية تعتمد فقط على الزيارات الدورية وتقارير الورق، بل أصبحت تعتمد على المجسات الذكية لمراقبة جودة الهواء والماء والتربة في الزمن الحقيقي، وعلى أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد المواقع الحرجة وتتبع تغير استخدام الأرض، وعن طريق الاستشعار عن بعد (Remote Sensing) للكشف عن التغيرات الكبرى في الغطاء النباتي والامتداد العمراني، أو التلوث الحراري، وكذا من خلال الطائرات بدون طيار "درون" لتفقد المواقع صعبة الولوج أو الواسعة، إضافة للاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ بالمخاطر البيئية واتخاذ قرارات وقائية، ويعتمد كذلك على المنصات الإلكترونية للتصاريح والمتابعة التي تسمح برقمنة ملفات المشاريع، وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
ويبين المتحدث بأن للرقمنة في الرقابة البيئية فوائد عديدة ومنها الدقة والسرعة في الرصد والتحليل وتقليص التكاليف على المدى البعيد، والشفافية وإتاحة المعلومة البيئية للمواطن، وصولا لتحسين قابلية تتبع المخالفات البيئية والتصرف الفوري، ويؤكد المتحدث صاحب مكتب دراسات مختص في إعداد دراسات التأثير ودراسات الخطر والمراجعة البيئية التحليلية والدراسات المرتبطة بإعداد المخططات في ميدان البيئة وكذا دراسة إزالة التلوث وتطهير المواقع والأوساط المستقبلة، والدراسات المرتبطة بإعادة تأهيل وإعادة تهيئة المواقع والأنظمة البيئية بالإضافة للدراسات المرتبطة بتنمية المساحات الخضراء وتهيئتها والدراسات المرتبطة بإنجاز الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالبيئة والدراسات المرتبطة بتسيير النفايات والاقتصاد الدائري، بأن مكاتب الدراسات اليوم هي فاعل بين المطرقة والسندان، وبالعودة للدور التقليدي لمكاتب الدراسات، فلطالما لعبت مكاتب الدراسات البيئية دورًا محوريًا في إعداد الملفات البيئية، على غرار دراسات التأثير على البيئة (EIE) ودراسات تقييم المخاطر البيئية وإعداد مخططات التسيير البيئي ورسم خطط الطوارئ البيئية، وتحرير تراخيص إنشاء المؤسسات المصنفة، أين كان هذا العمل يعتمد أساسًا على المعاينات الميدانية والخبرة التقنية، والاشتغال ضمن أطر تنظيمية محددة، أما اليوم فمكاتب الدراسات تواجه تحديات في زمن الرقمنة، فالرقمنة طرحت على هذه المكاتب تحديات جديدة غير مسبوقة، على غرار نقص التكوين في البرمجيات الحديثة مثل ArcGIS" AutoCAD Civil 3D، ENVI، QGIS، Python for Environmental Analysis"، والاستثمار المكلف في المعدات الرقمية مثل الطائرات بدون طيار، والمحطات المتنقلة، والمجسات متعددة الوظائف، ناهيك عن تأخر بعض الإدارات في اعتماد المنصات الرقمية مما يعيق التنسيق، وكذا التنافس مع كيانات دولية تمتلك خبرات وأدوات رقمية متقدمة، ونقص التشريعات التي تفرض الرقمنة كمعيار إلزامي في إعداد الدراسات البيئية.
و يرى الخبير بأن هناك تحولات مطلوبة من مكاتب الدراسات، وهو واقع أملته الرقمنة، أين وجب على هاته المكاتب، أن تتبنى الرقمنة كمكون أساسي في منهجية العمل، والاستثمار في التكوين المستمر للموارد البشرية، والتحول نحو التخصص في مجالات دقيقة مثل رقمنة خرائط المخاطر والنمذجة البيئية وتحليل صور الأقمار الصناعية، وعقد شراكات مع الجامعات ومراكز البحث لتعزيز القدرات الرقمية، ويبين محدثنا بأن الجمعية الوطنية للجغرافيا وتهيئة الإقليم والتخطيط والاستشراف تثمن استراتيجية الدولة في رقمنة قطاع البيئة، بالرغم من رهانات الرقابة الرقمية في البيئة الجزائرية، ففرص الانتقال الرقمي في الجزائر من شأنها أن توفر قاعدة بشرية شابة ومؤهلة، بالإضافة إلى المشاريع الرقمية العمومية التي هي قيد التنفيذ على غرار الوكالة الوطنية للعصرنة وبوابة التصريح البيئي، إلى جانب تسجيل ازدياد الوعي البيئي داخل المجتمع المدني، وصولا للدعم الدولي من شركاء تقنيين ومنظمات أممية، وبخصوص العقبات القائمة، فيتعلق ذلك بهشاشة الربط الرقمي في بعض المناطق، وتردد بعض المؤسسات في تقاسم المعطيات البيئية، مع نقص مواءمة المنظومة القانونية مع الأدوات الرقمية الحديثة، وضعف ثقافة "البيانات المفتوحة" في المجال البيئي.
ويقترح الأستاذ هشام عداد جملة من التوصيات العملية، مبينا بأنه وبصفته من المهنيين الممارسين في هذا المجال، فهو يقترح بعض التوصيات الملموسة، على غرار إدراج معايير رقمية إجبارية في دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع البيئية، وكذا إنشاء منصة وطنية موحدة للرقابة البيئية الرقمية، تربط بين الإدارات ومكاتب الدراسات والمستثمرين، وصولا لتمويل مشاريع الابتكار البيئي الرقمي ضمن برامج دعم الشباب والمؤسسات الناشئة، مع إدراج مادة "الرقمنة البيئية" في التكوين الجامعي لمهندسي البيئة والتعمير، وإطلاق خريطة وطنية تفاعلية للملوثات والمخاطر البيئية، وتشجيع استخدام تطبيقات الهاتف النقال لتتبع الانبعاثات والشكاوى البيئية.
ويعتبر محدثنا بأن مستقبل الرقابة البيئية في الجزائر، وفي العالم أجمع، لن يكون إلا رقميا، مشيرا بأن من لا يركب قطار الرقمنة اليوم، قد لا يجد لنفسه مكانًا في منظومة الغد، ومكاتب الدراسات، بمرجعيتها التقنية واحتكاكها اليومي بالميدان، مدعوة إلى أن تكون قاطرة هذا التغيير لا متأخرة عنه، مشيرا بأن ما نعيشه اليوم ليس فقط تحولا تكنولوجيا، بل هو تحول ثقافي في طريقة إدراكنا للبيئة، وقياسنا للأثر، وتفاعلنا مع المعطى الطبيعي، ويدعو محدثنا لاغتنام هذه اللحظة التاريخية لإعادة هندسة الرقابة البيئية على أسس جديدة قوامها الشفافية والدقة والسرعة والفعالية.
أحمد ذيب