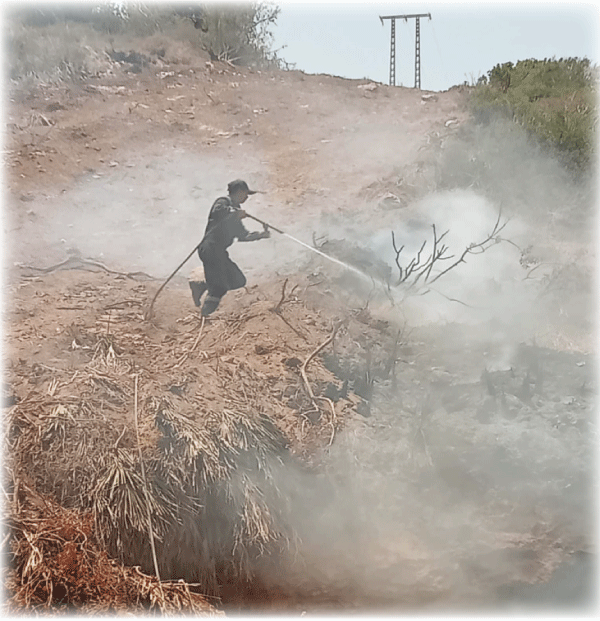
تشهد العديد من دول العالم خلال السنوات الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في عدد وشدة الحرائق، انطلاقا من أستراليا وكندا إلى دول البحر الأبيض المتوسط، في ظاهرة تتكرر سنويا وتزداد سوءا، وسط تحذيرات من ارتباطها بتغيرات مناخية أحدثت خللا يصفه الخبراء بالخطير في الأنظمة البيئية والمناخية ويدعون لضرورة الاعتماد على تقنيات متطورة قصد التحكم بها والتقليل من آثارها.
إعداد : إيمان زياري
تظهر الأبحاث أن التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب خلال الفترة الأخيرة، تؤدي إلى ظروف أكثر دفئا وجفافا، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ورطوبة التربة ووجود الأشجار والشجيرات وغيرها من مصادر الوقود المحتملة، مما يساهم في ازدياد موسم الجفاف وطول موسم الحرائق وبالتالي زيادة مخاطر حرائق الغابات.
ارتفاع درجات الحرارة.. وقود الحرائق
ويتوقع الخبراء أن يساهم ارتفاع درجات الحرارة العالمية في ازدياد حجم وتواتر وشدة حرائق الغابات خلال السنوات المقبلة، بحيث يشيرون إلى التأثير المباشر لتغير المناخ الذي يؤكدون على أنه يجعل من الغابات أكثر عرضة للحرائق، وذلك من خلال جفاف الأشجار والشجيرات والعشب وتحويل أوراق الشجر والفروع المتساقطة إلى حطب قابل للاشتعال، بينما تصبح الأشجار التي تعاني من نقص المياه أثناء فترات الجفاف، أكثر عرضة للحشرات والأمراض التي يمكن أن تضعفها وتقتلها، مما يخلق المزيد من الوقود للحرائق. ووفقا لمفوضية الإتحاد الأوروبي، فقد كان موسم حرائق الغابات لعامي 2022 و2023 من بين أسوأ خمسة مواسم مسجلة، مفصحة عن أن عام 2024 وحده، ولدت حرائق الغابات والنباتات العالمية فيه حوالي 1940 ميغا طن من أول أكسيد الكربون، بينما تسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص عبر العديد من دول العالم، بحيث أودت الحرائق في التشيلي بحياة 137 شخصا، وأطلقت حرائق الغابات الكندية خلال 5 أشهر فقط كمية من الكربون تفوق ما أطلقته روسيا واليابان من الوقود الأحفوري في عام 2022، بينما تحولت حرائق الغابات بالولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الحرائق تدميرا وتكلفة في تاريخ الدولة على الرغم من وقوعها خارج موسم حرائق الغابات المعتاد.
حلقة مفرغة
يصف الخبراء العلاقة بين تغير المناخ وحرائق الغابات وتلوث الهواء بالحلقة المفرغة التي تهدد الإنسان والحيوان والكوكب، وذلك بسبب ما ينتج عن حرق الأشجار من كربون وجسيمات دقيقة، تؤدي إلى تدهور الهواء بشكل كبير، إذ تصنف حرائق الغابات على أنها أحد أكبر مصادر الكربون الأسود الذي يوصف بالملوث الهائل ويفاقم موجات الحر، كما يغير أنماط الطقس، ويسرع ذوبان الجليد والثلوج، مما يديم دورة تغير المناخ وحرائق الغابات الشديدة، التي يعد تكرارها وكثافتها نتيجة ثانوية لتغير المناخ، بينما تتسبب أيضا في تفاقم المزيد من الحرائق، مما يؤدي إلى إدامة حلقة مفرغة. وتلحق حرائق الغابات ضررا بالغا بالصحة العامة، نتيجة لإطلاقها مجموعة من الملوثات في الغلاف الجوي، بما فيها الكربون الأسود وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، وقد تتحد هذه الملوثات مع تلوث الهواء، مما يزيد من الآثار الضارة للدخان على صحة الإنسان والطبيعة، وقد قال الرئيس التنفيذي لصندوق الهواء النظيف، جين بورستون، أن «الملوثات الخطيرة، بما فيها الكربون الأسود المنبعث من حرائق الغابات، مجتمعة في نصف ظاهرة الاحتباس الحراري حتى الآن، وتسهم في 8 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا بسبب تلوث الهواء، ويبرز الدخان الكثيف الناتج عن حرائق الغابات التهديد الخطير الذي تشكله الجسيمات المحمولة جوا». إ.ز

المدير الفرعي لحماية الأملاك الغابية بالمديرية العامة للغابات فريطس السعيد
انخفاض بنسبة 91 بالمائة في حصيلة حرائق الغابات بالجزائر
أكد المدير الفرعي لحماية الأملاك الغابية بالمديرية العامة للغابات، السيد فريطس السعيد، أن حصيلة حرائق الغابات بالجزائر قد عرفت إنخفاضا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخيرة، أين شهدت سنة 2024 أدنى حصيلة، بنسبة تفوق 91 بالمائة، بينما انخفض عدد الحرائق إلى 73 بالمائة مقارنة بالسنوات الـ10 الماضية، متحدثا عن مقاربة وطنية شاملة من أجل التصدي للحرائق والعمل على احتوائها وتقليل الخسائر.
النصر : ما هي حصيلة حرائق الغابات التي سجلتموها خلال سنة 2024 وكيف تقيمونها؟
شهدت الجزائر خلال سنة 2024 أدنى حصيلة حرائق غابات منذ سنوات، ما يعد إنجازا غير مسبوق ضمن المسار الوطني للوقاية من هذه الظاهرة، حيث قدرت المساحة الإجمالية التي مستها الحرائق بـ3.490.58 هكتارا فقط، في حين أن المعدل السنوي خلال السنوات الـ10 الأخيرة كان يقارب 40.000 هكتار، أي أن الانخفاض بلغ 91 بالمائة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد الحرائق المسجلة والتي بلغ عددها 740 بؤرة فقط، مقابل معدل سنوي خلال نفس الفترة وصل إلى 2800 حريق، أي بانخفاض قدره 73 بالمائة.
ما الذي ساهم في تحقيق هذا التراجع برأيك؟
تحقيق هذه النتائج يعكس نجاح الإستراتيجية الوطنية التي ارتكزت على التدخل السريع، التكامل المؤسسي واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
ما هي إستراتيجية الجزائر للتصدي للحرائق والعمل على احتوائها؟
تعتمد الإستراتيجية المتبعة من طرف الدولة الجزائرية على مقاربة وطنية شاملة، تقوم على الإستباق والجاهزية الميدانية والتنسيق المؤسساتي والتكنولوجيا الحديثة، وقد تم تجسيد الإستراتيجية من خلال جملة من التدابير التنظيمية والتقنية والعملياتية، ففي الجانب التنظيمي، أصدرت مراسيم تنفيذية على غرار المرسوم رقم 245/24 المؤرخ في 23 جويلية 2024، والذي يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق أعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، كما تم تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات وتفعيل اللجان الولائية والمحلية على مستوى 40 ولاية معنية، بهدف ضمان التكامل بين مختلف الفاعلين.
وماذا عن المستوى العملياتي؟
على المستوى العملياتي، تم تعزيز الجهاز العملياتي لقطاع الغابات بموارد بشرية ومادية تعمل بتناغم مع الأجهزة العملياتية للقطاعات المنوطة بمكافحة الحرائق، سواء كانت برية أو جوية، وفي هذا المجال، فإن الجهاز العملياتي لقطاع الغابات مكون من 5683 عامل غابات، و3245 عاملا موسميا، إلى جانب 544 فرقة تدخل أولى، و364 سيارة إطفاء «س س س آف آف آل» و493 برج مراقبة و2799 نقطة مياه، فضلا عن تجهيزات إضافية مثل الخيم الميدانية وحقائب الظهر المائية.
وعلى الصعيد الوقائي؟
على الصعيد الوقائي تم تنفيذ مجموعة من الأشغال الحراجية الهامة في إطار شبكة الدفاع عن الغابات «دي آف سي إي»، والتي شملت فتح وتهيئة أكثر من 49000 كلم من المسالك الغابية، وإنجاز 29539 هكتارا من الخنادق المضادة للنيران، وتهيئة وتنقية أكثر من 15000 هكتار من المساحات الغابية خلال سنة 2024 وحدها، مع برمجة مساحات إضافية لسنة 2025، كما تم تنفيذ أعمال مشتركة مع مختلف القطاعات منها الأشغال العمومية، سونلغاز، البلديات، السكك الحديدية والاتصالات، وذلك من أجل تنقية حواف الطرق والشبكات المرورية لمنع امتداد النيران.
وترافق هذه الجهود بحملات توعية وتحسيس واسعة النطاق، تشمل وسائل الإعلام والمساجد والمجتمع المدني، وهذه الإستراتيجية متكاملة تشمل ثلاثة أهداف رئيسية هي تحسين المعارف حول مسببات الحرائق والآثار التي يمكن أن تنجم عنها من خلال إشراك دور المواطن وتفعيل دور المجتمع المدني، ثانيا التقليل من عدد بؤر اندلاع الحرائق وثالثا تحسين فعالية التدخل ضد حرائق الغابات خاصة الحرائق الناشئة.
أي دور للتكنولوجيا في الوقاية من الحرائق؟
فعلا، التكنولوجيا تساعد كثيرا في رصد الوضع الميداني، بحيث نعتمد اليوم على استخدام طائرات بدون طيار «درون» بعدد 15 وحدة درون، إضافة إلى 20 طائرة درون أخرى لسنة 2025، مع تكوين 85 إطارا في تشغيلها، وكاميرات مراقبة وخرائط رقمية لتحديد أماكن الخطر، كما يتم تحليل صور الأقمار الصناعية لمعرفة تطور الغطاء النباتي والاستعداد المسبق للتدخل عند الضرورة، إلى جانب ربط شراكات مع مراكز بحث علمي لتطوير أنظمة إنذار مبكر وحلول رقمية ميدانية.
هل تعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالحرائق؟
نعم، هناك مشاريع قيد الاستعمال تعتمد على تحليل المعطيات مثل الرطوبة والرياح ونوع النباتات لتحديد الأماكن المعرضة للحرائق، مثل هذه المعلومات تستخدم لتوزيع الوسائل بشكل أفضل وتحديد أولويات التدخل.
يشهد العالم تزايدا ملفتا في عدد حرائق الغابات خلال السنوات الأخيرة، كيف تساهم التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في ذلك؟
هذا السؤال يطرح اليوم وبإلحاح على المستوى الدولي، فالمعطيات المناخية الحديثة تشير إلى أن التغيرات في المناخ تعد من الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع المقلق في عدد وشدة حرائق الغابات حول العالم خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفعل تأثير ارتفاع درجات الحرارة، توالي موجات الجفاف وتراجع الرطوبة، وكلها عوامل تسرع من قابلية اشتعال الغطاء النباتي، كما تسجل تغيرات حادة في أنماط التساقطات المطرية، خاصة في مناخ البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى نمو سريع للنباتات والأعشاب، ثم تجف هذه الكتلة النباتية في الصيف.
وماذا عن الجانب البشري؟
إلى جانب العوامل المناخية، فإن النشاط البشري غير المسؤول يعتبر العامل الأول لاندلاع الحرائق، ثم تتدخل بعد ذلك العوامل المناخية التي تزيد من حدة هذه الحرائق، فكل 9 حرائق من أصل 10 مسجلة في مناخ البحر الأبيض المتوسط يعود سببها للعامل البشري، من خلال التصرفات الخاطئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن قصد أو عن غير قصد، مثل التعدي على الغابات، التوسع العمراني العشوائي، سوء استعمال النار في الفضاءات الغابية وما جاورها، إضافة إلى مختلف مسببات حرائق الغابات، وكل هذا يساهم في خلق بيئة محفوفة بالمخاطر، وبالتالي يرى الخبراء أن هذه الظاهرة ليست نتيجة لعامل واحد، بل نتيجة تراكمات بيئية ومناخية وسلوكية.
ومن هنا، فإن التصدي لتزايد الحرائق يتطلب إستراتيجيات مزدوجة، من خلال الحد من آثار التغيرات المناخية عالميا بخفض الإنبعاثات الكربونية، ومن جهة أخرى تبني خطط تشاركية للوقاية والتدخل السريع، وهو ما شرعت فيه الجزائر كجزء من جهودها الإستباقية.
حاورته: إيمان زياري

في دراسة أعدها خبير البيئة و الاقتصاد الدائري كريم ومان
النفايات.. من الفرز إلى القيمة المضافة
يعتمد الاقتصاد الدائري المستدام على استرجاع النفايات و إعادة استعمالها وفق نظم تقنية و اقتصادية و بيئية محددة، لا يمكن التغاضي عنها لتحقيق الهدف الاجتماعي و الاقتصادي من العملية، و يرى خبير البيئة و الاقتصاد الدائري، كريم ومان، بأن العمل الميداني الجاد، و المدعوم بالمعرفة و البيانات الواقعية هو الطريق الصحيح إلى الاقتصاد الدائري المستهلك للنفايات القابلة للاسترجاع و إعادة الاستعمال من جديد دون الإضرار بالنظم البيئية و الصحية.
فريد.غ
و قد أعد كريم ومان، الذي كان يدير الوكالة الوطنية للنفايات، مديرا عاما لها، دراسة واقعية وافية تتعلق بعملية توصيف النفايات وبعدها التقني، و اعتبرها رافعة إستراتيجية أساسية لتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
و قد حصلت الصفحة الخضراء بجريدة النصر على نص الدراسة، التي تكتسي أهمية كبيرة للجماعات المحلية، و الاقتصاد الوطني، المتوجه نحو التنوع وتحقيق الاستدامة
يقول خبير البيئة الجزائري كريم ومان بأن المؤشرات الناتجة عن عملية التوصيف ليست مجرد إحصائيات، بل تُعد أدوات حقيقية لمساعدة صناع القرار لدى الجماعات المحلية والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، موضحا بان الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية يتطلب أولاً وقبل كل شيء معرفة دقيقة بكميات التدفقات المختلفة وتقلباتها الموسمية، حيث يُعد تحديد الكميات الدقيقة لمختلف التدفقات المكونة للنفايات المنزلية عملاً شاقاً ويتطلب خبرة مؤكدة في هذا الميدان.
في الواقع، يضيف المتحدث في تقريره، فإن تقدير كمية صنف معين من النفايات يعني حساب إجمالي كمية هذا التدفق، و ضرب مثالا على ذلك بالقارورات البلاستيكية المصنوعة من مادة ال (بي.يو.تي) المنتجة في نطاق جغرافي معين قد يكون بلدية على سبيل المثال، و ذلك خلال سنة واحدة. ولتحقيق ذلك، يتم اعتماد منهجية التوصيف.
توصيف النفايات.. إجراء علمي دقيق
حسب كريم ومان فإن توصيف النفايات هو إجراء علمي ومنهجي يهدف إلى تحديد التركيبة الكمية (بالوزن أو الحجم) والنوعية (النوع) للنفايات المنتجة من طرف السكان في منطقة محددة. و تعد هذه المنهجية أداة لا غنى عنها لاتخاذ القرار من أجل إدارة عصرية وفعالة للنفايات. تنقسم المنهجية إلى ثلاث مراحل رئيسية هي أخذ العينات، الفرز و الوزن، و الاستقراء على كامل الإقليم المستهدف.
مرحلة أخذ العينات
تُعد هذه المرحلة الأكثر حساسية، إذ تعتمد مصداقية الدراسة بأكملها على جودة العينة المختارة، و الهدف هو جمع كمية من النفايات تعكس بشكل دقيق عادات جميع سكان المنطقة المدروسة.
و يعتمد اختيار عينة ممثلة على أساليب إحصائية دقيقة لضمان أن تعكس العينة تنوع الإقليم المستهدف بالدراسة.و حسب الباحث فإنه و لتحديد هذه العينة، يتم اختيار عدة مئات من الأسر النموذجية، مع مراعاة معايير متعددة، أهمها نوع السكن، و من الضروري أيضا احترام نسبة المنازل الفردية والسكنات الجماعية، لضمان تمثيل خصائص كل نوع من أنواع السكن. 
و هناك معيار أخر ذو أهمية و هو المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة، إذ يمكن أن تختلف أنماط الاستهلاك بشكل كبير، حسب دخل الأسر، لذلك من الضروري إشراك أسر من أحياء مختلفة، لتمثيل هذا التنوع الاقتصادي و الاجتماعي.
و عادة ما تمتد عملية الجمع على أسبوع كامل لكل فصل من السنة، بهدف التقاط دورة استهلاك عادية، و تسمح هذه المقاربة بالحصول على بيانات دقيقة وتمثيلية للعادات الحقيقية لاستهلاك و إنتاج النفايات لدى الأسر المختارة.
مرحلة الفرز والوزن
بعد جمع عينة النفايات، يتم نقلها إلى منطقة فرز لتحليلها يدوياً، و تبدأ العملية بوزن العينة ككل، ثم تُفرش النفايات على طاولة فرز حيث يقوم العمال بفرزها إلى فئات محددة مسبقاً تُسمى “تدفقات”.
تشمل هذه التدفقات عادةً النفايات العضوية (القابلة للتحلل)، مثل بقايا الطعام، الورق والكرتون، الزجاج، المعادن، المنسوجات، البلاستيك وغيرها. يتم وزن كل تدفق على حدة، ثم تحسب النسبة المئوية لكل فئة مقارنة بالوزن الإجمالي للعينة. على سبيل المثال، بالنسبة لفئة البلاستيك، يتم فرز نفايات تغليف PET إلى فئات فرعية منفصلة، لأنها لا تملك نفس القيمة ولا نفس الاستخدامات الممكنة. تشمل هذه الفئات الفرعية الPET الشفاف، و «البيوتي» الملون، و «البيوتي» المعتم. ويتم وزن كل فئة فرعية بشكل منفصل، ما يسمح بتقديم صورة دقيقة جداً عن جودة وتركيبة كمية «البيوتي».
استقراء النتائج
المرحلة الأخيرة لتحليل تركيبة النفايات تتمثل في استقراء النتائج المتحصل عليها من العينة لتقدير الكميات السنوية لكل تدفق على مستوى كامل الإقليم البلدي، و تعتمد هذه العملية على مبدأ التناسب البسيط.
تُطبق النسب المئوية الناتجة عن الفرز اليدوي للعينة، على إجمالي كمية النفايات المنتجة من طرف إقليم البلدية خلال سنة واحدة.
كيفية حساب الكمية السنوية لتدفق معين الكمية السنوية للتدفق (طن)=
(وزن التدفق في العينة / الوزن الكلي للعينة) × الإنتاج السنوي للنفايات بالطن، و تسمح هذه المقاربة بتحويل البيانات المستخلصة من العينة إلى تقديرات دقيقة للكميات السنوية لكل نوع من النفايات على مستوى البلدية.
و باختصار، يتم تحليل عينة ممثلة من أكياس القمامة بالتفصيل لاستنتاج محتوى جميع نفايات البلدية خلال سنة واحدة.
و قدم خبير البيئة كريم ومان حالة عملية تتمثل في تقييم الكمية السنوية لنفايات تغليف البلاستيك PET لبلدية تعدادها 100,000 نسمة.
كإطار بلدي، كُلفت بمهمة تقدير الكمية السنوية لقارورات البلاستيك PET في بلديتي التي يبلغ عدد سكانها 100,000 نسمة. لإنجاز هذه المهمة، يجب أن أنظم العمل على مدار سنة كاملة لتغطية الفصول الأربعة.
المعطيات الأولية، إجمالي عدد السكان 100,000 نسمة، متوسط حجم الأسرة 5 أفراد، العدد الإجمالي للأسر 20,000 أسرة.
و تعتمد المنهجية أربع حملات توصيف موسمية على عينة ثابتة من 500 أسرة، كل حملة تدوم أسبوعاً.
نتائج توصيف النفايات الموسمية
قام فريق التقييم بفرز ووزن نفايات تغليف البلاستيك PET للعينة وكانت النتائج كما يلي:
حملة الربيع: 160 كلغ
حملة الصيف: 190 كلغ
حملة الخريف: 150 كلغ
حملة الشتاء: 140 كلغ
للحصول على قياس موثوق، تم حساب متوسط الحملات الأربع:
(160 + 190 + 150 + 140)/4 = 160 كلغ.
هذا يدل على أن عينة 500 أسرة تنتج في المتوسط 160 كلغ من نفايات قارورات البلاستيك PET أسبوعياً.
الإسقاط على كامل الإقليم البلدي
حساب النسبة لكل أسرة:
متوسط الإنتاج لكل أسرة في الأسبوع: 160 كلغ ÷ 500 أسرة = 0.32 كلغ/أسرة/أسبوع.
تعميم هذا المعدل على 20,000 أسرة:
0.32 كلغ/أسرة × 20,000 أسرة = 6,400 كلغ/أسبوع (6.4 طن).
الكمية السنوية:
6.4 طن/أسبوع × 52 أسبوع = 333 طن سنوياً.
النتيجة
استناداً إلى حملة توصيف شملت الفصول الأربعة، تم تقدير الكمية السنوية لنفايات تغليف البلاستيك PET في بلديتي ذات 100,000 نسمة بحوالي 333 طنا.
إبراز المؤشرات الرئيسية
الكمية السنوية المقدرة بـ 333 طنا من PET ليست مجرد رقم، بل تتيح استخلاص مؤشرات إستراتيجية عديدة، هذه البعض منها
العدد الإجمالي للقارورات سنوياً 10.1 مليون (333,000,000 غرام / 33 غراما لكل زجاجة).
الإنتاج لكل فرد 101 قارورة/فرد/سنة (أي حوالي قارورتين لكل فرد أسبوعياً).
التدفق اليومي البلدي: 27,650 قارورة تُنتج يومياً (تمثل 9 كلم من القارورات المصطفة يومياً).
الآثار التشغيلية و الاستراتيجية
إن التصور الواقعي لـ 333 طنا سنوياً، أي ما يعادل 10 ملايين قارورة سنوياً (حوالي 28,000 وحدة يومياً)، يعزز بشكل كبير الأبعاد التشغيلية و الاستراتيجية.
هذا التوضيح الكمي يلعب دوراً محورياً في تعبئة المنتخبين والمصالح التقنية للبلدية، إذ يبرر استثمارات كبيرة في أنظمة جمع وفرز واسترجاع فعالة، ضرورية لإدارة مثل هذا التدفق بكفاءة.
وأخيراً، فإن هذه الكمية البالغة 10 ملايين قارورة سنوياً تشكل حجة تجارية قوية وملموسة أمام المستثمرين المحتملين.
مؤشر الاستهلاك
إن كمية نفايات البلاستيك PET المنتجة لكل فرد في بلديتي ليست مجرد مؤشر بيئي، بل هي أيضاً أداة تحليل اقتصادي لمصالح التجارة وللفاعلين في قطاع المشروبات. إن 101 قارورة نفايات بلاستيكية PET لكل فرد في السنة هو مؤشر يعكس الاستهلاك المحلي ويمكن استخدامه من قبل منتجي السلع الاستهلاكية لتقييم سوق المشروبات في بلديتي.
كما يمكن الاستنتاج أن كل فرد في بلديتي ينفق ما بين 3,000 و15,000 دينار جزائري سنوياً على شراء المشروبات، ما يمثل سوقاً إجمالية تتراوح بين 30 مليون دينار و1.5 مليار دينار جزائري لإقليم البلدية بأكمله.
خلاصة الدراسة
تفرض عملية توصيف النفايات نفسها اليوم، إلى جانب بعدها التقني، كرافعة إستراتيجية لتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، فالمؤشرات الناتجة عن هذه العملية مثل الكمية السنوية المقدرة بـ 333 طنا من PET، عدد الزجاجات المنتجة أو معدل الاستهلاك الفردي ليست مجرد إحصائيات بسيطة، بل تُعد أدوات حقيقية لمساعدة صناع القرار لدى الجماعات المحلية و المستثمرين و الفاعلين الاقتصاديين.
تثمين هذه المؤشرات يعني أولاً تحقيق إدارة أكثر فاعلية لتدفقات النفايات، عبر استباق احتياجات الجمع و الفرز و إعادة التدوير.
كما تتيح الدراسة قراءة واقعية لإمكانيات السوق المحلي، قادرة على جذب المستثمرين في قطاع التدوير، و تحفيز عملية إنشاء فرص العمل، و تشجيع الابتكار في الاقتصاد الدائري.
و أخيراً، يقول الباحث و خبير البيئة الجزائري كريم ومان، فإن نشر هذه البيانات لدى الجمهور العام، وأصحاب المصلحة، يساهم في تعزيز الوعي الجماعي حول القضايا البيئية، ودفع التغيير نحو سلوكيات مستدامة.
وباختصار، فإن تثمين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لإدارة النفايات يحول القضية البيئية إلى محرك حقيقي للتنمية و إبراز جاذبية الإقليم لصالح الجماعات المحلية.