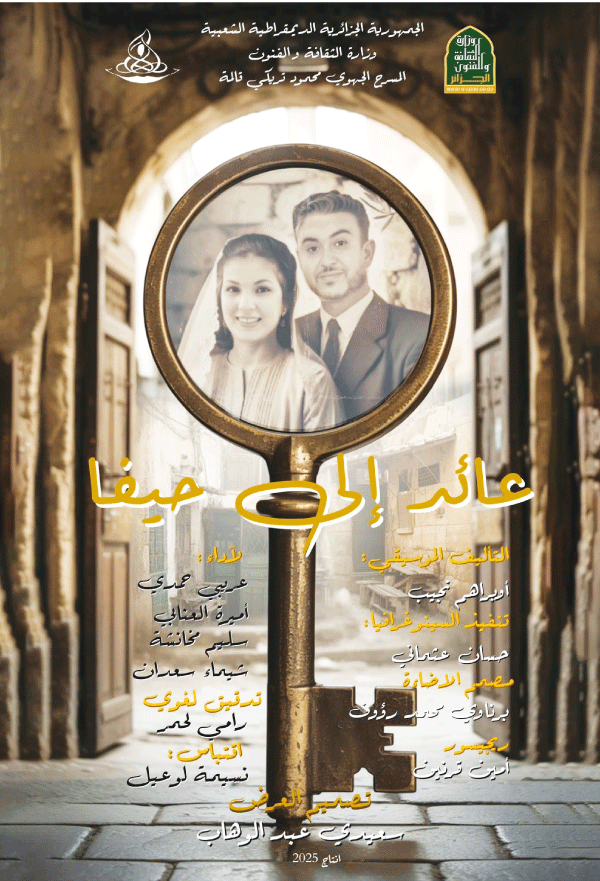
د. ياسين سليماني
عندما يتم ترحيل رواية، أو أي نص أدبي غير مسرحي إلى المسرح، من فضائها الأصلي إلى فضاء جديد هو الخشبة، بطزاجته، عبقريته، قوته، وهشاشته أيضا فإنّ الجمهور يتوقع أكثر من مجرد إعادة سردها. ينتظر رؤية جديدة، قراءة نقدية، أو حتى خيانة خلّاقة للنص الأصلي تمنحه حياة ثانية. لكن عرض "عائد إلى حيفا" من إخراج عبد الوهاب سعيدي (إنتاج مسرح قالمة) والذي قُدم عرضه الشرفي في مسرح قسنطينة بتاريخ 09 جويلية 2015 بدا وكأنه متهيّب في أن يدخل في هذه المغامرة الوجودية الفنية الخلاقة، وكأنه من البداية اختار أن يرفض الإبحار في مسارات مجهولة، جديدة، حية، مكتفيا بإعادة فجّة للرواية وقراءتها بصوت عالٍ بلا أدنى محاولة لبناء تجربة مسرحية قائمة بذاتها.
الرواية الأصلية، "عائد إلى حيفا" لغسان كنفاني، تحمل قوة عاطفية وسياسية كبيرة. لكنها في هذا الاقتباس أعيدت بطريقة تكاد تكون حرفية، مع تغيير وحيد تقريبا في نهايتها: فبعد عشرين عاما من تربيته عند العائلة اليهودية، نجد الابن "دوف" وبعد جلسة سكر طويلة ينتفض فجأة، ثم ينتفض ويتهم أمّه اليهودية بالكذب، ويعلن وعيه المفاجئ: "أنا فلسطيني ولست إسرائيليًا، أنا من الطرف الآخر". ثم يفجر البيت الذي عاش فيه عمره كله.
هذه النهاية، بدل أن تمنح النص عمقا، تكشف هشاشة الكتابة المسرحية. لحظة الوعي التي كانت المسرحية تطمح ليكون انقلابا دراميا، فكريا وجماليا يحدث الدهشة والمتعة عند المتلقي لم تكن لحظة متدرجة، كما أنها ليست صادقة وجوديا، بل تبدو تقريرية ومفروضة من الخارج، ليست من تفاعلات الشخصية مع نفسها، مع عقلها ومع وجودها، مع واقعها بل من إرادة المخرج (فقد بدا الإخراج يعاني من مسافة شعورية هائلة، وجبل جليدي حاد بينه وبين القضية التي بدا أنها يريد الدفاع عنها)، إنّ الوعي الأصيل ينبع من خبرة حقيقية، من أزمة داخلية تنمو ببطء، من مواجهة صادقة مع الحرية والمسؤولية. أما هنا فنحن أمام وعي مزيف، ديكور سياسي، يوزع الشعارات أو يكاد، ويغلق النقاش بدل أن يفتحه.
ثم إن مشكلة العرض لا تقف عند النهاية وحدها. لقد جاء كله في نبرة توضيحية مدرسية: عرض يشرح الرواية بدل أن يعيد ابتكارها على الخشبة. حوارات طويلة تشرح وتفسر، صوت راوٍ أثقل العرضَ في تقريرية بائسة بلا دلالة جمالية، مسرح فقير بصريا وحركيا، بلا مجاز أو لعبة أو اقتراح. كأن المخرج اكتفى بأن يطمئن الجمهور إلى أنه "احترم النص" ونقله بأمانة (على اعتبار أن الإضافة المقترحة لا جمالية)، لكن الأمانة هنا خيانة، لأنها قتلت حرارة العمل.
وهنا قد نرمي بحصى صغيرة في مياه ظلّت آسنة لأكثر من خمسة عقود، أي منذ مقتل كنفاني، وهي مسألة غالبا ما تُهمل في الحديث عن كنفاني نفسه. صحيح أن الرجل تحوّل إلى رمز نضالي استثنائي، وأن اغتياله المفجع أضفى عليه هالة أسطورية. لكن هذه البطولة السياسية لا تعني بالضرورة أن أعماله الأدبية هي الأفضل أو الأغنى من الناحية الفنية. في رأيي، مثلا، فإنّ كنفاني روائي متواضع فنيا إلى درجة لا تصمد معها الكثير من الأعمال الفلسطينية أصلا، كمثال (ويبقى هذا رأيا يمكن في مناسبات أخرى توفير الحجج اللازمة له وهي كثيرة) نجد عند إميل حبيبي عمقا سرديا وتركيبا فنّيا أكثر نضجا، وسخرية مأساوية أكثر إيلاما وصدقا (من يخاطر من الجزائريين بإنجاز مسرحية تستلهم عملا من أعماله؟). لكن العرض تعامل مع رواية كنفاني وكأنها نص مقدس، يستحق فقط التلاوة. لم يجرؤ على مساءلتها، لم يفتش في صمتها أو تناقضاتها أو إمكاناتها المسرحية.
ثم تأتي مشكلة التمثيل. كان واضحا أن الممثلين فيهم مادة خام جيدة من الناحية الجسدية والصوتية. لكنهم ظلّوا مادة خاما غير مصقولة. جاء الأداء ميكانيكيا، كأنهم يلقون حوارا مدبلجا بلا حرارة أو إنصات. الأخطاء اللغوية الكثيرة (ويا للدهشة أن الأخطاء انسحبت أيضا إلى التسجيلات الصوتية التي تستعيد شخصية الأب سعيد) لم تكن مجرد زلّات فردية، بل عرضت غياب التوجيه الجاد في التدريب.
لكن المسؤولية هنا لا تقع على الممثلين بقدر ما تقع على المخرج. إدارة الممثلين ليست توزيع أدوار فحسب، بل صناعة وجود على الخشبة. وظيفة المخرج أن يصهر هذه المادة الخام، أن يجعلها تحترق، أن يخلق الظروف ليولد الصدق. هنا غابت تلك الرؤية. لم نر عملا على الصمت، على النبرة، على الإيماءة. لم نر جهدا لتحويل القصة من حكاية تروى إلى حياة تعاش أمامنا.
كان يمكن للنص الأصلي أن يكون مجرد ذريعة للبحث عن أسئلة أصعب، عن صورة جديدة لفلسطين وللفقدان وللشتات. كان يمكن للعرض أن يقترح، أن يغامر، أن يزعج. لكنه اختار الطريق الأسهل: إعادة السرد، التوكيد، وما يقترب من الوعظ السياسي. والنتيجة كانت عرضا مسطحا، يفتقر إلى التوتر، إلى الجدل، إلى تلك الشرارة الغامضة التي تجعل المسرح فنا لا يشبه أي فن آخر.
في النهاية، يمكننا الدفاع عن الجرح الفلسطيني بالكثير من الجدية والفنية، بعيدا عن أي ابتذال أو ترديد شعارات فارغة، بعيدا عن التبسيط المخل الذي يجعل عرضا محترفا أقرب إلى العمل الهاوي المبتدئ الذي يخطو فيه صنّاعه خطواتهم الأولى في الطريق الطويل للفن، لدينا متسع واسع، مثل محيط بلا شاطئ، لاختيار نصوص كبيرة، أو كتابة نصوص جديدة تليق بهذه المأساة المفتوحة. بل إن ما يحدث يوميا من واقع مهين للكرامة الإنسانية، في فلسطين وفي ضمير العالم، كفيل وحده بأن يخلّف آلاف النصوص القوية والصادقة. ليست الحاجة اليوم إلى إعادة نفخ الروح في جسد روائي مستهلك، إن لم يكن ميتا فقد قُتل من فرط الاقتباس والاستهلاك، بل إلى شجاعة فنية تحفر في المعنى، وتُصغي إلى الألم، وتجازف بابتكار لغة جديدة تليق بفداحة الخسارة. هكذا فقط يمكن أن نشاهد عرضا يليق أن نحتفي فيه بالفن ونعلي فيه قيمة قضايانا الكبرى، وهكذا فقط نكون أمام عرْض فني لا عَرَض مسرحي، هامشي، زائل، هش، ومنذور للنسيان.