
إن المظهر الأبرز للصدقة في عرف الفقه الإسلامي وما درج عليه المسلمون في تاريخ مجتمعاتهم هو إخراج المال؛ نقدا أو عينا، زكاة أو تطوعا وبرا؛ لكن المظهر وإن كان أساسيا لا يعد الوحيد المطلوب شرعا لأداء الصدقة ونيل ثوابها، فقد كشفت نصوص شرعية أنها تتسع لتشمل سلوك الإنسان المسلم ذاته في علاقته مع محيطه الاجتماعي والبيئي، قولا وعملا، ففي الحديث النبوي الشريف ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل سُلَامَى من الناس عليه صدقةٌ، كل يومٍ تطلع فيه الشمس: تعدل بين اثنين صدقةٌ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقةٌ، والكلمة الطيبة صدقةٌ، وبكل خطوةٍ تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ، وتميط الأذى عن الطريق صدقةٌ)؛ رواه البخاري ومسلم، والسلامى يد الإنسان وهي العظام التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان
فهذا الحديث يشتمل على الكثير من أعمال بر ذات بعد فردي وجماعي، فكل سلامى منها يتطلب صدقة شكرا لله تعالى الذي أنعم به، ومنها:
(أولا) العدل بين الناس في مجالس الصلح أو القضاء أو أي مجلس آخر توزع فيه الحقوق بين الناس وتسترد المظالم وينصف المظلومون، ولو كانت هذه المجالس في المساجد أو داخل الأسرة، أو في مؤسسات التربية والتعليم أو في مؤسسات العمل ومختلف الإدارات، فالعدل في هذه المواطن صدقة عظيمة يترتب عليه ثواب جزيل.
(ثانيا)-تقديم يد العون للمحتاج، وهنا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مساعدة الرجل ليركب دابته أو إعانته ليحمل متاعه وأغراضه عليها، لكن المفهوم يتعدى لينسحب على كل مركوب في هذا العصر من دابة أو دراجة أو سيارة أو حافلة أو قطار أو طائرة أو غيرها، فكل من أعان غيره فيها كان مؤديا لصدقة تجلب أجرا.
(ثالثا)- الكلمة الطيبة التي تلفظ بها أمام الناس، فألا أو نصحا أو إرشادا أو تعليما أو إصلاحا بينهم، تعد هي الأخرى من أفضل الصدقات، وقد ورد مدحها في كتاب الله تعالى كثيرا منها قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون [إبراهيم: 24- 27]، وقال الله تعالى: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10]، ولذلك أمر الله تعالى بها؛ فقال: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الإسراء: 53]. وكان من أسباب دخول المؤمنين الجنة هدايتهم إلى القول الطيب؛ قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ [الحج: 23، 24].
(رابعا)إكثار الخطى إلى المساجد فكل خطوة يخطوها المسلم إلى المسجد تكتب له بها صدقة، وفي الحديث: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة).
(خامسا)-إبعاد الأذى عن طرقات الناس ومجالسهم وعدم تعريضها للتلوث وغيره، وهو عمل صالح يسهم في المحافظة على سلامة البيئة ونظافة المحيط والمحافظة على الصحة العامة؛ في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإيمانُ بضع وسبعون -أو بضع وستون -شُعبةً، فأفضلُها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبة من الإيمان)؛ (مسلم)، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ وجَد غُصنَ شَوكٍ على الطريق فأخَّره، فشَكر الله له؛ فغَفَر له)؛ (متفق عليه)،
فكل هذه الأعمال أعمال بر يؤديها المسلم فتكتب له بها صدقات عظيمة؛ وإن لم تكن ذات طابع مالي؛ ولذا فإن المسلم يسخر صحته في طاعة الله تعالى وخدمة الناس بالعدل والخير.
ع/خلفة
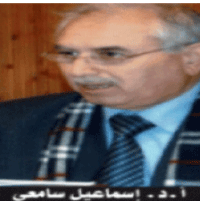
العمل أمانة وينبغي أن يكون صالحا
إن أمانة العمل متعلقة بالإنسان حيث أن الحياة حركة محورها الإنسان، قال الله تعالى: ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)) التوبة،105، وإذا كانت أمة اقرأ لا تقرأ، فإن الأمة نفسها المدعوة إلى العمل لا تعمل، ولا تنتج ما تأكل وتلبس، ناهيك عن أن تتقن ولا تغش قال جل جلاله: ((صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ(، النمل، 88. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ) أخرجه الطبراني وأبو يعلى والبيهقي؛ لكن ما يلاحظ أن العامل في البلاد الإسلامية إذا عمل نظريا وقانونيا ثماني ساعات فإنه ينتج إنتاج عمل نصف ساعة ما ينتجه العامل الياباني أو الصيني، وساعة إنتاج العامل الأوروبي، وما ترتب عن هذا الوضع أن المشاريع التي يمكن أن ينجز الواحد منها في يوم، صار ينجز في أسبوع ، والمشروع الذي ينجز في أسبوع أصبح في شهر، والذي في شهر امتد إلى سنة بل سنوات، وزادت التكلفة، وتأخرت التقانة. إنها معضلة المعضلات! فهل العامل المسلم وفي بلادنا فعلا يجسد المنهج الإلهي «وقل اعملوا»، ويمثل خيرية الأمم. قال جل جلاله: ((كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)) آل عمران،110
فالكثير من العمال والموظفين للأسف الشديد يتأخرون بأكثر من ساعة لمباشرة العمل ولا يبكرون، وينصرفون قبل فترة انتهاء العمل، ويقضون وقتا طويلا في تناول طعام الغداء، وشرب القهوة، وحتى في أداء الصلاة التي تحثهم على الانضباط؟، ويتغيبون لأعذار واهية، ولا يجدون ويكدون في تكوينهم واستيعاب كنه حرفتهم أو مهنتهم، ويجعلون من النقابة، والإضراب غطاء لأفعالهم، كل هذا دون وازع ديني ولا وخز ضمير، فنسيت الواجبات، وتضخمت المطالبة بالحقوق، وحدث ولا حرج عن العطل الموسمية والأعياد، فعطلة يوم تمدد إلى أسبوع، وعطلة أسبوع إلى شهر وهكذا، وقد عم هذا السلوك المشين الجامعة والأوساط الطلابية، أيضا، حيث تمس فئة من أبناء الأمة تعد لقيادتها
والعمل لا يسمى عملا إلا إذا كان صالحا لله ولعباده، وهو العمل الذي يراه الله ورسوله والمؤمنون، ويشهدون عليه دون خديعة والرسول صلى الله عليه وسلم في فرضه يعرف ذلك؛ فإذا كانت المسألة تتعمى على المؤمنين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله هو الذي يعلم، وليعلم كل عامل وعاملة أن الله يراقب أعمالهم، ويراقب آلية ما يعملون. (الشعراوي، تفسير، 8/700)، لذلك لابد من تربية الروح لدى المؤمنين واستنهاض الضمير في الإنسان ليكون دافعا له في العمل المتقن، وفي حركة الحياة.
وعلى الإنسان أن يطلب العلم مدة حياته، وأن يعمل طول عمره، فالأعمار محدودة جدا فلا عطلة ولا تعطيل، وأن حكم الصلاة الواجبة على الإنسان المسلم حتى وهو على فراش المرض وربما الموت، فينبغي أن يُنزل على الإنسان في العلم والعمل، ولا ننسى أن الإنسان بعمله وبما يتركه من أثر، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله قال صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له» ‘مسلم’. ففي الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة.
يوم 12 ربيع الأول ليس هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
يعتقد بعض المعترضين على الاحتفال بالمولد النبوي أن تاريخ 12 ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أن هذا ليس بصحيح، وتوضيح ذلك ما يأتي:
الثابت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، فلو سلّمنا أنه توفي في ربيع الأول فإنه يستحيل أن تكون وفاته في تاريخ 12 من ربيع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة. وقد أكّد هذا الإمام السهيلي في كتابه الروض الأُنُف؛ ذلك أن وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة قطعا وافق يوم الجمعة، يعني يوم 9 ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة كان يوم جمعة.
وإذا تتبعنا الحساب انطلاقا من يوم الجمعة 9 ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة إلى شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر للهجرة، مع مراعاة جميع الاحتمالات باعتبار تمام أو نقص الأشهر الثلاثة (ذو الحجة، محرم، صفر) بأن نجعل: الأشهر الثلاثة كلها تامة، أو الأشهر الثلاثة كلها ناقصة، أو شهران كاملان وشهر ناقص، أو شهران ناقصان وشهر كامل فإن الحاصل أن 12 ربيع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة على كل الاحتمالات سيكون يوم الخميس أو الجمعة أو السبت أو الأحد. ولم يوافق يوم الاثنين، مما يؤكد أن 12 ربيع الأول ليس هو يوم وفاته. ويوم الاثنين في تلك السَنة (أي 11ه) على كل الاحتمالات الأربعة يوافق يوم 1، 2. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 16. 20. 21. 22. 23.27. 28. 29. 30.
وما ادعاه البعض من انعقاد إجماع الأمة على أن يوم وفاته هو 12 ربيع الأول. فالجواب أن الإجماع الذي نصّ علماء الشريعة على حجيته القطعية التي لا يحلّ مخالفتها هو المتعلق بالأحكام الشرعية، كما في تعريف الإجماع (هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم -بعد وفاته على حكم شرعي عملي)، فنصوا على أنه حجة في (حكم شرعي عملي). وبناء عليه فلا يكون حجة في الأمور التاريخية.
د. محمد العربي شايشي أستاذ بجامعة الجزائر 1
عبر موقعه
الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ينوه بإطلاق مسابقة الجزائر في السيرة النبوية الشريفة
نوه موقع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بإعلان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر نهاية الأسبوع الماضي عن إطلاق مسابقة دولية في السيرة النبوية الشريفة، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وذلك من خلال نشر هذا الخبر في موقعه الرسمي بعنوان الجزائر تطلق «جائزة السيرة النبوية» لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية ونشر الاعتدال عالميًا
وقد نشر الموقع مضمون بيان الوزارة وما تهدف إليه هذه الجائزة من ترسيخ القيم الروحية والإنسانية المستمدة من السيرة النبوية، وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري في خدمة سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحرص الدولة الجزائرية على تعزيز مكانة السيرة النبوية ونشر إشعاعها العلمي والثقافي، بما يسهم في غرس القيم الأخلاقية والإنسانية التي حملها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ونقلها إلى الأجيال لتكون منارة في مواجهة تحديات العصر.
كما واصل الموقع قوله «تندرج هذه المبادرة في سياق التوجه الاستراتيجي للجزائر نحو جعل الدين رافعة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الوحدة المجتمعية، إضافة إلى التصدي للتطرف بخطاب وسطي مستمد من الهدي النبوي الشريف». ويأتي إطلاق الجائزة بعد افتتاح جامع الجزائر الأعظم، أكبر صرح ديني وثقافي في البلاد والعالم الإسلامي، والذي يعكس مكانة الجزائر كمنارة علمية وروحية ومعمارية. كما تؤكد هذه الخطوة على رؤية الجزائر في استثمار البعد الديني كركيزة للأمن القومي، وحماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي كصوت معتدل في العالمين العربي والإسلامي.