خطت الجزائر، أمس، خطوة عملاقة في استراتيجية الخروج من التبعية النفطية وتجسيد توجّه جديد يكرّس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج...
* الصين مستعدة للعمل مع الجزائر على تعميق التعاون في مجال الفضاءتلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، رسالة تهنئة من رئيس جمهورية...
* سعيود : مشروع عملاق يندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنمية أشرف وفد وزاري، مساء أول أمس السبت، على تدشين محطة السكة الحديدية لتندوف وإعطاء إشارة...
وصلت، أمس، إلى ميناء الجزائر أول شحنة من الحافلات المستوردة من قبل مؤسسة تطوير صناعة السيارات، والمقدر عددها بـ335 حافلة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس...
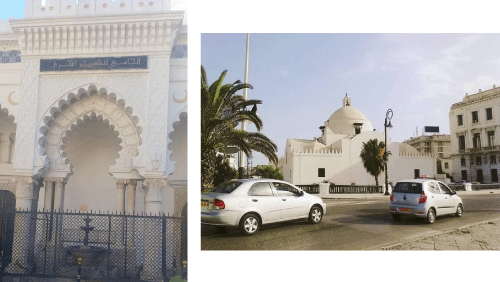
بين أحضان القصبة العتيقة، و ميناء الجزائر، يحتل جامع الجزائر موقعا إستراتيجيا، يزين ساحة الشهداء بواحد من أندر الآثار التي بقيت مخلدة للهندسة المعمارية المرابطية بالجزائر، و قد حاول المستعمر الفرنسي محو الجامع من الخريطة، ليقع في حب المبنى مهندسون فرنسيون هبوا لخدمته، و لو عن غير قصد.بلونه الأبيض الناصع، و هندسته الإسلامية المميزة، يجذبك المبنى الذي يقع بالجزء الشمالي الشرقي للعاصمة، تحديدا بساحة الشهداء، المنطقة التي تكتب تاريخ الجزائر بمختلف حقبه، فهو يحتضن الجامع الكبير، أو كما يفضل الكثيرون تسميته، المسجد العتيق، الذي يطل على ميناء الجزائر، أو نهج البحرية، كما كان يطلق عليه سابقا، ليكون بوابة العاصمة، على مر الزمن . تؤكد الدراسات أن الجامع الكبير، يعد أول و أقدم مسجد بالجزائر العاصمة، فيما يعتبر من أقدم المساجد بمنطقة المغرب الأوسط، بعد مسجد سيدي عقبة ببسكرة، و الجامع الكبير بتلمسان، و الجامع الكبير بندرومة، و قد بني في عهد الدولة المرابطية التي حكمت الجزائر في القرن الخامس للهجرة.
مراجع تشير إلى أنه بني على أنقاض كاتدرائية
يعود تاريخ بناء المسجد على يد مؤسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين، إلى العام 18 للهجرة، و تحديدا في الفاتح من شهر رجب 490 هجري، الموافق لـ18 جوان 1097 ميلادي، بينما اختلفت المصادر حول تاريخ بناء مئذنته، و يرجح أن يكون ذلك خلال 1324 و 1332 ميلادي، و يبلغ ارتفاعها 17 مترا، و بناها سلطان تلمسان الزياني أبو تاشفين بن أبو حمو موسى الأول، كما تشير بعض الدراسات، إلى أنه شيد على أنقاض كاتدرائية مسيحية، بنيت في العهد الروماني.
الجامع الكبير الذي شكل موقعه الجغرافي فارقا في دوره بالمنطقة، كان قبلة للمصلين، الذين يمكن أن يصل عددهم داخل قاعة الصلاة إلى 1500 مصلي، و طلبة العلم، لكونه كان يجاور سوقا كبيرا، إلا أن تواجده و قداسته في نفوس الجزائريين، كانت تزعج المستعمر الفرنسي الذي سعى بشتى الطرق إلى تدميره، ليصطدم بمقاومة شعبية كبيرة، أبت أن يمحى هذا المعلم عن خريطة الجزائر.
و تروي المراجع التاريخية قصة تحديد تاريخ بناء المسجد، و التي اكتشفت صدفة بعد 6 قرون من بنائه، حيث اكتشف المؤرخون سرا في منبر المسجد، يتمثل في كتابات نقشت بالخط الكوفي، مكنتهم من تحديد تاريخ البناء بدقة، لتكون بداية رحلة البحث و التعمق في خبايا المسجد.
انبهر الفرنسيون بمبنى الجامع الكبير، و قام أحد المهندسين الفرنسيين بإعادة بناء ألواح المنبر، بعد تآكلها، ليجري تركيبها مجددا على هيكل حديدي متحرك أكثر صلابة، ما ساهم في بقاء تلك النقوش شاهدة على معلم تاريخي، يشكل أحد الآثار المادية الشاهدة على الهندسة المعمارية المرابطية.
على مساحة قدرت ب 2000 متر مربع، يتربع الجامع الكبير، بذلك المبنى الضخم الذي يختلف قليلا عن هندسة باقي المساجد الجزائرية، حيث يتميز بقاعة صلاة مستطيلة الشكل و قليلة الارتفاع، مغطاة بسقف منحدر، ممزوج بالقرميد الأحمر القديم، تعانق مئذنة شاهقة العلو، يرتفع بها صوت الآذان، فيسمعه سكان القصبة السفلى.
كما أن دخول الجامع الكبير، ليس كدخول باقي مساجد الجزائر، فخصوصية الهندسة المرابطية، لا تزال قائمة، بأقواس متداخلة تصنع ديكورا خاصا بقاعة الصلاة، و نوافذ تشبه أيضا تلك الأقواس، و تطل على ساحة أو حديقة المسجد، المزينة مثل باحات البيوت الجزائرية القديمة، «وسط الدار»، أين تتمايل الأشجار، بجوار مائضة صغيرة، مصنوعة من الحجر، الزليج، الخشب و الرخام، كما لاحظت النصر، خلال زيارة هذا المعلم الديني و التاريخي و التراثي العتيق.
لاحظنا أيضا أن منبر الجامع، تزينه ألواح مزخرفة بأشكال هندسية مختلفة، و يمتد فوق 7 درجات مرتبطة بعارضة خشبية، ظلت شاهدة على تعاقب أئمة، و شيوخ، سعوا على مر الزمن، لرفع راية الإسلام عاليا.
و أدى الجامع الكبير دورا مهما في المجتمع الجزائري، فمن تحفيظ القرآن و الحديث، إلى تكوين و تخرج علماء و أئمة، لمعت أسماؤهم و ساهموا في خدمة الدين الإسلامي، ليظل هذا الشاهد يكتب تاريخ الجزائر.
إيمان زياري