استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. وفق ما...
حضر الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، في ثاني يوم من زيارته إلى دولة قطر، مراسم...
أكدت وزارة الصحة، أمس الاثنين، نجاح المرحلتين الأولى والثانية من الحملة الوطنية للتلقيح، التي استفاد منها قرابة 4 ملايين طفل عبر الوطن. وخلال يوم...
دعت وزارة الاتصال وسائل الإعلام المختلفة إلى ذكر أسماء أصحاب المضامين الإعلامية المنشورة، وفقا لما تنص عليه القوانين. وبحسب بيان لوزارة الاتصال، ورد فيه...

في كل يوم، تستقبل البحار والمحيطات أطنانا من البلاستيك، ولا تتحلل، بل تتحوّل إلى ملوّثات تهدّد الحياة البحرية وتعرقل قدرة المحيطات على أداء دورها الحيوي في تنظيم مناخ الأرض،
فهذه الجسيمات التي لا يزيد قطرها عن 5 ملم، قد تبدو صغيرة الحجم، لكن لها تأثرات كبيرة على البيئة والنظام الطبيعي، وتعد من أكبر التحديات البيئية التي تواجهها سواحل جزائرية اليوم.
رضا حلاس
الميكروبلاستيك.. من نفاية مرئية إلى سم غير مرئي
يمكن أن ينشأ الميكروبلاستيك من تحلل القطع البلاستيكية الكبيرة مع الوقت تحت تأثير الشمس والرياح، أو قد يدخل البيئة مباشرة من مصادر مثل الألياف الصناعية الناتجة عن غسيل الملابس، أو من ومستحضرات التجميل، ويتراكم هذا البلاستيك الصغير في المياه والرسوبيات، وتبتلعه الكائنات البحرية، بدءا من العوالق النباتية، مرورا بالرخويات والأسماك الصغيرة، حتى يصل إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية.
لا يقتصر الأمر على التلوث الحيوي فقط، فبحسب تقارير بحثية بيئية وأخبار منظمات علمية، يمتزج «الميكروبلاستيك» في منظومة المحيطات بحيث يمكن أن يؤثر على قدرة المحيط على امتصاص الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يضعف «الدرع الطبيعي» للأرض ضد تغير المناخ، وهذا التحذير العلمي يضيف بعدا جديدا لأزمة البلاستيك، من مشكلة بيئية محلية إلى تهديد عالمي للنظام المناخي.
بحوث حول تلوث «الميكروبلاستيك» بشواطئ سكيكدة
في الجزائر، تركز الاهتمام العلمي مؤخرا على هذه الظاهرة، ففي دراسة نشرت في المجلة العلمية «مارين بوليوشنبوليتن»
Marine Pollution Bulletin المعنية بالتلوث البحري، ووقعها فريق من الباحثين تقودهم الدكتورة حليمة قريني، من جامعة 20 أوت 1955 بولاية سكيكدة، أجريت أولى التقييمات المنهجية لتلوث «الميكروبلاستيك» على شواطئ ولاية سكيكدة.
هدفت الدراسة إلى تحديد كمية وتوزيع الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في رسوبيات الشواطئ الرملية، وفهم أنماط انتشارها عبر مواقع وجلسات زمنية مختلفة، وبينت النتائج أن مستويات «الميكروبلاستيك» المجمعة كانت عالية جدا مقارنة بقراءة أولية للمناطق الساحلية الأخرى في الجزائر. وأوضحت الدراسة، أن أكثر الأشكال شيوعا كانت الشظايا والحبيبات والرغويات والألياف، وهي تمثل أكثر من 98 % من جميع الجسيمات المكتشفة، مما يشير إلى أن مصادر التلوث متنوعة وأن الأنشطة البشرية تلعب دوراكبيرا في تكوين هذه الجسيمات.
أما عن أسباب التلوث، فحدد الباحثون مصادر محلية وأخرى بحرية، من بينها نفايات البلاستيك المتساقطة على الأرض ثم تجرفها الرياح إلى البحر، والنفايات البحرية الواردة من نشاطات صيد وملاحة، إضافة إلى النفايات الصناعية والحضرية من المناطق الساحلية المجاورة.
لماذا تثير هذه النتائج القلق؟
تشير الدراسة إلى أن تراكم الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الرسوبيات الساحلية ليست مجرد مشكلة نظافة، بل هو مؤشر على تراكم طويل الأمد، ويمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى، هذه الجزيئات تبقى في البيئة لفترات طويلة لأنها لا تتحلل بشكل كامل بل تتحول إلى أجزاء أصغر مع مرور الوقت.
والأخطر من ذلك أن هذه الجزيئات قد تتداخل مع القدرة الطبيعية للمحيطات على امتصاص الغازات الدفيئة، فعلى سبيل المثال قد تتأثر العوالق النباتية التي تعتمد عليها الكثير من السلسلة الغذائية البحرية في تنفسها ونموها، بوجود «الميكروبلاستيك»، مما يضعف نشاطها في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين وهما عمليتان أساسيتان في تحسين المناخ العالمي.
اللدائن الدقيقة.. الأزمة والحل
رغم عمق المشكلة وتشابك أبعادها البيئية، فإن مواجهة تلوث «الميكروبلاستيك» تبقى ممكنة عبر خطوات عملية متكاملة تنطلق من المحلي إلى العالمي، وتظل الجذور الأساسية للأزمة مرتبطة بالإفراط في استخدام البلاستيك، خاصة ذي الاستعمال الواحد، ما يفرض تقليص العبوات البلاستيكية، واعتماد بدائل قابلة للتحلل، وترسيخ ثقافة إعادة الاستخدام للحد من مصدر الجزيئات الدقيقة.
وفي البلدان الساحلية، تمثل إدارة النفايات الفعالة خط الدفاع الأول ضد تسرب البلاستيك إلى البحر، من خلال الاستثمار في جمع النفايات وفرزها وتثمينها وإعادة تدويرها.
كما تؤكد الدراسات العلمية، على غرار ما أظهرته دراسة جامعة سكيكدة، أهمية المراقبة المنتظمة في كشف مستويات التلوث، وفهم مصادره، وتتبع تطوره عبر الزمن، وهو ما يستدعي دعم هذه الأبحاث وتوسيعها على طول الساحل الجزائري.
ولا تكتمل الحلول دون تشريعات وسياسات بيئية صارمة، تشمل حظر بعض المواد البلاستيكية عالية الخطورة، وفرض معايير على المصانع والأنشطة الساحلية، وإنشاء مناطق بحرية محمية، ويبقى الوعي المجتمعي حجر الزاوية، إذ إن التوعية والتثقيف حول مخاطر «الميكروبلاستيك» وتأثيره على الحياة البحرية والمناخ قادران على إحداث تغيير حقيقي في السلوك الجماعي محليا وعالميا، وبمشاركة الأفراد والمؤسسات وصناع القرار لتحقيق حماية مستدامة للبحار والأجيال القادمة كافة في الجزائر والمنطقة المتوسطية والعالمية مستقبلا معا.
الميكروبلاستيك خطر صامت يهدد صحة الإنسان
ولم يعد «الميكروبلاستيك» مجرد خطر بيئي بعيد، بل تحول إلى مشكل صحي يثير قلق العلماء حول العالم، فقد أظهرت تجارب مخبرية على الحيوانات أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة قادرة على إحداث اضطرابات في الجهاز التناسلي للإنسان، خاصة من خلال التأثير على جودة الحيوانات المنوية لديه.
كما وجد أنها قد تضر بعمل الرئتين والأمعاء وتزيد احتمالات الإصابة بسرطانات مثل سرطان الرئة والقولون، إضافة إلى إضعاف جهاز المناعة، كما لوحظ لدى بعض الكائنات البرمائية. ورغم صعوبة إسقاط نتائج هذه الدراسات بشكل مباشر على الإنسان، بسبب اختلاف طبيعة ومدة التعرض، إلا أن الأبحاث الطبية الأخيرة بدأت ترصد مؤشرات مقلقة، من بينها ارتباط «الميكروبلاستيك» بالولادات المبكرة، والالتهابات المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويزداد القلق مع ثبوت خطر هذه المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة البلاستيك، مثل «ثنائي الفينول» و»الفثالات» (وهما مادتان صناعيتان تستخدمان في صناعة البلاستيك والمنتجات الاستهلاكية)، والمعروفة بتأثيرها السلبي والكبير على التوازن الهرموني، وبعضها مصنف كمادة مسرطنة. وتشير تقديرات سابقة إلى أن نسبة معتبرة من الوفيات عالميا قد تكون مرتبطة بالتعرض المفرط للفثالات، ورغم أن تقليل هذا الخطر يجب أن يتم بتغيير أنماط الاستهلاك اليومي، وهكذا فإن المسؤولية لا تقع على الفرد وحده، بل تستدعي استجابة جماعية تترجم إلى التزام حقيقي بإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية صحة الإنسان.
إن اللدائن الدقيقة كما توضحه الدراسة التي أجريت بجامعة سكيكدة، لم تعد تهديدا صامتا يقتصر على الشواطئ أو الكائنات البحرية، بل تحولت إلى خطر عابر للحدود يطال المحيطات وصحة الإنسان في آن واحد، فهي تخترق السلاسل الغذائية، تضعف النظم البيئية البحرية، وتقلص قدرة المحيط على أداء دوره الحيوي في تنظيم المناخ، وفي الوقت نفسه تتسلل إلى أجسام البشر، حيث تتراكم وتثير مخاوف متزايدة بشأن علاقتها بأمراض مزمنة واضطرابات صحية معقدة، ويعد تجاهل هذا الخطر حسب الباحثين، يعني أن نقبل بموت بطيء لأسس الحياة على وجه الأرض، أما مواجهته فتتطلب قرارا جماعيا شجاعا يجمع بين السياسات الصارمة والوعي المجتمعي.

منبع الخنقة ببكارية في تبسة
حظيرة بيئية وشريان سياحي وتنموي
تزخر تبسة بمؤهلات طبيعية ساحرة، تمنح لزائرها متعة المشاهدة والراحة النفسية خصوصا على مستوى بلدية بكارية، الواقعة على بعد 12 كلم شرق الولاية، أين يتواجد منبع مائي جميل تحيط بها الطبيعة من كل جانب و تثري قيمته كنوز تاريخية وأثريات منتشرة في المكان.
يتمتع منبع الخنقة بمياهه العذبة، وبمجرد الوصول إليه تستوقفك لوحة طبيعية تنبض بالجمال والروعة، فالمنطقة تعرف بطابعها المتميز و غاباتها الهادئة النظيفة، أين يتناغم حفيف الشجر مع خرير المياه ليعزف سيمفونية بديعة تستقطب تردداتها الزوار من كل بلديات الولاية من ولايات مجاورة كذلك.
كما يعتبر المنبع شريانا يضخ الحياة في المنطقة، لأنه يزود بعض قاطني مدينة بكارية بالمياه الصالحة للشرب، فيما يشكل جبل بورمان القريب والذي تتدفق المياه من بين صخوره حاضنة بيئية لأصناف نباتية ولأنواع من الطيور والحيوانات كذلك.
ويرى سكان بكارية أن الاهتمام بهذا المنبع بات ضرورة ملحة، لتوفير مناطق استقطاب سياحية ينشطها مستثمرون، وهو ما سيسمح بجذب المزيد من الزوار و السياح، ما سيوفر مناصب عمل لشباب البلدية الذين يعانون من البطالة. وقالوا، إن موقع المنبع الذي تقصده العائلات بكثرة، يتوسط منقطتي الحويجبات وبكارية، ويمكن أن يشكل منتجعا سياحيا
و فسحة طبيعية رائعة للباحثين عن مرافق للترفيه، لاسيما في أوقات العطل.
كما دعا مواطنون قابلناهم في المكان، إلى إعادة تأهيل الموقع من قبل السلطات المحلية أو المستثمرين الخواص، واستغلاله سياحيا بشكل أكبر. وذكر مسؤول ببلدية بكارية، بأن تدخلا متخصصا لتهيئة الموقع من شأنه أن يطور الحركية التجارية في المدينة التي تزخر بمواقع سياحية جد رائعة، يمكن أن تكون قاطبة للاستثمارات.
مضيفا، أن منبع الخنقة لوحده يزود جزءا كبيرا من سكان مدينة بكارية بالمياه الصالحة للشرب و يمون خزانا مائيا، و يساهم أيضا بشكل فعال في التخفيف من أزمة المياه الشروب بالنسبة لقاطني المناطق المتواجدة بالشريط الحدودي. و أوضح المتحدث بأن بلدية بكارية التي تزخر بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة، كانت مقصدا سياحيا للعائلات خلال الأعوام الماضية، إلا أن اعتراض محافظة الغابات على تجوال المواطنين داخل هذه المساحات الغابية عزلها مجددا.
مقترحا، وضع إجراءات لتنظيم التنقل و السياحة في المنطقة بشكل يضمن عودة الحركية بما يخدم الأنشطة التجارية و يوفر فرصا للعمل للشباب، خصوصا في حل سمح للمستثمرين الخواص بإنشاء مشاريع ذات طابع سياحي بيئي يتماشى مع خصوصية البلدية.
ع.نصيب

الخبيرة والمستشارة في البيئة والتنمية المستدامة حميدة مرابط
الجزائر سباقة قاريا لإعداد خطط التكيف المناخي
قالت المستشارة في البيئة والتنمية المستدامة، حميدة مرابط، بأن الجزائر تتخذ موقعا جيدا فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة مقارنة بدول أخرى، معتبرة أن بلادنا كانت سباقة إفريقيا إلى إعداد المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، كما دعت لتبني إستراتيجية وطنية شاملة والعمل بجد تحسبا لتقديم تقرير وطني حول التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة سنة 2030.
إيمان زياري
واعتبرت الخبيرة، أن الجزائر قطعت شوطا مهما في ميدان التنمية المستدامة وأهدافها 17، مرجعة الفضل في ذلك لمجهودات الدولة خاصة وزارة الخارجية، التي قالت إنها تولي الموضوع أهمية خاصة، إلى جانب العمل التقني لوزارة البيئة.
وعلى الرغم من أن الجزائر ليست من البلدان الملوثة، إلا أنها تنتج كميات هائلة من النفايات، وأشارت الخبيرة إلى أن كمية 32 مليون طن من النفايات سنويا تعتبر كبيرة جدا مقارنة بعدد السكان. داعية للعمل على الجانب التوعوي للتقليل من النفايات المنزلية، وتشجيع الاقتصاد الدائري وفق إستراتيجية وطنية شاملة يتم من خلالها إشراك الجميع وفي مختلف القطاعات وحتى المجتمع المدني. وأوضحت، أن التنمية المستدامة نظام أفقي، يخص كل القطاعات دون استثناء، في ظل التغيرات المناخية الكبيرة التي يعاني منها الكوكب.
لابد من العمل جديا على تقرير 2030
وتحدثت الخبيرة، عن الحاجة إلى ضبط خطة عمل شاملة وغير مجزأة للتحكم في مختلف المؤسسات الصناعية التي تنتج مواد مضرة بالبيئة وأكدت، أن التركيز على شركات دون أخرى من خلال القانون الذي يعاقب كل من يرمي النفايات أو يتخلص من المياه الملوثة في الطبيعة جيد، إلا أنه لا يعتبر كفيلا لتأمين المحيط.
مشددة، على ضرورة فرض المعاملة والمحاسبة الجماعية وفق إستراتيجية وطنية وتطبيق القانون على الجميع في مختلف ربوع الوطن وخصت بالذكر الشركات المتواجدة قرب الوديان مثل «الحراش صومام، بجاية، عنابة، سيبوس». وهي وديان قالت إنها تعرضت للتلوث.
مخططات التكيف المناخي فعالة ويجب أن تكون محلية أكثر
واعتبرت الخبيرة، الجزائر من البلدان السباقة لإعداد المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، متحدثة عن التقرير الأول الذي أعد سنة 2019، وكانت المستشارة من بين من أشرفوا على تجهيزه.
وأكدت، على أهمية إعداد تقارير محلية تتماشى مع خصوصية كل منطقة، بحيث يتم ضبط مخططات محلية على البلديات خاصة تلك التي تعاني من التأثير المباشر للتغيرات المناخية والتي ظهرت جليا خلال السنوات الأخيرة.
أما عن فعالية مثل هذه التقارير، فقد أكدت الدكتورة مرابط أن الجزائر قد استغلت المخططات مما ساهم في التقليل من المخاطر المناخية، وتحدثت عن مشروع السد الأخضر، ومشكلة التصحر التي وصلت إلى الشمال الجزائري، وهي من النقاط المهمة التي تم التركيز عليها في تقرير سنة 2019 للتكيف مع التغيرات المناخية. ودعت الخبيرة، إلى ضرورة التحرك العاجل والفعال قبل سنة 2030، وقبل موعد الجزائر في الأمم المتحدة لعرض مخطط التنمية المستدامة الخاص بها، بعد أن قدمت الجزائر تقريرا تطوعيا سنة 2019 وكان جيدا حسبها آنذاك.
منتقدة عدم الاستمرار في العمل بذات الوتيرة، وداعية لاستدراك الأمر خاصة وأن سنة 2030 ليست بعيدة، وعلى الجزائر تقديم تقرير وطني حول 17 هدفا للتنمية المستدامة أمام العالم.
نتقدم في مجال التنمية المستدامة لكننا بحاجة للعمل أكثر
أما عن واقع التنمية المستدامة في الجزائر مع مطلع سنة 2026، فقد قالت بأنها تحتاجها للعمل أكثر خاصة في ميدان الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات، والعمل على تحقيق الهدف العام للتنمية والمتمثل في تحسين معيشة المواطن، والتركيز على تربية المواشي وتوفير استثمارات فعالة من خلال دعم المربين.
وأشارت، إلى قضية البناءات الجديدة، وانتقدت غياب مبدأ الاستدامة في العمران، كما تحدثت عن عدم اعتماد بنايات أو مواد صديقة للبيئة والاقتصاد في الطاقة من خلال دراسة توجيه المباني وجعلها عرضة للإضاءة الطبيعية لا الكهرباء الصناعية، مما أنتج مباني مستنزفة للطاقة ما يعيق التنمية المستدامة ويساهم في تأثير أكبر للتغيرات المناخية. وأشارت مرابط، إلى عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتزويد المباني بالكهرباء والطاقة، بينما يركز المبدأ السابع للتنمية المستدامة على الطاقة، مما يساهم في تقليل الفاتورة على الدولة والمواطن معا، ونبهت أيضا إلى ضرورة استغلالها في الزراعة.
السد الأخضر كنز الجزائر الثمين
واعتبرت المستشارة في المجال البيئي، بأن التشجير من بين النقاط التي تتضمنها مبادئ الاستدامة، وأوضحت محدثتنا أن الجزائر تحتاج لغرس أشجار أكثر وفي كل الأمكنة، وتكثيف الغابات في مختلف المدن لامتصاص الكربون. مركزة على أهمية انتقاء الأشجار المناسبة لتحقيق هذا الهدف رقم 13 من التنمية المستدامة لمحاربة التغيرات المناخية وتحدثت عن العمل من أجل تجربة غرس أشجار أخرى وتربية الحيوانات وحتى إنشاء مصانع بالقرب من السد.
واعتبرت الخبيرة، السد الأخضر كنز الجزائر الثمين الذي يجب استثماره في مختلف النواحي، معتبرة إياه مشروعا اقتصاديا واجتماعيا أيضا، ودعت لاستحداث مراكز بحث خاصة به من أجل تطويره، خاصة وأنه مشروع وطني لا يخص مديرية الغابات فقط، بل يعني الجميع حتى الصناعة، والبحث العلمي المهم جدا لإثرائه والحد من التصحر.
ودعت، إلى تنويع الأشجار التي تغرس هناك، خاصة شجرة السيكويا العملاقة القادرة على امتصاص كمية كربون كبيرة، خاصة وأن الجزائر دخلت سوق الكربون، وبالتالي فإن التكيف مع التغيرات المناخية والعمل على التقليل من مسبباتها محليا بات هدفا رئيسيا حسبها.
وتطرقت المستشارة والخبيرة في البيئة والتنمية المستدامة، إلى السياحة بوصفها جانبا مهما في خطة التنمية المستدامة. وأكدت أن الجزائر ثرية طبيعيا وتاريخيا بما يجعل منها بلدا سياحيا بامتياز. ودعت في الأخير، إلى تطوير استثمارات طبيعية واستغلال السد الأخضر لأجل سياحة بيئية، ولتحقيق الهدف قبل موعد الأمم المتحدة في 2030. واعتبرت بعض النقاط استعجالية وأخرى تتطلب وقتا أكثر معتبرة أن 94 بالمائة من الخطط يجب أن تمس حقوق المواطن.

منظومة تكوين أطلقتها وزارة البيئة
برنامج وطني للتكيف المناخي عبر 28 ولاية
أطلقت مؤخرا، وزارة البيئة وجودة الحياة، برنامجا تكوينيا وطنيا حول التكيف مع التغيرات المناخية، برعاية أممية وشراكة مع مختلف القطاعات.
وانطلق البرنامج الذي يأتي بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من ولاية تيبازة، في أول دورة تكوينية لفائدة موظفين وإطارات بوزارة البيئة، إلى جانب ممثلي الإدارة المحلية بعديد القطاعات كالفلاحة، الري الصحة، السكن، التربية، الحماية المدنية والتعليم العالي. وذلك من أجل تطوير قدراتهم حول كيفية إدراج مبادئ التغيرات المناخية في المخططات التنموية وسبل التكيف معها.
وأفادت مصادر بوزارة البيئة وجودة الحياة، أن التكوين سيشمل موظفين وإطارات من مختلف المديريات المعنية بالعملية على مستوى 28 ولاية، وذلك لتجاوز أضرار التغيرات المناخية، من تصحر، جفاف، فيضانات، حرائق وغيرها.
وتهدف عملية التكوين التي تعكف الوزارة الوصية على تنظيمها منذ سنتين استجابة للتغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على مناطق واسعة من الجزائر، إلى إعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية بالتنسيق مع المجتمع المدني، قصد تعزيز حوكمة التخطيط والتنسيق المؤسساتي، وإنتاج قاعدة بيانات لتصميم حلول التكيف، وتحقيق أقصى قدر من التأثير.
ويعتبر المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، نتاج مشروع تعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، من أجل ترجمة التزامات الجزائر في الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي.
إيمان زياري

في ظل التحولات المناخية المتسارعة، وتزايد الضغوط على الأراضي الفلاحية، باتت الأمراض النباتية تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي في الجزائر، خاصة ما تعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب. وبين تدهور خصوبة التربة، وتراجع الممارسات الزراعية السليمة، وغياب المرافقة التقنية الفعالة، يجد الفلاح نفسه اليوم في مواجهة آفات جديدة وقديمة تتطور بسرعة وتخلف خسائر متزايدة وهذه الوضعية المقلقة تطرح بإلحاح تساؤلات جوهرية حول جاهزية المنظومة الفلاحية للتصدي للأخطار، وحدود الوعي والوقاية، ودور الإرشاد والإعلام المتخصص في حماية الإنتاج الوطني.
تحذير من استنزاف التربة وغياب المادة العضوية والتناوب الزراعي
في تصريح لجريدة النصر، حذر الخبير الفلاحي لبصير عبد الكريم، من تنامي خطر الأمراض النباتية، خاصة تلك التي أصبحت تهدد المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب. مؤكدا أن الأمراض الفطرية تتصدر قائمة الآفات الأكثر انتشارا في الحقول الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص مرض الفيوزاريوز "Fusariose"، الناجم عن فطر الفيزاريوم، الذي أصبح مشكلا وطنيا حسبه، تعاني منه أغلب المناطق الفلاحية دون استثناء.
وأوضح الخبير، أن خطورة هذا المرض لا تكمن فقط في انتشاره السريع، بل في تأثيره المباشر على مردودية المحصول وجودته، إذ يؤدي إلى ضعف النمو، واصفرار السنابل، وتراجع الإنتاج، وفي بعض الحالات خسائر فادحة للفلاحين، خاصة في ظل غياب التشخيص المبكر والتدخل الوقائي الفعال.
وأشار لبصير عبد الكريم، إلى أن "الفيوزاريوز" يجد بيئة مثالية للانتشار في الأراضي التي أنهكت زراعيا، وهو ما يقود إلى جوهر الإشكال الذي تعيشه زراعة الحبوب في الجزائر اليوم.
وفي هذا السياق، أرجع المتحدث تفاقم المشكلة إلى نقص المادة العضوية في التربة، موضحا أن الفلاح الجزائري تخلى في السنوات الأخيرة عن النظام الزراعي التقليدي القائم على إراحة الأرض أو ما يعرف بالتناوب الزراعي (عام حبوب وعام بور)، والذي كان يسمح للتربة باستعادة خصوبتها الطبيعية.
أما اليوم، فقد أصبحت الأرض تستغل لإنتاج الحبوب بشكل متواصل سنة بعد أخرى، ما أفقدها قدرتها على التجدد وجعلها فقيرة بيولوجيا وضعيفة المقاومة أمام الأمراض الفطرية كما يقول الخبير. وأضاف لبصير، أن هذا الاستنزاف المفرط للتربة جعل حتى الأسمدة الكيميائية غير مجدية في كثير من الأحيان، مؤكدا أن الأرض عندما تفقد توازنها العضوي، لا تعود قادرة على الاستفادة من الأسمدة مهما كانت كميتها أو نوعيتها، بل قد تتحول هذه المدخلات إلى عبء إضافي يخل بتوازن التربة ويساهم في انتشار الأمراض بدل الحد منها، وهو ما يستدعي حسبه، مراجعة شاملة للسياسات الزراعية الميدانية، وإعادة الاعتبار للممارسات الفلاحية السليمة. كما شدد الخبير، على أن معالجة هذا الوضع لا يمكن أن تكون آنية أو ظرفية، بل تتطلب مقاربة وقائية طويلة المدى، تبدأ بإعادة إدماج المادة العضوية في التربة، وتشجيع التناوب الزراعي، واعتماد بذور مقاومة للأمراض، إلى جانب تعزيز دور الإرشاد الفلاحي والمرافقة التقنية للفلاحين.
سماد يعيد الحياة للتربة ويواجه الفطريات في حقول الحبوب والقمح
وأشار الخبير الفلاحي، إلى أن الخروج من أزمة تدهور خصوبة التربة وانتشار الأمراض الفطرية، لا يمكن أن يتحقق بالحلول الظرفية أو الاعتماد الكلي على الأسمدة الكيماوية، بل يستدعي العودة إلى الممارسات الفلاحية السليمة ذات الأساس العلمي.
وأكد في هذا السياق، أن من بين أهم الحلول التي يوصى بها ميدانيا الاعتماد على التسميد العضوي الطبيعي، خاصة فضلات الأغنام والأبقار، لما لها من دور فعال في إعادة التوازن البيولوجي للتربة وتحسين بنيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية، إضافة إلى استخدام البقوليات كسماد أخضر على غرار الفول السوداني، والعدس والفول.
ومن بين التقنيات الناجحة أيضا، ذكر زراعة نبتة "لافيفرول" أو الفول في مرحلة مبكرة، وهي تقنية معروفة في الوسط الفلاحي باسم "السماد الأخضر". وهذه الطريقة تعزز حسبه من خصوبة التربة، وتحسن بنيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالماء، وتقلل من الحاجة للأسمدة الكيميائية الضارة، وتزيد من التنوع البيولوجي والكائنات الدقيقة، مما يدعم إنتاجية صحية ومستدامة للأراضي.وأوضح لبصير، أن هذه الممارسة ليست نظرية فقط، بل تم تطبيقها ميدانيا في عدة تجارب ناجحة بولاية قسنطينة، لاسيما في منطقتي البعراوية وبونوارة. أين أظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في بنية التربة وارتفاعا في مردودية الحبوب مقارنة بالسنوات السابقة، مع انخفاض واضح في معدلات الإصابة بالأمراض الفطرية.
كما كشف، أن الإقبال على هذه البذور في تزايد مستمر، حيث بات عدد معتبر من الفلاحين عبر مختلف ولايات الوطن يطالبون بها، بعد أن لمسوا فوائدها الكبيرة على المدى المتوسط والبعيد، ليس فقط من حيث الإنتاج، بل كذلك في تقليص التكاليف المرتبطة بالمبيدات والأسمدة الكيميائية.
الإعلام الفلاحي المتخصص.. ضرورة لمرافقة الفلاحين
في هذا السياق شدد لبصير، على أهمية البعد الإعلامي في مرافقة الفلاح، مقترحا إنشاء قناة وطنية أو منصة إعلامية متخصصة، على غرار كل الدول الكبرى الفلاحية، تكون مهمتها الأساسية الإرشاد والتوعية الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن.
وأوضح، أن هذه المبادرة من شأنها سد فجوة كبيرة في مجال الاتصال الفلاحي، من خلال تقديم شروحات مبسطة ودقيقة حول المستجدات المرتبطة بالعمليات الفلاحية الموسمية، والأمراض النباتية، طرق الوقاية، استعمال المبيدات المعتمدة، وكذا التقنيات الحديثة في الزراعة وتثمين الإنتاج.وأضاف الخبير، أن فكرة إنشاء هذه القناة طرحت منذ سنوات، غير أنها اصطدمت آنذاك بجملة من العراقيل، في مقدمتها غياب مقر مناسب ونقص الإمكانيات المالية، ما حال دون تجسيدها على أرض الواقع، غير أن الوضع حسبه عرف انفراجا ملحوظا في الفترة الأخيرة، تم مع مجيء وزير الفلاحة الحالي تذليل الصعوبات، من خلال تخصيص فضاء خاص داخل المقر الجديد للغرفة الفلاحية الوطنية، ما أعاد بعث المشروع وفتح آفاقا جديدة لتفعيله في أقرب الآجال.وأكد لبصير، أن هذه القناة أو المنصة الإعلامية في حال إطلاقها، ستلعب دورا محوريا في إيصال المعلومة الفلاحية الموثوقة إلى الفلاح، خاصة في المناطق الريفية والمعزولة، مع الاعتماد على خبراء وطنيين ذوي كفاءة عالية في مختلف التخصصات الفلاحية، بما يضمن محتوى علميا دقيقا وميدانيا في آن واحد، كما ستسهم في توحيد الخطاب الإرشادي، والحد من الإشاعات والممارسات العشوائية التي تضر بالمحاصيل، فضلا عن تعزيز ثقافة الوقاية والاستباق، وتحسين مردودية الإنتاج الوطني.
وختم الخبير، بالتأكيد على أن الإعلام الفلاحي المتخصص، أصبح ضرورة ملحة لدعم الأمن الغذائي ومرافقة التحولات التي يعرفها القطاع.
رضا حلاس
محافظة الغابات تستعد للحملة الوطنية للتشجير
برمجة غرس 100 ألف شجرة بقسنطينة
شرعت محافظة الغابات بولاية قسنطينة في التحضير لانطلاق الحملة الوطنية الكبرى للتشجير، التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع جمعية الجزائر الخضراء، حيث تم تخصيص 100 ألف شجرة كحصة للولاية ضمن أزيد من خمسة ملايين شجرة عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الغطاء النباتي والمحافظة على التوازن البيئي ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
وأفاد المكلف بالإعلام بمحافظة الغابات علي زغرور في اتصال بالنصر، بأن ولاية قسنطينة خصصت لها حصة معتبرة قُدّرت بـ100 ألف شجرة، مقارنة بالحملة السابقة التي نُظّمت السنة الماضية، والتي خُصص خلالها للولاية 24 ألف شجرة ، وهو ما يعكس حسب المتحدث الأهمية البيئية التي تحظى بها المنطقة، لاسيما إثر نجاح مختلف التجارب السابقة في مجال التشجير والعناية بالمغروسات.
وأوضح المتحدث، أن الجهات الوصية خصصت هذه الحصة الهامة للولاية في إطار البرنامج الوطني، مشيرا إلى أن المحافظة شرعت بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، في التحضير الميداني للحملة من خلال اختيار الأوعية العقارية المناسبة لعملية الغرس سواء في الأوساط الحضرية أو الغابية.
وأكد زغرور، أن عملية تحديد مواقع التشجير تتم بعناية كبيرة وبالتنسيق مع الجماعات المحلية والبلديات والمصالح التقنية إضافة إلى الجمعيات البيئية، لضمان نجاعة العملية واستدامتها، مشيرا إلى أن الهدف لا يقتصر على غرس الأشجار فحسب وإنما يمتد إلى ضمان متابعتها والعناية بها على المدى المتوسط والبعيد.
وأبرز المكلف بالإعلام، أن جهود الحفاظ على ما تم غرسه في الحملة الماضية ماتزال جارية، حيث أن البلديات تعمل على العناية بها ضمن الوسط الحضري أما محافظة الغابات فتقوم دوريا بسقي ومتابعة نموها وحمايتها من الأمراض في الغابات، مشيرا إلى الحملة ستنطلق يوم 14 فيفري المقبل على أن تتواصل إلى غاية 31 مارس المقبل، وهي فترة وصفها بالمثالية لعمليات التشجير نظرا للظروف المناخية الملائمة التي تساعد على تثبيت الشتلات ورفع نسب نجاحها.
وتابع ، أن الحملة السابقة عرفت نجاحا معتبرا سواء في المناطق الحضرية أو الغابية، حيث تم تسجيل نسب عالية لبقاء الأشجار المغروسة، بفضل المتابعة الدورية وتوفير شروط السقي والحماية، وهو ما شجّع السلطات الوصية على رفع حصة الولاية ضمن الحملة الوطنية.
وعن توفر الوسائل والتجهيزات لضمان نجاح غرس هذا العدد الكبير، أبرز الإطار بمحافظة الغابات أن السلطات وعلى رأسها الوالي قد وفرت مختلف الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح الحملة الماضية، وهو ما سيتجسد حتما الشهر المقبل سواء فيما يتعلق بتوفير العتاد والأشجار الملائمة ووسائل النقل إلى جانب تعبئة أعوان الغابات والمتطوعين والجمعيات الناشطة في المجال البيئي ما يعكس حسبه الطابع التشاركي الذي يميز هذه الحملة الوطنية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توسيع المساحات الخضراء، والحد من ظاهرة التصحر وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا، كما تمثل خطوة فعالة لتحسين الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على الطبيعة لدى مختلف فئات المجتمع. ويرى متابعون للشأن البيئي، أن نجاح حملة التشجير لا يقاس فقط بعدد الأشجار المغروسة وإنما باستمراريتها والعناية بها وهو الرهان الذي تسعى محافظة الغابات بقسنطينة على تجسيده بالتنسيق مع مختلف الشركاء من خلال المتابعة الدورية والتخطيط المحكم، حيث أنه ومع انطلاق هذه الحملة الواسعة تعلق آمال كبيرة على مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في إنجاحها، بما يجعل من التشجير ثقافة جماعية وسلوكا بيئيا مستديما وليس مجرد نشاط مناسبتي.
لقمان/ق

نتائج أدق لخدمة بيئة مستدامة
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة عالمية في التنبؤ بالطقس
أطلقت(نوا)، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة الأميركية، مجموعة رائدة من نماذج التنبؤ الجوي العالمية التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل تقدما ملحوظًا في سرعة التنبؤ وكفاءته ودقته.
ويراهن خبراء الأرصاد الجوية، على أن تمكن هذه النماذج من تقديم توجيهات أكثر دقة وبوتيرة أسرع، مع استخدام جزء بسيط من الموارد الحاسوبية. وفي هذا السياق، أوضح نيل جاكوبس، مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، قائلًا:»يمثل اعتماد الإدارة على الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في ابتكار نماذج الطقس، إذ تعكس هذه النماذج نهجا جديدا يهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية واسعة النطاق، وتحديد مسارات العواصف الاستوائية، وتسريع وتيرة توفير منتجات التنبؤ لخبراء الأرصاد الجوية والجمهور، وبكلفة أقل نتيجة الخفض الكبير في النفقات الحسابية».
وتتضمن المجموعة الجديدة من نماذج الطقس المدعومة بالذكاء الاصطناعي ثلاثة تطبيقات رئيسية. أولها نظام التنبؤ العالمي بالذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تنبؤات جوية أكثر دقة وبسرعة وكفاءة أعلى، مع تقليص استخدام الموارد الحاسوبية بنسبة تصل إلى 99.7% مقارنة بالنظام التقليدي.
أما التطبيق الثاني فهو نظام التنبؤ الجماعي العالمي بالذكاء الاصطناعي، الذي يوفّر مجموعة من سيناريوهات التنبؤ المحتملة لخبراء الأرصاد الجوية وصناع القرار.وتشير النتائج الأولية إلى تحسن واضح في الأداء مقارنة بالنظام الجماعي التقليدي، إذ يمتد نطاق دقة التنبؤ من 18 إلى 24 ساعة إضافية.
ويمثل التطبيق الثالث نظام التنبؤ الجماعي الهجين، وهو نظام مبتكر يجمع بين الذكاء الاصطناعي ونظام التنبؤ الجماعي العالمي، الذي يعد النموذج الرئيسي لدى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وتظهر الاختبارات الأولية أن هذا النموذج، وهو الأول من نوعه في مركز أرصاد جوية تشغيلي، يتفوق باستمرار على الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي فقط، وكذلك تلك القائمة على النماذج الفيزيائية وحدها.
وتبرز نماذج التشغيل الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحسنا كبيرا في دقة التنبؤ مقارنة بنظام التنبؤ العالمي التقليدي، لا سيما في الظواهر الجوية واسعة النطاق. كما تسجل انخفاضا ملحوظًا في أخطاء مسار الأعاصير المدارية عند فترات التنبؤ الطويلة.
وتتمثل الميزة الأبرز لنظام التنبؤ العالمي المتكامل في أن تكلفة التنبؤ الواحد لمدة 16 يوما لا تتجاوز 0.3% من الموارد الحاسوبية المطلوبة لنظام التنبؤ العالمي التشغيلي، مع زمن إنجاز يقارب 40 دقيقة فقط. ويعني هذا التأخير المنخفض حصول المتنبئين على البيانات الحيوية بسرعة أكبر مقارنة بالنظام التقليدي.
إ. زياري

نحو نظام غذائي عالمي مستدام
رؤيــــــة علميـــــة للتغلـب علـى تغيـــر المنــــــاخ
نشرت مجلة «نيتشر فود»، نتائج دراسة عالمية جديدة ترسم خريطة طريق لتحويل النظام الغذائي العالمي بما ينسجم مع الهدف الدولي للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، مع تحسين الصحة العامة وحماية البيئة، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وصنفت الدراسة باعتبارها واحدة من أكثر التقييمات شمولا للنظام الغذائي العالمي، إذ تعتمد على نماذج محاكاة متقدمة لتحليل تأثير 23 إجراء مقترحا على15 مؤشرا مرتبطًا بالصحة والبيئة والاقتصاد والجوانب الاجتماعية حتى عام 2050 .
وتظهر النتائج أن النظام الغذائي العالمي الحالي لا يسير وفق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبره سببا رئيسيا لفقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه والهواء. إضافة إلى ذلك، يسبب هذا النظام نحو ثلث الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، بينما تتراجع صحة الإنسان مع تزايد عدد السكان وتفاقم مشكلات السمنة وسوء التغذية في العديد من المناطق.
رؤية متكاملة لتحول النظام الغذائي
يقترح الباحثون ما أسموه «مسار التحول الغذائي»، وهو نهج يجمع بين حزمة متكاملة من الإجراءات القادرة على تغيير مسار النظام الغذائي العالمي.
وتشمل هذه الإجراءات تعزيز الأنماط الغذائية الغنية بالبقوليات والخضروات، وتقليل الاعتماد على اللحوم عالية الانبعاثات، إلى جانب حماية البقع الحيوية للتنوع البيولوجي ومنع تحويل الأراضي الطبيعية إلى مزارع.
كما تدعو إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية، مثل المياه والتربة، للحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية، فضلا عن دعم العدالة الاجتماعية عبر سياسات تعزز فرص العمل وتحسن الدخل في المجتمعات الزراعية.
ويؤكد فريق البحث أن تطبيق هذه الإجراءات مجتمعة ضمن سيناريو واحد يفضي إلى نتائج مهمة، أبرزها انخفاض كبير في مخاطر الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، وتراجع الفقر المدقع، وتحسن ملحوظ في المؤشرات البيئية من خلال خفض التلوث، وحماية التنوع الحيوي، وتحسين جودة الموارد المائية.
كما تظهر التقييمات حتى عام 2050 أن الجمع بين جميع التدابير يحقق تحسّنا شاملا في معظم المؤشرات مقارنة بالسيناريو المرجعي، غير أنه يتطلب تحولات هيكلية عميقة بين القطاعات لبناء نظام غذائي مستدام يتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
التنوع البيولوجي وتلوث النيتروجين
وفي ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، تعتبر الدراسة فائض النيتروجين مؤشرا رئيسيا لتأثيرات تلوث النيتروجين على الهواء والماء والتربة والغلاف الجوي، لما يسببه من أضرار للتنوع البيولوجي والصحة العالمية.
ويقدر النموذج ارتفاع انبعاثات النيتروجين من239 تيراغراما إلى 297 تيراغراما سنويا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2050.
وتشير النتائج إلى تمركز بؤر التلوث في الصين، والهند، وشرق أوروبا ومنطقة زراعة الذرة في أمريكا الشمالية، ما يعني تفاقم تلوث النيتروجين بحلول عام 2050. في حين تسجل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مستويات تلوث معتدلة نسبيا.
إ. زياري
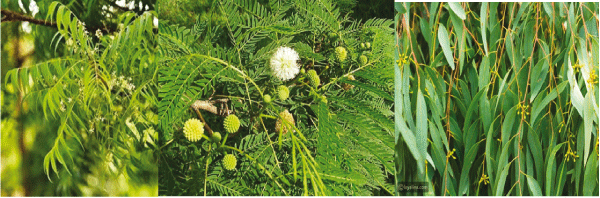
تشهد الجزائر خلال السنوات الأخيرة توسعا واضحا في انتشار النباتات والأشجار الدخيلة داخل المدن والأحياء السكنية والفضاءات العمومية والمفتوحة، وهي ظاهرة أصبحت تثير قلق مختصين في البيئة وجمعيات لحماية الطبيعة، وبين غياب التوجيه العلمي وسياسات التشجير غير المدروسة، تحولت بعض الأنواع إلى خطر بيئي وصحي يهدد محيطنا الحضري، ما يستدعي اليوم طرح العديد من الأسئلة وإعادة تقييم طريقة تعاملنا مع الثقافة النباتية والتساؤل حول كيفية حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي المحلي؟
رضا حلاس
اللوسينا والدفلى والكينا.. خطر أخضر يزحف على أحيائنا
وفي هذا السياق، يحذر عبد المجيد سبيح، رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة بقسنطينة، من الانتشار المتزايد لأنواع نباتية تعد خطيرة على التوازن البيئي، وتتقدم شجرة «اللوسينا» قائمة الأنواع الخطرة، بسبب قدرتها الكبيرة على الانتشار السريع، ونموها الكثيف الذي يمنع النباتات المحلية من الوصول إلى الضوء والمغذيات.
كما تتميز الشجرة بقدرتها على إنتاج كميات هائلة من البذور التي تنتشر بسهولة بفعل الرياح والمياه.وإلى جانب اللوسينا، تعد شجرة «الدفلى» من أخطر النباتات على الإطلاق، لاحتوائها على مواد سامة قد تشكل تهديدا مباشرا للصحة، ووجود النبات بكثافة قرب المدارس والأحياء قد يشكل تهديدا للأطفال والحيوانات الأليفة، أما شجرة «الكينا»(Eucalyptus)، رغم استخدامها التقليدي، فقد أثبتت الدراسات أنها تستنزف المياه الجوفية وتؤثر على خصوبة التربة، إضافة إلى قابليتها للاشتعال السريع، ما يجعل انتشارها قرب التجمعات السكنية محفوفا بالمخاطر. 
ويضيف رئيس الجمعية أن خطر هذه النباتات لا يقتصر على البيئة فقط، بل يمتد إلى صحة الإنسان فالدفلى على سبيل المثال تحتوي على مواد سامة تسبب تهيجا جلديا عند لمسها أو استنشاق دخان احتراقها، مشيرا إلى تسجيل بعض حالات التسمم سببها استخدام فروع الدفلى لإشعال النار دون معرفة درجة خطورتها، كما تتسبب أيضا في اضطراب قلبي وحتى القيء.
أما اللوسينا فقد أصبح اسمها متداولا في السنوات الأخيرة بسبب تسببها في تهيجات تنفسية وحساسيات موسمية لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية حبوب اللقاح، ومع انتشارها قرب المنازل تصبح هذه المشاكل الصحية جزءا من الحياة اليومية للمواطنين دون أن يدركوا مصدرها الحقيقي.
خلل بيئي يهدد الغابات والتنوع البيولوجي
وعلى مستوى الغابات، يصف رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة بقسنطينة، تأثير النباتات الدخيلة بأنه مدمر على المدى البعيد، إذ تؤدي هذه الأنواع الدخيلة سريعة النمو إلى تقليص المساحات المتاحة للنباتات الأصلية وإزاحتها تدريجيا من محيطها الطبيعي، مثل إكليل الجبل والزعتر والصنوبر الحلبي ومع انخفاض الغطاء النباتي الأصلي، تتأثر أيضا الكائنات الحيوانية التي تعتمد عليه في غذائها أو في بناء أعشاشها، ويفقد النظام البيئي بذلك توازنه الطبيعي، ما يرفع خطر الحرائق ويقلل من قدرة الغابة على التجدد، كما تتسبب بعض الأنواع خاصة «البقولية» في تغيير توازن التربة عبر تثبيت النيتروجين ما يخل بتوازنها الطبيعي، وهو أمر يعزز حظوظ النباتات المتكيّفة مع مستويات عالية منه، ويؤدي إلى تراجع التنوع البيولوجي.
ويضيف المتحدث، أن هذه النباتات تضاعف كذلك خطر الحرائق على غرار الأوكالبتوس، الذي يزيد من قابلية الاشتعال وتكرار الحرائق، مسببا أضرارا جسيمة للأنواع المحلية الحساسة، كما تمتص بعض الأشجار كميات كبيرة من المياه بما يؤدي إلى تجفيف المساحات الرطبة أو التأثير على مستوى المياه الجوفية. ولا يقف الخطر عند هذا الحد، بل قد تتحول النباتات الدخيلة إلى حاملات لآفات وأمراض جديدة من خلال جلب حشرات أو فيروسات غير مألوفة، أو توفير بيئة مناسبة لتكاثر الآفات التي تنتقل لاحقا إلى النباتات المحلية.
ويؤكد سبيح، أن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار النباتات الدخيلة هو الجهل البيئي لدى العديد من المواطنين، الذين يزرعون نباتات دخيلة لأنهم يرونها جميلة أو سريعة النمو دون معرفة آثارها، كما أن للأطراف المسؤولة عن التشجير دور في المشكلة، إذ غالبا ما يلجأ هؤلاء إلى النباتات الرخيصة وسريعة النمو لملء الفضاءات الخضراء دون دراسة بيئية مسبقة، إضافة إلى ذلك تسبب التجارة العشوائية في انتشار هذه النباتات، نظرا لرواج أصناف دخيلة في الأسواق الشعبية وعلى مواقع التواصل بأسعار زهيدة دون أي رقابة على نشاط بيعها للمواطنين، كما ساعد تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة على توفير ظروف ملائمة لتكاثر الأنواع الغازية في مناطق جديدة لم تكن تستوعبها من قبل.
حملات التشجير على وسائل التواصل.. نوايا حسنة وخطر غير محسوب
ولا يخفي عبد المجيد سبيح، قلقه من ظاهرة حملات التشجير المنظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فهذه المبادرات رغم نيتها الحسنة قد تتحول إلى مصدر قلق بدل أن تكون جزءا من الحل، فإذا كانت الحملات تروج لزراعة أصناف غير ملائمة حسبه، أو تشجع على الزراعة بدون توجه علمي مثل اختيار أصناف سريعة الانتشار وزراعتها في مناطق حساسة، فذلك يسرع من نمو الدخائل ويخلف عبئا على المدى الطويل.
ويؤكد الناشط البيئي، أن حملات التشجير يجب أن تكون مرافقة بتوجه علمي، كاختيار الأنواع المحلية وتوفير شتائل محلية، وتدريب المتطوعين على التقليم والري والمتابعة، وهو ما يؤكد حسبه أن المشكل ليس الحملات في حد ذاتها بل طريقة تنفيذها.
دور الجمعيات البيئية في توعية المواطنين
ويرى رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة بقسنطينة، أن الجمعيات النشطة في مجال البيئة تلعب دورا أساسيا في مواجهة انتشار النباتات الضارة، حيث تنظم حملات توعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وترافق المواطنين في تحديد الأنواع المناسبة للغرس داخل المدن، كما تقوم بعض الجمعيات بإعداد قوائم توجيهية تحدد النباتات الأصلية التي يمكن غرسها في كل منطقة حسب طبيعة المناخ والتربة، وتحرص هذه الجمعيات خلال نشاطاتها الميدانية على تقديم شروحات مبسطة للمواطن حول مخاطر النباتات الدخيلة، وتعليم اختيار الشتلات المحلية، التقليم، والتعامل مع بذور الدخائل، إضافة إلى تشجيع المدارس على استعمال الأنواع المحلية في الحدائق المدرسية، بالتنسيق والتعاون مع البلديات والمشاتل.
كيف يميز المواطن بين النباتات المفيدة والضارة؟
يمثل غياب الوعي النباتي أحد أكبر التحديات اليوم، ولتسهيل المهمة على المواطن العادي ينصح عبد المجيد، باتباع خطوات بسيطة كالاستفسار من جهات مختصة مثل جمعيات البيئة أو مهندسي الغابات قبل الغرس، وتجنب شراء النباتات مجهولة المصدر التي تباع في الأسواق أو على الإنترنت دون تسمية صحيحة أو معلومات واضحة، إضافة إلى اعتماد النباتات المحلية لأنها أكثر قدرة على التكيف، وأقل حاجة للمياه، ولا تشكل أي تهديد للنظام البيئي، كما ينصح باستعمال تطبيقات علمية للتعرف على النباتات أو زيارة صفحات المؤسسات الرسمية التي تنشر قوائم دورية بأنواع النباتات الموصى بها.
اختر نباتك بعناية.. حماية البيئة تبدأ بالوعي والتوجيه العلمي
وفي هذا السياق، يوجه رئيس الجمعية رسالة مفادها أنه ليست كل شجرة مفيدة، فالرغبة في التشجير وحدها لا تكفي إذا كانت تفتقر للمعرفة، وفي وقت يسعى المواطن إلى تحسين المشهد البيئي، قد يتسبب دون قصد في تخريب توازن طبيعي عمره مئات السنين، لذلك يشدد المتحدث على ضرورة التفكير قبل الزرع والسؤال قبل اتخاذ أي خطوة، لأن غرس شجرة دخيلة اليوم قد يتحول بعد سنوات إلى خطر يهدد صحة الأسرة والمحيط والغطاء النباتي المحلي، معلقا « ازرعوا بذكاء واختاروا أنواعا محلية موصى بها من قبل خبراء في المجال».
كما يوصي سبيح، بضرورة تحول الجمعيات البيئية من منظمات تطوعية إلى مؤسسات مؤطرة وموجهة ميدانيا، تعتمد في عملية التشجير على دراسة علمية مسبقة وتحت إشراف مختصين في البيئة والغابات.
وينصح بغرس أنواع من الأشجار والنباتات المحلية والملائمة للبيئة الجزائرية، مثل الروبيني سريع النمو ذي الأزهار الجميلة، والميليا التي تتحمل الحرارة والجفاف، والبلوط المفيد للتربة والحياة البرية، إضافة إلى الصوفورا المزدهرة في المناخ القاسي، والصنوبر المعمر، فهذه الأنواع توفر حسبه زينة طبيعية وتدعم التنوع البيولوجي دون تهديد البيئة المحلية.
ر.ح

شتاء جاف وصيف ممتد
الاحتبــاس يربـك دورة الفصــول الأربعـــة
تشهد دول العالم ومنها الجزائر، ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المتوسط، في تغير يرجعه الخبراء إلى استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري، ويؤكدون أنها خلفت اضطرابات مناخية متسارعة قلبت موازين الطقس، وغيرت ملامح الشتاء والصيف والربيع والخريف، وأصبح كل ذلك واقعا ملموسا ينعكس يوميا على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد والبيئة.
إيمان زياري
يعد رصد الفصول وتغيراتها أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للخبراء، إلا أن تغيرات كبيرة طرأت عليها خلال العقود الثلاثة الماضية، وهي اختلالات صارت قابلة للرصد عن طريق الملاحظة.
في الجزائر تسجل درجات حرارة قياسية وطقس متطرف، وشتاء جاف أحيانا وعنيف أحيانا أخرى، وفي عديد الدول الأخرى تحدث حرائق غابية متكررة وفي غير موسمها وفيضانات وكوارث طبيعية مدمرة، وتؤكد الدراسات أنه منذ سنة 1992 اختلفت درجات الحرارة وأنماط الفصول بصورة كلية، ناهيك عن أحداث متطرفة تؤثر على الاقتصاد والصحة، وتهدد التنوع البيولوجي بشكل كبير.
* الخبيرة المناخية زينب مشياش
التغيرات المناخية تعيد رسم فصول السنة
تؤكد الخبيرة المناخية زينب مشياش، أن تغير فصول السنة أضحى أمرا واقعا، ونتيجة حتمية للاحتباس الحراري الذي تسبب في تغيرات مناخية أثرت بشكل مباشر على دورة الفصول الأربعة. مشيرة إلى تغير مدة الفصول، فالربيع مثلا أصبح يحل أبكر بأسبوعين في المتوسط، ويأتي الخريف متأخرا بأسبوعين، زيادة على تقلص مدة الفصلين بشكل كبير ولافت، وأضافت أن الجزائر كغيرها من بلدان العالم تواجه هذا التقلب في الشكل العام للفصول خصوصا الشتاء والصيف.
وأكدت الخبيرة، أن هذا التغير صار قابلا جدا للملاحظة، وقالت إن دراسة أجرتها منذ بضع سنوات تحت عنوان «رؤية المواطن الجزائري للتغيرات المناخية»، خلصت إلى تسجيل ارتباك في الفصول وزيادة في فصل الصيف الذي أصبح ممتدا ويقارب نصف عام كامل تقريبا، مما يؤدي إلى تقليص فصل الخريف، كما ينتج عن حلول الصيف مبكرا ربيع أبكر كذلك.
أما بالنسبة لفصل الشتاء، فأوضحت الباحثة، أن الدراسة بينت تقلص مدته وهو ما أدى إلى اضطراب في نظام الهطول بتسجيل زيادة في الكمية وبشكل مكثف في فترة وجيزة، زيادة على تسجيل أعاصير وجو متطرف وأكثر حدة.
وقالت مشياش بأن الجزائر كغيرها من دول العالم خاصة المتواجدة في الجزء الجنوبي للكرة الأرضية، تعد من الدول المتأثرة بشدة بالتغيرات المناخية بحكم موقعها الجغرافي بين المناخ المتوسطي في الشمال والصحراوي في الجنوب، وقد أدت هذه التحولات إلى تراجع نسب التساقطات المطرية وعدم انتظامها مما أثر على الموارد المائية، وألحق أضرارا بالقطاع الفلاحي.
وأوضحت، أن حرائق الغابات ازدادت وسجل ارتفاع محسوس في منسوب مياه البحر واحترار في مياه المتوسط، مما جعل الجزائر اليوم ترصد حسبها فصلين فقط في السنة، هما صيف حار وجاف، وشتاء ماطر بعواصف أحيانا وجاف أحيانا أخرى.
في وقت تقلصت مدة فصلي الخريف والربيع بشكل كبير يكاد يجعلهما منعدمين، رغم أن دورهما مهم للغاية خاصة بالنسبة لدورة الكربون ونمو النباتات.
انعكاسات مباشرة والتنوع البيولوجي على خط النار المناخي
تؤثر التغيرات المناخية وارتباك الفصول على البيئة بشكل كبير، وتوضح محدثتنا، أن هذه الاضطرابات سوف تضر بمواسم نمو النباتات وأنماط هجرة الحيوانات، خاصة وأن قصر فصل الربيع يقيد دورة الزراعة بشكل كبير، بينما يجعل ازدياد هطول الأمطار المناطق ذات البنية التحتية القديمة أكثر عرضة لخطر الفيضانات وسيجبر القطاع الزراعي على التكيف مع فصول صيف أطول وأكثر حرارة، وربما مع نقص محتمل في المياه كذلك.
وحسبها، يعرض تغير المناخ الناس لمخاطر صحية نتيجة لتلوث الهواء والحرارة الشديدة التي تزيد من مخاطر أمراض الجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية. وتفصل المختصة في تأثير تغير الفصول على الغطاء النباتي وعلى شجرة الزيتون بشكل محدد، كاشفة عن نتائج دراسة ميدانية أبانت عن حجم الضرر الذي ظهر على محصول الزيتون في الجزائر، موضحة أن حبات الزيتون أصبحت تسقط من الشجر في وقت أبكر من المعتاد نتيجة لتغير الفصول، وبعد أن كان الجني يتم خلال عطلة الشتاء، أصبحت هذه الفترة تمثل نهاية المنتوج الذي يتساقط أرضا وتأكله الطيور، وهو أمر فرض حتمية الجني في وقت أبكر من المعتاد والتكيف مع التغيرات.
الحياة البرية في خطر
ولأن حياة الكائنات الحية مرتبطة بدورة الفصول الأربعة، أكدت الخبيرة أن تغيرها أثر بشكل مباشر على حياة الحيوانات، وقد سجل المهتمون بالحياة البرية تقلصا في مدة سبات بعض الحيوانات، بينما لم يعد هناك سبات أصلا لدى كائنات أخرى، وهي ملاحظة تم رصدها في موسم سباتها في عدة مناطق من العالم والجزائر. ما سيسبب حسب تحليلها اختلالا في التوازن البيولوجي، ويغير حتى من نسب ولادة بعض الحيوانات ويضاعف أعدادها.
وستتحمل بحسب الخبيرة، المجتمعات ذات الدخل المنخفض العبء الأكبر لهذا الخلل، إذ تؤثر أزمة المناخ بشكل غير متناسب على هذه البلدان، وتواجه مخاطر أعلى نتيجة الحرارة الشديدة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ وتلوث الهواء.
وتشدد في هذا الصدد، على ضرورة تبني استعدادات لمواجهة التحديات ووضع سياسة بيئية واضحة، تقوم على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتشجيع الطاقات المتجددة، وحماية الغابات، إلى جانب نشر الوعي البيئي لدى المواطن، في حين تؤكد على أن التكيف مع التغيرات المناخية يبقى ضرورة ملحة حفاظا على صحة الكوكب ومن أجل استدامة الموارد للأجيال القادمة.

تقرير الأمم المتحدة العالمي السابع للبيئة
الاستثمار في صحة الكوكب ما يزال ممكنا
أظهر التقرير العالمي الجديد للبيئة، الصادر عن الأمم المتحدة، أن الاستثمار في صحة الكوكب ما يزال ممكنا ومرتبطا بمدى سرعة تحرك البشرية، مؤكدا أنه باستطاعتها إصلاح عقود من الضرر البيئي وبناء مستقبل أفضل، من خلال تبني 5 مبادئ أساسية للتغيير والتزام كافة دول العالم بها.
وتوصل التقرير الأكثر شمولا للبيئة العالمية على الإطلاق في نسخته السابعة، إلى أن الاستثمار في صحة الكوكب يمكن أن يحقق تريليونات الدولارات سنويا كزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويجنب ملايين الوفيات، وينتشل مئات الملايين من الناس من براثن الجوع والفقر في العقود القادمة.
هذا ما يحصده العالم بتبني 5 مبادئ للتغيير
وحذر التقرير الصادر مؤخرا، من عواقب الاستمرار في اتباع مسارات التنمية الحالية، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تغيير مناخي كارثي، ودمار للطبيعة والتنوع البيولوجي، إلى جانب تدهور مدمر للأراضي وتصحر وتلوث قاتل مستمر، في مقابل تكلفة باهظة على الناس والكوكب والاقتصاديات.
ونوه التقرير إلى أن العالم ما يزال بإمكانه سلك مسار آخر يعد الأفضل، ويتضمن نهجا شاملا للمجتمعات والحكومات لتحويل أنظمة الاقتصاد والتمويل، والمواد، والنفايات، والطاقة، والغذاء، والبيئة، على أن يدعم كل ذلك بتحولات سلوكية واجتماعية وثقافية، تشمل احترام المعارف الأصلية والمحلية.
وأوضح التقرير، أن العائد من التغيير سيكون طويل الأجل على الاستثمار في التحول وبشكل واضح. بحيث تبدأ فوائد الاقتصاد الكلي العالمي في الظهور بحلول العام 2050، وتنمو إلى 20 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول العام 2070، على أن ترتفع بعد ذلك وتصل إلى 100 تريليون دولار سنويا.
كما تمت دعوة جميع الجهات الفاعلة إلى الاعتراف بمدى إلحاح الأزمات البيئية العالمية، والبناء على التقدم المحرز في العقود الأخيرة والتعاون في التصميم المشترك، وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والإجراءات المتكاملة التحقيق مستقبل أفضل للجميع.
ما الذي يجب أن يتغير؟
وفي خضم كل هذه المعطيات، نوه التقرير الذي تم تطويره بالتعاون بين 287 عالما من 82 دولة، إلى أن إعطاء نفس جديد وإصلاح الكوكب مرهون بالاستثمار في 5 مبادئ للتغيير، يتصدرها الاقتصاد والتمويل لأجل تجاوز الناتج المحلي الإجمالي وقيم رأس المال الطبيعي والإنساني ومن ثم إعادة استخدام الدعم الضار والتأثيرات الخارجية على الأسعار وكذا المواد والنفايات التي تحتضن نماذج الأعمال الدائرية والقابلة للتتبع والتجديد. في حين يركز المبدأ الثالث على عنصر الطاقة والحاجة الملحة لإزالة الكربون من العرض، في مقابل زيادة الكفاءة وضمان سلاسل قيمة معدنية مسؤولة وسد فجوة الوصول إلى الطاقة.أما بالنسبة للمبدأ الرابع، فيتعلق بأنظمة الغذاء، وذلك من خلال التحول إلى أنظمة غذائية مستدامة وتقليل فقدان الطعام وهدره وتحسين كفاءة الإنتاج، بينما يركز العنصر الخامس والمتعلق بالبيئة، على العمل لاستعادة النظم البيئية وتوسيع الحلول المعتمدة على الطبيعة وتسريع التكيف مع المناخ.ويبرز التقرير في النهاية، أن نافذة المناورة ضيقة بناء على الأدلة المستقاة من الواقع، في حين تبرز الفوائد الهائلة لعملية الاستثمار والتعجيل في اتخاذ تدابير جادة لانقاذ الكوكب وكل ذلك يؤكد أنه قد حان الوقت لاختيار المستقبل.
إيمان زياري

يرى خبراء في البيئة والجيوفيزياء، أن ما تشهده دول عدة في آسيا من عواصف وفيضانات يأتي ضمن نمط عالمي يشير إلى اشتداد متطرف للمناخ وتخطيط عمراني هش، مؤكدين أن احترار مياه البحار والمحيطات يؤثر بشكل مباشر ويجعل العديد من الدول والمناطق بما فيها شمال إفريقيا وحتى الجزائر عرضة لعواصف مماثلة قد يصعب التنبؤ بها.
إيمان زياري
وتشير تقارير مناخية حديثة، إلى أن آسيا أصبحت من أكثر القارات تعرضا للأمطار الغزيرة المفاجئة، إلى جانب ظاهرة «النينيو» وتأثيرها على الطقس، أين شهدت المنطقة هذا العام نشاطا ملحوظا للظاهرة التي تؤدي إلى اضطرابات مناخية تشمل زيادة الأمطار في بعض المناطق، مقابل الجفاف في مناطق أخرى، بحيث ساهمت هذه الظاهرة في تعزيز قوة العواصف الآسيوية.
من جانب آخر، تؤكد الدراسات على أن تغييرات استعمال الأراضي والتوسع العمراني غير المنظم خاصة على المناطق الرطبة، وردم الأودية ومجاري المياه الطبيعية، كلها عوامل تضاعف آثار الفيضان ففي عديد المدن الآسيوية الكبرى، تتحول الأمطار الغزيرة إلى فيضانات فورية بسبب انسداد شبكات الصرف أو افتقارها للقدرة الاستيعابية، كما يؤدي تدهور الغاباب، وإزالة الغطاء النباتي، وقطع الأشجار وتسريع إزالة الغابات، إلى قلة قدرة التربة على امتصاص المياه، ما يتسبب في انزلاقات أرضية كارثية كما حدث في بعض المناطق الجبلية بالهند والفلبين.
الباحثة في الجيوفيزياء الدكتورة ليلى عليوان
سخونة البحار والمحيطات وراء العواصف
وأكدت الباحثة في الجيوفيزياء ومديرة مخبر فيزياء الأرض بكلية المحروقات والكيمياء ببومرداس، الدكتورة ليلى عليوان، أن العواصف والأعاصير التي شهدتها عديد الدول الآسيوية وخلفت مئات القتلى والمفقودين وشردت الآلاف، مردها بالدرجة الأولى للتغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب خلال السنوات الأخيرة، بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي عانت منها مناطق عدة من العالم، مفسرة ذلك بحجم التبخر الذي ينتج عن هذه الحرارة وبالتالي تسجيل نسب أمطار أكبر قد تصعب مراقبتها.
وأرجعت الباحثة الظواهر المتطرفة من جانب آخر، إلى العامل البشري الذي حملته جزءا كبيرا من المسؤولية، متحدثة عن التوسع العمراني غير المدروس وانسداد الوديان وحتى قطع الغابات.
وأوضحت، أن إفريقيا وحتى الجزائر معرضة للفيضانات كباقي الدول، خاصة المتعلقة منها بارتفاع درجات الحرارة المسببة للتبخر والأعاصير والأمطار المفاجئة العنيفة، كما سجلت خلال المواسم السابقة بالجزائر وبعض الدول الإفريقية مثل ليبيا، مضيفة أن التضاريس أيضا قد تعيق سيولة المياه الناتجة عن الأمطار.
وقالت، بأن منطقة شمال إفريقيا والجزائر بشكل خاص، ليست بمنأى عن هذه الأخطار، أوضحت أن سطح البحر الأبيض المتوسط قد سجل ارتفاعا قياسيا في درجة حرارة سطحه، وهو ما من شأنه أن يؤثر على معدلات الهطول. كما قد يسبب أمطارا قوية وحتى أعاصير.
ويمكنه أيضا حسبها، أن يخلف تأثيرا وصفته بالخطير على البيئة البحرية، أما فيما يتعلق باحتمال تسجيل تسونامي بمنطقة شمال إفريقيا والجزائر، فقد استبعدت محدثتنا ذلك، وأكدت أن الظاهرة تحدث في مناطق معينة من العالم مثل اليابان.
الخبيرة البيئية والتنمية المستدامة صليحة زردوم
على إفريقيا والجزائر التكيف مع احتمالات الكوارث
قالت الخبيرة في البيئة والتنمية المستدامة صليحة زردوم، بأن العالم يشهد اضطرابات جيولوجية ومناخية متزايدة، منها ثورات بركانية وفيضانات، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وأحداث قطبية غير مألوفة، مؤكدة أهمية مواصلة البحث والاستعداد لضرورة فهم دينامية كوكب الأرض التي أصبحت تتغير بسرعة.
وأوضحت زردوم، أن دولا كثيرة شهدت فيضانات مدمرة، وبراكين وزلازل امتدت من باكستان إلى اليونان، إلى اليابان، والفيتنام خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، أين تعرضت العديد من دول العالم إلى كوارث مناخية صنفت ضمن ظاهرة المناخ المتطرف.
وأكدت، أن المعطيات العلمية تبرز أن التأثيرات ستكون عالمية، وقد تشمل منطقة شمال إفريقيا وحتى الجزائر، منذرة بشتاء غير مستقر بناء على تحليل البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، التي أظهرت أن ضعف الدوامة القطبية أدى إلى تقلبات مناخية عنيفة وأحيانا موجات حر غير عادية، تليها موجات برد غير عادية، تليها عواصف.
وقالت، إن التغيرات المتتالية والمتسارعة تؤثر على المحاصيل الفلاحية، الصحة، الأنظمة البيئية، كما قد ينتج عن ذلك أحد أكثر فصول الشتاء تطرفا في التاريخ الحديث لكوكب الأرض في نصف الكرة الشمالي.
تأثيرات مباشرة ودعوة لوضع خطط فعالة للتكيف
وحذرت الخبيرة، من خطر التهاون مع مثل هذه الأخبار والتعاطي معها بشكل خاطئ، خاصة موجات البرد غير المتوقعة، وأكدت أن إفريقيا ليست بمنأى عن هذه التغيرات بحكم أنها ضمن الدول التي تدفع ثمن الأضرار المناخية بالرغم من أنها ليست المسؤولة عن الأسباب بشكل مباشر.
مشيرة، إلى موجات الحر التي اجتاحت الدول ومن بينها الجزائر فضلا عن حالات الجفاف، وتسجيل تجاوز 50 درجة مئوية، بينما شهدت الجزائر تراجعا في نسب هطول الأمطار في عز فصل الشتاء، بما يعرض الغطاء النباتي للتدهور.
وتحدثت الخبيرة، عن العواصف الرملية والتربة التي أصبحت تؤثر على الحالة الصحية، التنفس، التنقل الجوي، كما تؤثر على المواسم الزراعية خاصة إنتاج بعض الأنواع مثل القمح والمحاصيل الإستراتيجية والحساسة للظروف المناخية كالتمور.
وأكدت، أن البيانات المتاحة حاليا تشير إلى تسجيل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مستوى المحيطات والبحار حول إفريقيا، كما أصبحت التيارات الجوية أكثر اضطرابا، وصارت مياه المحيطات دافئة بسبب الدوامة القطبية في الشمال.
موضحة، أن الدوامة أثرت على التيارات الهوائية المتجهة إلى إفريقيا، مما تسبب في تذبذب فصلي غير مألوف، بما يجعل إفريقيا والجزائر عرضة للتطرف المناخي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المألوف في الشتاء، إلى جانب الجفاف والفيضانات ومواسم فلاحية ومنتوجات مضطربة.
وفي ظل تسارع الظواهر المناخية المتطرفة، دعت إلى ضرورة الاستعداد الاستباقي لكونها ضرورة ملحة لإفريقيا عموما والجزائر بشكل خاص، بهدف تحسين قدرة المجتمعات على الصمود، من خلال تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير شبكة الرصد الجوي، وتوفير البيانات والتنبيهات حول الأمطار والحرائق والعواصف الرملية وخاصة إشراك السكان في عمليات التبليغ وإصلاح شبكات المياه.
كما دعت الخبيرة إلى تخزين مياه الأمطار عبر الحواجز، وتعميم الزراعات الذكية، وتبني أصناف زراعية تتحمل الحرارة والجفاف ومواجهة الحرائق والعواصف، وتنظيف الغابات وتعزيز الوعي المجتمعي، وتدريب المدارس على مخططات الطوارئ بشكل استباقي.
وأكدت على أهمية التخطيط المبكر، والتكنولوجيات الحديثة، وإشراك السكان وتوعيتهم لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص وبناء مجتمعات أكثر صمودا في التغيرات المناخية.

الباحثة في بيولوجيا النبات أسماء نويشي
تغيرات المناخ وراء ظهور نباتات غازية وحشرات بقسنطينة
تعتبر التغيرات المناخية وما تخلفه من ارتفاع في الحرارة وقلة المياه من أهم العوامل التي تؤثر على النباتات وتهدد بتراجع أنواع كما تتسبّب في ظهور أخرى غازية بقسنطينة، ما قد يشكّل تهديدا للتنوع النباتي الأصيل، كما تؤثر على كم ونوع المادة الفعالة في النباتات الطبية والعطرية، وتؤدي كذلك إلى بروز حشرات لم تكن موجودة وتسرّع من تطوّرها.
إسلام. ق
ترى الدكتورة المختصة في بيولوجيا النباتات بجامعة قسنطينة 1، أسماء نويشي، أنّ قسنطينة تتميّز بتنوع نباتي خاصة في الغابات والمناطق الجبلية، مثل جبل الوحش أين تنتشر أشجار البلوط الأخضر والبلوط الفليني وبعض أنواع الأوركيد. بالإضافة إلى النباتات المائية المتواجدة في محيط الوديان والمجاري المائية، والتي تتأثر كذلك بحدة الجفاف وتغير نوعية المياه، محذرة من أن هذه الأصناف مهددة بالاندثار والتراجع.
تهديد لوجود النبات وظهور أخرى غازية
وأضافت المتحدّثة، أنّ هذا التراجع يعود إلى الجفاف والإجهاد المائي الذي ينتج عنه ما يعرف بتغير مواسم النمو، فالإجهاد المائي بالأخص قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة يؤديان إلى انخفاض رطوبة التربة أو المحتوى المائي ما يضعف قدرة النباتات، خاصة قدرة الأشجار المعمرة على امتصاص الماء والعناصر الغذائية، فتتعرض للأمراض والآفات.
وأشارت أيضا، إلى التصحر وتعرية التربة نتيجة الجفاف وإزالة الغطاء النباتي، وكيف يقللان من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء والمواد العضوية الضرورية لنمو النبات.
وتطرقت الباحثة إلى معضلة التوسع العمراني والنشاط البشري الذي أدى إلى تقليل المساحة المتاحة للنمو ما يمنع التبادل الجيني بين مجموعات النباتات ويضعف قدرة التكيف، إذ يؤدي الأمر إلى تقسيم الوسط الطبيعي من مساحة شاسعة متصلة إلى مناطق أصغر معزولة فيقلل ذلك من المساحات المتاحة للنباتات والحيوانات ويعزل مجموعات النباتات عن بعضها.
وأردفت نويشي، أنّ أصنافا نباتية غازية لم تكن موجودة أو كانت قليلة الانتشار ظهرت بشكل ملحوظ مؤخرا، كالأكاسيا وبعض أنواعها، إذ باتت تُزرع وتنتشر بسرعة، وكذلك الزفزاف أو حشيشة الدينار.
وأوضحت الباحثة، أنّ شجرة الأكاسيا تتميّز بسرعة نموها وقدرتها على تحمل ظروف صعبة مثل الجفاف والملوحة، ما يسمح لها بالتفوق على النباتات المحلية والتنافس معها على الموارد. وحسبها فإن الأصناف الغازية تشكل تهديدا للتنوع النباتي الأصيل لأسباب عدة كالمنافسة الشديدة، وإطلاق مواد كيميائية سامة في التربة تمنع نمو البذور والنباتات الأخرى.
وتحدثت في مقابل ذلك، عن أن بعض النباتات تظهر قدرة أعلى على التكيف مع التغيرات المناخية بالأخص الجفاف وارتفاع الحرارة، نجد مثلا النباتات الشوكية والجفافية على غرار بعض أنواع الصبار والصباريات المحلية التي تملك آليات لتقليل فقدان الماء، وأيضا النباتات العطرية والطبية مثل إكليل الجبل، الزعتر، والريحان، والتي تملك أوراقاً جلدية أو صغيرة مغطاة بالشعيرات أو الزيوت التي تقلل من النتح وتساعد على تحمل الإجهاد، وأيضا الأصناف التي تتميز بنظام جذري عميق يمكنها من الوصول إلى المياه الجوفية.
تأثيرات كبيرة على دورة حياة الحشرات
ولفتت المتحدّثة، إلى أنّه من المحتمل جداً رصد أنواع من الحشرات لم تكن موجودة أو زاد تعدادها بشكل كبير، إذ ترجع الباحثة، ظهور هذه المعضلة على حدّ وصفها، إلى عامل بالغ الأهمية يتمثّل في ارتفاع درجات الحرارة، فالمناخ الأكثر دفئاً يسمح للحشرات التي كانت تستوطن مناطق دافئة جنوباً أو المناطق المدارية بالانتقال والاستيطان في قسنطينة.
ومن الأمثلة عن الحشرات التي قد تظهر أو يتزايد تأثيرها هي بعض أنواع النمل الأبيض، سوسة النخيل الحمراء، وأيضا حشرة حفارة أوراق الطماطم، وبعض الحشرات القشرية أو المن التي أصبحت دورة حياتها أسرع.
وأوضحت، أن حشرات المن تتميّز بدورتي تكاثر في الموسم الواحد توالد جنسي وآخر لا جنسي وهما مرتبطان بالحرارة، ففي الظروف الحارة تتكاثر المن بسرعة كبيرة بسبب التوالد اللاجنسي أو البكري، حيث تلد إناث المن صغاراً حية دون تلقيح ما يسرع زيادة أعدادها.
كما أن الحرارة تسرّع حسب ما شرحت الباحثة، من نمو الصغار وتقلل مدة الانسلاخات اللازمة للوصول إلى البلوغ، وبالتالي تتوالى أجيال عدة في فترة قصيرة. وأيضا عند ارتفاع الحرارة تظهر أعداد أكبر من المن المجنح الذي ينتقل إلى نباتات جديدة فتنتشر الآفة أكثر.
وفي الظروف الباردة تتكاثر المن جنسيًا وتبيض بيضاً يبيّت خلال الشتاء ليبدأ دورة جديدة في الربيع، ما يعني تسجيل مناطق إصابة جديدة إما مركزية أو منتشرة حسب نوع الأفراد «ولودة» أو «مجنحة». وعن تأثير الحرارة على دورة حياة الحشرات قالت نويشي، إنها تؤثر بشكل عميق، إذ تسرّع من العمليات التطورية مما يقلل من الفترة الزمنية بين الأجيال، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أجيال إضافية في نفس العام.
كما أن ارتفاع الحرارة شتاء يقلل معدلات موت الحشرات البالغة أو البيض واليرقات خلال مرحلة البيات الشتوي، كما تسمح للآفات الحشرية بالبقاء والتكاثر في مناطق لم تكن مناسبة لها سابقاً. وأضافت، أنّ زيادة أعداد الأجيال وظهور أخرى إضافية مع تغير مواسم ظهور الحشرات سواء كان ظهورا مبكرا أو غير متوقع، إلى جانب الاستخدام المتكرر وغير المنتظم للمبيدات بسبب زيادة أجيال الآفة، يرفع من خطر تطوير الحشرات لآليات مقاومة للمبيدات الكيميائية، فتربك هذه العوامل جداول المكافحة التقليدية وتقلل من فعاليتها.
الإجهاد المائي يؤثر على المواد الفعالة
وتشتهر قسنطينة ومحيطها، بالعديد من النباتات الطبية والعطرية وفق المتحدّثة، حيث تنمو هذه الأصناف في مناطقها الغابية وشبه القاحلة، وذكرت بعضا من أهم هذه الأنواع كالزعتر، إكليل الجبل، الخزامى أو اللافندر، الشيح، العرعار، الريحان، البابونج، الخياطة (جعيدة)، الدرياس (بونافع)، قرايص، لسان الثور وغيرها.
منبّهة، إلى أنه يمكن للتغيرات المناخية أن تؤثّر على كمية ونوعية المادة الفعالة بالأخص الزيوت الأساسية في النباتات الطبية والعطرية، إذ يمكن على سبيل المثال أن يزيد الإجهاد المائي من كم ونوع بعض المواد الفعالة على غرار الزيوت الطيارة أو المركبات الفينولية، وهي مركبات تنتجها النبتة كآلية دفاع ضد الإجهاد، مما يؤثر على الخصائص العلاجية للنبتة.
وأوضحت المتحدّثة، أنّ قلة الماء أو عدم كفايته ينتج ويزيد من تركيز بعض هذه المواد، لأنه يدفع النبات إلى محاولة حماية نفسه عن طريق زيادة المواد المفيدة التي ينتجها، لكن زيادة الجفاف المائي يغير تركيز مكونات الزيوت الطيارة مثل نسب مركب «الكارفاكرول» مقابل «الثيمول» في الزعتر، مما يؤثر على خصائص العلاج.
كما أشارت إلى أنّه تم استخلاص زيوت أساسية لنباتات جمعت في فترات الجفاف وفترات عادية ولوحظ الفرق.
وترى الباحث، أنّه لحماية الأصول الوراثية لهذه النباتات ينبغي جمع البذور، الأنسجة النباتية، والأجزاء الخضرية، وتخزينها في بنوك البذور أو حدائق الحفظ النباتية، مع التركيز على الأصناف المحلية النادرة. إلى جانب حماية الموائل الطبيعية للنباتات لضمان استمرار نموها وتطورها الطبيعي، وكذلك العمل مع مراكز البحث والجامعات لتطوير برامج للتكاثر وزراعة هذه النباتات بشكل مستدام ومدروس للحد من الضغط على مجموعاتها البرية. فضلا عن إجراء دراسات مسحية ووراثية لتحديد الأصناف الأكثر مقاومة للتغيرات المناخية وتوثيق المعرفة التقليدية لاستخدامها.
كما ترى الدكتورة، أنه ينبغي سن وتطبيق قوانين صارمة لحظر القطف الجائر والاستغلال المفرط لهذه النباتات.

توج بالمركز الأول في اللقاء الوطني للنوادي الخضراء
مشـــــروع لتثميـــن النفـايـــات العضويـــة وتحويلهــــا إلى سمــاد طبيعـــــي
توّجت بوذيبة ندى، طالبة بكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، تخصص ميكروبيولوجيا تطبيقية بجامعة الشيخ العربي التبسي بتبسة، بالمركز الأول لأحسن مشروع بيئي في اللقاء الوطني للنوادي الخضراء المنعقد بولاية بومرداس مؤخرا، حول موضوع البيئة والتغيرات المناخية.
وأوضحت الطالبة للنصر، أن التتويج تحقق بفضل المشروع المبتكر Compovita، وهو مبتكر علمي يهدف إلى تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي صديق للبيئة، مؤكدة أنها ثمرة عمل فريق شاب وطموح، يضم طلبة باحثين يمتلكون مهارات أكاديمية وعلمية متكاملة، وتضم المجموعة كلا من المعنية وزميلاها في البحث زهير براح، والحمزة محمد رياض، وقد تم العمل تحت إشراف الدكتورة سوسن سماعلي.
وذكرت المتحدثة، أن المشروع انطلق من إشكالية بيئية حقيقية، تعاني منها الجزائر عامّة وولاية تبسة بشكل خاص، إذ تنتج بلادنا أكثر من 12 مليون طن سنوياً من النفايات، منها 53 في المائة نفايات عضوية بمعدل 800 غرام للفرد يوميا وفق إحصائيات الوكالة الوطنية للنفايات AND، ورغم ضخامة هذه الكميات، ما تزال حلول التثمين الفعّال محدودة حسبها، وهو ما يُضاعف الأثر السلبي على البيئة.
وقالت، إن الفكرة ولدت من هذه الإشكالية، حيث يوفر مبتكرها “ كومبوفيتا” Compovita حلولا علمية مستدامة، تقوم على إعادة رسكلة النفايات العضوية وتحويلها إلى أسمدة طبيعية خالصة.
وبما أنّ عملية نضج السماد تستغرق عادة من 6 أشهر إلى سنة، عمل الفريق كما أوضحت، على تطوير مسرّع حيوي طبيعي يعتمد على كائنات مجهرية محلية، يختصر مدة إنتاج السماد إلى أربعة أسابيع فقط دون التأثير على الجودة.
وأفادت، أن الحلول المطورة تسمح باختصار الزمن وتقليل التلوث البيئي، وتحسين جمالية المحيط، ودعم الفلاحين بأسمدة طبيعية خالية من المواد الكيميائية، والمساهمة في تعزيز الزراعة المستدامة. كما قام الفريق بتطوير منصة إلكترونية خاصة بالمشروع، تُعرّف بمنتجاته وخدماته، وتُعدّ جسر تواصل فعّال بين الشركة وزبائنها.
وحسب الشابة، فإن المجموعة البحثية تؤمن بأن النجاح لا يتحقق بفضل منتج واحد فقط، بل يعتمد على روح الفريق والقدرة على الابتكار المتجدد معلقة :” عزيمتنا، شغفنا، وتكامل مهاراتنا هي القوة التي تدفعنا نحو التميّز، ومع كل خطوة، نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو أن يكون اسم Compovita رائدا في مجال التدوير الحيوي والزراعة المستدامة في الجزائر وخارجها».
وذكرت الطلبة ندى، أنه بالاستناد إلى المعلومات التي تلقّتها من مديرية البيئة لولاية تبسة، تبيّن أن الولاية تواجه مشكلا بيئيا ملحوظا، يتمثل في الكميات الكبيرة من الفضلات العضوية الحيوانية، خصوصا مخلفات الدواجن المنتجة، وقالت بأن هذه النفايات تُعدّ أحد مصادر التلوث البيئي الخطيرة في حال عدم استغلالها بطريقة صحيحة، وبما أنّ مشروعها يعتمد على إعادة تدوير النفايات العضوية بما فيها الحيوانية وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، فقد سعت رفقة زملائها إلى توجيه الاهتمام نحو هذا النوع من الفضلات بهدف تثمينها وتحويلها إلى عنصر مفيد للولاية.
وأضافت المتحدثة قائلة :» خلال مشاركتي في اللقاء الوطني للنوادي الخضراء حظي المشروع باهتمام خاص من السيدة وزيرة البيئة التي أعربت عن دعمها لهذه المبادرة، ووجّهت السيد مدير البيئة لولاية تبسة لمرافقتنا في هذا المسار والعمل معنا على معالجة هذه النفايات قبل استغلالها في إنتاج السماد الطبيعي”.
واعتبرت الشابة، أن تثمين هذه النفايات مساهمة فعالة في تحسين جودة الحياة البيئية، ونشر الوعي حول أهمية الفرز الأولي للنفايات وإمكان تحويلها إلى مورد طاقوي مستدام، والحد من الانتشار العشوائي للفضلات التي تشوه المحيط،، كما يساهم العمل في التقليل من ردم أو حرق النفايات و يحمي الهواء والتربة والمياه الجوفية.
وفيما يتعلق بالجانب التسويقي للمشروع، أوضحت أن المشروع اعتمد في بدايته على المنصة الإلكترونية “CompoVita” كوسيلة رئيسية للتعريف بالخدمات والمنتجات، وتقديم نصائح بيئية للمجتمع، بالإضافة إلى توفير فضاء للتواصل مع الأشخاص الراغبين في التخلص من نفاياتهم العضوية بطريقة مسؤولة.
ويتم الاعتماد كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لبلوغ مختلف شرائح المجتمع وعلى الحملات التحسيسية والتوعوية خصوصا للأطفال، إيمانا بأن الاستثمار في وعي الطفل هو الأساس لبناء جيل بيئي واعٍ ومثقف كما قالت.
إضافة إلى ذلك، تظل المشاركة في المعارض الوطنية وخاصة البيئية وسيلة فعّالة للتسويق حسبها، وقد شكلت نقطة انطلاق المشروع الذي وُلد من ملتقى بيئي وطني بعد أن كان مشروع تخرج في شهر اكتوبر.
عبد العزيز نصيب

حذر خبراء ونشطاء بيئيون، من خطر انتشار سمك «الصندر» في بحيرة أوبيرة المتواجدة بالقالة بولاية الطارف، وتحدثوا عن انتشار مقلق لهذا النوع المفترس، الذي قالوا إنه بدأ يغير ملامح التنوع البيولوجي في البحيرة، ويهدد بتأثيرات عميقة على السلسلة الغذائية والكائنات الأصلية.
إيمان زياري
ونددت جمعية حماية البيئة والمناطق الرطبة بالطارف، بالوضع الذي آلت إليه البحيرة المصنفة في إطار اتفاقية «رامسار» كمنطقة رطبة ذات أهمية عالمية، عقب تسجيل انتشار لافت لسمك الصندر المفترس الدخيل على المسطحات المائية الجزائرية، وافتراسه للعديد من الكائنات المائية بالبحيرة والتي عثر عليها داخل أحشائه.
مجهولون يقحمون الصندر في البحيرات ودعوات لوقف الانتهاكات
وقالت المستشارة القانونية للجمعية، الدكتورة وداد ليشاني، إن بحيرة أوبيرة تعيش اليوم وضعا بيئيا وصفته بالخطير والمقلق للغاية، نتيجة لإدخال نوع سمك غازي مفترس من طرف مجهولين، وهو سمك الصندر المعروف عالميا باسم “صندر لوسيوبيرسا».
وأوضحت، أن التجارب الدولية والإيكولوجية أثبتت أن هذا السملك يمثل أحد أخطر الأنواع الغازية على الأنظمة المائية، لأنه يفترس الأسماك المحلية، واليرقات، وحتى الضفادع والحيوانات الصغيرة ويتسبب في اختلال التوازن البيئي وانهيار في سلاسل الغذاء، ويهدد الأنواع المحلية بالانقراض، كما يؤدي إلى إفقار أو فقدان التنوع الحيوي وتدهور النظام البيئي.وإلى جانب الخطر الكبير الذي يسببه التواجد غير الطبيعي لهذا النوع من الأسماك، تحدثت الخبيرة البيئية أيضا، عن المشاكل الأخرى التي تعاني منها البحيرة والتي أثرت على خصائصها الطبيعية، بفعل التغيرات الهيدرولوجية والتلوث والصيد الجائر وغير القانوني، كما يغير سلوك الطيور المهاجرة التي تأتي إلى البحيرة بحثا عن غذائها الطبيعي، هذا السمك يتكاثر بسرعة ويهيمن على المسطح المائي، ما يجعل استعادة التوازن أمرا صعبا.ونددت الدكتورة ليشاني، بالتدهور الذي آلت إليه البحيرة نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي، وإلقاء القمامة والمخلفات على اختلاف مصادرها والصيد الجائر. وأوضحت، أن هذه العوامل مجتمعة تؤثر بشكل سلبي كبير على المنطقة المحمية، وطالبت بتشديد الرقابة و المتابعة لوقف التجاوزات التي وصلت إلى حد إطلاق غازي مفترس في موقع مصنف دوليا وهو ما قالت إنه انتهاك مباشر لالتزامات الجزائر الدولية تجاه اتفاقية» رامسار»، التي تمنع إدخال الأنواع الغريبة والغازية للمناطق الرطبة المصنفة، وتؤكد بالمقابل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لأجل الحفاظ على السلامة البيولوجية للنظم الطبيعية بهذه المناطق.
وحذرت الممثلة القانونية للجمعية، من خطر استمرار هذه الاعتداءات والتجاوزات الخطيرة وما أسمته بـ «التقصير في الحماية»، معتبرة أن هذا السلوك يهدد الموروث الإيكولوجي الوطني، والوضع الدولي للحظيرة، إذ أن برنامج المحيط الحيوي واتفاقية رامسار كلاهما يسمحان من الناحية القانونية بتفعيل إجراءات إنذار أو حتى سحب الاعتراف والتصنيف الدولي من طرف منظمة اليونيسكو، إذا ثبت فقدان الموقع لطابعه الإيكولوجي أو إخلال الدولة المتعاقدة بالتزاماتها في الحماية والصيانة والتسيير. وطالب، بفتح تحقيق مستعجل من طرف الجهات المختصة والمساءلة القانونية للمتعدين على هذا الإرث الطبيعي، وإنفاذ الحماية القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية، وبموجب القانون رقم: 11_02 لسنة 2011م، والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة داعية إلى تشكيل لجنة مختصة لتقييم الوضع البيئي في البحيرة ووضع خطة استعجالية للترميم والصيانة، والاستئصال التدريجي للنوع الغازي المفترس بطرق علمية وبمراعاة تجارب الدول بهذا الخصوص، مع إدراج البحيرة ضمن أولويات الاستعادة البيئية الوطنية وبرنامج تنمية محلي، يوفر فرص عمل خضراء بدل تدمير الموقع، على غرار الدول المتقدمة التي تستثمر في مجالاتها المحمية.
الخبيرة في التنمية المستدامة صليحة زردوم
إدخال أسماك “الصندر” للبحيرة المحمية خرق بيئي
تؤكد الخبيرة في البيئة والتنمية المستدامة، صليحة زردوم، أن أغنى المناطق الرطبة بولاية الطارف، من حيث النظم البيئية تواجه تهديدات خطيرة منها تحديات التغيرات المناخية، والجفاف، والتلوث الناتج عن أنشطة غير ملائمة منها الصيد الجائر، الزحف العمراني، واستنزاف الموارد المائية، واحتمالات صب مياه الصرف الصحي، ناهيك عن إدخال نوع من سمك “ الصندر المفترس”، إلى بحيرة أوبيرة المحمية، وهو سلوك وصفته بأنه خرق بيئي قد يتسبب بمشكلة حقيقية.
وقالت الخبيرة، إن بعض الجمعيات المحلية قد نددت بإدخال بعض الأنواع من الأسماك المفترسة، التي تشكل خطرا على التنوع البيولوجي المحلي وفق منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسبها، فإنه إن صح هذا الادعاء، فإنه يتعين على الجهات المختصة فتح تحقيق عاجل ومعاقبة المسؤولين عنه، لأن قانون البيئة من أجل التنمية المستدامة 03/11 يعاقب على هذا الفعل بسنة إلى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية من 50 مليونا إلى 300 مليون سنتيم، وهي عقوبات تمس كل شخص يتسبب في تدهور المجالات المحمية عن طريق صرف أو صب، أو رمي، أو وضع مواد تؤدي إلى تغيير خصائص المنطقة.
وترى زردوم، أن كل هذه العوامل أثرت سلبا وتسببت في تراجع التنوع البيولوجي، واختلال التوازن البيئي لأماكن أعشاش الطيور وموائلها داعية إلى تنظيم معاينات ميدانية وإعداد تقارير تفتيشية بيئية حيادية تؤكد أن تدهور البحيرة ناتج عن إدخال هذا السمك، أو احتمال وجود ملوثات أخرى.
مضيفة أنه لابد من متابعة الوضع للوقوف على صحة هذه الممارسات التي تشكل خرقا إيكولوجيا بمنطقة مصنفة ضمن اتفاقية "رامسار". ومشددة على ضرورة تطبيق إجراءات المراقبة الدورية و إشراك الجمعيات والنشطاء في السلطة الوصية فيما يتعلق بجريمة بيئية من هذا النوع.
ورجحت، أن يكون إدخال سمك الصندر، تم على خلفية تحسين الصيد في المنطقة، إلا أنه أثر على الحياة في البحيرة وتسبب في انقراض بعض الكائنات وألحق أضرارا.
مؤكدة أن الوضع ينذر باحتمال فشل تسيير منطقة محمية دوليا خاصة إذا كان إدخال هذا النوع مقصودا بسبب اقتصادي أو نتيجة إهمال، ما تسبب في خلل بيئي بالبحيرة، وهو ما يستوجب التحقيق والمساءلة، داعية من جهة ثانية، إلى ضرورة إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام وإشراك كافة المصالح المعنية في حل المشكلة. للتذكير، فإن بحيرة أوبيرة تتمتع بحماية مضاعفة بموجب اتفاقية “رامسار" للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية التي صادقت عليها الجزائر سنة 1982، والتي تفرض على الدول المتعاقدة الحفاظ على الخصائص الطبيعية للمناطق الرطبة، بما فيها المياه، التربة، النباتات، والحياة البرية، ومنع أي تدخل بشري يؤدي إلى تغيرات بيئية جوهرية أو تدهور النظام البيئي.
كما تلزم الاتفاقية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على الطابع البيئي للمناطق الرطبة، وإنشاء احتياطات طبيعية في هذه المناطق، وتشجيع البحث وتقوية قدرات المستخدمين الأكفاء في دراستها وتسييرها وحراستها، وإبلاغ الأمانة الدولية فورا بأي تغير ينتج عن التلوث أو التدخل البشري.
إيمان زياري
المهندسة في البيئة البحرية كنزة غزال
“الصندر” مفترس للنظام البيئي ولا بد من مكافحته
حذرت المهندسة البيئية، المتخصصة في البيئة البحرية، كنزة غزال من خطر انتشار سمك الصندر في البحيرات الجزائرية، لأنه من أكبر المفترسات للنظام البيئي، وقادر على إحداث تغيرات في تجمعات الأسماك المحلية ومنافسة الأنواع الأصلية.
وقالت، أن أصوله تعود إلى أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوربا بينما موطنه الطبيعي في المياه العذبة والمياه شبه المالحة الهادئة واصفة إياه بالنوع الانتهازي، القادر على تحمل نطاق واسع من درجات الحرارة، كما يستطيع التكيف مع المياه العكرة، ويمكنه أيضا تحمل نسبة ملوحة تصل إلى 12 في الألف.
وأوضحت المختصة في البيئة البحرية، أن هذا النوع من الأنواع الغازية ويمكن نقله عبر عدة نواقل رئيسية، خاصة بفعل التدخل البشري المباشر، مثل برامج إعادة التخزين السمكي، وتربية الأحياء المائية، وعملية النقل لأغراض الصيف، وهو قادر على إحداث تغييرات في تجمعات الأسماك المحلية ومنافسة الأنواع الأصلية، مما قد يؤثر على نشاط الصيد في حال عدم التحكم في عمليات إدخاله.وحذرت غزال، من خطر انتشاره في البحيرات والمياه شبه المالحة في الجزائر، معتبرة أن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على الكائنات المائية المحلية، مما يستدعي تدخل الخبراء ووزارة الصيد البحري من أجل وضع إستراتيجية وطنية لمكافحته وإدارته بشكل مستدام.
إيمان زياري

جمعية علم الطيور والبيئة بقسنطينة
«تليانة» .. مبادرة وطنية لتثمين الإرث الطبيعي للمقنين الجزائري
كشفت مؤخرا، جمعية علم الطيور والبيئة بقسنطينة، عن مشروعها التمهيدي الأولي الذي يحمل اسم «تليانة»، هذا المشروع يمثل مبادرة وطنية تمزج بين التحليل البيئي، المورفولوجي، والوراثة فوق الجينية إضافة إلى قراءة صوتية ميدانية تعتمد على خبرة المربين.
رضا حلاس
كما يعتبر المشروع مرحلة مهمة لعلم الطيور في الجزائر، لأنها أول مرة تقترح فيها هيئة محلية، تحديدا واضحا ومبنيا على أسس علمية للشكل الجزائري من Cardueliscarduelisparva.
ويؤكد رياض رحمون، صاحب فكرة المشروع، وعضو بجمعية علم الطيور والبيئة بقسنطينة، أن العمل لا يغير التصنيف الدولي، كما أنه لا يقترح نوعا جديدا، بل يقدم وصفا علميا واقعيا لشكل محلي، تطور داخل بيئته الطبيعية.
ويضيف المتحدث، أن الدراسة تؤكد أن الاسم العلمي الدولي Cardueliscarduelisparva يبقى ثابتا، وأن كلمة تليانة ليست جزءا من التسمية العلمية، بل هي تسمية بيئية محلية، تستخدم للدلالة على الهوية الإيكولوجية للمقنين الجزائري، دون المساس بالقانون العلمي للتصنيف.
كما يؤكد رياض أن المشروع يرتكز على تحليل معمق للمجال التلي الذي يمتد من السواحل إلى قمم الجبال الأولى، وهي منطقة تتميز بغطاء نباتي متنوع، بالإضافة إلى استقرار الضوء والرطوبة، حيث انعكست هذه الظروف على تكوين بصمة لونية واضحة لدى الطائر عبر أجيال طويلة.
ومن أهم هذه البصمات قوة التباين الحاد الطبيعي في الريش بين اللون الأسود والأبيض، مع ثبات في اللون الأصفر في الجناح، إضافة إلى القناع الأحمر الداكن، وهو من أهم الميزات والعلامات اللونية لطائر «تليانة».
وهذا التميز حسب المتحدث، ناتج عن الغذاء الزيتي المحلي، مع شدة الضوء واستقرار الإيقاع الهرموني للطائر، كما تؤشر الدراسة لاختلافات مورفولوجية خفيفة داخل المجال التلي، من حيث اختلاف طول المنقار (بين القصير والطويل) وذلك حسب المنطقة، وتبعا لطبيعة البذور المتوفرة، وقساوة الشوكيات ومستوى الرطوبة. ويصنف هذا الاختلاف والفارق العلمي ضمن التكيف الإيكولوجي داخل نفس الفرع وليس ضمن الاختلافات الوراثية.
كما أوضح رياض رحمون، أن المشروع يعتمد كذلك تقسيما إيكولوجيا دقيقا للمجال التلي، من حيث الغطاء النباتي، الرطوبة، الحرارة والارتفاع، وهو ما يفسر الاختلافات البيئية التي تؤثر على اللون، وطول المنقار ونمط السلوك من منطقة إلى أخرى. ومن ذلك تم تبني مفهوم «المعيار المرن»، والذي يحدد الهوية العامة للطائر مع احترام الاختلافات الطبيعية بين المناطق التلية، بدل فرض نموذج واحد لا يعكس الواقع البيئي.
أما من الجانب الصوتي، فإن المشروع لم يعتمد حسب عضو الجمعية على أجهزة مخبرية وبرامج تحليل ترددي، بل على قراءة سمعية معتمدة على خبرة طويلة للمربين، ومقارنة مباشرة بين الأصوات المحلية وأصوات النماذج الأوروبية، أين أثبتت الخبرة السمعية أن طائر «التليانة» يمتلك جملا صوتية واضحة ومقسمة وذات صفاء عال. إضافة إلى تناسبها مع البيئة التلية والتي تتميز بالغطاء النباتي الكثيف، مقارنة بنماذج البارفا الأوروبية، التي تتميز بأصوات أسرع وأقل فصلا، بسبب البيئة المفتوحة، وتأثير الهجرة الجزئية.
كما تقدم الوراثة فوق الجينية (الإبيجيناتيك) حسبه، تفسيرا مهما لتكرار هذه الخصائص والمواصفات عبر الأجيال، أين تترك البيئة التلية بضوئها وغذائها ورطوبتها تأثيرات قابلة للتوريث على طريقة عمل الجينات دون أن تغير بنيتها الأساسية، مما يحافظ على هوية «تليانة» رغم انتمائها الكامل إلى صنف «بارفا».
وبناء على هذه المعطيات التي قدمها صاحب فكرة المشروع، يقدم «تليانة» ملفا علميا تراثيا متكاملا يبرز الهوية البيئية والمورفولوجية والصوتية للمقنين الجزائري، ويبرز إدراجه ضمن التراث الوطني لأنه يعتبر جزءا من الذاكرة البيئية والثقافية للجزائر، وحمايته تعني حماية الهوية الصوتية المحلية. هذه الدراسة تمثل نموذجا علميا يمكن استخدامه لدراسة سلالات محلية أخرى تعيش في الجزائر، سواء من الطيور المغردة أو الطيور البرية التي تحتاج إلى وثائق تعريف بيئية مشابهة.

كما يمهد هذا المشروع الأولي لعدة مشاريع فرعية مكملة، مثل مفهوم المربي المحافظ، المكلف بإنتاج نماذج وفية للنموذج التلياني، تطوير سلالات شبه حرة تأهيلية، مخصصة لتهيئة الطيور في وسط قريب من بيئتها الطبيعية، وبرنامج إطلاقات مؤطرة ينجز بالتعاون مع السلطات المختصة. ويضيف المتحدث أن التقدم في هذا المشروع أصبح ممكنا بفضل التزام مسؤولي وأعضاء جمعية علم الطيور والبيئة بولاية قسنطينة، وعلى رأسهم أمين فريطس، الذي سمحت تنسيقيته ورؤيته بفتح وهيكلة الورشة العلمية «تليانة» على المستوى الوطني، كما لعب انخراط كامل فريق الجمعية في المشروع دورا حاسما في رفع جودته.
وبهذا أصبح مشروع «تليانة» أكثر من مجرد تعريف بطائر واحد، بل هو أساس لرؤية وطنية شاملة لحماية السلالات المحلية، وتعزيز السيادة الوطنية على مكوناتها البيئية الحية، كما ترسخ ثقافة بيئية علمية مستدامة في الجزائر، فـ»تليانة»، لا تقدم طائرا جديدا كما عبر، وإنما تمنح فقط اسما لإرث جزائري حي، بفضل فريق موحد، جاد، وملتزم بعمق في تثمين التراث الطبيعي الوطني.

تناولتها دراسة بحثية نشرت في مجلة دولية
"رحلة العشابة والعزابة" استراتيجية الرعاة بالنعامة لمواجهة الجفاف
قدم فريق من الباحثين الجزائريين، دراسة دقيقة لطريقة تكيف المجتمعات الرعوية بولاية النعامة، مع موجات الجفاف والجفاف الحاد، مبرزين إستراتيجيات التكيف وفق رؤية معمقة للتحديات والحلول التي انتهجها هؤلاء الرعاة في مواجهة التقلبات المناخية الموسمية.
ووفقا للبحث الذي نشر مؤخرا في مجلة "المناخ النظري والتطبيقي"، وهي مجلة متخصصة في أبحاث المناخ والنظم المناخية تابعة لدار النشر الدولية "سبرينغر". فقد شارك كل من الباحث سعيد بوعرفة، زينب مشياش، وعبد الصمد دردور، في إعداد مقال تحت عنوان "تكيف الموالين والبدو مع الجفاف وتغير المناخ في الصحراء الجزائرية الجنوبية الغربية –نعامة".
وأوضحت السيدة مشياش، أن المقال يستند جزئيا إلى عمل ميداني قامت بإجرائه كجزء من أطروحة الماجستير 2 في تخصص المناخ والإعلام في جامعة باريس – ساكلي بالتنسيق مع مركز المناطق الجافة بالجزائر.
بين التحديات والحلول
وتحلل الدراسة التي تتناول ما يعرف بـ"رحلة العشابة والعزابة"، والتي تعني رحلة الشتاء والصيف، بعمق إستراتيجيات التكيف للمجتمعات الرعوية في ولاية النعامة، في ظل تزايد الجفاف والجفاف الحاد، بهدف تقديم رؤية معمقة حول التحديات والحلول المتعلقة بهذه المجتمعات المحلية.تجمع الدراسة بين تحليل كمي لبيانات المناخ التاريخية للفترة الممتدة بين سنتي 1967 و2021، والرؤى النوعية المستخلصة من 150 مقابلة شبه منظمة مع رعاة محليين. وتضيف الباحثة أن النتائج قد أظهرت بأن الممارسات التقليدية في الرعي تتعرض الآن لتعديلات كبيرة، أو حتى التخلي عنها كليا، وذلك نتيجة للاضطرابات الموسمية وتدهور المراعي. تشير نتائج البحث حسبها، إلى أن الممارسات التقليدية مثل الترحال أو التنقل الموسمي، تشهد تعديلات كبيرة، أو تم التخلي عنها بسبب التقلبات المناخية الموسمية وتدهور المراعي بشكل حاد، وفي مقابل ذلك يقوم الرعاة تدريجيا باعتماد مصادر عيش بديلة واستراتيجيات تكيف جديدة استجابة لكل تلك التغيرات المناخية التي أجبرت الموالين والرعاة على تبني إستراتيجيات جديدة تدريجيا.
المزاوجة بين المعارف المحلية والبحث العلمي لاستدامة المجتمعات المحلية
وتبرز هذه البدائل عبر إدخال سلالات حيوانية أكثر مقاومة للجفاف، وتعديل مسارات التنقل، إلى جانب استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتنويع سبل العيش.
كما تسلط الدراسة الضوء على أهمية الجمع بين المعرفة المحلية والنهج العلمي، وتدعو إلى نهج متكامل يشمل المجتمعات والسياسات الوطنية والتعاون الدولي لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
كما تبرز الدراسة بحسب الباحثة مشياش، الدور الحاسم لدمج المعارف المحلية مع البحث العلمي من أجل تطوير إستراتيجيات فعالة للتكيف، كما تدعو إلى نهج شامل متعدد الأطراف، يضم المجتمعات المحلية، وتعديلات على السياسات الوطنية، إضافة إلى تعاون دولي يكون كفيلا بتعزيز قدرة الصمود أمام التأثيرات المستمرة لتغير المناخ.
وينتهي البحث إلى أن بقاء واستدامة هذه المجتمعات التقليدية، يعتمد على قدرتها على التكيف والابتكار ومواجهة التحديات التي يفرضها المناخ المتزايد في عدم استقراره.
إ.زياري

أطلقت الشابة هديل زروال، تطبيقا بيئيا ذا خصوصية زراعية، حيث يعنى بمتابعة وضعية المحاصيل في ظل اضطرابات المناخ ويقدم إخطارات بشأن التحولات التي تصيب الزرع.
لينة دلول
وأوضحت المبتكرة للنصر، أن agri dz مزرعتي، هو أول نظام برمجة جزائري، لمتابعة المحاصيل الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم البيانات الجغرافية، مؤكدة أن للمشروع تأثيرا مباشرا على التنوع البيولوجي، خاصة في المواقع التي تمت إعادة تهيئتها ومتابعتها دوريا، مع عودة بعض النباتات البرية المحلية وكذا الطيور الصغيرة إلى بعض النقاط التي أعيد تشجيرها.
وحسبها، فإن التنوع البيولوجي لا يعود بالغرس فقط، بل عبر المتابعة العلمية الدقيقة التي تضمن بقاء النبات على قيد الحياة واستقراره.
وأوضحت زروال، أن مشروعها يتمثل في مؤسسة ناشئة تقدم خدمات مبتكرة في مجال حماية الأراضي، أبرزها الأشغال الغابية، والفلاحية وإعادة تأهيل الأراضي، والتهيئة الريفية.
المعرفة العلمية لاستعادة التوازن البيئي ودعم القطاع الفلاحي
وأوضحت الشابة صاحبة 25 ربيعا، وخريجة ماستر 2 تهيئة ريفية من كلية علوم الأرض والكون والجغرافيا والتهيئة العمرانية، أنها تحمل وسم لابل مشروع مبتكر و مؤسسة ناشئة، وأن الفكرة انطلقت من إدراكها بأهمية الجمع بين المعرفة العلمية والعمل الميداني من أجل استعادة التوازن البيئي ودعم القطاع الفلاحي الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية المحلية.
وأشارت زروال إلى أنها لاحظت خلال سنوات دراستها أن العديد من المناطق تعاني من تدهور الغطاء النباتي، وضعف خصوبة التربة وتأثيرات الحرائق، إضافة إلى نقص التوجيه العلمي للفلاحين.
وقد قررت كما قالت، أن تبادر لتوفير حلول شاملة لإعادة التشجير وتنويع الغطاء النباتي، وكذا حماية الأراضي الزراعية من التدهور ودعم المشاريع الفلاحية عبر دراسات علمية لتهيئة المساحات الخضراء والغابية، ومرافقة الفلاحين بخدمات تقنية ورقمية لتحسين الإنتاج عبر تطبيق agri dz مزرعتي. موضحة، أن المشروع يهدف إلى بناء توازن بين المجال الغابي والقطاع الفلاحي، باعتبارهما عنصران متكاملان داخل المنظومة البيئية. ومؤكدة أن المشروع اليوم، يعمل ضمن مؤسسة ناشئة خاصة رسمية تجمع بين حماية الأراضي والخدمات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والخدمات الميدانية.
وبخصوص الأشغال الغابية التي يقدمها فريق المشروع، فهي بحسب المسؤولة عنه، التشجير وإعادة التأهيل والوقاية من الحرائق. أما في الجانب الفلاحي، فيتم العمل على تهيئة الأراضي، والغراسة، ومتابعة المشاريع الزراعية.
وفيما يخص أعمال التهيئة الريفية، فإنه يتم حسبها، إعداد الدراسات الطبوغرافية والمجالية، لأن مؤسستها الناشئة بيئية وفلاحية وتعتمد على الدمج بين الجانب الميداني والعلمي والرقمي.
وأوضحت المبتكرة، أن هذا الهيكل يمنح مشروع المؤسسة قدرة متقدمة على تقديم خدمات دقيقة، وتنفيذ مشاريع تواكب احتياجات القطاعين الغابي والفلاحي.
هذه هي المناطق التي استهدفناها في المشروع
وخلال تجسيد المشروع، قالت زروال، بأنه تم استهداف المناطق التي تجمع بين الحساسية الغابية والأهمية الفلاحية في المرحلة الأولى وذلك في المرحة الأولى، مع التركيز على الأراضي الممتدة في المدن ذات الطابع الفلاحي والزراعي، وتلك التي تواجه احتمالات أكبر للتعرض للحرائق وتعرف تدهورا في تربتها، وتضم مساحات زراعية تحتاج إلى إعادة تهيئة، أو تملك إمكانيات لتنفيذ مشاريع غرس ناجحة. موضحة، بأن الاختيار كان مبنيا على تحليل علمي يشمل العوامل المناخية، ونوعية التربة، وطبيعة التضاريس، إضافة إلى حاجة السكان والفلاحين لخدمات مرافقة.
وأضافت صاحبة المشروع، بأنها فضلت الانطلاق من المناطق التي يمكن أن تحدث فيها العمليات الميدانية أثرا واضحا، سواء في استرجاع الغطاء الغابي، أو تحسين الأداء الفلاحي الذي يخدم حماية الأراضي.
وتابعت، بأن ما أثر فيها خلال سنواتها الجامعية ونزولها للميدان بعد ذلك، أنها شاهدت كيف تفقد الغابات مساحاتها تدريجيا بسبب الحرائق والتدهور، خاصة حرائق القالة لولاية الطارف 2021، ومجموعة كبيرة من الولايات المتضررة ما انجرت عنه خسائر في المحاصيل الزراعية ناهيك عن عجز بعض المناطق عن استرجاع غطائها النباتي لغياب المتابعة العلمية.هذه المشاهد المتكررة جعلت زروال، تؤمن بأن حماية الغابة والمحاصيل الزراعية ليست مجرد عملية غرس، بل منظومة كاملة تبدأ بالتشجير وتستمر بالمتابعة الدقيقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وحسب المتحدثة، فإن هذه التجربة الشخصية دفعتها إلى أن تركز على دمج التقنيات المتقدمة مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لضمان نجاح الغرس واستمرار الأشجار في النمو.
الذكاء الاصطناعي في خدمة البيئة
وأضافت المتحدثة، أن التشجير ليس مجرد عملية زرع أشجار، بل مشروع بيئي وتنموي شامل من أهم فوائده حماية التربة من الانجراف والتدهور، تحسين المناخ المحلي وزيادة الرطوبة، فضلا عن تقليل درجات الحرارة ومكافحة ظاهرة «الجزر الحرارية»، ودعم النشاط الفلاحي عبر تحسين جودة التربة والغطاء النباتي، زيادة على توفير فرص عمل في المناطق الريفية تعزيز جمال المدن وتحسين جودة الحياة لكن يبقى الأهم أن التشجير الحقيقي لا ينجح دون متابعة، وهذا ما يغيب أحيانا عن الفهم العام.
كما أوضحت، أن الأشجار تحتاج إلى مراقبة ميدانية وتقنية منذ الأشهر الأولى، وهنا يأتي دور الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي. مؤكدة أن دورها كمختصة في المجال هو تتبع صحة النمو والرطوبة والمخاطر التي قد تواجه التشجير.
وذكرت المتحدثة، أن التشجير يعد أحد أهم أساليب التخفيف من آثار التغيرات المناخية، لأنه يمتص ثاني أكسيد الكربون ويرفع نسبة الأوكسجين، كما يثبت التربة ويحافظ على رطوبتها، ويكون مناطق عازلة تقلل من انتشار الحرائق، زيادة على دوره في إعادة بناء التوازن المائي والبيئي. لكن الجيل الجديد من برامج التشجير يحتاج إلى متابعة تكنولوجية، لأن الحرائق أصبحت أكثر انتشارا وتعقيدا كما أوضحت.وأشارت زروال، إلى أن الاستشعار عن بعد يسمح برصد تغير لون الأشجار، وانخفاض الرطوبة، وتدهور التربة، وجرد المساحات المهددة وآثار الحرائق بعد وقوعها.
أما الذكاء الاصطناعي فيساعد على تحليل هذه البيانات بسرعة ودقة واقتراح التدخل المناسب، وبذلك يصبح التشجير منظومة وقاية واستشراف.
نواجه نقصا في الوعي بأهمية المتابعة بعد الغرس
وحسب الشابة، فإن المواطن صار يملك وعيا جيدا بأهمية الغرس والتشجير، وأصبح يشارك في الحملات التطوعية بكل حماس رغم نقص الوعي بأهمية المتابعة بعد الغرس.وقالت، بأن من بين المفاهيم الخاطئة التي تصححها دائما، الاعتقاد بأن دور الفرد ينتهي بعد زرع الشتلة، الحقيقة أن الأشجار تحتاج إلى متابعة دقيقة خلال السنة الأولى على الأقل، وإلا تفشل العملية بالكامل.
ومن أبرز المفاهيم الخاطئة التي تحاول تصحيحها كذلك، الاعتماد فقط على المبادرات الشعبية دون وجود مختصين، لأن المتابعة يجب أن تتم بواسطة خبراء في التربة والغطاء النباتي والاستشعار عن بعد، لأن نجاح العملية يعتمد على التقييم العلمي المستمر، وهذا بالضبط هو الدور الذي تقوم به في مؤسستها كما شرحت.
ونوهت المبتكرة إلى ضرورة الفصل بين الفلاحة والغابات لأن الغطاء النباتي هو أساس التنمية الريفية والفلاحية، وهو ما يتم بحسبها العمل على ربطه من خلال الدراسات التقنية والرقمية.
البيانات ضرورة قصوى للتعامل مع اضطراب المناخ
ومن التحديات التي تواجه عمليات التشجير في الميدان تذكر المتحدثة شح المياه في العديد من المناطق، وهو ما يجعل نجاح الغرس مرتبطا باختيار الأنواع المناسبة وبأنظمة ري عقلانية. زيادة على ذلك، فإن نوعية التربة التي تختلف من منطقة لأخرى، وقد تتطلب معالجات أولية أو تقنيات خاصة للاستصلاح، بالإضافة إلى تأثير العوامل المناخية مثل موجات الحر والرياح القوية، وكذا غياب المتابعة لدى بعض المبادرات التطوعية، وذكرت زروال، الحاجة إلى بيانات دقيقة حول الرطوبة والتربة والغطاء النباتي، وهو ما يعالجه المشروع عبر الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي.
ومن بين أهم العمليات التقنية التي تقوم بها صاحبة المؤسسة دراسة المناطق لاختيار أفضل الأصناف حسب طبيعة خصائص الأرض، وذلك قبل عملية التشجير حتى لا تكون هناك خسائر.كما يعتمدون في مؤسستها، على النباتات المحلية بشكل أساسي، لأنها أثبتت قدرتها على التكيف مع المناخ الجزائري، ومقاومة الجفاف والحرائق.ونوهت صاحبة المشروع، بأن اختيار الأنواع يتم وفق معايير علمية تشمل طبيعة التربة، ودرجة ملوحتها، ومعدل الأمطار، والرياح، والمناخ ومستوى الرطوبة، وقابلية النبات لتحمل جفاف الشبكة الهيدروغرافية والارتفاعات، والانحدارات ودورها البيئي في تثبيت التربة وتحسين التنوع البيولوجي.
أصناف تحدد نجاح المشاريع الغابية والفلاحية
ومن بين الأنواع النباتية التي اعتمدت عليهم زروال، الأشجار الحرجية المحلية، والنباتات المقاومة، وبعض الأصناف المثمرة المناسبة للمناخ الجاف، إضافة إلى نباتات تحسين التربة.وأوضحت، بأنها لا تنجز أي عملية غرس دون الاستناد إلى منهجيات علمية وتقنيات احترافية، من بينها تحديد المسافات المناسبة بين الأشجار حسب النوع والمنطقة، واعتماد تقنيات الري بالتنقيط في المناطق الفلاحية، واستخدام الحفر العميقة لحماية الجذور وتخزين المياه، زيادة على دراسة الطبوغرافيا لتحديد اتجاهات الجريان ومصادر التعرية واستعمال تقنيات الاستصلاح لتحسين التربة قبل الغرس، بالإضافة إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لرصد تطور الأشجار وتحليل المشاكل المحتملة. وهذه المنهجية العلمية هي حسبها، ما يجعل التشجير فعالا ومستداما لا مجرد نشاط رمزي.
هكذا تحصلت على وسم مشروع مبتكر
وقالت صاحبة التطبيق للنصر، إن مبادرة «عين مليلة الخضراء» سنة 2024، أثرت في نمو فكرة مشروعها، وخصوصا وأنها مبادرة تطوعية شاركت فيها من جانب التشجير والتهيئة الميدانية، وكذا باعتماد مراقبة تقنية باستعمال الخرائط والتحليل المكاني.
وقد كانت التجربة ناجحة ومست الوعي البيئي لدى الشباب، كما أظهرت أهمية الجمع بين العمل التطوعي والمتابعة العلمية.
أما النموذج الثاني، فيخص متابعة أراض فلاحية في منطقة واد العثمانية أثناء تطوير النموذج الأولي للتطبيق، أين تمت مرافقة فلاحين في المنطقة، ومتابعة حالة التربة ومراحل النمو من الزرع إلى الحصاد ورصد الرطوبة والمؤشرات، وإنتاج الخرائط الطبوغرافية، ناهيك عن تتبع المحصول عبر الاستشعار عن بعد وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وهو ما سمح للفلاحين بتحسين إنتاجهم بشكل واضح.
وهذه النتائج القوية مكنت مشروعها كما أخبرتنا، من الحصول على علامة وسم مبتكر Label Innovant من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، وبمصادقة 12 وزارة، وهو ما يؤكد القيمة العلمية والتطبيقية للعمل.
أهدف إلى بناء ثقافة بيئية
وقالت هديل زروال، إنها تحرص على بناء ثقافة بيئية حقيقية لدى الأطفال والشباب، لا تقتصر على يوم الغرس فقط بل تمتد إلى فهم أهمية المتابعة وحماية الأشجار بعد زرعها، وذلك من خلال تنظيم ورشات توعوية ميدانية تعرف الأطفال بأهمية الغابات والغطاء النباتي، و أنشطة تطبيقية تشرك الشباب في الغرس، ثم تبين لهم كيف تتم مراقبة الأشجار عبر التكنولوجيا.
وتحدثت أيضا عن استعمال صور خرائط الاستشعار عن بعد لشرح كيف تتغير الغابات بمرور الوقت، مع تعليمهم مبادئ بسيطة للذكاء الاصطناعي وكيف يستخدمه المختصون لرصد صحة الأشجار وإظهار تأثير كل شخص على بيئته بطريقة عملية وليس مجرد نظريات.
وقالت، إنه وبعد إطلاق المشروع لاحظت أن الكثير من المشاركين كانوا في البداية يركزون على يوم الغرس فقط، أما بعد مشاركتهم في أيام التشجير ومعايشتهم لمرحلة المتابعة العلمية عبر الخرائط والتحليل الرقمي، صاروا يدركون أن نجاح الشجرة لا يرتبط بالزرع فقط، بل بالسقي والحماية، والمراقبة، ورصد المؤشرات الحيوية.
كما لاحظت محدثتنا، زيادة الوعي بضرورة عودة الفلاح أو المتطوع إلى الموقع بعد أسابيع لمتابعة الشجرة، وتراجع ظاهرة الغرس العشوائي واحترام أكبر لتوصيات المختصين حول اختيار الأنواع، والتباعد مع اهتمام الشباب بمتابعة صور مناطقهم عبر صور الأقمار الصناعية التي تعرض عليهم.
نتائج مباشرة على التنوع البيولوجي
وأوضحت المتحدثة، أن المشروع كان له تأثير مباشر على التنوع البيولوجي، خاصة في المواقع التي تمت إعادة تهيئتها ومتابعتها دوريا لأنه عندما تزرع الأنواع المحلية المناسبة، ثم تراقب الأشجار باستعمال الاستشعار عن بعد لقياس الرطوبة وصحة الغطاء النباتي، فإن المنطقة تبدأ تدريجيا في استعادة توازنها حسب تأكيدها.
كما لاحظت، عودة بعض النباتات البرية المحلية التي تظهر تلقائيا عندما تتحسن التربة، مع ارتفاع نسبة الغطاء الأخضر في الصور الجوية بعد عدة أشهر، وظهور الحشرات النافعة التي تلعب دورا كبيرا في النظام البيئي.
ورصدت الشابة أيضا، عودة الطيور الصغيرة إلى بعض النقاط التي أعيد تشجيرها، خصوصا بعد تحسن الكثافة النباتية. موضحة بأن التنوع البيولوجي لا يعود بالغرس فقط، بل عبر المتابعة العلمية الدقيقة التي تضمن بقاء النبات على قيد الحياة واستقراره.
نقدم خدمات موجهة للفلاحين
وقالت زروال، بأن شركتها تقدم خدمات موجهة أساسا للفلاحين وللشباب المستثمر، بهدف تمكينهم من الاستثمار الصحيح والناجح اعتمادا على أدوات دقيقة وحلول تقنية موثوقة. موضحة، أن هذه الخدمات تساعدهم على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات علمية، سواء في اختيار المحاصيل، أو متابعة الأراضي، أو تنظيم العمليات الفلاحية الحديثة. وحسبها، فإن الخدمات تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للغرف الفلاحية، ومحافظات الغابات، والهيئات البيئية، والبلديات، والولايات، باعتبارها جهات تعتمد على البيانات الميدانية والتحليل الجغرافي في التخطيط والمتابعة.
وأضافت المتحدثة، بأن حلول المشروع تشكل عنصرا أساسيا في تهيئة الأرياف وتطوير المدن، لأنها تساهم في تحسين إدارة الأراضي، وترشيد الموارد، ودعم المشاريع التنموية القائمة على معطيات دقيقة.

التقرير النهائي لمؤتمر الأطراف 30
«العصر الجديد من التنفيذ» التزامات وخطط جديدة لحماية الكوكب
أنهت الدول المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف 30 «كوب30» ببيليم البرازيلية عملها، وأغلقت ملفاتها بملخص نهائي للمفاوضات التي جمعت قادة العالم بغابات الآمازون بتعهدات والتزامات جديدة، بينما تم رفع العديد من الأرقام في شكل مبالغ يراهن على فعاليتها في التكيف المناخي وأخرى لحماية الغابات، وخطة صحية لمساعدة ملايين الأشخاص عبر العالم سميت بـ»العصر الجديد من التنفيذ».
بعد أكثر من 10 أيام من مفاوضات ماراتونية، وشد وجذب حول قضايا المناخ الشائكة، أصدر مؤتمر الأطراف 30 تقريره النهائي، ووفقا لبيان رسمي صادر عن المؤتمر، فإن مجريات بيليم البرازيلية قد أظهرت أن العالم ينتقل من الطموح إلى العمل، وذلك من خلال عمل أسبوعين من المفاوضات، أين شكلت بيليم منصة لتسريع التنفيذ وتوسيع الحلول، وكذا لتجديد الثقة في التعددية وتركيز العمل المناخي على حياة الناس اليومية.
وبالنظر إلى جملة المحاور الرئيسية التي اجتمع حولها المفاوضون من دول ومنظمات دولية متخصصة، فقد تم التركيز على ضرورة التشغيل السريع لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، إلى التقدم في التكييف وتمويل الغابات وأنظمة الغذاء ومبادرة التغير العالمية، أين أظهر مؤتمر الأطراف 30 تحولا متزايدا من التفاوض إلى التنفيذ، وذلك من خلال أجندة العمل التي تبناها المفاوضون.
تسريع الحلول
يقدم تقرير نتائج العمل المناخي العالمي نظرة شاملة على اتساع وعمق العمل عبر أجندة العمل لتسريع التنفيذ، حيث قامت رؤية جديدة للعمل المناخي العالمي بتبسيط 480 مبادرة إلى 117 خطة لتسريع الحلول بحيث تتماشى مع الجرد العالمي الأول.
ويركز المحور الأول على انتقال الطاقة والصناعة والنقل، بحيث تقدم الشركاء بخطة استثمارية بقيمة 1 مليون دولار لمضاعفة القدرة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
ويتعلق المحور الثاني برعاية الغابات والمحيطات والتنوع البيولوجي أين وفت الدول مبكرا بتعهد ملكية الأرض البالغ 1.7 مليار دولار، والذي جدد بمبلغ 1.5-2 مليار دولار، وحماية مسبقة على مساحة 160 مليون هكتار، مع تدفق 20 بالمائة من الأموال مباشرة إلى الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وخصص المحور الثالث لتحويل أنظمة الزراعة والغذاء، ويفيد البيان الختامي لكوب 30، أنه قد تمت تعبئة أكثر من 9 مليارات دولار لبناء مناظر طبيعية متجددة، وصلت إلى 12 مليون مزارع واستعادة 210 ملايين هكتار.
أما المحور الرابع، فهو الخاص بالمدن والبنية التحتية والمياه، وكشفت الأرقام عن تقليص المدن لـ850000 طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2024، بحيث تهدف منصات التمويل الجديدة للوصول إلى 200 مدينة بحلول عام 2028.
خطة صحية ودعم الشباب لقيادة راشدة
ولأن التنمية البشرية والاجتماعية كانت من بين المحاور الرئيسية للمفاوضين، فقد تم إطلاق خطة عمل بيليم الصحية بالتزام بمبلغ 300 مليون دولار، بحيث تستفيد مبادرات سباق المرونة 437.7 مليون شخص حول العالم.
ويتعلق المحور السادس والأخير بمن أسماهم التقرير بالممكنين والمسرعين، أين أعلن شركاء «فيني» عن مليار دولار من خطوط أنابيب التكيف القابلة للاستثمار بحلول عام 2028، بما في ذلك 500 مليون دولار من وكالات متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية.
كما أعد مشروع «موتيراو» العالمي رؤية تركز على الواقع، مع إطلاق تقرير الجرد الأخلاقي العالمي ودفع «التغلب على الحرارة» الذي قدم حلولا لحماية 3.5 مليار شخص.
وشاركت المجتمعات الأصلية والتقليدية إستراتيجيات التكيف والطاقة المتجددة المستندة إلى المعرفة القديمة، بينما جمع منتدى المناخ الذي يقوده الشباب قادة شباب من أكثر من 100 دولة، مقدما دعوات للعدالة وتمويل المناخ، والمرونة التي يقودها المجتمع. إيمان زياري

الناشط هشام بوعيشة
النشــــاط البيئـــــي في حاجـــــة إلى تأطيــــر
يعتبر الناشط البيئي، هشام بوعيشة، من الوجوه الفاعلة على المستوى المحلي بقسنطينة في المجال، حيث يقول في حديثه مع النّصر إنّ لجدّه تأثير على حبّه للبيئة، معتبرا أنّ هذا النشاط أصبح يستقطب طاقات شبابية وأنّ الانخراط في الجمعيات والنوادي يضمن الاستمرارية وينظّم النشاط، حيث يرى أن التطوّع الفوضوي والحديث بلغة الأرقام في مجال البيئة يخلق مشكلة.
ويعدّ، هشام بوعيشة، ابن حي الإخوة عباس «واد الحد» أحد الناشطين المتطوّعين المعروفين بقسنطينة في مجال البيئة، حيث كان حريصا على الحضور في مبادرات الغرس والتنظيف المتعلقة بالبيئة التي تنظّم على المستوى المحلي وكذا المشاركة في غرس ثقافة العناية بالبيئة مع تلاميذ المدارس، أحب هذا المجال منذ الصغر مثلما قال في حديثه مع النّصر بعد اعتياده مرافقة جدّه في نشاطاته المتعلقة بغرس وزبر الأشجار والاعتناء بالبيئة ما أسهم في نمو بذرة حب المجال بداخله، وانضم، بوعيشة، إلى سلك الجيش وبعد تقاعده تفرّغ أكثر لهذا النشاط، حيث انضم إلى جمعية حماية الطبيعة والبيئة سنة 2006.
ويرى المتحدّث أنّ الانخراط في الجمعيات البيئية خطوة مهمة لممارسة التطوّع وممارسة هذا النشاط، حيث تتيح له إمكانية التطوّر والتكوّن وأيضا اكتساب خبرات في الميدان بالاحتكاك بأناس لهم نفس الاهتمامات والانشغالات، ويعتقد أنّ العمل في إطار جمعوي يمنح الحماية والطابع القانوني للممارسة خاصة وأنّ التطوّع في بعض الأماكن يستلزم تراخيص من طرف الجهات الأمنية، البلدية أو سونلغاز مثلا، كذلك التطوّع والنشاط في المجال البيئي يحتاج إلى تنسيق، قواعد وأنظمة ينبغي العمل بها بعيدا عن العشوائية والفوضى حسب المتحدث، حيث لفت إلى وجود فئة من الشباب تفكّر بأنّها ما دامت متطوّعة في عمل خيري مفيد فلا اعتبارات أو نقاشات ينبغي لها أن تطرح حول كيفية التنفيذ.
ولفت المتحدّث إلى أنّ التطوّع والنشاط في المجال البيئي أصبح يرتبط بالكم وهو ما يمثّل إشكالية حيث يتحدث كثير من النشطاء والمتطوعين بلغة الأرقام غير أنّ العملية حسبه لا ينبغي أن تقاس بعدد الأشجار التي تغرس، إذ يجب التفكير في عوامل أخرى تخص القدرة على صيانة هذه الأشجار والإمكانيات المتوفرة لذلك والحرص على الغرس بطريقة سليمة وصحيحة واختيار الأماكن المناسبة وكذا الأصناف الملائمة، حيث أن إشكالية الغرس لأجل الغرس من بين القضايا التي ينبغي النظر فيها فغرس أشجار على سبيل المثال في مؤسسة تربوية دون دراسة حيث يمكن لجذورها أن تسدّ شبكة الصرف الصحي أو تؤثر على شبكة الكهرباء ما يتسبب في مشاكل أكبر كان يمكن تفاديها بالتنسيق مع مختلف الفاعلين ودراسة العملية قبل تنفيذها، كما أن رفع كيس من القمامة ووضعه في مكان مناسب أفضل من رفع 20 كيسا بطريقة عشوائية والتقاط صور معها، مشيرا إلى أنّ جانب التثقيف والتوعية من الجوانب التي يعملون على ترسيخها بين المهتمين بالمجال. وأضاف أنه ينبغي اتباع منهجية عمل مدروسة على غرار القيام بعملية الغرس في مواقيتها في فصل الشتاء وكذلك صيانة الأشجار على طول العام ومتابعة حالتها باستمرار طيلة حوالي 5 سنوات التي تلي الغرس من زبر والسقي في الفترة الليلية وحمايتها من الأمراض بالأدوية ومنحها فيتامينات الوقاية من التجذر وبعد مرور هذه السنوات يمكن الاكتفاء بعملية الزبر فقط. ورغم أنّ المستوى التعليمي لبوعيشة متواضع حيث يحوز على مؤهل التاسعة متوسط إلا أنّه راكم خبرات معرفية جراء سنوات من المشاركة والتجارب التي خاضها في المجال واحتكاكه بالمختصين بالإضافة إلى حرصه على البحث، حيث يقول إنّه يمكن للفرد حتى التعلم من تلاميذ المدارس الذين يمتلكون روح المبادرة ونوعا من البراءة لحماية البيئة كما أن الرسالة تمرّ بينهم بسلاسة، وذكر المتحدّث أنّ التوفيق بين التطوّع والحياة الشخصية جزئية مهمة في هذا المجال، حيث يرى أنّ التوسّع في هذا النشاط لا ينبغي أن يكون على حساب الاهتمام بأسرته على سبيل المثال والتزاماته الشخصية، وهو المبدأ الذي يسعى إلى تطبيقه شخصيا بالتوفيق بين الجانبين، كما أنّ العناية بالبيئة ينبغي أن تنطلق من الحي والمحيط القريب للفرد ثم العمل على التوسع تدريجيا. وأردف المتحدّث أنّ الثقافة البيئية توسعت نوعا ما بما يعكس تطورا في الفكر والوعي، حيث لم تعد تقتصر المبادرة في هذا النشاط على فئة كبار السن مثلما كان سابقا بل أصبحت هناك طاقات شبانية، كذلك الفتيات والأطفال رغم أنها ليست بالكم المراد، مضيفا أنّ وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا في هذا الجانب كما أن هذا النشاط يحتاج إلى الاستمرارية التي تأتي حسبه من خلال العمل في شكل مؤطّر.
إسلام. ق

l تحويـل النفايـات من عـبء بيئـــي إلى مـورد اقتصــادي
عرفت فعاليات الطبعة التاسعة من صالون الجزائر الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات (ريفاد 2025)، التي اختتمت السبت بعد ثلاثة أيام غنية بالأنشطة المتنوعة، التي جمعت أكثر من 100 عارض من مختلف الولايات والمجالات الصناعية والبيئية والتكنولوجية، في منصة فريدة ضمت الشركات العمومية والخاصة، المؤسسات الناشئة، الجمعيات البيئية، والطلبة الجامعيين المهتمين بالابتكار والاقتصاد الأخضر.
روبورتاج: عبد الحكيم أسابع
ويكتسي هذا الصالون أهمية استراتيجية على المستويين البيئي والاقتصادي، حيث يعكس التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، ويؤكد على ضرورة تحويل النفايات من عبء بيئي يشكل تهديدا على صحة الإنسان والبيئة، إلى مورد اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل وتحفيز البحث العلمي والابتكار المحلي، كما يمثل الصالون منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم السياسات الوطنية الهادفة إلى الاقتصاد الدائري، الذي أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة في الجزائر.
رسكلة الألمنيوم.. منتجات صناعية
مستدامة

قدمت ''شركة عمار شرق غرب ميتال''، في طبعة هذه السنة لصالون الجزائر الدولي لرسكلة وتثمين النفايات نموذجا رائدا في رسكلة الألمنيوم على المستوى الوطني، حيث أوضح مسير الشركة، معمر هدار، للنصر، أن الشركة التي تأسست سنة 2020، تعتمد على جمع النفايات المعدنية من مختلف الولايات الجزائرية عبر شبكة متكاملة من الموردين المحليين، لتحويلها إلى منتجات صناعية قابلة للاستخدام مثل مقابض الأبواب والخردوات المعدنية الصغيرة، التي تدخل في الصناعات الميكانيكية والبناء والصناعات المنزلية. ويُعتبر هذا النشاط الاقتصادي والبيئي محركا متعدد الأبعاد، فهو يقلل من تراكم النفايات المعدنية في المدن ويحد من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالتخلص العشوائي للنفايات، ويحد من اعتماد البلاد على استيراد المواد الخام، ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، تُمثل تجربة الشركة خطوة نوعية نحو تطبيق الاقتصاد الدائري في الجزائر، حيث يتم تحويل المواد المهملة إلى منتجات قابلة للتسويق، مع إمكانية إعادة تدويرها لاحقاً لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية.
رسكلة الإطارات المطاطية.. عنوان آخر للاستقلالية الصناعية
تجربة رائدة أخرى رأت النور في ولاية عين الدفلى، قدمتها "شركة إيرل جات قران"، التي أسست بدورها نموذجا متقدما في مجال رسكلة الإطارات المطاطية، حيث تستخرج من هذا النوع من النفايات، أكثر من 600 مادة قابلة للاستخدام الصناعي في قطاعات متعددة. وأوضح صاحب الشركة، تومي لخضر، أن هذه المواد تُستخدم في صناعة لوحات الفرامل، مواد البناء، قطع غيار السيارات، وأرضيات القاعات الرياضية والملاعب، مما يحقق قيمة مضافة للنفايات المطاطية التي كانت في السابق مصدر تلوث بيئي.
وأشار ذات المسؤول إلى أن المشروع ساهم في خفض فاتورة الاستيراد، من خلال إنتاج محلي للمواد التي كانت تُستورد، وهو ما يعزز الاستقلالية الصناعية للجزائر في هذا القطاع الحيوي، كما يتيح المشروع – يضيف محدثنا - تقليل تراكم الإطارات في البيئة، ما يحمي المواطن من الأخطار المحتملة للحرائق والانبعاثات السامة، ويعزز السلامة البيئية.
الرسكلة الورقية وتحويل النفايات
الصناعية

وفي مجال رسكلة الورق والكرتون، عرضت شركة "طونيك صناعة"، الشهيرة باسم ''تونيك أومبالاج''، المعروفة بنشاطها لأكثر من ثلاثة عقود تقوم اليوم في وحداتها بتحويل الورق المسطح والكرتون إلى منتجات متعددة مثل قوالب البيض، الورق الصحي، وعلب التغليف، مع معالجة يومية تتراوح بين 30 و40 طنا من النفايات الورقية. وأكد المدير العام، حسان حمامو ، لـ النصر، أن المشروع لا يقتصر على تقليل حجم النفايات فقط، بل يسهم أيضا في تحقيق استفادة اقتصادية من المواد المهملة، وتوفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، مع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في مجال التغليف والورق، ما يجعل من هذه التجربة الرائدة، نموذجا ناجحا لكيفية توظيف الابتكار الصناعي في معالجة النفايات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة. من جهته عرض مجمع '' جيباك '' العمومي حلولا مبتكرة ومستدامة في مجال استرجاع وإنتاج وتحويل منتجات الورق والكرتون، من خلال تثمين المواد المعاد تدويرها والمساهمة في حماية البيئة، وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد دائري، فعال ونظيف، من خلال شركته الفرعية '' بابيراك ''.
"ملاط تلبيس"
مشروع صديق للبيئة يحد من الانبعاثات
و يوفر الطاقة

وفي سياق تعزيز الابتكار البيئي، قدم خريجان من الجامعة الجزائرية، وهما المهندسان المعماريان، عبد الغافور بورصاص ودغموم هيثم، المنتسبان إلى حاضنة الأعمال الجامعية، مشروعهما المبتكر الذي يهدف إلى تطوير ملاط تلبيس مستدام، يقلل استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة، ويخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 بالمائة.
ويقوم المشروع – حسب الشروحات المقدمة لنا من قبل صاحبي المشروع - على تعديل ملاط التلبيس التقليدي، ليصبح أخف وزنا وأكثر عزلا حراريا، وهو ما يسهم في تحسين الكفاءة الطاقوية للمباني ويحد من التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام مواد البناء التقليدية، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة في الإنتاج وتُصدر انبعاثات كربونية مرتفعة.
وقد حصل الفريق على تمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 2 مليون دينار لدعم التجسيد العملي للمشروع، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الابتكار في قطاع البناء المستدام.
قارورات البلاستيك و بقايا الأقمشة لإنتاج ألياف البوليستر
وفي مجال البناء أيضا، قدمت شركة ''أس بيا الفتح"، نموذجا مبتكرا آخر، من خلال إعادة تدوير قارورات المياه البلاستيكية، وبقايا الأقمشة لإنتاج ألياف البوليستر التي تستخدم في العزل الحراري ومواد البناء، مما يتيح خفض الاعتماد على المواد المستوردة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق منتجات محلية ذات جودة عالية.
وأوضح مسؤول المشتريات، أيمن بن وسار شمس الدين، لـ النصر، أن هذه المبادرة تسهم في تحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات صناعية قابلة للاستخدام، وتحد من التلوث البيئي، مع دعم البحث العلمي لتطوير تقنيات مبتكرة في مجال المواد المستدامة، ما يجعل هذا المشروع مثالا ناجحا على الابتكار الصناعي البيئي، الذي يجمع بين الاستدامة الاقتصادية والحماية البيئية.
معالجة النفايات الخطيرة والطبية حماية للبيئة والصحة
وشكلت مشاركة عدة شركات في طبعة هذه السنة من الصالون فرصة، لإبراز مجال نشاط هام مكن من تخليص البيئة والمحيط وحتى المواطن الجزائري من عدة أخطار، ويتعلق الأمر بشركات مثل '' أن سي سي '' و "سينتاك"، ''ترانسكو''، ''إكفيرال''، و''قرين سكاي'' و '' التي قدمت حلولا متقدمة لمعالجة النفايات الخطيرة والطبية، باستخدام تقنيات متنوعة تشمل الحرق، التعقيم، والتحويل الصناعي.
وفي هذا الصدد قدمت شركة "أن سي سي أنفيرونمنت" صورة واضحة عن مكانتها كأحد الفاعلين الرئيسيين في قطاع معالجة النفايات في الجزائر، بفضل خبرة تمتد منذ تأسيسها سنة 2012.
وأوضح المدير العام للشركة، عبد الفتاح حمود لـ النصر، أن المؤسسة طورت منظومة متكاملة تبدأ من تجميع النفايات ونقلها إلى مواقع المعالجة، مرورا بعمليات الرسكلة والتثمين، خصوصا فيما يتعلق بالنفايات الخاصة والمواد الخطرة كالنفايات الكيميائية، وتتميز الشركة بفريق عمل عالي الكفاءة، تلقى تكوينا متخصصا يغطي مختلف مراحل السلسلة، مع توفير تجهيزات حماية متطورة تضمن أعلى معايير السلامة المهنية.
وشدد المتحدث على أن التعامل مع المواد الكيميائية يخضع لقواعد صارمة، إذ لا يمكن رسكلة أو إعادة استعمال الحاويات التي تنقل هذه المواد حمايةً للصحة والبيئة، بل يجب تخصيصها دائمًا لنفس نوع الحمولة. وتعمل الشركة انطلاقا من مقرها ببرج الكيفان على رسكلة جزء كبير من النفايات داخل الوطن، فيما يتم تصدير الكميات غير القابلة للمعالجة محليًا نحو أوروبا، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وكشف السيد حمود، عن تطور جديد تمثل في طلبية واردة من شركة إسبانية متخصصة في صناعة البلاستيك، ما سيسمح بتحويل مواد كانت تُطرح نسبة كبيرة منها في السابق في مراكز الردم التقني إلى مورد اقتصادي يساهم في تقليص الضغط على هذه المراكز. وأكد أن الشركة تتجه إلى توسيع نشاطها نحو التصدير وتنمية تجارة خارجية في مجال النفايات، مع التأكيد على ضرورة إشراك الخبراء الميدانيين في كل خطوة تتعلق بتنظيم القطاع أو إعداد القوانين المؤطرة له. كما عرضت شركة ''سينتاك'' حصيلة تجربتها في التعامل مع النفايات الخاصة والخطيرة في مجالات الأدوية والمستشفيات والمخابر الصناعية، مع ضمان معايير السلامة البيئية والصحية.
و أبرزت شركة ''ترانسكو'' الخاصة، والمتخصصة في معالجة النفايات الطبية والخطيرة تجربتها هي الأخرى بقدرة معالجة تصل إلى 250 كلغ/ساعة، وهي تسعى اليوم لتوسيع نشاطها في الجنوب الجزائري لتغطية كافة مناطق البلاد. وفي المجال ذاته تركز شركة '' إكفيرال'' على حرق المواد الصيدلانية والنفايات الصناعية، مع تصنيع محلي للغلايات وآلات الحرق، ما يحد من استيراد المعدات ويعزز الصناعة الوطنية.
وفي سياق ذي صلة، أبرزت شركة '' قرين سكاي" التي تنشط في مجال رسكلة الخشب وصناعة منصات خشبية صديقة للبيئة، على تقديم نماذج جديدة قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة موجهة للاستخدام في البناء المستدام والمشاريع الصناعية.وتعكس هذه المشاريع التزاما مزدوجا بالسلامة البيئية والصحة العامة، مع تقديم حلول عملية للاستفادة من النفايات، وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة، وتوفير منتجات صديقة للبيئة في مختلف القطاعات الصناعية والطبية.
كما عرضت الشركة المختلطة الجزائرية–المصرية "أر جي كاتاليست ألجيريا" في صالون الجزائر الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات، حصيلة تجربتها لتأكيد موقعها كشريك إقليمي في مجال إعادة تدوير و رسكلة المخلفات الخاصة والخطيرة.
شراكات دولية لمعالجة
و تثمين النفايات المعقدة و الخطرة
وأوضح مدير المجمع رامي زيدان، أن الشركة الجزائرية المصرية تنشط ضمن شبكة دولية تمتد من مصر، إلى سلطنة عمان وسلوفينيا، ما يعزز خبرتها في معالجة أحد أكثر أنواع النفايات تعقيدا، وعلى رأسها ''الحوامل الحفازة المستعملة (الكاتاليزور)".
وبين المتحدث أن الشركة تصدر الكاتاليزور من الجزائر إلى مصر لإعادة تدويره، غير أن المناخ الاستثماري المشجع في الجزائر دفع المجمع – كما ذكر - إلى إطلاق مشروع صناعي كبير في منطقة بلارة بولاية جيجل، وهو حاليا في طور الإنجاز. وسيخصص هذا المصنع لتثمين النفايات الخاصة الخطرة، خصوصًا الحوامل الحفازة، ضمن وحدة صناعية تمتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع، ما سيسمح باستخراج المعادن الثمينة وإعادة إدماجها في سلسلة الإنتاج.
وقدمت شركة "مدهوت" المتخصصة في رسكلة المكونات الإلكترونية إضافة نوعية، هي الأخرى خلال مشاركتها في صالون الجزائر الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات، حيث أوضح مسيرها ناصر بن حنيش، أن المؤسسة تعمل على تطوير شراكة استراتيجية مع مستثمر ألماني مستعد لجلب أحدث التكنولوجيا المتخصصة في معالجة هذا النوع الحساس من النفايات. وأشار إلى أن الشركة تمتلك رخصة الاستغلال وتتوفر على جهاز متطور لتدمير المعطيات الحساسة المخزنة في الأقراص الصلبة، كما اقترحت جهازا جديدا يعمل بتقنية الإتلاف المغناطيسي بقوة 500 واط لضمان محو كامل وآمن للبيانات.
وأكد بن حنيش أن "الحلول موجودة"، وأن الشركة استكملت الدراسة الخاصة بإنجاز مقرها الجديد بالتعاون مع الشريك الألماني، وهي حاليا في مرحلة تنسيق متقدم مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتجسيد المشروع ميدانيا.
تقنيات ذكية وآلات حديثة للفرز
الانتقائي الآلي

في مجال الابتكار، عرضت شركة ''جينوفكس''، آلة فرز انتقائي آلي للنفايات، قادرة على العمل في الفضاءات المفتوحة والمغلقة على غرار المطارات، ومقار الشركات، والمعارض، مع منصة تتبع ذكية للحاويات، تُمكن من معرفة نسبة الامتلاء والوقت ودرجة الحرارة والرطوبة.
وأوضح مدير الشركة، محمد إسلام رحال، لـ النصر، أن المشروع بدأ كفكرة جامعية قبل ثلاث سنوات، وتطور ليصبح شركة ناشئة، متخصصة في الابتكار البيئي. وتساهم هذه التقنية – حسب المتحدث - في رفع كفاءة الفرز، و تقليل الأخطاء البشرية، وتحسين جمع النفايات وإعادة تدويرها، إلى جانب إتاحة البيانات الرقمية لاتخاذ القرارات البيئية بشكل أدق، بما يعزز قدرة الجزائر على تطبيق نظم الاقتصاد الرقمي البيئي.
كما تبرز في ذات السياق تجربة شركة '' روسيكلو فارت" المتخصصة في تثمين النفايات الهامدة، وفرز البلاستيك، وفرز الحديد لاستخدامه في تبليط الطرقات وصناعة الألواح الإسمنتية، بما يدعم الاقتصاد المحلي.
أما المؤسسة الولائية لجمع ونقل النفايات لولاية معسكر، فحققت قفزة نوعية في إنتاج السماد العضوي من النفايات العضوية لتوفير مادة زراعية محلية، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية المستوردة.
تساهم هذه المشاريع في تحويل النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام، تعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، دعم الصناعات الوطنية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في الجزائر، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.
منتجات صيدلانية ومستحضرات تجميل صديقة للبيئة
أما في جناح مكتب الربط لجامعة الجزائر 1، بقيادة السيدة دليلة عبدون، فقدم فوج من الطالبات، بالتعاون مع البروفيسور عائشة بيا معامرية والدكتورة صبرينة بن مبارك، مشاريع مبتكرة لتطوير منتجات صيدلانية قابلة للتحلل وصديقة للبيئة، أنتجتها الخريجات في إطار مشاريع مذكرات الماستر 2، التي تحولت إلى مشاريع شركات ناشئة.
و في هذا الصدد برزت الشركة الناشئة، '' ليريا كوسمتيكس ''، التي أسستها خريجة قسم كيمياء صيدلانية، لينة ريان نعاك، والتي تقدم منتجات تجميل طبيعية من خلاصات نباتية، مع اعتماد على تثمين البقايا النباتية والزيوت غير المستغلة، ما يعزز الاستدامة ويقلل الهدر.
وتشمل مجموعة '' ليريا كوسمتيكس – حسب الشروحات المقدمة لنا ''صابونا طبيعيا متعدد النباتات بتركيبة تعتمد على خلاصات عديد النباتات مما يمنحه خصائص مطهرة ومرطبة ومجددة للبشرة، كما قدمت غسولا طبيعيا خال من الكبريتات والمواد الكيميائية الضارة، إضافة إلى زيوت طبيعية للعناية بالشعر، وتقوم كل هذه المنتوجات على تثمين البقايا النباتية والزيوت غير المستغلة، من خلال إعادة تحويلها إلى مستحضرات تجميل فعالة وآمنة، مما يجعل عملها – كما ذكرت- نموذجا واقعيا لتطبيق مبادئ تثمين النفايات داخل قطاع التجميل الطبيعي.
مشروع طلابي آخر يتمثل في المؤسسة الناشئة '' الحرة سكرتس"، لصاحبتها جيهان نور الهدى بوصوفة، والمتخصصة بدورها في العناية بالبشرة باستخدام مستخلصات نباتية محلية، تقلل الاعتماد على المنتجات الكيميائية الضارة، وتفتح المجال لتطوير سوق محلي صديق للبيئة.
أما مشروع " سبيرولينا '' بقيادة أحلام بومعزة، فيطبق التكنولوجيا الحيوية لمعالجة مياه الصرف الزراعي الصناعي عبر زراعة السبيرولينا، ما يسهم في تنقية المياه، امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج كتلة حيوية ذات قيمة مضافة عالية في مجالات متعددة مثل الأسمدة ومستحضرات التجميل، ويعتبر المشروع – حسب المشرفة – السيدة معامرية، نموذجا ناجحا للتقاطع بين الزراعة المستدامة والتكنولوجيا البيئية.
مشاريع مبتكرة في إطار العمل
الجمعوي

سجلنا في فضاء الصالون حضور ومشاركة نوعية لافتة للحركة الجمعوية الوطنية، التي لم تتأخر هي الأخرى في تقديم حلول مبتكرة، من بينها، الجمعية الوطنية التطوعية – الجزائر، التي قدمت "مشروع شعر البحر" الرامي لجمع الشعر من الحلاقين لاستخدامه في امتصاص الكربوهيدرات الملوثة في البحار، ومشروع مصفاة الواد لفصل النفايات الصلبة عن المياه.
كما سجلت الجمعية الجزائرية للتراث والبيئة والتنمية البشرية، حضورا متميزا لعرض تجربتها في مجال معالجة النفايات السامة، على مستوى وحدات قامت بإنشائها، و استخلاص المعادن الثمينة من "الكاتاليزور"، ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة للشباب في مجال البيئة.
وتؤكد هذه المبادرات على أهمية العمل الجمعوي في تعزيز الاستدامة البيئية، تحفيز الابتكار المحلي، خلق فرص عمل، وإدماج الشباب في الاقتصاد الأخضر، مما يربط بين التنمية المجتمعية والاقتصاد الوطني.
والمحصلة أنه مع اختتام الطبعة التاسعة من صالون الجزائر الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات، أكد المشاركون الذين التقت النصر بممثليهم، أن الابتكار والبحث العلمي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المؤسسات الناشئة والجمعيات، كلها عوامل أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام يحافظ على البيئة ويخلق قيمة اقتصادية حقيقية.
وقد جسدت هذه الطبعة رؤية وطنية متقدمة، تضع الجزائر على طريق الاقتصاد الدائري، وتحفز الشباب على الابتكار في مجال البيئة، مع تعزيز الاستفادة من الموارد المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات متعددة، من البناء إلى الطاقة والصناعات الكيميائية.